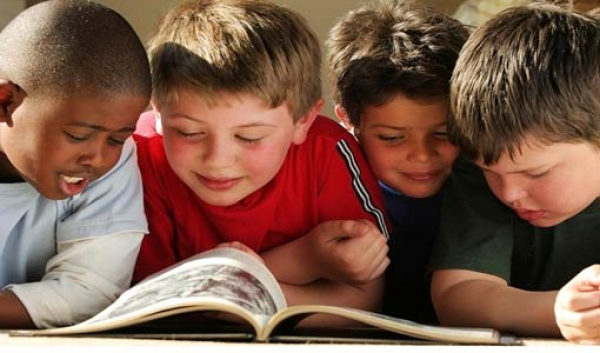emamian
تنمية حُب القراءة في نفوس أطفالنا
سهام الفضل
إنّ ظاهرة بُعد أطفالنا عن القراءة، وعدم اكتراثهم بها تستدعي التأمل وتستوقف الانتباه، وقد أثبتت الحقائق العلمية والبحوث الميدانية وأيدتها الملاحظة أنّ الولد الذي يشب بعيداً عن القراءة في صغره يظل عازفاً عنها، كارهاً لها... ويمكن ملاحظة ذلك عند أولادنا الذين تكدّس لهم مدارس العصر، البرامج الدراسية المكثفة، بشكل لا يستطيع معها الطفل أن يجد وقتاً للقراءة، وبالتالي أن يحب القراءة وتصبح نوعاً من الهواية لديه.. أضف إلى ذلك أنّ الطفل إذا ما بقي لديه بعض الوقت ولو كان قصيراً، فإنّه يسرع إلى التلفزيون أو الكمبيوتر أو غيرها من الوسائل الترفيهية الحديثة، التي قضت على أي أمل بأن يتوجه الطفل إلى القراءة.. ومع ذلك نجد أنفسنا أمام بعض التساؤلات: - ما هو الغرض من القراءة؟ وما هو دورها في حياة أطفالنا، وإلى أي مدى تسهم في نموهم؟ إنّ القراءة ضرورة حققها الإنسان الذي ميزه الله عن سائر المخلوقات بنعمة العقل والبيان ليتيسر له تبادل الأفكار مع أفراد مجتمعه وسائر الناس، ويعتبر الجاحظ إنّ القراءة هي: "الأداة الأقدم والأفضل بين كل ما أنتجته عبقرية الإنسان من وسائل التلقين. "لذا كان اهتمام المسلمين بالقراءة والكتابة تلبية للأمر الإلهي في قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق/ 1-5)، وعلى هذا إنّ القراءة خير ما يتيح للعقل من أن يقارن ويوازن، ثمّ يستنبط ويستدل ويستخلص، ومن ثمّ يكون لهذا أثره في السلوك بالقول والكتابة والعمل... ويؤكد ذلك قول بعض المربين عن الغرض من الكتابة أنه: "هو اقتباس الأفكار عن اللغة المكتوبة.. كذلك فإنّ الغرض من الإصغاء هو اقتباس الأفكار عن اللغة المحكية.. والقراءة على نوعين: قراءة جهرية وقراءة صامتة.. ولعل المتعلم أحوج إلى القراءة الصامتة على اعتبار أنها أكثر شيوعاً أو استعمالاً في الحياة اليومية، وأدعى إلى سرعة الفهم من القراءة الجهرية..". لقد تناول الباحثون العلماء القراءة من نواحيها المختلفة بالدراسة والبحث من حيث أنواعها، ومن ثمّ توصلوا إلى عدة نقاط: إنّ القراءة لا يمكن أن تصبح عادة بالضغط والإكراه، ولا ينبغي أن تكون تحت أي ظرف من الظروف، ولا ربط هذه العادة بأشكال من العقوبات إن لم تمارس، كأن تقول له: إن لم تقرأ هذا الكتاب سنحرمك من كذا وكذا. كما لا ينبغي جعل القراءة للأطفال شرطاً لقيام الأهل بأداء شيء يريدونه. إن إتباع هذا الأسلوب قد يولد إحساساً لدى الطفل بالعداء نحوها.. وهذا ينافي القول بأنّ القراءة هي استجابة طبيعية لاشباع حاجات نفسية تدفع الأطفال إلى القراءة، فما علينا إلا أن نضع بين أيديهم كتباً شائقة الموضوع، حتى تصبح القراءة لديهم عادة ومتعة ومحببة منذ الصغر، ننميها لديهم لما لها من دور في حياتهم. لنرى ما كتبه الأستاذ عباس محمود العقاد عن سبب حبه للقراءة يقول: "لست أهوى القراءة لأكتب، ولا أهوى القراءة لأزداد عمراً في تقدير الحساب، وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، وحياة واحدة لا تكفيني ولا تحرك كل ما فيّ من بواعث الحياة، والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة في مدى عمر الإنسان الواحد لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق، وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب. فكرتك أنت فكرة واحدة، وشعورك أنت شعور واحد، خيالك أنت خيال فرد إذا قصرته عليك، ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة أخرى، أو لاقيت بشعورك شعوراً آخر، ولا قيت بخيالك خيال غيرك، فليس قصارى الأمر أنّ الفكرة تصبح فكرتين، أو أنّ الشعور يصبح شعورين، أو أنّ الخيال يصبح خيالين، كلا، وإنما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مئات الفكر من القوة والعمق والامتداد". إنّ هذا الأمر يصدق إلى حد كبير مع أطفالنا، إنّ للقراءة دوراً في حياتهم لا يقل عن الدور الذي تلعبه في حياة الكبار.. والسؤال الذي نطرحه كيف نحبب ونشوق أطفالنا إلى القراءة؟ - كيف تجعل طفلك قارئاً؟ يبدأ المربي بتعويد طفله على القراءة الممتعة المتواصلة. فمهارة القراءة لا ترسخ في الذهن إلا بالمران والاستعمال.. وبالتالي تبدأ القراءة تؤتي أكلها، فمن خلالها يقول أحد المربين: "تدرس القيم، وتعمق المبادىء، وتكوّن الاتجاهات، وتوسع الميول، وترهف الإحساسات، وتنمي التذوق، وتشبع الحاجات النفسية المختلفة، وتوثق الصلة بين الطفل والصفحة المطبوعة، إنها باختصار تضيف إلى عمره عمراً، وإلى حياته حياة ما كان له أن يحظى بهما لو نشأ عزوفاً عن القراءة، بعيداً عن مصادر المعرفة والتثقيف..". نتوصل إلى أنّ للطفل حاجات نفسية متعددة يستطيع أدب الأطفال أن يسهم في إشباعها، وقبل أن نبين حاجات الطفل نتطرق إلى أهمية المكتبة المنزلية الصالحة.. وكيف نلبي حاجات الطفل النفسية. - أهمية وجود مكتبة في البيت: إنّ وجود مكتبة في البيت يساهم بشكل كبير في بناء المادة الفكرية والعلمية للأطفال والسبب في ذلك يرجع إلى أهمية الكتاب والإستفادة منه لأنّه يشكل الدعامة الأولى للمعرفة لما تقدم لهم من مناهل الثقافة، وتهديهم إلى مصادر المعرفة في أقصر وقت وبأيسر جهد. لذا يجب إعداد مكتبة ذات رفوف قريبة من الطفل يستطيع أن يصل إليها بسهولة ليختار ما يشاء منها. لأنّ المكتبة تشكل جزءاً أساساً من أركان البيت، ولها غرض ثقافي ولأنها كما قلت تقدم للأبناء المعلومات العامة للإستزادة من المعرفة والثقافة العامة، فالطفل يجب أن يتعرف على أشياء كثيرة تحيط به يؤثر فيها أحياناً وتؤثر فيه أخرى نتيجة حاجة هامة من حاجاته العقلية وهي الحاجة إلى الاستطلاع. يقول أحد الكتاب: "كثير من الأسر التي لا توفر أجواء المطالعة والمكتبة يعاني أبناؤها من الفقر الفكري، ولذلك فإن بيوت العلماء والمفكرين تخرج علماء ومفكرين في حين بيوت الصناع تخرج صناعاً، فالجو العام في البيت له تأثيره الكبير في بناء الفكر المطلوب للأبناء بشكل متكامل". كذلك فإن أدب الأطفال إذا خصص صفحات للمسابقات، ولألعاب التسلية ينمي الذكاء والمعلومات وإثارة الرغبة في القراءة، ويمكن أن تتطور لتشجيع الأطفال ذوي المواهب في الأدب والفنون على تقديم انتاجهم في مسابقات أدبية أو فنية مناسبة يمكن نشر ما يفوز منها في مجلة مخصصة للأطفال. لذا يجب على المربي أن يختار لأطفاله الكتب التي تحتوي الفكرة والموضوع، والتشويق والألعاب والتسلية لتصبح القراءة لديه متعة يلجأ إليها في وقت فراغه. - من حاجات الطفل النفسية: حاجته إلى الأمن: يقول أحد المربين: "فالقصص التي يشيع فيها حب الآخرين وحرص أفراد الأسرة بعضهم على بعض، والتآزر بينهم في مواجهة مواقف الحياة المعقدة ومشكلاتها المختلفة، نقول أن أمثال هذه القصص تشبع إلى حد كبير حاجة الطفل إلى الإحساس بالطمأنينة والأمن، إنّه يتابع باهتمام شديد أحداث القصة ليرى كيف يسلك كل من أفراد العائلة تجاه الآخرين، كما يتابع الخط الذي تنمو فيه هذه العلاقة". وكل ذلك له أثره الفعال في حياته داخل أسرته. شعوره بقيمته الذاتية: إنّ الطفل يريد أن يكون شخصاً هاماً معتنى به له مكانه في أسرته ومجتمعه وأن يعترف به كشخص له قيمة ومكانة، لذا يساهم أدب الأطفال من خلال قصص: يحترم فيها الأب ابنه والأُم ابنتها، وإن تقديم المدح والثناء للطفل على كل عمل يقدمه ينمي ثقته بنفسه. يضاف إلى كل ما سبق أن قراءة الكتب والقصص تنمي عند الأطفال ثروتهم اللغوية. كما تساعد على اتقان اللغة العربية وغير العربية. وكلما أتقن اللغة سهل عليه فهمها واكتساب الكنوز العلمية والأ>بية المدخرة فيها، كما أن إتقان اللغة العربية تساعدهم على التحديد الدقيق لمفاهيمها فضلاً عن تنمية بعض المهارات فيهم. فلنحرص على الدقة في تشكيل الكلمات ليلتفت الأطفال منذ البداية إلى الكلمة الصحيحة. فعلينا كمربين ومدرسين أن نجعل الطفل يألف هذه اللغة بجميع مفرداتها وتراكيبها واصطلاحاتها وقواعدها على أتم وجه.. - ما هو دور الأسرة في تنمية ميول الأطفال في القراءة وتشجيعهم عليها؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب علينا أن نوضح أوّلاً مسؤولية الأسرة. لقد اهتم الإسلام بدور الأسرة لأنها كما يقول محمد لبيب النجحي: "هي البيئة الاجتماعية الأولى التي يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته والتعرف على نفسه عن طريق عملية الأخذ والعطاء والتعامل بينه وبين أعضائها.. وفي هذه البيئة الاجتماعية يتلقى أول إحساس بما يجب وما لا يجب القيام به". كذلك اهتم الإسلام بالبيئة التي تحتضن الطفل، لأنّه دائماً يحتاج إلى أحضان ملئوها الرعاية والعون، وبيئة ثقافية يعيش فيها ويتشكل لأنّه شديد التفاعل والاندماج مع البيئة المحيطة به، وقد قصد بالبيئة الاجتماعية بأنها: "المجتمع البشري وعلاقات أفراده وجماعاته بعضهم مع البعض الآخر. فالبشر والعلاقات البشرية على اختلاف أنواعها سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم مهنية أم ثقافية أم سيكولوجية أم غير ذلك يتألف منها البيئة الاجتماعية". إنّ بعض علماء النفس قام بتجارب على بعض الأطفال الذين يبلغ عمرهم أربع سنوات.. وجاءت النتائج مذهلة، ذلك أنّ الطفل الذي يبلغ عمره أربع سنوات، وقد نشأ في وسط عائلة مستقرة مادياً وأدبياً.. ويعيش في منزل تتوافر فيه الكتب والمجلات.. يستطيع أن يتعلم أي شيء بسهولة تامة.. ودرجة ذكائه عادة تكون أكبر من درجة الطفل الذي ينشا وسط الأحياء الفقيرة المعدمة ويعيش في منزل لا يهتم أحد فيه بالثقافة. نعود إلى دور الأسرة في تنمية ميول الأطفال في القراءة وتشجيعهم عليها، إن هنالك مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك: 1- بما أنّ البيت يأتي في مقدمة المؤسسات الاجتماعية الأكثر تأثيراً في الطفل وتكويناً لشخصيته، لذا يجب أن يكون كل من فيه قدوة صالحة لها دورها الفعال. وقد ذهب بعض علماء النفس إلى أنّ الطفل مقلد لوالديه في كثير من أعماله، لأنّه النموذج الذي يجب أن يحتذي به ويؤكد ذلك قول أحد المربين: "بأنّ القراءة شأن أي سلوك آخر تلعب القدوة فيه دوراً كبيراً في تنميته، ولنتصور طفلين أحدهما يرى والده يتصفح قبل أن ينام مجلة أو يقرأ كتاباً، وثانيهما طفل لا يعرف الكتاب منزله ولا يطرق بابه، فلنشعر أطفالنا بأهمية الكتاب والقراءة لأنّ الكتاب عُرف على مر السنين أنّه الصديق الأمثل، وأنّ القراءة هي الهواية التي تغذي العقل والروح، والأسرة الناجحة هي التي تعتني بالكتاب وبنوعيته، وبإثارة اهتمام أطفالها نحوه وعنايتهم بنظافته وترتيبه... 2- من واجبات الأسرة كذلك إعطاء فرصة للطفل للاختيار في مجال اقتناء الكتب التي يريدها بما يتناسب مع رغبته وقدراته وميوله دون أن نفرض عليه كتاباً معيناً.. والسبب في مراعاة قدرات الأطفال وميولهم هو أن لا نرهقهم بقراءة كتاب يصعب عليهم فهمه وقراءته دون رغبة فيه. فعلى المربين أن يختاروا لأطفالهم من الكتب ما يتناسب وأعمارهم وثقافتهم وميولهم وقدراتهم حتى تكون الفائدة أكبر والقطاف أنضج ويكون بذلك تلبية لقول الإمام علي (ع): "حدّثوا الناس عما يعرفون". وبالتالي إذا أغري الطفل بمطالعة الكتب التي تلائم سنه وميوله ودُرب على القراءة في البيت وعلى مقاعد الدراسة رافقته هذه العادة الطيبة كل أيام حياته، ونكون بذلك قد أوجدنا به عادة وهواية ومنفعة يشكرنا عليها طيلة حياته. 3- ولتشجيع أطفالنا على القراءة ينبغي أن تخصص الأسرة جزءاً من ميزانيتها لشراء الكتب تثري بها المكتبة المنزلية.. كما أن عليها من فترة إلى أخرى أن تحرص على سماع ما يقرأ أطفالهم والإنصات إليهم لتحببهم بها وبيان اهتمامهم بالكتاب وبهم. كما ينبغي اصطحاب أولادنا إلى المكتبات العامة ومعارض الكتاب، لأن من شأنها أن تخلق رغبة قوية لدى الطفل في اقتناء الكتب، بل إنّ عملية ارتياد المكتبة العامة تصبح إحدى متعه اليومية حيث تنمى لديه الاستقلال في تحصيل المعرفة.. فضلا على خلق صلة طيبة بينه وبين أمين المكتبة لأنّه دائماً يلبي متطلبات ورغبات الطفل في اختياره للكتاب، فضلاً عن اطلاعه على كل جيد في عالم الكتب. وأخيراً.. إن أعظم تشجيع للطفل لتعلم القراءة يكون بخلق الإحساس لديه بأن قراءة الكتب والصحف والمجلات مهمة وممتعة ولها دورها الفعل في حياته الثقافية والاجتماعية... ونختم بقول أحد المربين أنّ "الأمة التي يحسن كل أبنائها القراءة والكتابة، ويستطيعون الاستفادة منهما، لي أفضل من حيث المستوى الاجتماعي، وأرقى حضارة وأسرع تقدماً، وأجدر بالاعتبار من أمّة عشرها علماء، وتسعة أعشارها أميون". فلنجعل الكتاب ثروتنا وحاجتنا، وصدق الإمام جعفر الصادق (ع) حين يقول: "احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها". وقال أيضاً: "إنّه سيأتي على الناس زمان هرج لا يستأنسون فيه إلا بكتبهم".
أيهما أهم للصحة.. سرعة المشي أم عدد الخطوات؟
الجواب مع باحثين من جامعة سيدني بأستراليا وجامعة جنوب الدانمارك، وجدوا أن انخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان والوفاة يرتبط بتحقيق 10 آلاف خطوة في اليوم
ومع ذلك، فإن سرعة المشي أظهرت فوائد تتجاوز عدد الخطوات التي تم تحقيقها.وقال الدكتور ماثيو أحمدي باحث في كلية الطب والصحة بجامعة سيدني: "إن حجم ونطاق هذه الدراسات التي تستخدم أجهزة التتبع التي يتم ارتداؤها على المعصم، يجعلها أقوى دليل حتى الآن يشير إلى أن 10 آلاف خطوة في اليوم هي المقدار المثالي للفوائد الصحية، وأن المشي بشكل أسرع يرتبط بفوائد إضافية"يوفر المشي السريع فوائد كثيرة للجسم والعقل، أما فوائد المشي السريع لمدة ساعة يوميا فتكون مضاعفة بالمقارنة بفوائد المشي السريع لمدة نصف ساعة ولكنها قد تكون منهكة للجسم،
ويمكن أن تشمل فوائد المشي السريع لمدة نصف ساعة يوميا:
رياضة المشي السريع لحرق الدهون إذ يساعد المشي السريع على فقدان الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية وزيادة كتلة العضلات.
تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
تقليل مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة الضار في الجسم.
من فوائد المشي السريع لشد الجسم زيادة كتلة العضلات الضعيفة مما يساعد على شد الجسم وإعطائه قوام رشيق.
تخفيض ضغط الدم.
خفض سكر الدم من خلال تحسين زيادة حساسية الأنسولين في الخلايا.
تحسين صحة العقل وزيادة قوته.
تحسين جودة النوم والتخلص من الأرق.
زيادة الثقة بالنفس، والتقليل من خطر التقلبات المزاجية.
تحسين عملية الهضم، وحركة الأمعاء والتخلص من الإمساك.
الحياة.. نسائم أمل ورجاء
يمكن أن تكون الحياة مزرعة بأحد المعاني التالية:
أ) مزرعة مهمة متروكة بلا عناية ولا إهتمام، تكثر فيها الاشواك والطحالب والطفيليات والأمراض والنباتات الضارة.. صفراء.. هزيلة.. خاوية.. تبعث على الأسى والأسف.
ب) مزرعة مزدهرة، نظرة، مثمرة، خَضِرة.. ظلالها وارفة كثيفة، وأشجارها مهرعة عامرة، العناية بها دائمة متواصلة، فهي تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها، يقول الشاعر في المقارنة بين المزرعتين:
إذا أنتَ لم تزرعْ وأبصرتَ حاصداً *** ندمت على التقصير في زمنِ البذر!!
وهذا هو معنى (التغابن) كاسم من أسماء القيامة.. لأنّ مَن جدّ وجد ومَن زرع حصد، ومَن لم يفعل ندم وافتقد، ومن استثمر الحياة - وهي أفضل رأس مال عرفه الإنسان- استحالت مزرعته من (جنينة) إلى (جنّة)، ومن أهملها -عامداً أو مقصّراً- عاش (الفقر) و(القفر) في نار لا تبقي ولا تذر.
هل هناك بين الصنفين صنف ثالث؟ نعم، هم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فعسى أن يتوب الله عليهم.
- الحياة متجرٌ كبير:
يعرف التجّار قبل غيرهم أنّ السوق لا تحابي ولا تجامل أحداً، في قائمة ونشطة بنشاط أربابها وأصحابها والساعين لادامة حركتها، وانّ خير التجّار وأكثرهم ربحاً هم الذين يلتزمون بأصول التعامل في السوق، ويحرصون على اكتساب سمعة طيبة تتيح لهم الحظوة عند زملائهم من رفاق السوق وعند عملائهم وزبائنهم. الحياة يمكن أن تكون متجراً كبيراً لا تكاد حركة البيع والشراء تتوقف فيه لحظة: (البائع) فيها الإنسان نفسه، و(المشتري) هو الله تبارك وتعالى، و(البضاعة) أو (التجارة) هي الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان لكسب رضا صاحب السوق، المهيمن عليها، والمتصرّف بأحوالها وفق نوايا وأهداف وأساليب تعامل، ومقاصد تجّارها. هي تجارة من نوع خاص وفريد جدّاً، (المشتري) فيها هو (المانح) وهو (القابض) وهو (المكافئ).. والبائع فيها رابح في جميع صفقاته، فإذا باع بصدق وتعامل بإخلاص، فهو لن يخسر شيئاً على الاطلاق، فالتجارة مع الله رابحة.. ورابحة دائماً، والإيمان به والعمل في سبيله يحقق من درجات الربح أكلها وأعلاها.. هاتِ لي أيّة خسارة في الحياة الدنيا بالنسبة للعاملين في سوق الله، إنّها في حسابات التجارة الربّانية والصفقات الإلهيّة رابحة وإن بدت في أعين الناس خسارة.. هي رابحة ربحاً غير مرئيّ ولا منظور، أو انّه غير قابل للحساب عن طريق الرياضيات. المتاجرون مع الله يتحدثون وإنما عن شيء اسمه الألطاف الخفيّة، فإذا خسروا شيئاً، أو فقدوا شيئاً، التمسوا تعويضه أو (ربحه) في غيره.. وإليك بعض الأمثلة: هم يجدون -مثلا- في الخسائر الآنية ربحاً مستقبلياً أكبر.. أو قرباً إلهياً أكبر يتيح لهم أن يلجأوا إلى ملاذهم، ولذلك ترى أنّ شعارهم هو (الخير في ما وقع) حتى وإن بدا هذا الواقع للوهلة الأولى ليس خيراً، بل شرّاً ظاهر، الّا أنّهم ينظرون إلى (النصر المعنوي) إن فاتهم (النصر المادِّي)، ويستطلعون نحو الأفضل إن خسروا ما بين أيديهم من صفقات مادّية. ذات مرّة احترقت معامل مخترع الكهرباء (أديسون) وكان قد تقدّم به العمر.. كان يمكن أن يقول وهو واقف على أطلال معامله التي استحالت رماداً: لم يعد في العمر فسحة أو متسع لإعادة البناء من جديد.. أو يقول: لقد احترقت آمالي كلّها جميعاً.. أو يقول: يكفيني ما أنجزت وحققت.. لم يقل ذلك، بل قال: الحمد لله.. سيكون بامكاننا أن نعيد البناء من جديد وبلا أخطاء هذه المرّة!! تجّار السوق الإلهيّة لا يختنقون بسموم الحياة، تبت عليهم نسائم الأمل والرجاء على طول طريق الحياة.. هي (سيولتهم) إن فقدوا السيولة!!
شهيد فلسطيني في مواجهات جنين ومقاومون يستهدفون حاجزاً إسرائيلياً
استشهد في ساعة مبكرة اليوم الخميس فتى فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر دان غرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر طبية أن "عدي طراد هشام صلاح " استشهد من جراء إصابته برصاصة في الرأس في المواجهات الدائرة في بلدة كفر دان.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "صفا" بأنّ مواجهات عنيفة اندلعت في كفر دان بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة ودهم منازل ذوي الشهيدين، أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.
وقال شهود عيان إنّ قوات الاحتلال أخضعت ذوي الشهيدين إلى تحقيق ميداني، فيما اعتقلت الشاب أحمد عباد، ابن عم أحد الشهيدين.
كذلك، استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء أمس الأربعاء، حاجز "دوتان" الإسرائيلي قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالرصاص، قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام.
وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مقتل ضابط إسرائيلي بعد إطلاق مسلحين فلسطينيين النار قرب حاجز الجلمة في جنين.
المصدر:المیادین
ايران توقّع على الزامات العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي
وقع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان على مذكرة الزامات العضوية الدائمة لايران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، وذلك اثناء حضوره قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي في مدينة سمرقند الاوزبكية برفقة الوفد الايراني عالي المستوى.
وقال الوزير أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر مساء الاربعاء انه والامين العام لمنظمة شنغهاي قد وقعا هذا المساء في مدينة سمرقند التاريخية على الزامات العضوية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة شنغهاي للتعاون.
واضاف وزير الخارجية "لقد دخلنا الان في مرحلة جديدة من شتى اشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة و غيرها" وتابع " لقد قدم الامين العام للمنظمة تهانيه بمناسبة الانضمام الدائم لايران والتوقيع على الوثيقة واعتبره تطورا هاما".
هذا وكان اعضاء منظمة شنغهاي قد وافقوا على الانضمام الدائم لايران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.
وقد وصل الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي يوم الاربعاء الى مدينة سمرقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية الى اوزبكستان.
وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة اقليمية كبرى انشأت في عام 2001 بهدف اطلاق التعاون المتعدد الاوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان .
وقد انضمت لهذه المنظمة فيما بعد دولة منغوليا في عام 2004 ، كما انضمت اليها ايران وباكستان والهند وافغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت اليها بيلاروسيا ايضا بصفة مراقب فيما بعد.
واصبحت الهند وباكستان عضوان دائميان في المنظمة في صيف عام 2016 فيما استمرت ايران ومنغوليا وافغانستان وبيلاروسيا في العضوية بصفة مراقب.
اما الاعضاء الدائمون فهم الهند وكازاخستان والصين ومنغوليا وباكستان وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان، فيما تشكل ايران وافغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا الاعضاء المراقبون، الى جانب 6 دول أخرى هم شركاء الحوار في المنظمة وهم جمهورية أذربيجان وارمينيا وكمبوديا والنيبال وتركيا وسريلانكا.
الرئيس الايراني يجتمع بأمين عام منظمة شانغهاي للتعاون
إجتمع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بأمين عام منظمة شانغهاي للتعاون " جانغ مينغ" اليوم الخميس، على هامش أعمال القمة الـ 22 لزعماء منظمة شانغهاي التي تستضيفها " سمرقند" في أوزبكستان.
ويزور رئيسي اوزبكستان ايضا، لاجراء لقاءات رسمية مع مسؤولي البلاد.
وتضم المنظمة الاعضاء الرئيسين، الهند وكازاخستان والصين وقرغيزيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان.
وتشارك ايران وبيلاروسيا وافغانستان ومنغوليا بصفة مراقب، فيما دول آذربيجان وأرمينيا وكبموديا النيبال وتركيا وسيرلانكا فتشارك بصفة شركاء حوار لمنظمة شانغهاي للتعاون.
وسط اجراءات امنية وخدمية مكثفة.. الملايين يتوافدون الى كربلاء المقدسة لاحياء الاربعينية
مسلمو العالم توحدوا في كربلاء خلف راية الامام الحسين عليه السلام في مسيرات وتجمعات اختصرت شغف الانسانية جمعاء بالثورة الحسينية.
بدت كربلاء كما لو انها ملاذاً لكل المظلومين والمستضعفين في كل اقطاب الارض.
افواج تتلوا اخرى، الصغير والكبير والنساء والشيوخ يتسابقون لشرف زيارة المرقد المقدس، وعلى الرغم من كثافة الحشود الزائرة والاجراءات الامنية المكثفة، الا ان مراسم الزيارة تسير بانسيابية تامة يكاد لا يستشعرها الزائر.
وتشير توقعات السلطات المحلية في كربلاء الى ان اعداد المشاركين في ذكرى اربعينية الامام الحسين هذا العام قد تصل الى 20 مليون زائر من بينهم 3 ملايين زائر من جمهورية ايران الاسلامية.
وتواصل الحشود المليونية توافدها من جميع انحاء العالم باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام لتجديد البيعة والولاء للثورة الحسينية.
قائد الثورة الاسلامية يبلغ السياسات العامة للخطة التنموية الـ 7 للبلاد
قام قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي اليوم الاثنين بإبلاغ السياسات العامة للخطة التنموية الـ 7 للبلاد تنفيذا للبند الاول في المادة 110 من الدستور.
وجاء هذا الابلاغ بعد استشارة سماحته مجمع تشخيص مصلحة النظام مع أخذ اولوية تطور الاقتصاد المصحوب بالعدالة حيث تم ارسال هذه السياسة الى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس المجمع ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.
وأعرب سماحته عن شكره للجهود التي بذلها اعضاء وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في تقديم وجهات نظرهم والمشاركة الفاعلة للسلطات الثلاث والاركان الاخرى في النظام الاسلامي، معتبرا اعداد ومصادقة قانون الخطة التنموية السابع على اساس هذه السياسات خطوة اخرى لتحقيق اهداف النظام الاسلامي.
وتشمل السياسات العامة لهذه الخطة التنموية الامور التالية: الاقتصاد وشؤون البنية التحتية والثقافة والاجتماع والعلم والتقنية والتعليم السياسة والسياسة الخارجية والدفاع والامن والادارة والحقوق القضائية.
والبنود التي أقرها سماحته مايلي:
الاقتصاد:
۱ـ الهدف العام والأولوية الرئيسية للخطة السابعة، وفقا للسياسات العامة المعتمدة، هو التقدم الاقتصادي جنبا إلى جنب مع العدالة بمتوسط معدل نمو اقتصادي يبلغ 8٪ خلال البرنامج.
۲ـ ترسيخ الاستقرار على المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف والتضخم الأحادي الرقم خلال خمس سنوات وتوجيه السيولة والائتمانات المصرفية نحو الأنشطة الإنتاجية.
۳ـ إصلاح هيكل الميزانية الحكومية من خلال:
- حصر وتوضيح الديون العامة والتزامات الحكومة وادارتها وسداد الديون.
تحقيق الموارد وإدارة النفقات الحكومية وتجنب الاقتطاعات في الميزانية.
تحديد مهام المشاريع الإنشائية نصف المكتملة بتسليمها من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص غير الحكومي في مشاريع البناء الهادفة للربح.
بيان وتنظيم إيرادات ومصروفات شركة النفط والشركات الحكومية الأخرى في الموازنة.
۴ـ إحداث تحول في النظام الضريبي مع نهج تحويل الضرائب إلى المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي الحالي، وإنشاء قواعد ضريبية جديدة، ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز دور توجيه وتنظيم الضرائب في الاقتصاد مع التركيز على ازدهار الإنتاج و العدالة الضريبية.
۵ ـ إنشاء نظام ضمان اجتماعي شامل يشمل مجالات الإغاثة والدعم والتأمين على المستويات الأساسية والفائضة والتكميلية من أجل تقديم خدمات عادلة.
6- ضمان الأمن الغذائي وإنتاج ما لا يقل عن 90٪ من السلع الأساسية والمواد الغذائية بالداخل مع الحفاظ على الاحتياطيات والموارد المائية وتحسينها ورفع مستوى صحة وسلامة الغذاء.
تعديل نمط الزراعة حسب المزايا الإقليمية والموارد المائية وإعطاء الأولوية لإنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية.
۷ـ إنشاء نظام إدارة متكامل للموارد المائية بالدولة وزيادة إنتاجية المياه الزراعية بنحو خمسة بالمائة.
التحكم في المياه السطحية وإدارتها وزيادة موارد المياه الجوفية من خلال إدارة مستجمعات المياه والخزان الجوفي.
التخطيط للحصول على مياه أخرى وإعادة تدوير المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي.
۸ ـ الزيادة القصوى في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الحقول المشتركة.
زيادة معدل إعادة التدوير في المجالات المستقلة.
زيادة القيمة المضافة من خلال استكمال سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز.
۹ـ تنفيذ العديد من الخطط الاقتصادية الوطنية الضخمة، والرئيسية، والبنية التحتية، الحديثة التي تقوم على اساس النظرة المستقبلية.
۱۰ـ تفعيل المزايا الجغرافية السياسية وتحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات والطاقة والاتصالات والمواصلات من خلال تسهيل اللوائح وإنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة.
۱۱ـ تحقيق السياسات العامة لتنمية الأراضي فيما يتعلق بالمزايا الفعلية والمحتملة وتنفيذ حالاتها العالقة مع إيلاء اهتمام خاص للبحر والسواحل والموانئ والمياه الحدودية.
۱۲- تحسين النظام الصحي على أساس السياسات الصحية العامة.
البعد الثقافي والاجتماعي:
۱۳ـ الارتقاء بالثقافة العامة من أجل ترسيخ نمط الحياة الإسلامية الإيرانية، وتعزيز التضامن الوطني والثقة بالنفس، وتعزيز الهوية الوطنية وروح المقاومة والعمل والجهد في المجتمع من خلال حشد كافة مرافق وقدرات الدولة ، الحكومية والوطنية.
۱۴ـ تعزيز كفاءة وفاعلية الإعلام الوطني في توسيع وتعميق الثقافة الإسلامية الإيرانية والتصدي الفعال للحرب النفسية والغزو الثقافي والسياسي للأعداء.
۱۵ـ تعزيز ركن الاسرة وازالة العقبات التي تحول دون النمو وتطور النساء.
۱۶ـ زيادة معدل الولادة إلى 2.5 على الأقل في خمس سنوات، بما في ذلك دعم الإنجاب، وإزالة العقبات، وخلق حوافز فعالة، والإصلاح الثقافي.
۱۷ـ تطوير السياحة والدعاية للصناعات اليدوية.
۱۸ـ تعزيز الصحة الاجتماعية والوقاية والحد من الأضرار الاجتماعية وخاصة الإدمان والتهميش والطلاق والفساد بناء على مؤشرات صحيحة والاستفادة القصوى من مشاركة الناس وفي الوقت المناسب.
الشؤون العلمية والتكنولوجية والتعليمية:
۱۹ـ ترسيخ السيادة الوطنية وحماية القيم الإسلامية الإيرانية في الفضاء السيبراني من خلال استكمال وتطوير شبكة المعلومات الوطنية وتوفير المحتوى والخدمات المناسبة، وتعزيز القوة السيبرانية على مستوى القوى العالمية ، والتأكيد على تعزيز أمن الدولة والبنى التحتية الحيوية والبيانات العامة.
۲۰- زيادة تسريع التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكار وتسويقهما ، خاصة في مجالات المعلومات والاتصالات ، والتكنولوجيا الحيوية ، والتكنولوجيا الدقيقة ، والطاقات الجديدة والمتجددة.
تحديث وتعزيز نظام التعليم والبحث في الدولة.
شؤون السياسة والسياسة الخارجية:
۲۱ـ النشاط الفعال في الدبلوماسية الرسمية والعامة من خلال خلق التحول الثوري وبناء القدرات في الموارد البشرية في الجهاز الدبلوماسي والتعاون المستهدف والفعال للمنظمات والمؤسسات المسؤولة عن الشؤون الخارجية.
۲۲ـ تعزيز النهج الاقتصادي في السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والعالمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أولوية الجيران.
الشؤون الدفاعية والامنية:
۲۳ـ تعزيز القاعدة الدفاعية من أجل تحسين الردع واكتساب التقنيات القوية التي تحتاجها الصناعات الدفاعية والأمنية ، مع التأكيد على الاكتفاء الذاتي للدولة في أنظمة ومعدات وخدمات الأولوية من خلال تخصيص ما لا يقل عن 5٪ من الميزانية العامة للدولة.
۲۴ـ تقوية البنى التحتية وتحسين الآليات والأجهزة العامة لحماية وتحسين المرونة ضد التهديدات، وخاصة التهديدات السيبرانية والبيولوجية والكيميائية والبروتينية مع أولوية الدفاع المدني.
الشؤون الادارية والقانونية والقضائية:
۲۵ـ التحول في النظام الإداري وإصلاح هيكله على أساس السياسات العامة للنظام الإداري مع التأكيد على ذكاء وإدراك الحكومة الإلكترونية، وإزالة المنظمات الموازية وغير الضرورية ، وتحديث القوانين والأنظمة ، وإصلاح الأساليب والقضاء على الفساد وأسسه في الإدارة.
۲۶ـ تحديث وثيقة التحول القضائي وتنفيذها مع التركيز على الحيلولة دون وقوع الجرائم والدعاوى القضائية.
- استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات القضائية.
- تنفيذ الحدود بنسبة 100٪.
الدعم القانوني والقضائي للاستثمار والأمن الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
- الاستفادة من قدرات الناس وتطوير الأساليب التعاونية وغير القضائية في تسوية الدعاوى.
- تقوية وتثبيت نصيب القضاء من موارد الموازنة العامة للحكومة وتوفير الاحتياجات المالية والتوظيفية للقضاء.
- رفع المستوى العلمي والكفاءة المعنوية للضباط القضائيين.
- مراجعة القوانين للحد من أنواع الجرائم وتقليل استخدام أحكام الحبس.
تربية احترام الوقت
لعل أظهر عيوبنا والتي تتمحور حولها معظم سلبيات الأداء أنّنا لا نقدّر قيمة الوقت، مقارنة مع من سبقونا على مضمار التطور العصري وهذا أمر شديد الخطورة يستحق أقصى الاهتمام في العملية التربوية ومنذ الصغر.
أن تحيا يعني أن تشعر بنبضات الزمن، تلك النبضات التي يظهر وقعها في كلّ التغيرات التي تجري في عالمنا الداخلي (النفسي) وعالمنا الخارجي (عالم الأشياء والوقائع) على السواء.
والزمن نسبي كما هو معلوم، فكل عالم له زمن محلي خاص به، بل إنّنا في عالمنا هذا نجد أزمنة عدة: زمن طبيعي تجري في رحابه الظواهر الطبيعية وزمن بيولوجي يتعلق بذات الإنسان ككائن عضوي يتكون من خلايا حية وزمن نفسي داخلي يتعلق بحياتنا النفسية ومشاعرنا الداخلية, وزمن تاريخي يتعلق بكل ما يصنعه الإنسان في شتى الحالات الاجتماعية عبر مسيرته التاريخية سواء كان فردا أو جماعة وهذا الصنف الأخير هو الذي يمس الإنسان مسا أعمق من غيره، ذلك لأنّ له علاقة مباشرة بحياته أي بمنجزاته وبطموحاته وبقيمه التي يختارها ويؤسس عليها سلوكه، وهو غالباً ما يبدأ الوعي به فور أن يشعر الكائن بالتغيرات التي تطرأ على محيطه الذي يعيش فيه خاصة حين يبدأ في التمييز بين ذاته كوجود مستقل وبين موضوعات العالم الخارجي التي تؤثر فيها هذه الذات وتتعامل معها. ويتفق علماء النفس على أن هذا الوعي نبدأ في اكتسابه منذ مراحل الطفولة المبكرة وينمو حسب تعامل ذواتنا مع المحيط ثم ينتهي بموت الفرد.
فما دور هذا الوعي بالزمن وما مدى تأثيره في تفاعلنا مع العالم الذي نعيشه؟
مرحلتان
إننا إذا أخذنا معياراً نفعياً لقياس هذا الوعي تجلت - في نظرنا - مرحلتان أساسيتان يمر من خلالهما الإنسان:
- المرحلة الأولى، وهي التي تبدأ منذ الولادة وتنتهي عند البلوغ، يكون الوعي فيها شبه منعدم ونعني بذلك عدم شعور الطفل بقيمة الزمن وأهميته وهذا - بالطبع - راجع لعدم نضج جهازه العضوي من جهة ولعدم اكتسابه خبرات اجتماعية من جهة أخرى ولذلك فإدراك الزمن في أبعاده الثلاثة (حاضر- ماض- مستقبل) والعلاقات التي تربط بينها يكون غير مكتمل، بل يكون فقط عبارة عن إحساس لا يؤدي بعد إلى ما يمكن أن نسميه بالقلق أو التوتر النفسي الذي يدفع الكائن الإنساني إلى القيام بأفعال وردود أفعال تجاه مثيرات تمس شخصيته ومقامه.
ـ المرحلة الثانية، وهي التي تبدأ مع سن النضج وتستمر حتى الشيخوخة مع ملاحظة أن تفاعلاتها تقل حدتها شيئا فشيئا مع الزمن.
ففي هذه المرحلة يبدأ الكائن في الوعي بالزمن، وهذا - بالطبع - يرجع لأسباب عدة، منها النمو الاجتماعي والنمو الفكري وخاصة التغيرات العضوية والفيزيولوجية التي تلحق بنية الإنسان: فاستيقاظ الغريزة الجنسية مثلا يعتبر عاملاً مهماً في إدراك الزمن والوعي به ولذلك اعتبرت هذه المرحلة من أدق وأحرج المراحل التي يمر بها الإنسان في عمره، لأنّ ردود الفعل فيها غالباً ما تكون غير ناضجة وتتسم بالاندفاعية وعدم الروية، ذلك لأنّ الفرد يرغب في الاستفادة من الزمن بأقصر الطرق وأيسرها، بل وبأسرعها، كما سبق القول، الشيء الذي يؤدي به غالباً إلى السقوط في متاهات بل في متاعب ومشاكل (عقد نفسية، إحباطات، أمراض نفسية، فشل مدرسي، انحراف، جرائم... إلخ). خصوصاً إذا لم يكن المراهق مهيأ تربويا لهذه المرحلة، وذلك حتى يتمكن من إدراك عنصر الزمن وإقامة حساب له وتصريفه أحسن تصريف.
وهنا - بالطبع - يكمن دور التربية التي يتلقاها الطفل في المدرسة والبيت والتي تحاول أن تنظم أوقاته، وذلك بتعويده منذ بداية تربيته على إدراك قيمة الزمن وبضرورة إعطاء الأسبقية لما هو أهم وأفيد بالنسبة له ولمجتمعه، هذا دون إنكار دور التربية العامة التي من المفروض أن تلقن للطفل منذ نعومة أظفاره: تربية اجتماعية وأخلاقية ودينية ووجدانية... إلخ، والتي تحاول أن توجه هذه الاندفاعية نحو ما ينفع الفرد ومجتمعه في الوقت نفسه.
إذن أفلا يمكن أن نتحدث والحال هذه عن نمط آخر من التربية يمكن أن نصطلح عليه بـ(التربية الزمنية) أو التربية الوقتية؟
إنّه من الخطأ الجسيم أن نعتقد أن هذه المهمة الصعبة تقوم بها المدرسة بكاملها وأن الفرد يكتسب خطة لعمله ولوقته انطلاقاً مما يتلقنه من مناهج في الفصل.
حرب الوقت
إن مسألة إكساب الطفل هذا الوعي بالزمن لا يمكن أن تؤتي أكلها إلّا إذا شاركت الأسرة المدرسة وسهرت على بناء هذا الجانب العام الذي يعتبر أساساً مهماً في بناء المجتمع، خصوصاً في مجتمعاتنا النامية التي ما أحوجها إلى (تربية وقتية) تجعل الفرد يدرك أن الوقت رأسمال وجب استغلاله وترشيده ترشيداً حسناً.
وإذا كان عصرنا يشهد الآن ثورة في ميدان الزمن، إن صح هذا التعبير، وإذا كان الوقت قد أصبح بهذه القيمة، فما العمل بالنسبة لنا، نحن شعوب العالم الثالث؟ هل يلزمنا الخضوع لهذه الوتيرة السريعة التي تلف العالم الآن. أم يتوجب علينا السير وفقاً لخطط وقتية تقليدية وحاجياتنا وإمكاناتنا تنبع من ظروفنا، أم نبحث بدلاً من هذا وذاك عن خطة ثالثة توفيقية؟
لن أجيب عن هذا التساؤل لأني بدوري أطرحه على المهتمين والباحثين في شئون المجتمعات وتطوراتها وحركياتها ولكن كيفما كان الحال، فإنّه لابدّ لنا أولا وقبل كلّ شيء من أن نهتم بعنصر الوقت وأن ننشئ أبناءنا على الوعي به وبقيمته.
هنا إذن يبرز دور التربية الوقتية التي نقصد بها تلك العملية التي تقوم على إكساب الفرد وعيا بالزمن وبأهميته، وذلك بتلقينه الوسائل النظرية والعملية الكافية لتنظيم أوقاته وتصريفها تصريفاً إيجابياً وفق أهداف وغايات تحددها فلسفة المجتمع وتخطيطه التنموي، وذلك حتى يكون مهيأ لاستقبال ظروف مجتمعه والمساهمة في حل مشاكله أو على الأقل المساهمة في بحثها ودراستها. وحتى يقدر هذا الفرد وقته علينا أن نضبط أوقاته منذ نعومة أظفاره ونسهر على هذه العملية بكامل المسئولية: احترام أوقات الأكل والنوم والوقت الحر (لعب- مطالعة- فسح) وقت الدراسة... المواعيد... إلخ. بالإضافة إلى هذا محاولة الاستفادة من الوسائل التي تستجد في عالم التكنولوجيا والتي تعينه على التعلم الذاتي والبحث عن المعلومات من خلال الاستعانة - مثلاً - بالوسائط المتعددة الاتصال: كمبيوتر... إنترنت... إلخ، وذلك حتى يتمكن من مسايرة تضخم المعلومات وتراكم المعارف بسرعة أكثر.
وإذا كنا نعيش بالفعل في عصر تسيطر فيه التكنولوجيا وآلياتها التي تجتاح بيوتنا لتتعايش مع عاداتنا وتقاليدنا جنباً إلى جنب، إن لم نقل إنها أصبحت تقضي على بعضها لتحل محلها، فما أحوجنا في هذا الظرف إلى خطة ومنهج يتعلقان بترشيد هذه العملة التي هي الوقت. ويتناسبان مع هذه التحديات التي تواجهنا. في الحقيقة قد يقول قائل متسائلاً: ولم هذه التربية الوقتية إذن إذا كنا قادرين على الحصول على وسائل التكنولوجيا (في ميدان الإعلام والمواصلات والإنتاج الصناعي) أليست هذه كافية تماماً لبسط سيطرتها والتغلب في آن على المشاكل ومن بينها مشكلة الوقت في حد ذاتها؟
بالطبع، لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في حياتنا اليوم، خصوصاً كعامل من عوامل النمو والتطور ولكن من جهة أخرى، يجب ألا يغيب عن أذهاننا أنّه لا يمكن لهذه الوسائل أن تؤدي دورها إلّا بوساطة عقلية - ذهنية تحسب للزمن حساباً وتقدّره تقديراً، إذ دون هذه العقلية لا يمكن أن ننتظر النتائج المرجوّة ولو كنا نملك ما نملك من القدرات العلمية والتكنولوجية المتطورة.
فمَن منا يستطيع أن ينكر أن هناك ثروات مهمة وطاقات لا يُستهان بها تهدر وتذهب سدى في مجتمعاتنا لا لسبب إلّا لعدم تقدير أبنائها لعامل الوقت وحتى نتلافى هذا يتوجب أن ننشئ أجيالنا المستقبلية على إدراك قيمة الزمن والوعي بخطورته، ذلك لأنّ الحرب الطويلة التي ننتظرها غداً هي حرب ضدّ الوقت.
المعارضة عند الطفل.. آفة أم أمر طبيعي؟
كريستين نصار
صعوبات عدة ومتنوعة يواجهها الأهل يوميًا مع أطفالهم. والمعارضة عند الطفل تأتي على رأس قائمة هذه الصعوبات حيث يفرض التساؤل التالي نفسه: أهي آفة أم أنها أمر طبيعي؟
كلّ الأطفال يستخدمون المعارضة: إما ليتكيّفوا مع مرحلة جديدة من حياتهم، أو ليكتسبوا استقلاليتهم، وإظهار الطفل لمعارضته شيء ضروري وصحي لنموه بشكل جيد، مهما بدا الأمر متناقضًا، يمكن القول إن الطفل بحال جيدة حين يعارض.
فالمعارضة هي انعكاس لمرحلة جديدة من حياة الطفل، ومن رغبته بالاستقلالية، وبالتالي، يعيش الأهل بشكل دائم ومنتظم وضعيّات، لا بل مراحل، من المعارضة تستمر عموماً إلى أن يستقل ويترك المنزل الأسري. هذا، ويحصل التعبير عنها في المجال أو المجالات المتعددة، التي تتضمن فرض الممنوعات (العائلية، الاجتماعية، المدرسية)، والتي تساعد الطفل على تكوين قوانينه الداخلية انطلاقًا من إدراكه الشخصي لهذه الممنوعات (وهذا ما يسمى «الأنا العليا»).
ومن الممكن أن تكون هذه المعارضة عبارة عن موقف رفض عام، حيث تتواتر الصراعات بشكل يومي، وحيث تتعدد مواضيعها وتتنوع: يمكن التمييز هنا بين شكلين (الرفض الناشط والرفض السلبي - العدائي) وهما غير متماثلين، إن من حيث الدلالة، أو من حيث المظاهر أو النتائج (أي ما ينجم عنهما من انعكاسات).
الرفض الناشط: هو الذي يتم التعبير عنه بـ«لا» واضحة، ببكاء، بغضب، بعدوانية لفظية...إلخ، من مظاهره الأكثر تواترًا نذكر: رفض البيبرون، رفض الأوامر والتعليمات، رفض القيام بالفروض والواجبات، التعبير عن مظاهر غضب مع التلفظ بإهانات، أو مع حركات عنيفة أي، باختصار، القيام بسلوكات ظاهرة خارجيًا، لكن، تجدر الإشارة إلى أن معظم الرافضين الناشطين لا يذهبون بعيدًا من حيث المشاكسة والصراع: فهم، غالبًا، أطفال يجادلون ويجب التصارع معهم ليقوموا بتنفيذ ما يُطلب منهم.
وتعتبر بعض مراحل الطفولة، مولدة لهذا النوع من الرفض:
- من السنة الثانية إلى أربعة أعوام: حيث يبدأ الطفل بضبط اللغة، وينمو الإحساس عنده، بقيمته كشخص قادر على تحقيق التواصل مع الآخرين، والتأثير فيهم: في هذه المرحلة، يرفض الطفل عمليًا كل شيء، ويقيّم نتائج رفضه، بحيث يعيد تكرار الأكثر تأثيرًا في هؤلاء ويترك السلوكات الأخرى.
- مرحلة ما قبل - المراهقة (10 - 12 سنة) - وتتميز بوضعية خاصة، إذ يطلب من الطفل ترك أحلام أو مواقف الأطفال، لكن يمنع عليه التصرف كمراهق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يترك المدرسة الابتدائية على المستوى المدرسيّ، ليجد نفسه ضمن إطار تربوي لن يتغير منذ السنوات العشر حتى سبعة عشر عاماً، وعلى المستوى الفيزيقي (الجسدي)، العقلي والعاطفي، هناك تفاوت بالنسبة للزملاء الذين يلتقيهم يومياً.
يواجه أطفال هذه المرحلة الإكراهات (الضغوط) نفسها: العائلية، المدرسية والاجتماعية - الثقافية المفروضة على المراهقين، وهم يترجمون انزعاجهم من هذا الوضع عن طريق رفض ناشط وشامل تجاه كلّ الإكراهات، رفض يهدف لإظهار اختلافهم عن المراهقين، لكن، بما أنهم مازلوا يجهلون تمنياتهم الفعليّة بخصوص المستقبل، فإنهم يرفضون كلّ شيء دون أن يكونوا قادرين على إعطاء التفسيرات الكفيلة بإيضاح رفضهم.
- مرحلة المراهقة: حيث تبدو المعارضة في أوجها، وهذا أمر طبيعي.
فلكي يصبح مراهقًا، على الطفل دفن معتقداته الطفلية السابقة، ومنها اعتقاده بأن أهله هم الأجمل، الأقوى، يعرفون كلّ شيء...إلخ، وبمقدار ما يكبر، يحتاج إلى هدم هذه الهوامة، الذي يتطلب مروره بعدّة مراحل:
المرحلة الأولى: حيث لا يتقبل الطفل إعادة النظر هذه بالنسبة للأهل كنموذج ويحاول، برعونة، إصلاح أهله محاولاً، بذلك، المحافظة على مثاله الهوامي للأهل الكاملين، وهذا المثال غير موجود، تماماً كمثال الطفل الكامل، غير الموجود هو الآخر.
المرحلة الثانية: حيث يقوم الطفل فعلياً بعملية الدفن للتخلص من هذا المعتقد، ومن الطبيعي أن يترافق ذلك مع ألم وحال نفسية مميزة: «فقد يتوصل لتحمل هذه الفترات المؤلمة عن طريق سلوكات تصحيح، إبداع أو تسامي: سيتابع بحثه من حيث التماهي، مثلا، عن طريق محاولة التشبّه براشدين يتخيّل أنهم مثاليون (وليتمكن من تحقيق الاستقلالية، يجب ألا يكون هؤلاء هم الأهل)، هنا نجد حيطان الغرفة تمتلئ بصور لأبطال رياضيين أو ممثلين... إلخ. وقد لا يتحمل هذا الألم، فيحاول إلغاء انزعاجه عن طريق سلوكات معارضة وانتقال للفعل (يتلفظ بتعابير نابية - عدائية، يكسر الأشياء فتتطاير شظايا، يتصرّف بعنف مثلاً) أو هروب أو انفجار غضب... إلخ.
المرحلة الثالثة: حيث يدرك الطفل واقع أن الأهل، وإن كانوا غير كاملين، فإنّهم نجحوا بأن يصبحوا راشدين، وهنا، سيحاول اختبار قوة مبادئهم وطبعهم كأهل عن طريق مهاجمتهم، فإن بقوا صامدين وثابتين في مواقفهم، يتخذهم مثالا له كي يصبح راشداً مستقلاً. غني عن القول هنا بأنّ «في كلّ مراهقة، هناك جريمة»، جريمة رمزية طبعاً، بحق الأهل لأخذ مكانهم، أي إبعادهم كي يصبح راشدًا ويتمكن من بناء منزله الخاص به، وهذا ما يفسر حدّة مشاهد المعارضة في هذه المرحلة من العمر.
الرفض السلبي - العدائي: هنا، يقول الشخص «نعم» بهز الرأس و«لا» بالقلب، فالرافضون السلبيون، العدائيون يتجنبون الوضعيات غير السارة دون الدخول في صراع، رسمياً، هم دائمو الموافقة، لكنهم يتدبرون أمرهم ليفعلوا ما قرروا هم فعله:
في البيت: يقولون بأنّهم يملّون (يضجرون)، ومع ذلك، لا يمكن التحدث معهم إن كانوا يشاهدون التلفزيون مثلا أو...، يوحون بالانطباع أنه يُطلب منهم الكثير (القمر مثلاً) تجاه أي طلب يتم توجيهه إليهم، لا يقبلون التعرّف على أخطائهم ويلقون المسئولية على الآخرين (قد يحلفون، لدى ارتكابهم خطأ إملائيا، أن الأستاذ هو من علّمهم بهذه الطريقة).
مع رفاقهم: يندمجون معهم، في مرحلة أولى، لأنّهم دائمو الموافقة على ما يقال، وقد يعدون، مثلا، بإعارة أشيائهم للرفاق، لكنهم، إن لم يكونوا يريدون ذلك، فإنهم يستنبطون أكاذيب لتبرير عدم جلبهم لها. وأكاذيبهم هذه سرعان ما تؤدي، في مرحة ثانية، لرفض الرفاق لهم حيث تكون ردة فعل هؤلاء قوية بمقدار ما كان تقديرهم الأوّلي لهم قوياً.
على مستوى التعلم: يعاني هؤلاء عموماً إخفاقاً مدرسياً، من تدن في احترام الذات، لكنّهم لا يفعلون شيئاً لتغيير موقفهم.
هذان النمطان من المعارضة لا يلتقيان إلا نادراً، لكن الطفل يلجأ غالباً لهذا النمط أو ذاك تبعاً للظروف كالكذب لتجنب تلقي القصاص أو الانخراط الشخصي في عمل ما، الغضب، العدوانية اللفظية أو الرفض الصريح لتأكيد الذات تجاه بعض المفروضات،... إلخ، لكن، تجدر الإشارة، هنا، إلى أن للموقف العدواني الفضل بأنه صريح، حتى وإن كان متطرفاً، إذ يسمح، بعد انقضاء الأزمة، بمناقشة المشاكل التي تمّ عرضها وليس لتجنبها.
هنا يفرض التساؤل الجوهري التالي نفسه على الأهل: حين يعارض الولد، ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟
لابدّ من تنبيههم، بادئ ذي بدء، لواقع كون المعارضة لا تشكّل سوى الجزء المنظور، نوعاً ما، من المشكلة: فالطفل، المراهق على وجه الخصوص، يستخدم العديد من الوسائل الملتوية ليعبّر عن سوء حالته (ليقول إنه ليس على ما يرام)، فهو يتخيّل، عن خطأ أو عن صواب، أن الأهل يفهمون ألمه النفسي بشكل أفضل إن عبّر عنه، مثلاً، عن طريق الجسد، وهنا يحصل الخطر الأكبر، إذ قد يتم التركيز على الأعراض الظاهرة أو قد يحصل حوار أو عراك حول هذه الأعراض السطحيّة للمعارضة، في حين يبقى الاضطراب الأكثر عمقاً خارج الإطار فيزداد خطورة... إلخ.
لذا، من المتوجب على الأهل، كخطوة أولى، تقييم الوضعية: هل هي سوية أم غير سوية؟
بمعنى آخر يجب أن يكونوا قادرين على التمييز بين السلوكيات السوية (أي المتلائمة مع مميزات النمو) وبين السلوكيات المثيرة للتساؤل، وهذا ما يتطلب منهم تعلم الملاحظة والتقاط بعض مؤثرات الصحة، أي معرفة ما السلوكات التي يجب أن تشغل بالهم، وما السلوكات التي تعتبر عادية بالنسبة لنموّه، يشكل ذلك، في الحقيقة، أول مرحلة في برنامج التغيير الذي سيضعونه، ثم إن السلوك يمكن قياسه وملاحظته (مثل حرارة الجسم).
وباختصار، نقول: تجاه سلوك الطفل، على الأهل طرح الأسئلة الثلاثة التالية على أنفسهم:
- هل هو قادر، على المستوى النفسي والعاطفي، على تحقيق ما يطلبونه منه؟
- والتعليمات التي وجّهوها له، هل هي دقيقة وواضحة بشكل كاف كي تكون قابلة للتطبيق؟
- ومواقف الطفل و/أو المراهق، هل هو موقف رفضي واضطرابي أم أنه ببساطة تعبير عن عدم قدرته على احتمال الإحباط.
نصائح عملية
كي لا نطيل، في هذا المضمار، نتوجه للأهل بالنصائح العملية التالية (وهي ناجمة عن خبرة وممارسة علاجيتين طويلتي المدى من قبلنا، ومن قبل العديد من المعالجين النفسيين) التي تساعدهم بمقدار كبير:
- تجنبوا، قدر المستطاع، الدخول في صراع مع الطفل أو المراهق، وإن اضطررتم لذلك، فأوقفوا العراك بأسرع ما يمكن لأنّكم الخاسرون مسبقاً.
- لا تشعروا بالذنب، فلستم عرّافين، ثم، مع أفضل إرادة في العالم، تبقى الصراعات موجودة ومستمرة.
- لا تنسبوا الصراع لأنفسكم، فابنكم يحاول بكل بساطة، اختبار حدوده أو رؤية إن كان بإمكانه تسييركم.
- تقبّلوا الإخفاقات، فلستم كاملين (لا وجود لإنسان كامل، كما لا وجود لطفل أو مراهق كامل).
- فسّروا موقفكم مرة واحدة، لا تدخلوا في جدال معه، فأنتم الخاسرون مسبقاً.
- تقبّلوا، لا بل ساعدوه ليعبر عن إحباطه، فالتعبير اللفظي وغير اللفظي يساعده كثيراً على التنفيس عمّا يعتمل بداخله ومن ثم، على الارتياح.
- لا تكثروا من استخدام القصاصات، وعلى العكس، أكثروا من استخدام التدعيم والتركيز على السلوكات الإيجابية والمتكيفة التي يقوم بها.
- لا تحسّوا أنكم وحدكم من يواجه مثل هذه الصعوبات، وأنكم مسئولون عن كلّ سوء يحدث، حاولوا مناقشة ذلك مع أهل آخرين (خصوصاً الصادقين منهم)، فسرعان ما يتبين لكم أنّهم يواجهون المشاكل مع أولادهم: استغلوا الفرصة وتبادلوا الخبرات فيما بينكم إذ من شأن ذلك مساعدتكم على مواجهة الصعوبة بتقاسمها مع الآخرين وبالاغتناء مما يقدمه لكم تبادل الخبرات فيما بينكم.
- لاحظوا دون تأويل: خذوا حذركم من انفعالاتكم وردّات فعلكم (اللفظية وغير اللفظية).
- حاولوا دائماً استعادة التواصل مع ابنكم (أو ابنتكم): فالصراع والشجار... يحولان دون ذلك أما الحوار الهادئ فيؤمنه.
- حاولوا دائماً إيجاد مجال ثان للتفاهم، فيما بعد: من الأسهل دائماً فهم الأمور بعد أن تهدأ الحالة.
- لا تسمحوا أبداً للاعتقاد بأنّكم مربون سيئون يسيطر على ذهنكم.
- اعتبروا، منذ البداية، أن السلوك (سلوك المعارضة خصوصاً) هو مؤشر على الصحة: صحة ابنكم (أو ابنتكم) الذي يكبر، يصبح أكثر استقلالية وتتطور شخصيته، ودوركم، يكمن في رعاية هذا النمو والتطور المحققين عنده وتأمين الإطار السليم لهما.
- خذوا الوقت الكافي لتقييم النصائح الموجهة إليكم، إذ ليس من السهل تطبيقها ضمن الإطار اليومي: فقد تشعرون، في أحيان كثيرة، أن الأحداث تتجاوزكم (وهذا أمر طبيعي)، لكن ثقوا بأنفسكم وتذكروا دائماً أنكم لستم وحيدين، وأن الوقت يجري لمصلحتكم.
- لا تترددوا أبداً باستشارة الأخصائي حين تحسّون بأن الأمور تتجاوزكم، فكلما جاءت المعالجة بشكل أبكر كان الحل أسرع، وإمكانات الشفاء أكبر وأفضل، وإلّا فإنّ الأمور ستتفاقم وستتأزم الأحوال.
كخلاصة لما سبق، نعيد التركيز على واقع كون سلوك المعارضة (أو أي سلوك اضطرابي وإشكالي) عند الطفل أو المراهق هو عبارة عن طريقة اتصال غير مباشر يسمح له بتحقيق فوائد مباشرة كالاستئثار باهتمامكم، تجنب القيام بما تطلبونه منه (أو منها)...إلخ، كما يسمح له - وعلى المدى الطويل - بتأكيد شخصيته ورغبته بالاستقلالية لكن، شرط ألا يكون مكثفًا (حادًا) ويؤدي لتهميشه، ولإثارة الاضطرابات بالعلاقات أو بالدينامية العلائقية المميزة للعائلة. إن كان كذلك، على الأهل التصرف وأخذ الأمور بأيديهم (تعتبر هذه آخر مرحلة في برنامج التغيير). وهنا، نشير إلى أن التغيير ممكن، لا بل يحققه الأهل غالباً، في مسيرة حياتهم العائلية، ودن أن يدروا، يساعدهم في ذلك الحب والعفوية المميزان لهم كأهل، ما القول، إذن، حين يضيفون لهذه القدرة العفوية فعالية التخطيط له (أي للتغيير)؟
باختصار نقول: من غير الممكن، ومن غير المطلوب، تغيير شخصية الولد، لكن إمكان تعديل الأهل للسلوكات الإشكالية التي تظهر عنده تبقى شديدة الارتفاع، خصوصاً حين يتعاملون معها بالشكل الموضوعي الذي تم التركيز عليه في السطور السابقة: تقييم ومن ثمّ، معالجة كلّ سلوك بمفرده: بدءاً بالأقل حدّة واضطراباً، صعوداً للأكثر إشكالية.