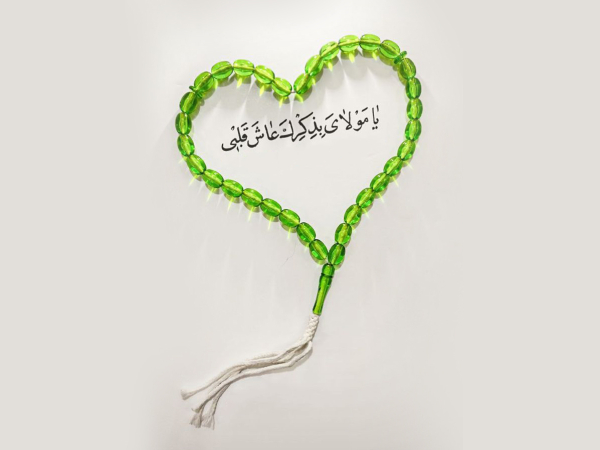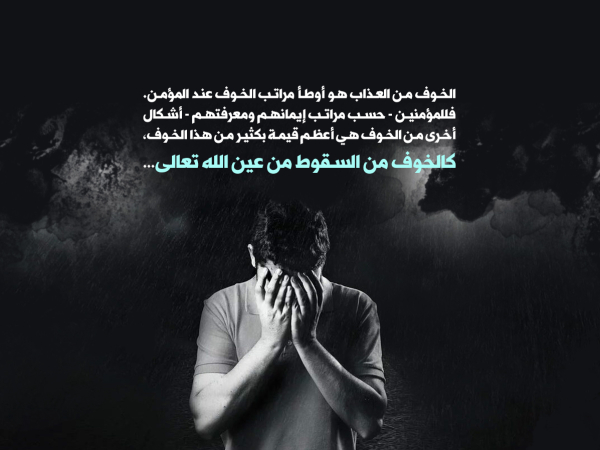emamian
شعائر الله في الحج؛ رموز معنوية وتوحيدية
ويُحذّر القرآن الكريم في الآية الثانية من سورة المائدة المباركة، من عدم احترام شعائر الله والأشهر الحرم وأيضاً الأضاحي والزوار الذين يقصدون بيت الله.
وجاء في هذه الآية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا".
كما ذُكرت الأضاحي في سورة الحج، الآية 36، كـ جزء من شعائر الله "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ" هذا التأكيد على الشعائر يدلّ على أن مناسك الحج الظاهرة ليست مجرد أعمال رمزية، بل لها ارتباط عميق بالمعاني الروحية والتوحيدية. إن الاهتمام بهذه العلامات يعدّ من علامات تعظيم الشعائر وتقوى قلوب المؤمنين.
من وجهة نظر القرآن الكريم، فإن مناسك الحج تُظهر آثار عظمة الله، لذلك يجب الحفاظ على جميع الخصائص والميزات لهذه الحدود والشعائر بدقة شديدة والالتزام بها.
كما يجب الحذر من أن يتم تنفيذ أي عمل بشكل غير صحيح؛ لأن مثل هذا الخطأ يُبطل العمل في الظاهر وفي الباطن.بلا شك، فإن العناية بهذه الحدود تُعتبر من علامات تقوى القلوب ومن مظاهر الإحسان في سبيل الله.
الشكرُ على نِعَمِ اللهِ
الشكرُ على نِعَمِ اللهِ
قالَ تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا * مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾[1].
جعلَ اللهُ عزَّ وجلَّ للإنسانِ مقامَ الخلافةِ الإلهيَّةِ، فَسخَّرَ لهُ ما في السَّماواتِ والأرضِ للرُّقيِّ بهِ نحوَ الكمالِ. وهيَ نِعمةٌ لا تَدومُ ولا تَزيدُ إلَّا بوجودِ أسبابِها وأداءِ الواجبِ نحوَها؛ لذا كانَ لا بُدَّ للإنسانِ من أنْ يقومَ بما يَفي لِهذهِ النِّعَمِ الإلهيَّةِ، ولو بالقليلِ منَ العملِ الآتي:
1. أداءُ الشُّكرِ للهِ على هذهِ النِّعَمِ؛ لأنَّ الشُّكرَ يُزيدُ في النِّعَمِ والبَرَكاتِ، ومَظهرُ ذلكَ هوَ التَّصرُّفُ في هذهِ النِّعَمِ بما أمرَ اللهُ بهِ، قالَ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[2]، وعنِ الإمامِ الصادقِ (عليهِ السلامُ): «مَنْ أُعْطِيَ اَلشُّكْرَ أُعْطِيَ اَلزِّيَادَةَ، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾[3]»[4].
ومِن أهمِّ أبوابِ الشُّكرِ الامتِناعُ عن ظُلمِ النَّاسِ أوِ الاستعانةِ بنِعَمِ اللهِ على معاصيهِ، ولا سِيّما التَّكَبُّرُ على عبادِهِ، فَعنِ الإمامِ عليٍّ (عليهِ السلامُ): «مَا أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً، فَظَلَمَ فِيهَا، إِلاَّ كَانَ حَقِيقاً أَنْ يُزِيلَهَا عَنْهُ»[5]، وعنِ النبيِّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ): «يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَابْنَ آدَمَ، مَا تُنْصِفُنِي، أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ، وَتَتَمَقَّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي!»[6].
2. ذكرُ نِعم اللهِ وعدمُ الغفلةِ عنها، قالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾[7]، وعن رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ) في قولِهِ تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾[8]: «بنِعَمِ اللهِ وآلائِهِ»[9]، وعنِ الإمامِ الصادقِ (عليهِ السلامُ) في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾[10]، قالَ: «اَلَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِمَا فَضَّلَكَ، وَأَعْطَاكَ، وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ»، ثمَّ قالَ: «فَحَدَّثَ بِدِينِهِ، وَمَا أَعْطَاهُ اَللَّهُ، وَمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْه»[11].
ومن ذلكَ إظهارُ النِّعمِ الّتي أنعمَ اللهُ بها على الإنسانِ، فعنِ الإمامِ الصادقِ (عليهِ السلامُ): «إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِه بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَيْه، سُمِّيَ حَبِيبَ اللَّه مُحَدِّثاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ، وإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْه، سُمِّيَ بَغِيضَ اللَّه مُكَذِّباً بِنِعْمَةِ اللَّهِ»[12].
3. القناعةُ بنِعَمِ اللهِ تعالى وعدمُ الإسرافِ فيها، فعنِ الإمامِ الكاظمِ (عليهِ السلامُ): «مَنِ اِقْتَصَدَ وَقَنِعَ بَقِيَتْ عَلَيْهِ اَلنِّعْمَةُ، وَمَنْ بَذَّرَ وَأَسْرَفَ زَالَتْ عَنْهُ اَلنِّعْمَةُ»[13].
4. السَّعيُ في قضاءِ حوائجِ الناسِ، فالمرويُّ عن أميرِ المؤمنينَ (عليهِ السلامُ): «يَا جَابِرُ، مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ مَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيْهِ عَرَّضَهَا لِلدَّوَامِ وَاَلْبَقَاءِ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي مَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيْهِ عَرَضَّهَا لِلزَّوَالِ وَاَلْفَنَاءِ»[14].
إنَّ مِن أعظَمِ الأيّامِ عندَ اللهِ يومَ الخامسِ والعشرينَ من ذي القَعدةِ، وهوَ يومُ دَحوِ الأرضِ، وهوَ أحدُ الأيّامِ الأربعةِ الّتي خُصَّتْ بالصِّيامِ بينَ أيّامِ السَّنةِ، وفيهِ أعمالٌ خاصّةٌ مُستحبّةٌ، على المؤمنينَ السَّعيُ للقيامِ بها، والدُّعاءُ لِوليِّ أمرِ المسلمينَ بالحِفظِ، ولِلمُجاهدينَ بالتَّوفيقِ والنَّصرِ.
[1] سورة النازعات، الآيات 30 - 33.
[2] سورة الأعراف، الآية 96.
[3] سورة إبراهيم، الآية 7.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص95.
[5] الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص482.
[6] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص28.
[7] سورة فاطر، الآية 3.
[8] سورة إبراهيم، الآية 5.
[9] السيوطيّ، الدرّ المنثور، ج4، ص70.
[10] سورة الضحى، الآية 11.
[11] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص94.
[12] المصدر نفسه، ج6، ص438.
[13] ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول، ص403.
[14] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام)، ص403.
كيف يكون الله حاضراً في حياتنا؟
إذا كان كمال الإنسان وسعادته الحقيقيّة تكمن في التقرّب إلى الكمال المحض وصيرورته عند الله كما هو حال الشهداء، فإن تحقّق ذلك إنما يكون من خلال أمرين أساسيّين هما: المراقبة والمحاسبة. فالإنسان إذا أدرك أنه في محضر الله لا بد له من مراقبة أعماله والانتباه لتصرّفاته من جهة، ومن جهةٍ أخرى عليه أن يحاسب نفسه باستمرار. فالمراقبة الدائمة والحساب المستمرّ هما اللذان يوصلان الإنسان إلى المكان الذي لا ينظر فيه إلا إلى الله. ويبيّن القرآن الكريم هذين الأصلين في سورة الحشر المباركة بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[1]. فهذه الآية تدعونا إلى أصلين أخلاقيين، الأوّل المراقبة، والثاني المحاسبة. فكلّ إنسانٍ مكلّفٌ بمراقبة نفسه ومحاسبتها، فيراقبها في أفعالها وتصرّفاتها وأقوالها ويحاسبها، فإذا عمل خيراً شكر الله، وإذا عمل سوءاً استغفر الله وتاب إليه.
1- المراقبة:
معنى المراقبة مشتقّ من "الرقبة"، فالذي يرفع رقبته ليشاهد أكثر يكون مراقباً. وعلى الإنسان أن يراقب كلّ شيء في حياته من الكلام والفعل والنّظر وغيرها... لكي لا يقع فيما لا يرضي الله، وما يخالف أمره، فهو عزّ وجلّ ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾[2]، ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾[3]، وهو مستعدّ وجاهز ليسجّل كلّ شيء ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾[4]، والإنسان الذي يراقب نفسه باستمرار سوف يحرص على أن لا يرتكب أية مخالفة، فعن أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبة له قال: "فرحم الله من راقب ربه، وخاف ذنبه، وجانب هواه، وعمل لآخرته، وأعرض عن زهرة الحياة الدنيا"[5]. ومما وصّى به إمامنا الصادق عليه السلام: "واقصد في مشيِك، وراقب الله في كل خطوة، كأنك على الصراط جائز، ولا تكن لفّاتا"[6].
2- المحاسبة:
وأما المحاسبة فأن يحاسب الإنسان نفسه من خلال البحث والتدقيق في أعماله ليرى إن كان قد أدّى التكاليف الإلهية على أكمل وجه أم لا، فإذا اكتشف أنه ارتكب ما يخالف أمر ربّه استغفر وأناب إليه نادماً عازماً على أن لا يعود إلى معصيته مطلقاً، وسعى مباشرة لإصلاح الأمر وجبران ما فاته. وإذا اكتشف أنه أدّى ما عليه حمد الله وشكره على ما وفّقه إليه، وهو مدرك أنه لا مجال للمقارنة بين طاعاته ونعم الله السابغة عليه، لذا يجد نفسه مقصّراً دائماً في محضر الحق، ولا يفتأ عن إظهار العجز والضّعف أمام ساحته، فلا يبتعد عن العبودية له قيد أنملة، ولا يجد نفسه في محضره إلّا عبداً. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه قال: "أيها الناس لا يشغلنّكم دنياكم عن آخرتكم، فلا تؤثروا هواكم على طاعة ربكم، ولا تجعلوا أيمانكم ذريعة إلى معاصيكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهّدوا لها قبل أن تعذّبوا، وتزوّدوا للرحيل قبل أن تُزعَجوا، فإنّها موقِفُ عدل، واقتضاء حقّ، وسؤالٌ عن واجبٍ، وقد أبلغ في الإعذار من تقدّم بالإنذار"[7].
وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ووازنوها قبل أن توازنوا، حاسبوا أنفسكم بأعمالها، وطالبوها بأداء المفروض عليها والأخذ من فنائها لبقائها"[8].
[1] سورة الحشر، الآية: 18.
[2] سورة غافر، الآية: 19.
[3] سورة ق، الآية: 18.
[4] سورة يس، الآية: 12.
[5] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 75، ص 18.
[6] م.ن: ج 73، ص 167.
[7] م. س، ج74، ص183.
[8] الطبرسي، الميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 154، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلاملإحياء التراث، 1988م، الطبعة 2، باب وجوب محاسبة النفس كل يوم...، ح 5.
كيفيّة التحقّق بمقام الصّبر؟
إنّ من النتائج الكبيرة والثمار العظيمة لتحرّر الإنسان من عبودية النفس، الصّبر في البلايا والنوائب. فالإنسان إذا أصبح مقهوراً لهيمنة الشهوة والميول النفسية، كان رقّه وعبوديته وذلّته بقدر مقهوريّته لتلك السلطة الحاكمة عليه. ومعنى العبودية لشخصٍ هو الخضوع التّام له وإطاعته. والإنسان المطيع للشهوات المقهور للنفس الأمّارة يكون عبداً منقاداً لها. وكلّما أوحت هذه السلطات بشيءٍ أطاعها الإنسان وخضع لها منتهى الخضوع، حتى يغدو عبداً خاضعاً ومطيعاً أمام تلك القوى الحاكمة. ويبلغ به الأمر إلى مستوى يفضّل طاعتها على طاعة خالق السماوات والأرض، وعبوديتها على عبودية مالك الملوك الحقيقيّ.
وفي هذه الحالة تزول عن نفسه العزّة والكرامة والحرية، ويحلّ محلها الذلّ والهوان والعبودية، ويخضع لأهل الدنيا، وينحني قلبه أمامهم وأمام ذوي الجاه والحشمة، ولأجل بلوغ شهواته النفسية يتحمّل الذلّ والمنّة، ولأجل الترفيه عن البطن والفرج يستسيغ الهوان، ولا يتضايق من اقتراف ما يخالف الشرف والفتوّة، عندما يكون أسيراً لهوى النفس والشهوة.
وينقلب إلى أداةٍ طيّعة أمام كل صالحٍ وطالح، ويقبل امتنان كلّ وضيعٍ عنده لمجرّد احتمال نيل ما يبتغيه حتّى إذا كان ذلك الشخص أحطّ وأتفه إنسان. إنّ عبيد الدنيا وعبيد الرغبات الذاتية، والذين وضعوا رسن عبودية الميول النفسية في رقابهم، يعبدون كلّ من يعلمون أنّ لديه الدنيا أو يحتملون أنّه من أهل الدنيا، ويخضعون له، وإذا تحدّثوا عن التعفّف وكبر النفس، كان حديثهم تدليساً محضاً، وإنّ أعمالهم وأقوالهم تكذب حديثهم عن عفّة النفس ومناعتها.
إنّ هذا الأسر والرّق للشهوات وأهواء النفس، من الأمور التي تجعل الإنسان دائماً في المذلّة والعذاب والنصب. ويجب على الإنسان ذي النبل والكرامة أن يلتجئ إلى كلّ وسيلةٍ لتطهير نفسه منها. ويتمّ التطّهر من هذه القذارات والتحرّر من كلّ خسّةٍ وهوانٍ بمعالجة النفس، وهي لا تكون إلَّا بواسطة العلم والعمل النافع.
أمّا العمل: فيكون بالرياضة الشرعية وبمخالفة النفس فترةً يتمّ فيها صرف النفس عن حبّها المفرط للدنيا والشهوات والأهواء حتّى تتعوّد هذه النفس على الخيرات والكمالات.
أمّا العلم: فيتمّ بتلقين النفس وإبلاغ القلب بأنّ الناس الآخرين يضاهونه في الفقر والضعف والحاجة والعجز، وأنّهم يشبهونه أيضاً في الاحتياج إلى الغنيّ المطلق القادر على جميع الأمور الجزئية والكليّة. وأنّهم غير قادرين على إنجاز حاجة أحدٍ أبداً، وأنّهم أتفه من أن تنعطف النفس إليهم ويخشع القلب أمامهم. وإنّ القادر الذي منحهم العزّة والشرف والمال والوجاهة قادرٌ على أن يمنح الجميع.
ومن العار حقيقةً على الإنسان أن يتذلّل وينحطّ في سبيل بطنه وشهوته ويتحمّل الامتنان من مخلوقٍ فقيرٍ ذليلٍ لا حول له ولا علم ولا وعي. إذا أردت أيّها الإنسان أن تقبل المنّة فلتكن من الغنيّ المطلق وخالق السموات والأرض، فإنّك إذا وجّهت وجهك إلى الذات المقدسة، وخشع في محضره قلبك، تحرّرت من العالمين[1]، وخلعت من رقبتك طوق العبودية للمخلوق لأنّ العبودية لله وحده لا شريك له.
[1] أي كل ما سوى الله عزّ وجل.
كيف استشهد الإمام الجواد (عليه السلام)؟
لقد ابتُلي الإمام محمد الجواد (عليه السلام) بابتلاءات عديدة:
منها: اليتم، فقد فارقه أبيه الإمام علي الرضا (عليه السلام) وهو صغير حينما أشخصه المأمون إلى خراسان، وقد آلم هذا الموقف قلب إمامنا محمد الجواد (عليه السلام) فكان يبكي لفراق أبيه..
ومنها: الغربة حيث أُخرج من مدينة جدّه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُبعد عنها، فقد ودّع الإمام أهله وولده وترك حرم جدّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذهب إلى بغداد بقلبٍ حزين. ويُروى أنّه لمّا خرج من المدينة في المرّة الأخيرة، قال: "ما أطيبك، يا طيبة! فلست بعائد إليك".
ومنها: السجن، إذ سجنه المعتصم، ولم يأذن لأحد بالدخول عليه.
ومنها: السمّ، فقد كان المعتصم يتربّص بالإمام ويعمل الحيلة في الفتك به، إلى أن سنحت له الفرصة فدسّ إليه السمّ، وقد اختلفت الرواية في كيفيّة سمّه له:
فمن قائل: أمر فلاناً (من كتّاب وزرائه) بأن يدعو الإمام إلى منزل الوزير، فدعاه، فأبى أن يجيبه، وقال: "قد علمت أنّي لا أحضر مجالسكم"، فقال: إنّي إنّما أدعوك إلى الطعام، وأحبّ أن تطأ ثيابي، وتدخل منزلي فأتبرّك بذلك، فقد أحبّ فلان بن فلان (من وزراء المعتصم) لقاءك. فصار إليه، فلمّا طَعِمَ منه أحسّ بالسمّ، فدعا بدابّته، فسأله ربّ المنزل أن يقيم، قال: "خروجي من دارك خير لك". فلم يزل يومه ذلك وليله في خِلفَةٍ2 يتقيّأ ذلك السمّ ويعاني آلامه في بطنه، حتّى قُبض (عليه السلام).
وقائل: إنّه أنفذ إليه شراب حماض الأترج- شبيه بالليموناضة- وأصرّ على ذلك، فشربها (عليه السلام) عالماً بفعلهم.
وقال آخرون: إنّ التي سمّته زوجته أمّ الفضل بنت المأمون لمّا قدمت معه من المدينة إلى المعتصم:
فلمّا انصرف أبو جعفر الجواد (عليه السلام) إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبِّرانِ ويعملانِ الحيلة في قتله، فقال جعفر لأخته أمّ الفضل- وكانت لأمّه وأبيه- في ذلك، لأنّه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه لتفضيله أمّ أبي الحسن ابنه عليها مع شدّة محبّتها له، ولأنّها لم تُرزق منه بولد، فأجابت أخاها جعفراً، فرُوي أنّها وضعت السمّ في منديل وأعطته إيّاه فمسح به، ورُوي أنّهم جعلوا سمّاً في شيء من عنب رازقيّ وكان يعجبه العنب الرازقيّ، وقدّمته له، فلمّا أكل منه ندمت وجعلت تبكي. فقال لها: "ما بكاؤك؟ والله ليضربنّك الله بفقر لا ينجبر، وبلاء لا ينستر"، فبُليت بعلّة في أغمض المواضع من جوارحها، صارت ناصوراً3 ينتقض في كلّ وقت فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلّة حتّى احتاجت إلى رِفْد الناس. وتردّى جعفر في بئر فأخرج ميتاً وكان سكرانَ.
ورُوي عن الإمام علي الرضا (عليه السلام)، أنّه قال في حقّ ولده الإمام الجواد (عليه السلام): "يُقتل غصباً فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوّه وظالمه فلا يلبث إلّا يسيراً حتّى يعجّل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد.."
وعلى أيّ حال فقد جرى السمّ في بدن الإمام عليه السلام، وبقي يتقلّب في فراشه، يعاني حرارة السمّ في يومه وليلته، يتقيّأ ذلك السمّ ويشكو آلام بطنه، حتّى دنا أجله..
ورُوي عنه (عليه السلام)، أنّه قال في العشيّة التي توفّي فيها: "إنّي ميّت الليلة"، ثمّ قال: "نحن معشر إذا لم يرض الله لأحدنا الدنيا نَقَلَنا إليه".
ويقال إنّ الإمام لمّا تناول السمّ تقطّعت أمعاؤه وأخذ يتقلّب على الأرض يميناً وشمالاً من شدّة الألم، ويجود بنفسه والتهب قلبه عطشاً- فقد كان الوقت شديد الحرّ والسمّ يغلي في جوف الإنسان- فطلب جرعة من الماء، والتفت إلى تلك اللعينة قائلاً: ويلك إذا قتلتِني فاسقيني شربة من الماء، فكان جوابها له أن أغلقت الباب ثمّ خرجت من الدار، فبقي الإمام يوماً وليلة يعالج ألم السمّ.. ولا يجد أحداً يسقيه شربة من الماء..
ولمّا بلغت روحه التراقي صعد سطح الدار، ورمق السماء بطرفه، وتشهّد الشهادتين، وغمّض عينيه، وأسبل يديه ورجليه، وعرق جبينه، وسكن أنينه، وفارقت روحه الدنيا..
من هي سمات خير الإخوان؟
حدّدت لنا الروايات الشريفة صفات عديدة للأصدقاء والإخوان، وأرشدتنا إلى كيفية اختيار أفضلهم، وأقربهم إلى الله، لأنَّ القرين والصاحب يؤثّر على دين المرء وسلوكه، فالمرء على دين خليله كما ورد في الروايات الشريفة.
لذا ينبغي أن نختار من توفّرت فيه الملامح التي رسمها وحدّدها المعصومون عليهم السلام على الشكل الآتي:
1- الدَّاعي إلى الله تعالى:
والمراد منه من كانت دعوته بالعمل، إضافة إلى القول، كما عبّرت عن ذلك النصوص الشريفة حيث ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام): "خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبِرّ وأعانك عليه"[1].
2- المعين على الطّاعة:
الطّاعة هدف خلقة الإنسان الحقيقي في هذه الدُّنيا، وخير الأصدقاء من يُعين على هذا الهدف السّامي. ورد عن رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لمَّا سُئل من أفضل الأصحاب: "من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكّرك"[2].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: "المعين على الطّاعة خير الأصحاب"[3].
وعنه (عليه السلام) أيضاً أنّه قال: "إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه"[4].
3- الصَّادقون:
وهم الّذين ينبغي معاشرتهم، كما يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "وعليك بإخوان الصِّدق فأكثِر من اكتسابهم، فإنّهم عُدّة عند الرَّخاء وجُنّة عند البلاء"[5].
وعن الإمام الحسن (عليه السلام) في وصيِّته لجنادة في مرضه الّذي توفّي فيه: "اصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلتَ صدّق قولك، وإن صلت شدّ صولك، وإن مددتَ يدك بفضلٍ مدّها، وإن بدت عنك ثلمة سدَّها، وإن رأى منك حسنةً عدّها، وإن سألتَه أعطاك، وإن سكتّ عنه ابتداك، وإن نزلت إحدى الملمَّات به ساءك"[6].
4- من يُذكّرنا بالله والآخرة:
عن النّبيّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما سُئِل أيّ الجلساء خير؟ فقال: "من ذكّركم بالله رؤيته وزادكم في علمكم منطقه. وذكّركم بالآخرة عمله"[7].
5- مصاحبة العلماء:
أكّدت الرّوايات المباركة على صحبة العلماء ومجالستهم، لأنّهم قادة الركب الرَّبَّانيّ الّذين يأخذون بيد المرء إلى العالم العلويِّ ويصلون به إلى حيث أراد الله سبحانه، من خلال بثّ معارفهم وممارسة دورهم في الهداية والتّربية، والدِّفاع عن مبادىء الدِّين وصيانة الشَّريعة من أن تدخلها البدع والانحرافات. وممّا ورد في ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: "جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك"[8].
وما في وصية لقمان الحكيم لابنه: "يا بنيّ جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإنَّ الله عزّ وجلّ يُحيي القلوب بنور الحكمة، كما يُحيي الأرض بوابل السَّماء"[9].
وفي المقابل، فإنّ ترك مجالسة العلماء موجب للخذلان، لأنَّ الابتعاد عنهم معناه الابتعاد عن المدرسة الإلهيّة الّتي أمر المولى سبحانه بالتَّربّي في كنفها وتحت ظلالها، وهذا ما جاء صريحاً في دعاء الإمام علي السجّاد (عليه السلام) أنّه قال: "أو لعلّك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني"[10].
6- مصاحبة الحكماء والحلماء:
وهناك روايات أكّدت أيضاً على مصاحبة الحكماء ومجالسة الحلماء، لِما في هذين الصنفين من النّاس من مواصفات عالية تترك آثارها في الجنبة العلميّة والعمليّة بما يُساعد الإنسان عبر العلاقة بهم في طريقه إلى الكمال.
فعن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) أنّه قال: "أكثر الصَّلاح والصَّواب في صحبة أولي النُّهى والصَّواب"[11].
[1] م.ن، ص284, الحديث الحكمة - 9534.
[2] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 138.
[3] الآمدي، غرر الحكم، ص 284, الحكمة - 9508.
[4] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 164.
[5] م.ن، ج 71، ص 187.
[6] م. ن، ج 44، ص 139.
[7] م. ن، ج71، ص186.
[8] الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص430، نشر مكتب الاعلام الاسلامي، قم , 1407هـ.
[9] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1، ص 204.
[10] م.ن، ج 95، ص 87.
[11] الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص429.
خوف أهل الآخرة؟
الخوف من العذاب هو أوطأ مراتب الخوف عند المؤمن. فللمؤمنين - حسب مراتب إيمانهم ومعرفتهم - أشكال أخرى من الخوف هي أعظم قيمة بكثير من هذا الخوف، كالخوف من السقوط من عين الله تعالى. فالذين يشكون من ضحالة في المعرفة لا يعرفون قيمة لطف الباري عزّ وجلّ، ولذا لا يحظى هذا الأمر بأهمّية عندهم. فعندما يريد القرآن الكريم أن يوضّح عاقبة أهل الشقاء فإنّه يقول: ﴿..وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..﴾[1]، فهل فكّرنا يوماً بأنّه ما الذي سيحصل إذا لم ينظر الله إلينا يوم القيامة؟ وهل يتمتّع هذا الأمر بأهمّية عندنا أساساً، أم إنّ المهمّ عندنا هو الحصول على نعم الجنّة؟ فالأطفال الذين يتمتّعون بفطرة سليمة يُدركون هذا النمط من العذاب، فإنّ أقسى أنواع العذاب للطفل هو أن تستاء أمّه منه فلا تلتفت إليه، لكنّ قليلي المعرفة من الناس لا يُدركون مثل هذه العلاقة مع الله، فكيف لهم أن يعرفوا ما الذي سيحصل إذا استاء الله منهم. لكنّه في اليوم الذي يكونون فيه بحاجة لمثل هذه النظرة فسيُدركون مدى شدّة العذاب الناجم من حرمانهم منها. فبعض عباد الله يخشون استياء الله منهم وعدم تحدّثه إليهم، ولا يخافون من جهنّم. وهذا أيضاً نمط من أنماط الخوف من الله. فكلّ مَن حاز حبّ الله في قلبه كان خوفه من استياء الله أكثر، وحتّى إذا كان متنعّماً بألطاف الله تعالى فإنّه يخشى انقطاع تلك الألطاف.
فإذا أمعنّا النظر في أحوالنا وسلوكيّاتنا الاختياريّة فسنُلاحظ أنّ العامل من وراء حركاتنا ونشاطاتنا الاختياريّة هو إمّا خوف الضرر أو رجاء النفع. وإنّ اختلاف الناس في سلوكيّاتهم ناشئ عن اختلافهم في تشخيص الضرر أو النفع، وإلاّ فأيّ تصرّف يقوم به أيّ امرئ فإنّ الغاية منه هو دفع ضرر ما عن نفسه أو جلب نفع ما لها. فلا بدّ أن يكون أحد هذين العاملين الاختياريّين مؤثّراً في جميع أفعالنا الاختياريّة. حتّى العاشق فإنّه يشعر - بسبب سلوكه مع معشوقه - بلذّة عقلانيّة ولطيفة في روحه وهو يسعى عن غير وعي وراء هذه اللذّة. إذن فهو أيضاً يُفتّش عن لذّة نفسه من خلال عدّة وسائط.
إذن فسلوكنا الاختياريّ هو إمّا لدفع ضرر أو لكسب فائدة. فعندما نحتمل وجود الضرر تصدر منّا ردّة فعل طبيعيّة لهذا الاحتمال تُدعى "الخوف". فالخوف إذن هو حالة طبيعيّة تحصل عند احتمال الضرر، ولا نكاد نجد في عالم الطبيعة إنساناً لا يكون الضرر محتملاً بالنسبة له. أمّا بالنسبة للمؤمن فهناك أضرار أهمّ من تلك وهي الأضرار الأخرويّة. ومن هنا فإنّ من أهمّ العوامل التي تدفعنا للمضيّ في طريق الكمال هو الالتفات إلى الأضرار التي تُهدّد سعادتنا الأبديّة. فالالتفات إلى هذه الأضرار يوجب الخوف، وهو حالة الانفعال التي تحصل للإنسان في مقابل احتمال الضرر. وإنّ تأكيد القرآن الكريم على مفاهيم من قبيل الخوف، والخشية، والتقوى، والوجل، والرهبة، وأمثالها ثمّ الإطراء عليها بأشكال شتّى يأتي من باب أنّ هذه الحالات هي أهمّ العوامل لحركة الإنسان التكامليّة. وبالطبع فإنّ هذه الحالات تقترن برجاء النفع أيضاً، وإنّ كلا العاملين مهمّ، غير أنّ تأثير الخوف يفوق تأثير الرجاء. نفهم من ذلك أنّ الخوف يُعدّ عاملاً مهمّاً من عوامل السعادة، هذا - بالطبع - إذا كان الخوف من الأخطار المعتنى بها، وليس ثمّة من ضرر يُمكن أن يُعتنى به بالنسبة للمؤمن أشدّ من الأخطار الأخرويّة، وهي الأخطار المتعلّقة بالساحة الإلهيّة المقدّسة. ومن هنا فلا بدّ من تقوية هذا الخوف[2].
[1] القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 77.
[2] من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ألقاها في مكتب الإمام السيد علي الخامنئي(دام ظله) في قم بتاريخ 18 آب، 2011 م.
الحرية بالمفهوم الإسلامي
الحرية بالمفهوم الإسلامي غير مفصولة عن الهدف الذي وجد الإنسان من أجله، وهو تكامله ورقيّه ونيله أرفع المراتب في هذا الوجود، فالإنسان العاقل حرٌ في دائرة الطريق الموصل إلى هدفه المنشود، فالتكاليف الإلهية والقوانين الربانيّة التي شرعها الله عز وجل تجلب إلى الإنسان المصالح وتدفع عنه المفاسد، فينتج عنها تكامله المعنوي والمادي، وبالتالي سعادته في الدارين الأولى والآخرة.
فالسير ضمن الطريق الذي شرّعه الله عز وجل هو الحرية الحقيقية، لأنّه يوصل الإنسان إلى سعادته وكماله، ولا يفصله عن الهدف المأمول، يقول الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني (قدس سره): "إنّ الحريّة التي يقول الإسلام بها، محدودة بالقوانين الإسلاميّة"[1].
"ينبغي أن تكون الحريّة ضمن حدود الإسلام والقانون، فلا يصار إلى مخالفة القانون بدعوى الحريّة"[2].
فمن البديهي للإنسان الساعي لتحقيق هدفه أن يقيّد رغباته بما يحقق هدفه ويتناسب معه، فإذا أردنا أن نتحرر من ذل الجهل فعلينا أن نلتزم بقيود التعلم، وبالتالي لا بد أن تُفهم الحرية على أساس رفع القيود التي تشكل مانعاً دون تحقيق الهدف المنشود، حتى وان كان ذلك لا يتم إلا عبر تشريع قيود، فالإسلام إنما يشرع القوانين ويضع الحدود للحرية، لأنه يرى أن هذه الضوابط ضرورية للحفاظ على الحرية وضمان استقلال شخصية الإنسان الفردية والاجتماعية، يقول الإمام قدس سره: "إنّ الحريّة التي يقول الإسلام بها، محدودة بالقوانين الإسلاميّة"[3].
فمن هنا صرّح الإمام قدس سره بعدم استغلال الحرية والتذرع بها لأجل الوصول إلى المآرب الفاسدة يقول (قدس سره): "احفظوا حدود الإسلام، ولا يساء استغلال الحريات، فالحرية مقيدة بحدود الإسلام"[4].
والإمام الخميني (قدس سره) يرفض ما يسمى بالحرية التي تؤدي إلى الفوضى أو الشتم أو السباب وإهانة الآخرين، وغير ذلك مما يسيء إلى الأخلاق والقيم، يقول (قدس سره): "عندما تقرأون الصحف فإنكم كثيرا ما تشاهدون فيها أن هذا يسيء إلى ذاك وذاك يسيء إلى هذا، والآن بعد تحرر الأقلام، فهل صحيح أن يتحدث كل إنسان بما يشاء تجاه الآخرين؟ وان يتصرف كل واحد مع الآخر، بحيث تدب الفوضى في البلاد وتخرج من النظام؟
هذا هو معنى الحرية؟ هل أن الحرية في تلك البلدان التي تريد نهبنا هي على هذه الشاكلة؟ لو كانت هكذا لما حصل الانسجام ولما تطورت، إنهم يريدون من خلال كلمة الحرية التي يلقونها في عقول الشباب أن يفرضوا سلطتهم عليكم ويسلبوا حريتكم، إنهم يدركون ما يفعلون، يقولون: أنتم قمتم بثورة فأنتم الآن أحرار، أنت تتحدث بما تشاء عن ذاك، وذاك يتحدث عنك بما يشاء، وهذا يسخر قلمه ضدّك، وأنت تسخر قلمك ضد الآخرين، أنهم يدركون ما يفعلون ويريدون من خلال الحرية أن يسلبوا حريتكم، أن يوجدوا عندكم الحرية غير الصحيحة ويسلبوا منكم الحرية الحقيقية"[5].
[1] الكلمات القصار، عنوان الحرية، ص 143.
[2] م.ن، ص 143.
[3] م.ن، ص 143.
[4] م.ن، ص 143.
[5] منهجية الثورة الإسلامية، ص 371.
إيران.. التخصيب حق ذاتي لا رجعة عنه
وقال آية الله خامنئي إن على الجانب الأميركي الذي يشارك في المفاوضات غير المباشرة أن يوقف ترهاته.
واوضح أنه عندما يتحدثون بأنهم لن يسمحوا لإيران بتخصيب اليورانيوم هو كلام فارغ، مؤكدا ألا أحد ينتظر الإذن منهم، والجمهورية الإسلامية لها سياسة خاصة بها تنتهجها وهي ماضية في تنفيذ سياساتها.
واستبعد قائد الثورة الإسلامية أن تفضي المحادثات الجارية إلى نتيجة على غرار ما حدث في فترة رئاسة الشهيد إبراهيم رئيسي.
وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق د.هادي سيدأفقهي ومن بيروت مدير موقع الخنادق د.محمد شمص، وتناقشهم هذه الأسئلة:
- هل تصريحات قائد الثورة الإسلامية هي مؤشر فعلي لفشل المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة؟
- بعد هذه التصريحات هل بقي باب للتفاوض والمحادثات أم أن التصعيد سيكون عنوان المرحلة المقبلة؟
- الولايات المتحدة تحدثت عن أنها لن تسمح لإيران بالتخصيب ما هي أدواتها وكيف ستتعامل طهران مع هذا الموقف؟
- الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها السابق تجاه التخصيب، لماذا هذا التراجع وما هي أسبابه؟
رواشنطن لها تاريخ طويل في المواقف المتقلبة والتراجع عن المواقف هل يمكن أن تتراجع الآن في ظل الإصرار الإيراني على مواصلة التخصيب؟
- هل التأكيد الإيراني على مواصلة التخصيب يتضمن نسبة محددة أم أن موضوع النسبة أمر مرن بالنسبة لطهران ويمكن التفاوض بشأنه؟
- هل الولايات المتحدة مستعدة للتصعيد مع إيران وهل هي قادرة على تحمل تبعات أي تصعيد خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية؟
- هل من الممكن أن نشهد مزيدا من الوساطات الدولية والإقليمية أم أن الأمر انتهى ولو في الوقت الراهن على أقل تقدير؟
سيرة الإمام الرضا عليه السلام في الحياة والعائلة
لقد جسّد أهل البيت عليهم السلام القيم الإسلامية العليا في سلوكهم وأفعالهم، كالإخلاص والصدق والأمانة والتواضع والكرم والعفو والعدل والإحسان. والاقتداء بهم يعني تجسيد هذه القيم في حياتنا اليومية مما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع. وكذلك الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام يوجب الاستقامة على الصراط المستقيم. فإنّ أهل البيت عليهم السلام هم الهداة المهديون الذين أرشدوا الناس إلى الصراط المستقيم. فهم المصداق الأبرز للآية الشريفة: ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (1).
والاقتداء بهم يعني السير على نهجهم القويم، وتجنب الانحراف والضلال. ولهذا يمكننا أن نفهم أن الاقتداء بأهل البيت العصمة والطهارة عليهم السلام هو السبب لتحقيق السعادة في الدارين. لأنه من خلال الالتزام بأخلاقهم الرفيعة، يمكننا أن نعيش حياة طيبة هانئة، وننال رضا الله تعالى وجنته. والنكتة الجديرة بالذكر هي إنّ أهل البيت عليهم السلام واجهوا في حياتهم العديد من التحديات والمصاعب، وثبتوا على الحق ولم يتزعزعوا. والاقتداء بهم يعني التحلي بالصبر والشجاعة والعزيمة لمواجهة تحديات العصر ومستجداته. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ (2).
ضرورة إعادة قراءة سيرة الإمام الرضا عليه السلام في العصر الحاضر
إنّ الإمام الرضا عليه السلام هو ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام وقد عاش في فترة عصيبة من تاريخ الأمة الإسلامية، حيث شهدت صراعات سياسية وفكرية واجتماعية. ورغم هذه الظروف الصعبة، استطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يقدم نموذجًا فريدًا في القيادة والإمامة، وأن يرسخ القيم الإسلامية في المجتمع. كان الإمام الرضا عليه السلام بحرًا من العلم والمعرفة حيث أعطى الله لأئمة المعصومين عليهم السلام علما فنقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: « مَحالِّ مَعْرِفَةِ الله وَمَساكِنِ بَرَكَةِ الله وَمَعادِنِ حِكْمَةِ الله وَحَفَظَةِ سِرِّ الله وَحَمَلَةِ كِتابِ الله وَأَوْصِياء نَبِيِّ الله » (3)، وقد استطاع من خلال علمه وحكمته أن يرد على الشبهات والأباطيل، وأن ينشر الوعي والثقافة الإسلامية. وفي عصرنا الحاضر، الذي يشهد تطورات علمية وتقنية هائلة، نحتاج إلى الاقتداء بالإمام الرضا عليه السلام في طلب العلم والمعرفة، واستخدامها في خدمة الإسلام والمسلمين.
كان الإمام الرضا عليه السلام يتميز بالحوار والتسامح مع المخالفين، وقد استطاع من خلال الحوار الهادئ والموضوعي أن يقنع الكثيرين بصحة الإسلام. يمكننا أن نفهم هذا من خلال مناظراته مع كبراء المذاهب والأديان الأخرى عندما أصبح عليه السلام وليّ عهد المأمون العباسي. وفي عصرنا الحاضر، الذي يشهد صراعات ونزاعات طائفية ومذهبية، نحتاج إلى الاقتداء بالإمام الرضا عليه السلام في الحوار والتسامح، ونبذ التعصب والتطرف.
كان الإمام الرضا عليه السلام مثالا بارزا لمساعدة الآخرين خصوصا الفقراء والمساكين وكان مصداقا ظاهرا للزهد والورع عن الدنيا وزخارفها. فعندم نراجع رواياته الشريفة يمكننا أن نشاهد هذا بوضوح. فعلينا أن نتعلم من كيفية حياته عليه السلام.
التعادل بين الدنيا والآخرة
إنّ من أبرز ما يميّز سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو التوازن العجيب الذي تجسّد في حياته بين الاهتمام بأمور الدنيا والسعي لنيل رضا الله والدار الآخرة. لم يكن عليه السلام من الزاهدين الذين يعتزلون الدنيا وينقطعون عن الناس. لم يكن عليه السلام يرى في الدنيا شراً محضاً، بل كان يعتبرها مزرعة للآخرة وأن الإنسان يجب أن يستغلها في طاعة الله ومرضاته. في المقابل، لم يكن الإمام الرضا عليه السلام من الذين يغرقون في ملذات الدنيا وشهواتها وينسون الآخرة. بل كان عليه السلام يعتبر الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار القرار.
فقد نقل محمد بن عباد: « كان جلوس الرضا على حصير في الصيف وعلى مسح في الشتاء ، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزيأ. ولقيه سفيان الثوري في ثوب خز فقال : يا ابن رسول الله لو لبست ثوبا أدنى من هذا ، فقال : هات يدك ، فأخذ بيده وأدخل كمه فإذا تحت ذلك مسح ، فقال: يا سفيان الخز للخلق والمسح للحق» (4).
وقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام: « اجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة منه لمناجاته، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات، والذين يعرفونكم عيوبكم، ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم، وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث الساعات. لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. إجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا، بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما لم ينل المروة ولا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين» (5).
المداراة مع الناس
لم تكن المداراة عند الإمام الرضا عليه السلام مجرد تكتيك أو أسلوب للمسايرة، بل كانت نابعة من إيمانه العميق بقيمة الإنسان واحترامه لحريته في التفكير والتعبير. كان عليه السلام يرى أن المداراة هي الوسيلة الأنجح لكسب القلوب وتغيير النفوس وأن العنف والخشونة لا يزيدان الأمور إلا تعقيداً وتأزماً. فقد روى سهل بن زياد الآدمي عن الإمام الرضا عليه السلام:« لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان سره، قال الله جلّ جلاله: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول)، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله بمداراة الناس، فقال:(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء، يقول الله عز وجل: (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) » (6).
وأيضا روى الإمام الرضا عليه السلام حول التفريج عن المؤمنين: « مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (7).
حسن الخلق
إن حسن الخلق من أهم الصفات الإنسانية التي أكد عليها الله سبحانه وتعالى حيث قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (8). والإمام الرضا عليه السلام كان منبعا راسخا لحسن الخلق. فقد روي عنه عليه السلام: « من خرج في حاجة ـ ومسح وجهه بماء الورد لم يرهق وجهه قتر ـ ولا ذلة ـ ومن شرب من سؤر اخيه المؤمن يريد بذلك التواضع ادخله الله الجنة البتة ، ومن تبسم في وجه اخيه المؤمن كتب الله له حسنة ، ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه» (9). وأيضا روي عنه عليه السلام:« أَقْرَبُکُمْ مِنِّي مَجْلِساً يوْمَ الْقِيامَهِ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ خَيرُکُمْ لِأَهْلِهِ » (10).
إن الاطلاع على سيرة الإمام الرضا عليه السلام لا يقتصر على قراءة مقال أو كتاب، بل هو رحلة مستمرة في بحر علومه وأخلاقه. أدعوكم إلى تخصيص وقت منتظم لقراءة الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية التي تتناول حياة الإمام عليه السلام والاستماع إلى المحاضرات والندوات التي تتحدث عن سيرته العطرة.
إن الهدف الأسمى من دراسة سيرة الإمام الرضا عليه السلام هو تطبيقها في حياتنا اليومية وتحويلها إلى سلوك وممارسة. أدعوكم إلى أن تتأملوا في الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها الإمام عليه السلام وأن تسعوا جاهدين إلى اكتسابها والتحلي بها.
1) سورة البقرة / الآية: 5.
2) سورة البقرة / الآية: 119.
3) مفاتيح الجنان (للشيخ عباس القمي) / المجلد: 1 / الصفحة: 651 / الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية – طهران / الطبعة: 1.
4) مناقب آل أبي طالب (لإبن شهرآشوب) / المجلد: 3 / الصفحة: 470 / الناشر: المطبعة الحيدرية – النجف الأشرف / الطبعة: 1.
5) فقه الرضا عليه السلام (مجموعة من العلماء) / المجلد: 1 / الصفحة: 337 / الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث – قم / الطبعة: 1.
6) الأمالي (للشيخ الصدوق) / المجلد: 1 / الصفحة: 408 / الناشر: مؤسسة البعثة – بيروت / الطبعة: 1.
7) الكافي (لمحمد بن يعقوب الكليني) / المجلد: 2 / الصفحة: 200 / الناشر: دار الكتب الإسلامية – طهران / الطبعة: 4.
8) سورة آل عمران / الآية: 159.
9) مصادقة الإخوان (للشيخ الصدوق) / المجلد: 1 / الصفحة: 52 / الناشر: مكتبة الإمام صاحب الزمان – النجف الأشرف / الطبعة: 1.
10) صحيفة الإمام الرضا عليه السلام (محمد مهدي نجف) / المجلد: 1 / الصفحة: 67 / الناشر: دار الأضواء – بيروت / الطبعة: 1.