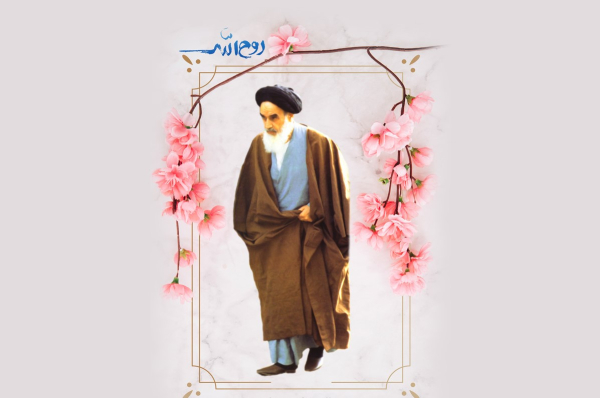emamian
بيان قائد الثورة الإسلامية حول الجريمة الإرهابية في كرمان
وجاء في هذا البيان أن أعداء الشعب الإيراني الشريرين والمجرمين خلقوا مرة أخرى كارثة وقاموا باستشهاد عدد كبير من مواطنينا الأعزاء في كرمان وفي الأجواء العطرة في مقبرة الشهداء.
وقال قائد الثورة الإسلامية في هذا البيان: خيم الحزن على الشعب الإيراني وباتت العديد من الأسر حزينة على فقدان فلذات أكبادها وأعزائها. لم يستطع المجرمون قساة القلوب تحمل عشق الناس وشوقهم لزيارة ضريح قائدهم العظيم الشهيد قاسم سليماني.
وأكد سماحته أن على المجرمين القساة أن يعلموا أن جنود الطريق المنير للشهيد سليماني لن يتحملوا خبثهم وجریمتهم. سواء الأيدي الملطخة بدماء الأبرياء أم العقول الفاسدة والشريرة التي قادتهم إلى هذا الضلال ستكون هدفاً للرد القاصم والعقاب العادل من الآن فصاعدا. وليعلموا أن هذه الكارثة سيكون لها رد قوي إن شاء الله.
وقال آية الله العظمى خامنئي في هذا البيان: انني اشارك عائلات الشهداء الثكلى العزاء؛ واعرب عن تضامني معهم؛ سائلا الباري تعالى ان يمنّ عليهم بالصبر والسلوان، كما اتعاطف مع جرحى هذا الحادث واسأل الله لهم بالشفاء.
واضاف قائد الثورة الإسلامية ان ارواح هؤلاء الشهداء ستحل ضيفا انشاء الله على سيدة نساء العالمين وام الشهداء الصديقة الطاهرة (س).
أهم خدمة انجزها الشهيد سليماني هي إحياء محورالمقاومة
قال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، ان انتشار صيت واسم وذكرى وصفات الشهيد سليماني يعود إلى صدقه، و أهم دور وخدمة لهذا الشهيد الجليل هو إحياء محور المقاومة في المنطقة.
واضاف قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه عائلة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، ان المقاومة في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر هي بسبب وجود محور المقاومة، وقد بذل الشهيد سليماني الكثير من الجهود لإحياء جبهة المقاومة، وواصل هذا العمل بنفس الإخلاص والحكمة والأخلاق.
وتابع قائلا : يجب أن يستمر خط تعزيز جبهة المقاومة.
في الشتاء.. هذه الخضروات تقوي مناعتك
أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إلى أن الخضروات الشتوية تعد من المواد الغذائية التي تحتوي على عديد من العناصر المهمة للجسم ولتقوية الجهاز المناعي.
وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن هذه الخضروات تعزز من قوة الجهاز المناعي بما تحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية مهمة.
وتشتهر الخضروات الشتوية أيضا بمحتواها العالي من فيتامين "سي" والألياف الغذائية.
ومن هذه الخضروات الكرنب (الملفوف) والبصل الأخضر والكرافس والجزر والكوسة واللفت والملفوف الأحمر والخس والثوم الأخضر.
وأشارت دراسات حديثة إلى أن بعض الخضروات الشتوية تساعد أيضا على خفض معدل الكوليسترول في الدم، ومن هذه الخضروات السبانخ والقرنبيط والجزر وقرع العسل والبنجر والكرنب.
جدير بالذكر أن النظام الغذائي المتوازن يعد أساسا لا غنى عنه لصحة جيدة وتعزيز الجهاز المناعي، وذلك إلى جانب النوم الجيد والنشاط البدني، فضلا عن حصول الجسم على فترات راحة كافية.
موقع فرنسي: كيان الاحتلال الخاسر الأكبر بعد حرب غزة وسيختفي!
نشرت صحيفة "موند أفريك" تقريرا يتحدث عن الحرب الاسرائيلي على غزة واكدت أن تأثيرها سيكون سلبياً أكثر عليها من على فلسطين، وأن هذه الحرب الاستعمارية التي تشنها ستفشل مثلما فشلت جميع المشاريع الاستعمارية وسوف تختفي الصهيونية.
تحدث موقع "موند أفريك" الفرنسي، في تقرير عن الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي لا تزال تلقى دعماً وضوءاً أخضر من الولايات المتحدة الأميركية، ويشير إلى أن مستقبل الصهيونية المتمثل بـ"إسرائيل" لا يتحدث عنه أحد، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر هو على "إسرائيل" نفسها وهي الخاسر الأكبر في هذه الحرب، أكثر من الدولة الفلسطينية.
فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:
لا يزال لدى "إسرائيل" الضوء الأخضر الأميركي والدولي للاستمرار، طالما لم يتم التوصل إلى حل ما بعد الحرب، وما دام المفاوضون مستمرين في الحديث عن حل إداري ليس فقط لغزة، بل أيضاً لفلسطين والمنطقة برمتها. لكن لا أحد يتحدث أو يناقش مستقبل الصهيونية، ممثلة بـ"إسرائيل" اليوم، بينما على المدى الطويل فإن الأخيرة بشكلها الحالي أكثر عرضة للخطر من الدولة الفلسطينية.. لماذا؟
أصبحت "إسرائيل" معزولة بشكل متزايد في العالم. لقد أصبح الدعم غير المشروط نادراً على نحو متزايد، والتكاليف في الأرواح البشرية والمواد هائلة. سيتعين على "إسرائيل" أن تقوم بتقييم ما بعد هذه الحرب والكشف عنه لعامة الناس، ولن تتمكن بعد الآن من إخفاء الأرقام عندما يعود الجنود إلى منازلهم، أو عندما يعودون معوقين، أو لا يعودون على الإطلاق.
في الحرب، نصف قوة المقاتلين على الأقل تكمن في إرادتهم للقتال. لكن على الجانب الإسرائيلي، لن يكون هذا موجوداً كثيراً بـ"استثناء بين المتطرفين والمستوطنين"، بينما على الجانب الفلسطيني، فهو فطري ومتأصل في جميع السكان.
بعد الحرب، من المحتمل أن تكون هناك انتخابات في "إسرائيل". هذه لن تكون سهلة. المنافسة الشديدة ستكون بين اليمين المتطرف والمعارضة. وبغض النظر عمن سيفوز، فإن الفصيل الذي يخسر الانتخابات سيكون لديه ما يكفي من النفوذ لمنع الفصيل الذي يفوز من إدارة البلاد بشكل صحيح. وسندخل مرة أخرى في دوامة الانسداد، كما حدث في السنوات الأخيرة مع 5 انتخابات متتالية في أقل من 4 سنوات.
ناهيك عن أن عملية التطبيع مع الدول العربية ستتباطأ. والقضية الفلسطينية عادت إلى واجهة المشهد السياسي.
وبالتالي فإن الصهيونية، ممثلة بـ "إسرائيل"، هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب. ولم تكسب "إسرائيل" شيئاً لا عسكرياً ولا سياسياً، ولا في أي مجال آخر سوى زرع بذور الانتقاد، وحتى الكراهية، في جميع أنحاء العالم. ماذا ستنتج هذه البذور؟.. ومن المحتمل أن تندلع حرب جديدة ضد الصهيونية (وليس ضد اليهود) في غضون سنوات قليلة، والتي من المحتمل أن تكون أكثر فتكاً.
إن هذه الحروب التي تشنها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين منذ عام 1948 هي حروب استعمارية بحتة. جميع المشاريع الاستعمارية فشلت واختفت، وسوف تختفي الصهيونية أيضاً بالطريقة نفسها.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي قناة العالم وإنما تعبر عن رأي الصحيفة حصراً
لقاء سابق للشهيد العاروي مع قائد الثورة الاسلامية..
وفي هذا اللقاء وجه العاروري خطابه لایة الله الخامنئي بعد أن أبلغه سلام وتحيات إسماعيل هنية والشعب الفلسطيني قائلاً: كما تفضلتم نحن نعتقد بأن القدس وفلسطين ستتحرر من قبضة الصهاينة وفق الوعد الإلهي وسوف يصلي في المسجد الأقصى كل المجاهدين والأمة الإسلامية جمعاء.
كما أشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى مواقف الإمام الخميني الحازمة في دعم قضية فلسطين قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية وأيضاً مواقف قائد الثورة الإسلامية الصريحة قائلاً: نحن كنا دائماً شاكرين للدعم المستمر الذي لا يتغير من قبل الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني ولا نزال كذلك.
وأشار السيد صالح العاروري إلى معاداة أمريكا والكيان الصهيوني للجمهورية الإسلامية وفرضهم الحظر وممارستهم التهديد وتابع قائلاً: نحن كحركة مقاومة وكحركة حماس نعلن عن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ونؤكد على أن أي خطوة عدائية تجاه إيران هي خطوة عدائية ضد فلسطين وحركة المقاومة ونحن نرى أنفسنا في الخط الأمامي للدفاع عن إيران.
ثم أشار السيد العاروري إلى قدرات حركات المقاومة الدفاعية في فلسطين قائلاً: تقدم حماس وسائر حركات المقاومة على المستوى الدفاعي لا يقارن أبداً بالأعوام الماضية ولقد باتت اليوم كل الأراضي المحتلة والمراكز الأساسية والحساسة بالنسبة للصهاينة في مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية.
كما تحدث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول صفقة القرن واصفاً إياها بأنها أخطر مؤامرة تعمل على محو الهوية الفلسطينية وقدم السيد العاروري تقريراً عن آخر تطورات وأوضاع مدينة غزة والضفة الغربية لنهر الأردن.
وفي ختام هذا اللقاء قدمت وفد حركة حماس لوحة نُقشت عليها صورة المسجد الأقصى للإمام الخامنئي.
لبنان: استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في اعتداء إسرائيلي
ارتقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم الثلاثاء، شهيداً، من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان) بأنّ "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.
واستشهد أيضاً 6 أشخاص آخرين من قادة وكوادر الحركة من جراء استهداف مبنى بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة، هم القائد القسامي سمير فندي - أبو عامر، القائد القسامي عزام الأقرع - أبو عبد الله، الشهيد محمود زكي شاهين، الشهيد محمد بشاشة، الشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.
حب الإحسان وكره الفسوق والعصيان
ورد في الدعاء عن أهل بيت العصمة (صلوات الله عليهم): "اللّهمَّ حبّب إليّ فيه الإحسان، وكرّه إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرّم عليّ فيه السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين".
حب الإحسان:
ينقسم الإحسان إلى قسمين:
أ- الإحسان إلى النفس، وذلك مقابل ظلم النفس، فطاعة الله عزَّ وجلَّ والالتزام بأوامره ونواهيه هو من الإحسان إلى النفس، وأمَّا ارتكاب المعاصي فهو ظلم وإساءة لهذه النفس، لأنّك تلحق بها الأذى والعذاب نتيجة ارتكاب هذه المعاصي.
والإحسان أيضا هو أن تأتي بالطاعة على وجهها تامَّة غير ناقصة، ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: "إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكلِّ حسنةٍ سبعمائة... فقلت له: وما الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليَّت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صُمت فتوقَّ كلَّ ما فيه فساد صومك... وكلُّ عملٍ تعمله لله فليكن نقيّاً من الدَنس([1]).
ب- الإحسان إلى الغير، وذلك مقابل ظلم الغير وحرمانه، قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾([2]).
يتجلّى الإحسان إلى الغير بمظاهر عديدة لا ترتبط فقط بالمسائل المادّية من الإنفاق وقضاء الحوائج وإن كانت هي أبرز نماذجها، فالمعاملة مع الناس، من البدء بتحيَّتهم وطريقة تحيَّتهم إلى آخر ما يمكن أن يكون فيه إظهار المودّة لهم هو من مصاديق الإحسان.
إنَّ فوائد الإحسان تظهر في الدنيا والآخرة، فهذه الآية تحدّثنا عن فائدة الإحسان على مستوى علاقة الإنسان بالله والتي تتمثَّل بحبّ الله للإنسان المُحسن.
وأمَّا الفوائد الدنيويَّة فقد وردت الروايات بها ونتعرّض هنا لبعضها:
محبَّة الناس: عن الإمام علي عليه السلام: "من أحسن إلى الناس استدام منهم المحبّة"([3]).
رفع العداوة والخصومة: عن الإمام علي عليه السلام: "الإحسان إلى المسيء يستصلح العدوّ"([4]).
كره المعصية:
هل تشعر بالذنب عند ارتكابك معصية ما؟ أو أنَّ المسألة تمرّ ولا يؤنِّبك ضميرك على ما فعلت؟ إنّه علامة الإيمان. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: "إنَّ المؤمن ليرى ذنبه كأنَّه تحت صخرة يَخاف أن تقع عليه، والكافر يرى ذنبه كأنّه ذبابٌ مرَّ على أنفه"([5]).
إنَّ ما يوجب كره المعصية عند الإنسان هو أن يذهب بتفكيره إلى من يعصي. إنَّك بمعصيتك لا تُسيء إلى إنسان مثلك ذي قدرةٍ محدودة، وعلمٍ محدود، بل إنَّك تُسيء إلى ربِّك صاحب النِعَم والأيادي عليك، والعالم بكلِّ ذنب اقترفته وبالسبَّب الذي جعلك ترتكبه.
إنَّ الذي يرتكب المعصية ولا يبالي، يقع في ذنبٍ أكبر من ارتكابه للمعصية، لأنَّه يظنُّ في نفسه الأمن من مكر الله، وهو من كبائر الذنوب فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام لمّا سُئل عن أكبر الكبائر فقال: "الأمن من مكر الله، والأياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله"([6]).
الحذر من الغضب الإلهي:
إنَّ أعظم المخاطر التي تُحدق بهذا الإنسان فتقضي عليه في الدنيا والآخرة، أن يصل إلى درجةٍ يكون محلاً للغضب الإلهيّ، لأنَّ ذلك يعني أن يقع على الطرف المقابل تماماً لما هو المطلوب، إنَّ سعي المؤمن وجهده إنّما هو للوصول إلى مقام الرضا الإلهي، فإذا وصل الإنسان إلى مقام سخط الله، فقد أصبح في الطرف المقابل تماماً للمطلوب من الإنسان الوصول إليه.
إنَّ الطريق الذي يُمكن من خلاله الأمن من الغضب الإلهيّ، أن تحذر من أن تقع في الغضب، لأنّ الغضب يجرّ إلى ظلمِ الناس، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لمّا سأله رجل: أحبُّ أن أكون آمنا من غضب الله وسخطه: "لا تغضب على أحد تأمن غضب الله وسخطه"([7]).
إنّ أعظم قومٍ استحقَّوا الغضب الإلهيّ هم اليهود، وذلك لظلمهم الناس ومعصيتهم لله عزَّ وجلَّ رغم النِعَم المتتالية عليهم. قال تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾([8]).
فهذا الظلم الذي مارسه بنو إسرائيل ولا زالوا يمارسونه إلى الآن يوجب حلول الغضب الإلهيّ عليهم.
إنَّ الغضب الإلهي هو ما تدعو الله أن يأمَنك منه في كلِّ يوم في صلاتك حيث تقرأ فاتحة الكتاب فتقول: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾.
فهل فكَّرت يوماً كيف يُمكنك أن تكون في مأمن فعلا من أن تكون من المغضوب عليهم؟
([1]) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج68 ص 248.
([2]) البقرة: 195.
([3]) عيون الحكم والمواعظ - علي بن محمد الليثي الواسطي - ص 440.
([4]) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج1 ص 641.
([5]) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج74 ص 77.
([6]) الكافي - الشيخ الكليني - ج2 ص 545.
([7]) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج3 ص 2268.
([8]) البقرة:61.
حياة الزهراء (عليها السلام) كنموذج للحياة المعاصرة
إنّ حياة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل والسعي والتكامل والسموّ الروحيّ للإنسان، وكان زوجها الشاب في الجبهة وميادين الحرب دائمًا، وكانت مشاكل المحيط والحياة قد جعلت فاطمة الزهراء (عليها السلام) مركزًا لمراجعات الناس والمسلمين.
وقد أمضت البنت المـُعِينة للنبي (صلى الله عليه وآله) حياتها بمنتهى الرفعة في تلك الظروف، وقامت بتربية أولادها الحسن والحسين وزينب وإعانة زوجها علي (عليه السلام) وكسب رضى أبيها النبي (صلى الله عليه وآله)، وعندما بدأت مرحلة الفتوحات والغنائم لم تأخذ بنت النبي ذرّة من لذائذ الدّنيا وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور التي تميل لها قلوب الشابّات والنساء.[1]
ضرورة أن تكون زوجات المسؤولين قدوةً في تجنّب الإسراف
أقول للنساء المسلمات -الشابّات وربّات البيوت- لا تذهبنّ وراء الإعلام الاستهلاكيّ الذي يروّج له الغرب كالأرَضَة في روح المجتمعات البشريّة ومجتمعات الدول النامية ومنها دولتنا. فالاستهلاك جيد بالمقدار اللازم وليس في حدّ الإسراف، وعلى نساء المسؤولين اللواتي لدى أزواجهن أو لديهنّ مسؤوليّات في المجالات المختلفة أن يكنّ أُسوة للأخريات من حيث الابتعاد عن الإسراف. ويجب عليهن أن يعطين الأخريات درسًا في أنّ المرأة المسلمة هي أرفع من أن تصبح أسيرة المجوهرات والمسكوكات الذهبيّة وأمثال هذه الأشياء. ولا نريد أن نقول إنّها حرام، بل نريد أن نقول إنّ شأن المرأة المسلمة هو أرفع من أن يقوم البعض -في الفترة التي يعيش كثير من أبناء مجتمعنا في وضع هم بحاجة فيه إلى المساعدات المادّية- في شراء الذهب والزينة ووسائل الحياة المتنوّعة ويسرفون في مجالات الحياة المختلفة.[2]
معرفة المرأة، عامل في ابتعاد الأسرة عن الترف والكماليّات
اليوم، إنّ أكثر فتياتنا ونسائنا الشابّات تديّنًا وثوريّة وإخلاصًا وإيمانًا، هم من بين الشرائح المتعلّمة. إنّ أهل الترف والكماليّات والتعلّق بوسائل الزينة، أو الذين يريدون تقليد النماذج الغربيّة تقليدًا أعمى في الملبس ونمط العيش، هم غالبًا لا يتحلّون بالعلم والمعلومات والمعرفة بالنحو الوافي. فالشخص ذو المعرفة يمكنه ضبط تصرّفاته ومسلكه، ومطابقته بكلّ ما هو حقّ وحقيقة وصلاح. لذا، ينبغي في الميدان العلميّ، فتح كلّ طرق الفعاليّة والنشاط أمام النساء. وعلى الفتيات، حتّى في القرى أن يتابعن تعليمهن. توصيتي إلى الآباء والأمّهات أن يسمحن لبناتهنّ بالالتحاق بالمدارس وبأن يتعلّمن. وإذا كنّ يمتلكن الاستعداد ويرغبن، فليتابعن بعد طيّ المراحل الابتدائيّة دراستهنّ العالية والجامعيّة، ولا تمنعوهنّ. دعوهنّ يكنّ في عداد المتعلّمات وذوات المعرفة في مجتمعنا الإسلاميّ.[3]
[1] في لقاء مه جماعة من النساء، بمناسبة مولد السيّدة الزهراء عليها السلام ويوم المرأة 25/9/1371هـ.ش [16/12/1992م]
[2] في لقاء مع جماعة من النساء، بمناسبة ولادة السيّدة الزهراء (س) ويوم المرأة 25/9/1371هـ.ش [16/12/1992م]
[3] خطابه في جمع من الأخوات في أرومية 28/6/1375هـ.ش [18/9/1996م]
مِنْ معالِم شخصيّة الإمام الخمينيّ (قدس سره)
يذكر الإمام الخامنئيّ دام ظله، وعلى مدى خطبٍ عديدةٍ الكثير من الصّفات الّتي تتمتّع بها شخصيّة الإمام الخمينيّ قدس سره، ونحن هنا سنستعرض أهمَّها تاركين التّفصيل فيها، وكذلك عرْض غيرها إلى ما يلي من الدّروس، بسبب التّداخل الموجود بينها وبين مضامين الدّروس التّالية.
1- الثّقة بالنّفس:
"الإيمان بالذّات - الثّقة بالنّفس - لقد علّم الإمام الشّعب الإيرانيّ معنى "نحن قادرون". وقبل أن يُلقِّن الإمام الشّعب الإيرانيّ ويعلِّمهم "نحن قادرون"، كان قد أحياها في داخله، وقد أظهر وأبرز اعتقاده بقدراته الشخصيّة بالمعنى الحقيقيّ للكلمة. في عاشوراء 1963م، هدّد الإمام - وعلى الرُّغم من غربته وسط طلّاب وأهالي قمّ في المدرسة الفيضيّة - "محمّد رضا شاه" قائلًا: إذا فعلت كذا، وإن أكمَلت على هذا المنوال، فسأطلب من الشّعب الإيرانيّ أن يطرُدك من إيران"... وفي ذلك اليوم الّذي عاد فيه الإمام من منفاه، هدّد حكومة "بَختيار" في خطابه في "جنّة الزّهراء عليها السلام"، وقال بالصّوت الملآن: "سأصفع وجه حكومة "بختيار"، و"سأعيّن الحكومة"، هذه هي الثّقة بالذّات"[1].
2- الإيمان والعمل الصّالح وتزكية النّفس:
"الخصوصيّة الأولى هي الإيمان، والخصوصيّة الثّانية هي العمل الصّالح، وفي آخر الدُّعاء الوارد في الآية الكريمة ذُكرت صفة ثالثة، هي صفة تزكية النّفس وتهذيبها... وهذه الخصوصيّات الثّلاث كانت تشكِّل معالم بارزة في حياة إمامنا قدس سره... وما تشاهدونه اليوم من المكانة الرّفيعة الّتي يحظى بها إمامُنا الرّاحل في جميع أرجاء المعمورة، مردُّها إلى تلك الخِصال الثّلاث الّتي كان يتمتّع بها قدس سره"[2].
3- حُبّ الشّباب له:
"كان - الإمام الخمينيّ- الأستاذ الّذي يجذِبُ إليه الطّلبة الشّباب المتعطّشين منذ الوهلة الأولى، هو الشّخص الّذي كان معروفًا بين تلاميذه في تلك الأيّام باسم "السّيد روح الله"، وكان الشّباب الأفاضل المُثابرون المتحمّسون مجتمعين في حلقة درسه، وفي مثل هذا الجوّ كان دخولنا على قم"[3].
4- المُجدِّد:
"كان الإمام الخمينيّ مَظهرًا للتّجديد العلميّ، والتبحُّر في الفقه والأصول. وكنت قد شاهدت قَبلَهُ أستاذًا بارعًا في مشهد، وهو المرحوم آية الله الميلانيّ، الّذي كان من الفقهاء البارزين، وكان زعيم الحوزة العلميّة في قمّ آنذاك، هو المرحوم آية الله العظمى البروجرديّ، الّذي كان أستاذًا للإمام الخمينيّ، وكان هنالك أيضًا أساتذة كبار آخرون، إلّا أنّ الوسط الدّراسيّ الّذي كان يجتذب إليه القلوب الشابّة المتلهّفة الدّؤوبة المتحفّزة نحو تفعيل الطّاقات، هو درس الفقه والأصول الّذي كان يُلقيه الإمام. وأخذنا نسمع بالتدرّج من الطّلبة الأقدم منّا، بأنّ هذا الرّجل فيلسوفٌ كبيرٌ أيضًا". وكانت دروسُه الفلسفيّة أوّل دروس فلسفيّة في قمّ، غير أنه يرجِّح في الوقت الحاضر تدريس الفقه"[4].
5- شخصيّة الإمام الجامعة:
"ما تجلّى من أبعاد شخصيّته، من بعد تأسيس الحكومة الإسلاميّة كان أهمّ وأعظم ممّا شوهِدَ منها من ذي قبل، فقد انعكست شخصيّتُهُ الفذّة على أُفقَين:
- الأوّل: أُفق القائد والمتصدّي لزمام الأمور.
- والثّاني: أُفق الزّاهد والعارف، لأنّ مَزْج هاتَين الصِّفتين، بعضهما ببعض، عملٌ لا يتسنّى للإنسان مشاهدته، إلّا لدى الأنبياء مثل داوود وسُليمان، ومثل خاتم الأنبياء"[5].
6- الإمام قدس سره الإنسان الرّقيق الرّؤوف:
"كان الإمام الخمينيّ من أهل الخَلوة وأهل العبادة والتّضرّع والدُّعاء والبكاء في منتصف اللّيل، وكان من أهل الشّعر والقِيَم والمعاني الرّوحيّة والعرفان والتعلُّق بالله. هذا الشّخص الّذي بثّ الرّعب في أوصال أعداء الشّعب الإيرانيّ، وهذا السّدّ المنيع والجبل الشّامخ، حينما تَعرُض له مواقف عاطفيّة وإنسانيّة تراه إنسانًا رقيقًا ورؤوفًا"[6].
7- الإمام قدس سره والذّوبان في الإرادة الإلهيّة:
"الإمام اكتسب كلّ هذه الصّفات من جرّاء التّقوى والتمسُّك بالدّين والامتثال لأمر الله، وقد بيَّن شخصيًّا هذا المعنى بين طيّات كلامه، ملوِّحًا بأنّ كلّ ما هو موجود إنّما هو مِنْ الله، وكنتيجةٍ للذّوبان في الإرادة الإلهيّة، وأنّ الله هو الّذي نَصَر الثّورة، وهو الّذي حرّر خرَّمشهر، وهو الّذي ألّف بين قلوب أبناء الشّعب، فكان ينظر إلى كلّ شـيء من وجهة نظر إلهــّية، وفي مقابل ذلك فتح الله أمامه أبواب رحمته"[7].
8- الاعتراف بالخطأ:
"هو أيضًا قال مرارًا في كتاباته - خصوصًا في أواخر عمره الشّريف - وفي تصريحاته إنّني أخطأتُ في القضيّة الفلانيّة. واعترفَ بأنّه أخطأ في القضيّة الفُلانيّة والفُلانيّة، وهذا يستلزم درجة كبيرة من العظَمة، يجب أن تكون روح الإنسان كبيرة حتّى يستطيع أن يفعل ذلك ويَنسِب الخطأ لنَفسِه. كان هذا الجانب المعنويّ في شخصيّة الإمام وأخلاقه. وهذا من الأبعاد المُهمّة للدّرس الّذي يعلّمنا الإمام إيّاه"[8].
9- الارتباط الدّائم بالله:
"وأودّ الإشارة على هامش الحديث إلى أنّ جهاد هذا الرّجل العظيم لا يقتصر على الجهاد السّياسيّ والاجتماعيّ أو الجهاد الفكريّ، وإنّما رافق كلَّ حالات الجهاد هذه جهادُ الباطن وجهادُ النّفس والالتزام بالارتباط الدّائم والمستمرّ بالله سبحانه وتعالى، وهذا درسٌ لنا إذا ما خُضْنا ساحة الجهاد الفكريّ أو الجهاد العلميّ أو الجهاد السياسيّ، فهذا لا يعني أنّه يحقّ لنا الإعراض عن هذا القسم من الجهاد"[9].
10- شخصيّة الإمام: جلالٌ وجمال
"لقد بُذلت جهودٌ في حياة الإمام لتحريف شخصيّته، فالعدوّ، من جهة كان يحاول منذ انتصار الثّورة، وفي وسائل إعلامه العالميّة أن يُعرّف (يُقدّم) الإمام على هيئة شخصيّة ثوريّة متصلِّبة عنيفة - على غِرارِ ما نعرفه في تاريخ الثّورات الكبيرة والمعروفة في العالَم، كالثّورة الفرنسيّة أو الثّورة الماركسيّة للاتّحاد السّوفياتيّ وبعض الثّورات الأخرى- ومن جهةٍ ثانية كإنسانٍ صُلْب مُتشدّد يُقطِّب حاجِبيه باستمرار، ولا ينظر إلّا إلى مواجهة الأعداء، ولا يتحلّى بأيّة عاطفة ومرونة، هكذا كانوا يُعرّفون الإمام وهذا كلام باطل. أجل، فلقد كان الإمام حاسمًا لا يتزلزل، وراسخًا في قراراته - كما سأُشير إلى ذلك - إلّا أنّه كان مَظهرًا للعاطفة واللّطف والمحبّة والمواساة والعشق لله ولخلق الله، ولا سيّما بالنّسبة إلى الطّبقات المظلومة والمُستضعفة في المجتمع، وهذا عمل تصدّى له العدوّ منذ اليوم الأوّل من انتصار الثّورة في وسائل الإعلام العالميّة"[10].
[1] خطاب الإمام الخامنئيّ دام ظله، مراسم الذّكرى الـ "24" لرحيل الإمام الخمينيّ قدس سره 04/06/2013 م.
[2] خطاب الإمام الخامنئيّ دام ظله، الذّكرى السّنويّة الخامسة لرحيل الإمام الخمينيّ قدس سره الزمان: 14/3/1373ش. 24/12/1414ه. 4/6/1994م.
[3] خطاب الإمام الخامنئيّ دام ظله، الذّكرى السّنويّة العاشرة لرحيل الإمام الخمينيّ قدس سره صلاة الجمعة، الزمان: 14/3/1378ش. 19/2/1420هـ. 4/6/1999هـ.
[4] المصدر نفسه.
[5] خطاب الإمام الخامنئيّ دام ظله، الذّكرى السّنويّة العاشرة لرحيل الإمام الخمينيّ قدس سره صلاة الجمعة، الزمان: 14/3/1378ش. 19/2/1420هـ. 4/6/1999هـ.
[6] المصدر نفسه.
[7] المصدر نفسه.
[8] خطاب الإمام الخامنئيّ دام ظله، الذّكرى السّنويّة الثّانية والعشرون لرحيل الإمام الخمينيّ قدس سره الزمان: 14/3/1390ش. 1/7/1432هـ. 4/6/2011م.
[9] خطاب الإمام الخامنئيّ دام ظله، الذّكرى السّادسة والعشرين لرحيل الإمام الخمينيّ قدس سره 04/06/2015.
[10] المصدر نفسه.
تجليات المقام المعنويّ للسيّدة الزهراء عليها السلام
إنّ حياة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل والسعي والتكامل والسموّ الروحيّ للإنسان، وكان زوجها الشاب في الجبهة وميادين الحرب دائمًا، وكانت مشاكل المحيط والحياة قد جعلت فاطمة الزهراء (عليها السلام) مركزًا لمراجعات الناس والمسلمين.
وقد أمضت البنت المـُعِينة للنبي (صلى الله عليه وآله) حياتها بمنتهى الرفعة في تلك الظروف، وقامت بتربية أولادها الحسن والحسين وزينب وإعانة زوجها علي (عليه السلام) وكسب رضى أبيها النبي (صلى الله عليه وآله)، وعندما بدأت مرحلة الفتوحات والغنائم لم تأخذ بنت النبي ذرّة من لذائذ الدّنيا وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور التي تميل لها قلوب الشابّات والنساء.[1]
ضرورة أن تكون زوجات المسؤولين قدوةً في تجنّب الإسراف
أقول للنساء المسلمات -الشابّات وربّات البيوت- لا تذهبنّ وراء الإعلام الاستهلاكيّ الذي يروّج له الغرب كالأرَضَة في روح المجتمعات البشريّة ومجتمعات الدول النامية ومنها دولتنا. فالاستهلاك جيد بالمقدار اللازم وليس في حدّ الإسراف، وعلى نساء المسؤولين اللواتي لدى أزواجهن أو لديهنّ مسؤوليّات في المجالات المختلفة أن يكنّ أُسوة للأخريات من حيث الابتعاد عن الإسراف. ويجب عليهن أن يعطين الأخريات درسًا في أنّ المرأة المسلمة هي أرفع من أن تصبح أسيرة المجوهرات والمسكوكات الذهبيّة وأمثال هذه الأشياء. ولا نريد أن نقول إنّها حرام، بل نريد أن نقول إنّ شأن المرأة المسلمة هو أرفع من أن يقوم البعض -في الفترة التي يعيش كثير من أبناء مجتمعنا في وضع هم بحاجة فيه إلى المساعدات المادّية- في شراء الذهب والزينة ووسائل الحياة المتنوّعة ويسرفون في مجالات الحياة المختلفة.[2]
معرفة المرأة، عامل في ابتعاد الأسرة عن الترف والكماليّات
اليوم، إنّ أكثر فتياتنا ونسائنا الشابّات تديّنًا وثوريّة وإخلاصًا وإيمانًا، هم من بين الشرائح المتعلّمة. إنّ أهل الترف والكماليّات والتعلّق بوسائل الزينة، أو الذين يريدون تقليد النماذج الغربيّة تقليدًا أعمى في الملبس ونمط العيش، هم غالبًا لا يتحلّون بالعلم والمعلومات والمعرفة بالنحو الوافي. فالشخص ذو المعرفة يمكنه ضبط تصرّفاته ومسلكه، ومطابقته بكلّ ما هو حقّ وحقيقة وصلاح. لذا، ينبغي في الميدان العلميّ، فتح كلّ طرق الفعاليّة والنشاط أمام النساء. وعلى الفتيات، حتّى في القرى أن يتابعن تعليمهن. توصيتي إلى الآباء والأمّهات أن يسمحن لبناتهنّ بالالتحاق بالمدارس وبأن يتعلّمن. وإذا كنّ يمتلكن الاستعداد ويرغبن، فليتابعن بعد طيّ المراحل الابتدائيّة دراستهنّ العالية والجامعيّة، ولا تمنعوهنّ. دعوهنّ يكنّ في عداد المتعلّمات وذوات المعرفة في مجتمعنا الإسلاميّ.[3]
[1] في لقاء مه جماعة من النساء، بمناسبة مولد السيّدة الزهراء عليها السلام ويوم المرأة 25/9/1371هـ.ش [16/12/1992م]
[2] في لقاء مع جماعة من النساء، بمناسبة ولادة السيّدة الزهراء (س) ويوم المرأة 25/9/1371هـ.ش [16/12/1992م]
[3] خطابه في جمع من الأخوات في أرومية 28/6/1375هـ.ش [18/9/1996م]