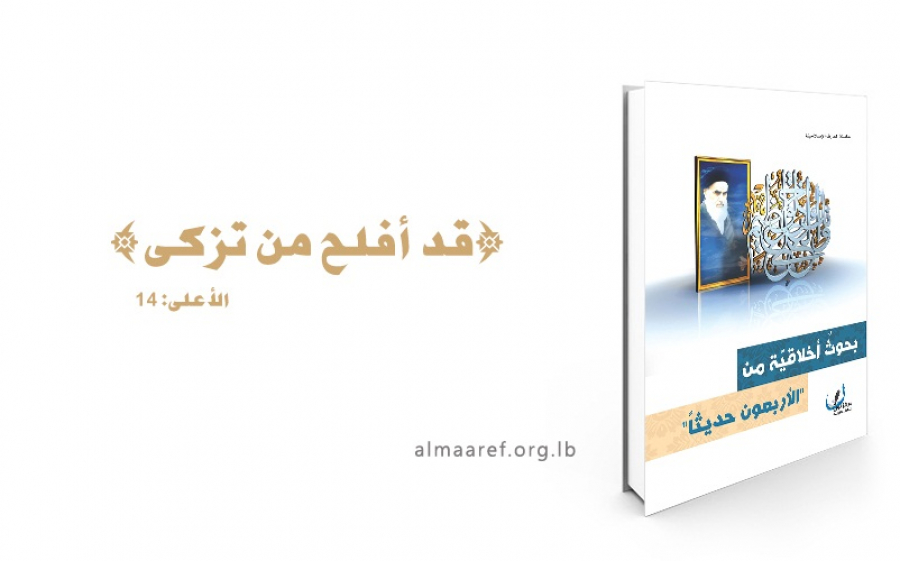يحدد القرآن الكريم غاية خلق الإنسان بقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾([1])، والعبادة في جذرها المعنوي تطلق على الفعل الذي يكون طيّعاً ليّناً مذلّلاً بحيث لا يكون فيه عصيان ولا مقاومة ولا اعتداء، من هنا سميت الطريق التي كثر المرور عليها أو سوّيت بحيث لم تعد أحجارها أو أشواكها مؤذية، بل صارت ليّنة غير شكسة ولا عاصية بالطريق المعبّد أو المسلوك المذلّل.
ومن اللافت أن الكتاب العزيز لم يعرض عبادة الله تعالى كهدف أقصى لخلق الإنسان، بل تحدث عن هدف لهذه العبادة بقوله ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾([2]).
والتقوى في مفهومها تلتقي مع الوقاية وهي المشتركة معها في جذرها المادي لتصب في خانة معنى المنعة والحصانة والحماية، ولعله لهذا الأمر عبّر تعالى بـلباس التقوى، فإن من وظيفة اللباس حماية الإنسان جسداً، فأراد الله تعالى أن يكون للإنسان قلباً وروحاً حماية أخرى تتحقق من خلال لباس معنوي هو التقوى ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾([3]).
ووصول الإنسان إلى مرحلة التقوى يصعده إلى المرتبة القرآنية الأعلى وهو الفلاح الذي يعني الفوز والظفر، قال تعالى: ﴿...فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون﴾([4]).
وفي بيان قرآني آخر للوصول إلى مرحلة الفوز النهائي المعبّر عنه بالفلاح قال تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى﴾([5]) والتزكية من زكا التي تأتي بمعنى طهر وأيضاً بمعنى زاد ونما كما في إطلاق أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما ورد عنه «العلم يزكو على الإنفاق»([6]) أي ينمو ويتكامل، فتزكية النفس المحققة للفلاح تعني إنماءها والعمل على تكاملها ورقيها.
من هنا فالتعبير بـ (تزكية) لعله أفضل من التعبير الوارد في عنوان الندوة (إصلاح) الذي قد ينصرف الذهن منه إلى فساد قد سبق.
على كلٍّ، فمما تقدم نعرف أهمية وقيمة تزكية النفس ودورها في تحقيق غاية خلق الإنسان.
وكذلك نعرف أهمية السؤال عن المنهج القويم في تزكية نفس الإنسان.
مسارات في التزكية
في استعراض وجيز لمدارس ومناهج تزكية النفس في المجتمع الإسلامي نلاحظ مسارات عديدة يتصف بعضها بالغرابة ويولّد استهجان المطّلع عليها.
أ – فبعضهم انتهج في سيره السلوكي لتزكية نفسه العمل على إرهاق الجسد لتطويعه وفي هذا الإطار يروى عن بعض الشيوخ أنه ألزم نفسه بالقيام على رأسه طوال الليل، وكذا الحال بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينامون على مسامير ونحو ذلك.
ب – وبعضهم انتهج في سيره السلوكي لتزكية نفسه العمل على إذلال النفس وإهانتها لتذليلها، كما هي حالة السالك الذي حكى قصته الغزالي بأنه سرق ثياباً في حمام عام وهرب ليلحقه الناس ويقولون عنه: سارق الحمّام، وهكذا حصل، فاعتقد أنه وصل إلى النتيجة المتوخاة فسكنت نفسه.
ج – وبعضهم انتهج في سيره السلوكي لتزكية نفسه العمل على تنقية الذهن من الخواطر العارضة له، فدعا هؤلاء إلى تركيز الانتباه إلى أحد المحسوسات مثل حجر أو جسم آخر، فينظر إليه بالعين الظاهر مدة، ولا يطبق عينه مهما أمكن، وينتبه بجميع القوى الظاهرية والباطنية إليه، ويستمر على هذه الحال مدة، قالوا بأن الأفضل أن تكون أربعين يوماً أو أكثر، وتجرأ بعضهم في بيان هذا الاتجاه بتمثيل آخر وهو أن يركّز السالك نظره على شحمة أذن فاتنة جميلة، أو محيّا شيخ مرشد بحجة أن اللبّ حينما يحصر تعلقه بشيء واحد يستطيع أن يقطع علاقاته مع الآخرين، ثم في مرحلة ثانية يقطع هذا الارتباط الوحيد ليركّز قلبه على الله تعالى ليصل إلى المبتغى المنشود.
التصوف والعرفان
وقد عُرف أصحاب بعض الاتجاهات السابقة بالمتصوفة الذين سمّوا بذلك:
أ – إمّا لأنهم كانوا يلبسون الصوف في الصيف الحار.
ب – وإمّا من الصفة أي صفة مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي كان يجتمع فيها الجائعون فسمّوا بذلك لأنهم يقتدون بأهل تلك الصفة.
ج – وإمّا من الصفواء جمع الصفاة، وتعني الصخر الأملس الذي لا ينمو عليه النبات ومنه قوله تعالى: ﴿كمثل صفوان عليه تراب﴾([7]) .
د – وإمّا من صوفانة التي تعني النبات الصغير الذي لا قيمة له.
ولعل هذه المحاولات لتفسير التصوف من ناحية الاشتقاق اللغوي ترجع إلى الخلفية التي ينطلق منها محدِّد المصطلح من ناحية نظرته إلى التصوف، من هنا نرى أن بعض من ينحو بالتصوف إلى الناحية المعرفية يرد المصطلح إلى أصل يوناني هو (Sophi) أو (Sophia) اليونانية التي تعني الحكمة وهذا ما يقرّب التصوف إلى العرفان في حين يصرّ البعض على التفرقة بين التصوف والعرفان في أن الأول يقع في دائرة السلوك والعمل في حين أن الثاني ينطلق من منهج علمي ومن خلاله يطل على السير والسلوك.
من هنا قسّموا العرفان إلى نظري وعملي، يبحث في النظري منه عن معرفة الله والعالم والإنسان، في حين يبحث في العملي منه عن العلاقات والواجبات المفروضة على الإنسان مع نفسه ومع العالم ومع الله، فالأول شبيه بالفلسفة والثاني بالأخلاق.
العرفاء والفقهاء
وقبل الحديث عن نهج الإمام الخميني (قدس سره) ورأيه في المسارات السابقة ينبغي التمييز بين مدرستي الفقهاء والعرفاء في نظرتهم إلى الغاية لتزكية النفس التي على الإنسان أن يسعى نحوها، ففي حين يرى الفقهاء أن الهدف الأقصى هو وصوله إلى السعادة، يعمّق العرفاء أطروحتهم بأن غاية تزكية النفس هي الوصول إلى الله تعالى.
فالفقهاء يرون أن تعاليم الإسلام يمكن اختصارها في ثلاثة أنواع:
الأول: العقيدة التي من خلالها يتحقق الإيمان.
الثاني: الأخلاق وهي التي ينبغي أن يتعامل معها سلوكياً كترك الرذائل والتحلّي بالفضائل.
الثالث: الأحكام وهي التي ترتبط بأعمال الإنسان الخارجية.
أما العرفاء فإنهم يتحدثون عن ثلاث مراتب:
الأول: الشريعة.
الثاني: الطريقة.
الثالث: الحقيقة.
وقد ذكر العرفاء أن هذه المصطلحات الثلاثة مأخوذة من حديث نبوي شريف هو: «الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي«([8]) .
وقد ذكروا بيانات عديدة للتمييز بين هذه المراتب المتدرّجة.
فقالوا: الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تحضره، والحقيقة أن تشهده.
وقالوا: الشريعة أن تقيم بأمره، والطريقة أن تقوم بأمره، والحقيقة أن تقوم به.
وقد طبَّق العارف السيد حيدر الآملي (قدس سره) هذه المراتب في العقيدة والأحكام:
* ففي العقيدة ذكر أن توحيد أهل الشريعة عبارة عن نفي آلهة كثيرة، وإثبات إله واحد، ونفي آلهة مقيدة وإثبات إله مطلق، والتوحيد عند أهل الطريقة يتحقق حينما يقطعون نظرهم عن الأسباب، ويتوكلون عليه حق التوكل، ويسلّمون أمرهم إليه كلياً، ويفرحون بما يجري عليهم منه لأنه ليس في الوجود غيره، ولا فاعل سواه.
أما توحيد أهل الحقيقة فيتحقق من خلال أنهم لا يشاهدون في الوجود غير الله، ولا يعرفون في الحقيقة غيره، لأن وجوده حقيقي ذاتي، ووجود غيره عارضي مجازي في معرض الفناء والهلاك آناً فآناً.
وحول هذه الحقيقة يستشهدون ببيتي شعر جميلين هما:
البحر بحر على ما كان في قدمٍ إن الحوادث أمواج وأنهار
لا تحجبنّك أشكال تشاكلها عمّن تشكل فيها فهي أستار
فالبحر هو الحقيقة، وأما الأمواج فهي فانية، هي هالكة باستمرار، بل بالدقة هي لا شيء، فالحقيقة هي فقط البحر.
* وفي الأحكام الفقهية ذكر السيد الآملي أن وضوء أهل الشريعة يتحقق بالغسلتين والمسحتين، أما وضوء أهل الطريق فيتحقق بطهارة النفس عن رذائل الأخلاق وخسائسها، وطهارة العقل من دنس الأفكار والشبه المؤدية إلى الضلال والاضلال، وطهارة السر من النظر إلى الأغيار، وطهارة الأعضاء من الأفعال غير المرضية عقلاً وشرعاً.
أما وضوء أهل الحقيقة فهو » عبارة عن طهارة السّر عن مشاهدة الغير مطلقاً، والنية فيه هي أن ينوي السالك في سرّه أنه لا يشاهد في الوجود غيره ولا يتوجه إلا إليه لأن كل من توجّه في الباطن إلى غيره فهو مشرك بالشرك الخفي «.
سؤال مفصلي:
بعد الاتضاح الإجمالي للمراتب العرفانية الثلاث طرح سؤال أساسي يتعلق بدور هذه المراتب في الوصول إلى غاية تزكية النفس، فهل الشريعة هي مجرد وسيلة للوصول إلى الطريقة وبالتالي للحقيقة، وعليه فإنها قد يستغنى عنها؟ أم أنه لا بد منها على كل حال ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة بدونها؟
منهج الإمام الخميني (قدس سره) السلوكي:
يجيب الإمام الخميني (قدس سره) رائد مدرسة العرفان في عصره عن هذا السؤال بشكل حاسم مبيّناً منهجه بقوله: «واعلم... أن طي أي طريق في المعارف الإلهية لا يمكن إلاّ بالبدء بظاهر الشريعة، وما لم يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقة لا يحصل له شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة، كما لا يمكن أن يتجلى في قلبه نور المعرفة، وتتكشف العلوم الباطنية، وأسرار الشريعة، وبعد انكشاف الحقيقة، وظهور أنوار المعارف في قلبه، سيستمر أيضاً تأدبه بالآداب الشرعية الظاهرية». ويتابع الإمام الخميني (قدس سره) ما رسمه من ميزان فيقول: ومن هنا نعرف بطلان دعوى من يقول: (إن الوصول إلى العلم الباطن يكون بترك العلم الظاهر) أو (إنه وبعد الوصول إلى العلم الباطن ينتفي الاحتياج إلى الآداب الظاهرية). وهذه الدعوى ترجع إلى جهل من يقول بها، وجهله بمقامات العبادة ودرجات الإنسانية «.
ويطبق الإمام الخميني (قدس سره) منهجه هذا على العبادات فيتحدث عن عبادة الحج التي يهدف من خلالها الوصول إلى الحقيقة بقوله » هي رأسمال من أفق التوحيد والتنزيه، وسوف لن نحصل على النتيجة ما لم ننفذ أحكام وقوانين الحج العبادية بشكل صحيح ولائق شعرة بشعرة «.
وعلى ضوء هذا المنهج يحاكم الإمام الخميني (قدس سره) بعض الاتجاهات السلوكية التي عرضتها سابقاً فيقول: » ومن التصرفات الخبيثة للشيطان لإضلال القلب وإزاغته عن الصراط المستقيم وتوجيهه نحو فاتنة أو شيخ مرشد. ومن إبداع الشيطان الموسوس في صدور الناس، الفريد من نوعه، هو أنه مع بيان عذب ومليح، وأعمال مغرية، قد يعلق بعض المشائخ بشحمة أذن فاتنة جميلة ويبرر هذه المعصية الكبيرة بل هذا الشرك لدى العرفاء، بأن القلب إذا كان متعلقاً بشيء واحد، استطاع أن يقطع علاقاته مع الآخرين بصورة أسرع، فيركز كل توجهه أولاً على الفتاة الجميلة بحجة أن القلب ينصرف عن غيرها وأنه منتبه إلى شيء واحد ثم يقطع هذا الارتباط الوحيد ويركز قلبه على الحق المتعالي، وقد يدفع الشيطان بإنسان أبله نحو إنسان أبله، نحو محيّا مرشد مكّار وحش، بل شيطان قاطع للطريق ويلتجئ في تبرير هذا الشرك الجليّ إلى أن هذا المرشد هو الإنسان الكامل، وأنه لا سبيل للإنسان في الوصول إلى مقام الغيب المطلق إلا بواسطة الإنسان الكامل المتجسد في المرآة الأحدية للمرشد، ويلتحق كلٌّ منهما بعالم الجن والشياطين. ذاك – المرشد – بالتفكير في جمال معشوقه ومفاتنه إلى نهاية عمره، وهذا – الإنسان البسيط – بالانتباه الدائم إلى محيا مرشده المنكوس حتى آخر حياته، فلا تنسلخ العلقة الحيوانية عن المرشد، ولا يبلغ الإنسان الأبله الأعمى إلى منشوده ومبتغاه «.
إن خلاصة منهج الإمام (قدس سره) أن الوصول بتزكية النفس إلى غايتها المنشودة له معبر وحيد لا تتحقق بدونه ألا وهي الشريعة التي يعتبرها ميزان معرفة الحق من الباطل في مسارات السلوك.
سماحة الشيخ د. أكرم بركات
([1]) الذاريات: 56
([2]) البقرة: 21
([3]) الأعراف: 153
([4]) المائدة: 100
([5]) الأعلى: 14
([6]) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٥ - الصفحة ٧٦
([7]) البقرة: 264
([8]) جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٤ - الصفحة ٢٣٠