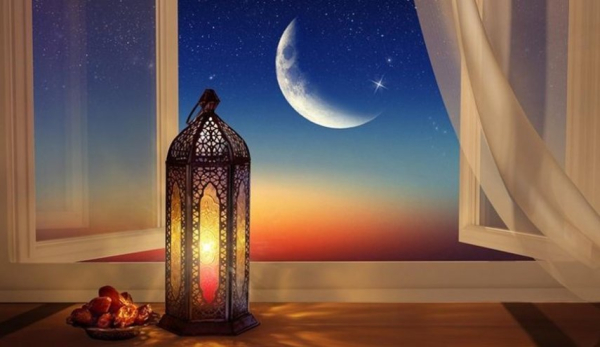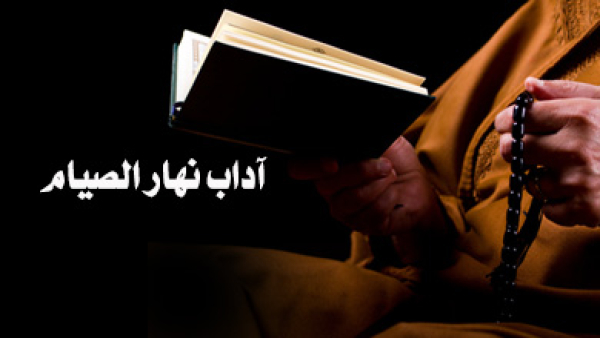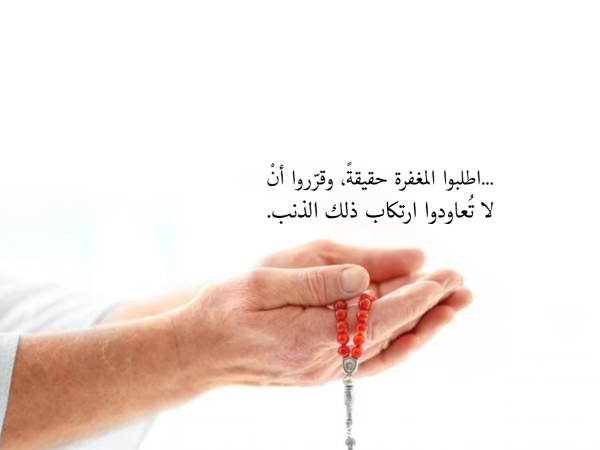emamian
شهر رمضان.. معلومات هامة حول الشعور بالعطش خلال الصيام
بحسب ما نشره موقع Everyday Health، تقول الدكتورة شيلبي أغاروال، اختصاصية طب الأسرة في واشنطن دي سي، ومؤلفة كتاب The 10 Day Total Body Transformation: "إن الترطيب مهم لأن أجسامنا تعمل حقًا [بشكل أفضل مع] توازن الماء الكافي".
أما بالنسبة للجفاف فتقول الدكتورة مالينا مالكاني من نيويورك، إنه إذا لم يتم معالجة الجفاف، فربما تؤدي الحالات الشديدة منه إلى حدوث مشاكل مثل صعوبة التنفس وزيادة درجة حرارة الجسم وضعف الدورة الدموية والنوبات. ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن أن يساهم الجفاف بشكل عام في التهابات المسالك البولية وحصى الكلى.
ويوضح الخبراء فيما يلي الفارق بين الترطيب والشعور بالعطش والجفاف وبعض الحقائق المهمة لتجنب التعرض لأي متاعب أثناء الصيام:
1. الظمأ لا يعني الإصابة بالجفاف
يقول الدكتور جينغر هولتين من سياتل ومؤلف كتاب Anti-Inflammatory Diet Meal Prep، إن العطش لا يمكن اعتباره مؤشرًا على أن هناك إصابة بالجفاف، لأن "كل شخص يحتاج إلى تقييم ما إذا كان هذا صحيحًا بالفعل بالنسبة له، لأن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالعطش. يقول هولتين: "لا يكون السبب دائمًا هو الجفاف بنسبة 100%"، فمن الممكن على سبيل المثال، أن يتسبب شيء بسيط مثل الطعام الحار في الشعور بالعطش أكثر من المعتاد. ووفقًا لما نشرته كليفلاند كلينك، فإن الزيادة الحادة في العطش يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية مثل مرض السكري. ويمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لدواء يتم تناوله بل إن بعض الأدوية تسبب جفاف الفم دون التسبب في الجفاف بحد ذاته.
2. لون البول الأصفر الداكن
يضيف الدكتور بولتين أن فحص "لون البول يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا على حالة الترطيب"، مشيرًا إلى أن مخطط ألوان البول المكون من ثمانية مستويات يحدد لون البول من اللون الأصفر الفاتح إلى الأصفر الداكن أو البني، وفقًا لما نشرته قيادة الصحة العامة بالجيش الأميركي، وعلى الرغم من اختلاف طبيعة جسم كل شخص، فإن الألوان الأربعة الفاتحة تشير إلى أن الشخص يتناول كميات مناسبة من المياه، أما الأربعة الداكنة فيمكن أن تعني أنه مصاب بالجفاف، لكن يحذر الدكتور هولتين من أن تدهور لون البول إلى النطاق البني، ولابد من المسارعة للحصول على رعاية طبية عاجلة، لأنه يمكن أن يعني الجفاف الشديد.
3. مخاطر الإفراط في الماء
يبالغ البعض في شرب المياه، ويقول الدكتور هولتين إن "هناك حالة تسمى نقص صوديوم الدم، وتحدث عندما ينخفض تركيز الصوديوم في الجسم - وهو إلكتروليت شديد الانخفاض ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى تضخم الخلايا في الجسم، وهي حالة تهدد الحياة".
بحسب كليفلاند كلينك ومايو كلينك، فإنه بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بنقص صوديوم الدم (ما يسمى بسمية الماء)، لكن يكون البعض أكثر عرضة لخطر مرتفع، من بينهم مرضى الفشل الكلوي وفشل القلب الاحتقاني واختلال وظائف الكبد والقيء الشديد المزمن أو الإسهال ومرض أديسون، والأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومدرات البول. أظهرت الأبحاث أن الرياضيين الذين يمارسون رياضة التحمل ربما يكونون أيضًا معرضين لخطر الإصابة بنقص صوديوم الدم.
4. مخاطر الجفاف الشديد
ولكن الخبر السار، بحسب الدكتورة مالكاني، هو أنه إذا لم يكن لدى الشخص أحد عوامل أو حالات الخطر المذكورة، فليس هناك ثمة ما يدعو إلى القلق، حيث إنه "بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، لا يمثل الإفراط في الماء مصدر قلق خطير، لأن الكلى قادرة على إفراز أي سوائل زائدة للحفاظ على توازن الماء والكهارل".
فيما يوضح موقع MedlinePlus أن أعراض نقص صوديوم الدم الشديدة تشمل التشنجات والارتباك والتعب والصداع والغثيان وضعف العضلات، وهي التي تحتاج إلى ضرورة التوجه إلى طبيب.
وفي هذا الصدد يحدز هولتين من أن "[الجفاف] خطير للغاية على الأطفال والنساء الحوامل وبعض كبار السن، خاصة إذا كان شخص من هذه الفئات مريضًا بالحمى أو القيء أو الاسهال، لذا فإنهم يحتاجون إلى عناية طبية على وجه السرعة لتقييم حالة الترطيب في أجسامهم".
5. الحوامل والأطفال وكبار السن
وفقًا لمايو كلينك، يكون القيء الشديد والإسهال غالبًا السبب الرئيسي للجفاف عند الأطفال. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون لدى كبار السن كمية أقل من الماء في الجسم، ويمكن أن تؤدي بعض الأدوية والحالات إلى تفاقم الأمور. أما النساء الحوامل فإن غثيان الصباح الشديد، المعروف باسم التقيؤ الحملي، يمكن أن يسبب القيء ويؤدي إلى الجفاف.
6. مصادر متعددة للماء
توضح دكتورة مالكاني أن الحصول على الماء في الجسم لا يقتصر على تناول السوائل فقط، مشيرة إلى أنه "في حين أن حوالي 80% من مدخولنا من الماء يأتي من السوائل، فإن حوالي 20% منها يأتي من الأطعمة المائية مثل الفواكه والخضروات الغنية بالعصارة". على سبيل المثال، بحسب ما نشرته مايو كلينك، يحتوي البطيخ والسبانخ على ما يقرب من 100% من الماء من حيث الوزن. وتضيف دكتورة مالكاني أن الأطعمة المرطبة الأخرى تشمل الخيار والكرفس والفجل والجرجير والجريب فروت والشمام والفراولة.
7. أطعمة تسبب العطش
وتشير دكتورة مالكاني أنه "على الجانب الآخر، فإن الأطعمة المالحة والأطعمة الغنية بالصوديوم تسبب الجفاف لأنه عندما يتم امتصاص الملح ويبدأ في الدوران في الدم، يستجيب الجسم عن طريق سحب الماء من خلايا الجسم لإحداث التوازن اللازم مما يؤدي إلى زيادة العطش".
8. قلة النوم تسبب الجفاف
توصلت دراسة، نُشرت في فبراير 2019 بدورية Sleep، إلى أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات كل ليلة يعانون من الجفاف أكثر من أولئك الذين ينامون ثماني ساعات بانتظام. يشير العلماء إلى اضطراب الفازوبريسين، وهو هرمون يفرز في الليل يساعد الجسم في الحفاظ على حالة الترطيب.
9. عدد أكواب الماء يوميًا
حول عدد الأكواب من الماء المناسب تناولها يوميًا، يقول دكتور هولتين إن "هناك مجموعة من ما يحتاجه الإنسان، والتي تعتمد على العديد من العوامل، بما يشمل النشاط البدني والنظام الغذائي والبيئة التي يعيش فيها، من بين عوامل أخرى"، مثل الظروف الصحية الأساسية والجنس والعمر وما إذا كان المرأة حاملاً أو مرضعة.
توصي أحدث الإرشادات الصادرة عن الأكاديمية الأميركية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بتناول 15 كوبًا من السوائل للرجال وحوالي 11 كوبًا من السوائل للنساء يوميًا.
10. العطش والجوع وفقدان الوزن
بينما يؤكد الخبراء على خطورة تعرض الجسم للجفاف وأن الظمأ يعد أحد العلامات على احتمال حدوث الإصابة بجفاف، إلا ان كثرة شرب الماء لا يعد حلًا أكيدًا، فربما يتطلب الأمر الحصول على اسعافات عاجلة في الطوارئ بحقنة سوائل عن طريق الوريد، كإجراء مبدئي. كما يشير موقع كليفلاند كلينيك إلى أنه في حالات الجفاف الخفيفة، يمكن أن يكون تناول مشروب يحتوي على إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم مفيدًا، بخاصة إذا الشخص يتعرق أو يتقيأ أو يعاني من الإسهال، مما يؤدي إلى فقدان الشوارد اللازمة أيضًا للحفاظ على ضغط الدم المناسب.
وتنبه دكتورة أغاروال إلى أهمية ملاحظة أنه يحدث خلط في بعض الأحيان حيث يمكن أن يخطئ الشخص الجوع بالعطش، وربما يتصور الشخص أنه جائعًا في حين يكون الجسم في حالة ظمأ ويحتاج لتناول الماء لإحداث التوازن اللازم ولمساعدة أعضائه على أداء وظائفها.
وأخيرًا، ينصح الخبراء بشرب الماء قبل البدء في تناول الطعام لأنه يساعد في إنقاص الوزن، إذا كان الشخص يهدف إلى الحفاظ على وزن مناسب.
هل شهر رمضان فرصة لتغيير العادات السيئة؟
ووفق مختصين قد يجد الشخص صعوبةً في بداية رحلة الإقلاع، ولكن بالعزيمة والإصرار وزيارة العيادات المتخصصة وتغيير بعض العادات التي كانت تُحفّز على العودة لهذه السلوكيات،يكون ذلك ممكنا.
وتُشكّل مشكلة السمنة والسُكّري عائقًا كبيرًا لدى البعض، ويُعد شهر رمضان، فرصةً وقائية وعلاجية لإعادة النظر في النظام الغذائي، وممارسة الرياضة.
وأكدت الأبحاث العلمية جدوى وفوائد الصيام المتقطع وجدوى ذلك في تحسين الصحة من منظور طبي ، ولعل شهر رمضان فرصة لغنائم الأجور العظيمة، والفوائد الصحية والنفسية .
وأكدت اخصائية اجتماعية أن عادة السهر في شهر رمضان من أخطر العادات التي تؤذي النفس،حيث يؤثر ذلك على هرمونات الجسم، وترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، ويُسبّب خللاً في الجهاز المناعي، ويرفع معدل الإصابة بالأمراض.
لذا يجب على الوالدين أن يكونا قدوةً صالحةً لأبنائهم، ويقسموا اوقاتهم، وتشجيعهم بأن شهر رمضان ليس موسمًا للسهر والكسل، بل ميّزه الله عن بقية الشهور بفضائل عديدة.
كيف يتجنب الصائم “الحموضة” خلال شهر رمضان؟
الارتجاع المريئي يحصل عند تدفق حمض المعدة إلى الأنبوب الذي يربط بين الفم والمعدة، ويسمى المريء. عندما يلامس حمض المعدة الارتجاعي بطانة المريء، فإنه يسبب إحساسا حارقا في الصدر أو الحلق، ويسمى بحرقة المعدة.
ما هي الأعراض.. ولماذا تزيد في رمضان؟
يصيب الارتجاع المريئي نسبة كبيرة من الناس، وتشمل أعراضه:
– رجوع أحماض المعدة إلى الفم.
– ألم في الصدر.
– بحة أو التهاب في الحلق.
– طعم حامض أو مر في الفم.
– صعوبة في التنفس.
– سعال جاف.
– ضيق في الحلق.
– صعوبة في البلع.
- الشعور بالاختناق أو بوجود ورم في الحلق.
تزداد مشاكل هذا المرض خلال شهر رمضان، بسبب التغير الحاصل في نظام ونوع الأكل.
كيف يجب أن يتعامل الصائم مع حالات الارتجاع المريئي لضمان صيام صحي وسليم؟
استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مهند العقلا، أكد ،أن الإصابة بالارتجاع المريئي تزداد بشكل ملحوظ خلال رمضان، مما يتطلب من الصائم اتباع نصائح دقيقة، تشمل:
– كسر الصّيام على وجبة خفيفة، مثل التمر أو الماء أو الشوربة الخفيفة.
– تقسيم وجبة الإفطار على دفعتين، حيث تكون الدفعة الثانية من الأكل بعد حوالي ساعة أو ساعة ونصف.
– تجنب الأطعمة الدسمة، مثل المقالي والحلويات.
-تجب الإكثار من العصائر والمشروبات مع وجبات الطعام.
– عدم النوم مباشرة بعد وجبة السحور، والانتظار فترة ساعة أو ساعة ونصف.
وشدد العقلا ، على “ضرورة التزام الأشخاص الذين يعانون من المرض، بالتوصيات والنصائح الطبية الدقيقة خلال رمضان، خاصة أن العديد منهم يجدون في الصيام راحة تخفف من معاناتهم، بشرط الالتزام بنوعيات وكميات الطعام المحددة.
ضيفة السفرة الرمضانية.. تعرف إلى فوائد شوربة العدس
“العدس الأصفر” من أهم البقوليات التى تتميز باللون المميز، ويعد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة للجسم.
وتعتبر شوربة العدس من أهم الوجبات الغذائية الأساسية والمفضلة في شهر رمضان المبارك، وقد لا تخلو سفرة طعام من وجودها.
مما لا شك فيه أن للعدس العديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم، ويعد من أهم الوجبات الأكثر تناولاً أثناء فصل الشتاء، وذلك يرجع إلى ما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية مهمة كفيتامين “أ وب وج”، ونسبة عالية من البروتينات والبقوليات والحديد والألياف والبوتاسيوم، وهذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.
فوائد شوربة العدس
تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن العدس ملك الموائد أثناء فصل الشتاء، ومن أهم أطباقه هى “شوربة العدس”، التى تحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة من الخضراوات كالبطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر، والبقوليات والفيتامينات، ولذا فتناولها له العديد من الفوائد المهمة للجسم، ومنها:
1- العدس بصفة عامة يحميك من نزلات البرد، ولكن شوربة العدس تحميك 3 أضعاف العدس.
2- يساهم في النوم باسترخاء، ولذا فشوربة العدس من الأطعمة التى تخلصك من القلق والتوتر.
3- تقلل فرص تعرضك للشيخوخة.
4- لأنها وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.
5- تقوية الجهاز العصبي، والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب، ولذا العدس بشكل عام وشوربة العدس بشكل خاص من الأطعمة التى تجلب لك السعادة.
6- تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية كالكالسيوم.
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان ، مساء اليوم الإثنين، إنه تم اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية ، وأن باب المفاوضات لن يبقى مفتوحًا إلى الأبد.
وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة: "إن ملك السعودية وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة السعودية وسنرسل له دعوة مماثلة".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني ان "إيران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال أمير عبد اللهيان ان "قطر تسير دائما في الاتجاه الصحيح ولعبت دورا في مجال تبادل الأسرى والاتفاق النووي".
وعقدت الجولة الأخيرة من مفاوضات رفع الحظر في فيينا في أغسطس / آب الماضي ، لكنها توقفت منذ ذلك الحين ، ويقول المحللون إن بعض العوامل مثل ضغوط الكيان الصهيوني والخلافات مع الكونجرس والمشكلات الداخلية في الولايات المتحدة كانت سبب إحجام إدارة بايدن عن العودة إلى الاتفاق النووي في الأشهر الماضية.
وتحاول الدول الغربية كسر مقاومة إيران للإصرار على مصالح البلاد من خلال شن حرب دعائية إعلامية خلال الأشهر الماضية.
وكان دعوة جمهورية إيران الإسلامية بالتحقق من رفع الحظر ، والحصول على ضمانات فيما يتعلق باستمرارية الاتفاق النووي وإلغاء مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الذرية من المطالب الرئيسية لايران في مفاوضات رفع الحظر وأكدت على أن العودة للاتفاقية الثنائية هي في مقابل بعض القيود التي تعود بفوائد اقتصادية ملموسة على الشعب الإيراني .
مصدر: العالم
المواجهة بين حكومة نتنياهو ومعارضيها ترسم نهاية الكيان الاسرائيلي
وجاء في كلمة لابيد: "هذه أيام صعبة، الأيام الصعبة تتطلب أناس أشداء، أشخاص لا يتنازلون بسهولة، يعرفون ما الذي يؤمنون به ولديهم الاستعداد للنضال من أجله، يجب علينا أن نصمد أمام هذا التحدي. الطريقة الوحيدة للصمود أمام هذا التحدي، زملائي في المعارضة هي من خلال الوقوف معاً. إذا وقفنا معاً سوية، حاربنا سوية، وربطنا الكنيست بالشوارع، ومشاركة السلطات المحلية، فإن هذه الحكومة لن تصمد. هناك أشياء غير قليلة يمكن أن نقوم بها معاً".
(أقوال الكنيست، 2 كانون الثاني 2023).
مع التصعيد التدريجي الذي تقوم به المعارضة وتعنت رئيس الحكومة الحالي "بنيامين نتنياهو" في مواقفه إزاء الإصلاحات القانونية التي يعتزم تحقيقها تشتد الأزمة افي الداخل الإسرائيلي يوماً تلو الآخر . هذا الاشتباك السياسي والذي بدأت تظهر إزاءه ملامح اصطفاف داخلي قد يشعل حرباً أهلية، لم يعد باستطاعة المسؤولين تهدئته كما كان من الممكن القيام به في مراحله الأولى، إذ أن كلا الطرفين يقومان بإجراءات تعزز من صعوبة الموقف وتزيده شرخاً، فكما لنتنياهو أساليبه في التعامل مع هذه الأزمة، والتي عمادها التحالف مع اليمين المتطرف وهو العامل أكثر خطورة في تفجير الوضع الداخلي، فإن المعارضة الحالية وفي سبيل منع تطبيق تعديلات نتنياهو تقوم بإدارة حملات ضغطها على مختلف الأصعدة وهو ما تستعرضه هذه الورقة.
تتمحور حركة المعارضة الحالية حول استقطاب أكبر عدد ممكن من الدعم الخارجي والداخلي لزيادة الضغوط على الحكومة الحالية في سبيل منع إجراءات "نتنياهو" من أن تطبق، لذا وعلى صعيد الداخل يقوم قادة اليسار والأحزاب الأخرى بخطوات يمكن إدراجها تحت العناوين التالية:
منع نتنياهو من استمالة أو احتواء حركة مؤيدي المعارضة، وإرساء جو من السلبية الدائمة حوله.
الضغط بشتى الطرق على "نتنياهو" والأحزاب الحليفة له.
المناكفة السياسية المرتفعة في سبيل الإبقاء على التوازن في الصراع.
منع نتنياهو من استمالة مؤيدي المعارضة، وإرساء جو من السلبية الدائمة إعلامياً حوله:
تظهر خطابات نتنياهو ما بعد الاحتجاجات، مساعيه الشاقة لاحتواء المتظاهرين ومن خلفهم المسؤولين عن تلك الاحتجاجات، لذا فإنه وعبر منصاته الإعلامية على مواقع التواصل وخطاباته في الكنيست أو الاجتماعات الحكومية، يعمل على استمالة الخصوم وتهدئة الشارع. وفي سبيل منع رئيس الحكومة من استمالة المعارضين لسياساته "الإصلاحية"، وبزخم كبير يدير قادة المعارضة حملة إعلامية وتشويهية لنتنياهو وسياساته للحفاظ على الزخم الموجود في الشارع وجعل كل ما تقوم به الحكومة غير مجد.
ولإيضاح ما يقوم به نتنياهو والإضاءة على ما تقوم به المعارضة "إعلامياً"، فمع بداية الأزمة واندلاع الاحتجاجات داخل الكيان المؤقت، دعا عضو الكنيست "تسفيكا فوغل" إلى اعتقال يائير لابيد وبيني غانتس، ولاستدراك ما طلبه "تسفيكا" وإظهار نفسه مظهر المحافظ على الديمقراطية في "إسرائيل"، رفض "نتنياهو" ما صرح به عضو الكنيست وغرد عبر تويتر قائلاً: "في بلد ديمقراطي، لا يعتقل قادة المعارضة مثلما لا تسمي وزراء الحكومة بالنازيين، ولا تسمى الحكومة اليهودية بالرايخ الثالث ولا تدعو المواطنين لأعمال الشغب المدنية".
هنا حاول نتنياهو التأثير على الجماهير برفضه اعتقال غانتس ولابيد انطلاقاً من الاعتبارات الديمقراطية التي يؤمن بها كما المتظاهرين، وفي نفس الوقت أراد أن يظهر المعارضة على أنها غير حكيمة في خطواتها واتهاماتها كعبارة "نازية" في دولة عانت ما عانته منها في السابق.
بهدف منع هذا النوع من التغريدات من أن يكون له وقع على الجماهير من المعارضة، سارعت القيادات في الرد وبما يتعلق بهذه التغريدة، رد "لابيد" بالقول: "نتنياهو، في بلد ديمقراطي لا يُفترس المواطنون ولا القضاء. أصبحت رئيس وزراء ضعيفاً يرتجف خوفاً من شركائه المتطرفين. إنهم يقودون إسرائيل إلى الانهيار. هكذا تنهار الديمقراطية في يوم واحد".
هنا تظهر لهجة "لابيد" وحتى باقي القيادات في المعارضة، لهجة تحذيرية من أن المخاطر محدقة بالكيان وهنا يمكن القول بأن هذا التخويف الدائم حتى لو كان واقعياً فهو استعطافي تخويفي، للإبقاء على حالة القلق من نتنياهو وسياساته وشد أزر الأحزاب المعارضة وجماهيرها لمنع أي تفلت ممكن أن يحصل.
أما على صعيد الاحتجاجات وما تتضمنه من شعارات وإجراءات استفزازية وتعبوية للجماهير، فإن المعارضة تعمد دائماً على استخدام الشعارات التي تضفي طابعاً من الغضب والاحتجاج القاسي، ما يحولها- الاحتجاجات- إلى عنيفة، تعبئ الجو العام بما لا يستطع المنافس إيصال رأيه وصوته إليها، وتعمد أيضاً على رفع الشعارات التي تجلب
الاستعطاف الخارجي وهو ما سنناقشه لاحقاً.
وبالتالي يمكن استخلاص أهم الأساليب المعتمدة من قبل المعارضة للحفاظ على جبهتهم وحمايتها من أي خرق:
الرد الدائم إعلامياً على أي تصريح صادر عن الائتلاف الحاكم.
اعتماد خطاب الترهيب والتخويف من نتنياهو وسياساته.
رفع الشعارات التعبوية والمثيرة للغضب خلال الاحتجاجات.
الاعتماد على الصحف والمواقع في كتابة التحليلات التي تنذر من المخاطر الكبيرة التي ستقع على الكيان إزاء سياسيات "بنيامين نتنياهو".
الضغط بشتى الطرق على "نتنياهو" والأحزاب الحليفة له:
لا تفوت الأحزاب المعارضة، فرصة إلا وتقوم من خلالها بالضغط على نتنياهو ومن يدور في فلكه، لذا فإنها تعمل دائماً على خلق مناخ كبير وسلبي يصبح رئيس الحكومة غير قادر على تحمل ضغطه وتبعاته، وهنا تعتمد المعارضة أسلوب الاستفزاز في التعاطي مع الحكومة، فبالرغم من المخاطر الكبيرة الناجمة عن ما يجري، إلا أنها- المعارضة- لا تزال تحركاتها قائمة بل وتتوسع حتى أنها قد طالت جيش الاحتياط وطياري سلاح الجو مؤخراً والعديد من المؤسسات والنقابات، وهي نقطة قوة في يد الأحزاب المعارضة في زيادة الضغط على الحكومة.
هذا التوسع والذي ينذر بتفكك تدريجي للكيان، تقوم المعارضة من خلاله باستفزاز نتنياهو وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور. أضف إلى ذلك، فإن الأحداث الإقليمية والدولية غير المواتية للكيان في الوقت الحالي، تقوم المعارضة في تحميل مسؤوليتها أيضاً لنتنياهو وحكومته، فما جرى مؤخراً من اتفاق إيراني- سعودي برعاية صينية، قامت المعارضة بعدما اعتبرته اتفاق خطر على المصالح الإسرائيلية في المنطقة، بتحميل مسؤوليته لنتنياهو وسياساته الفاشلة. وحتى ما جرى في "مجيدو" من عملية غامضة الآثار ومبهمة تفاصيل وصول المتسلل إليها، سرعان ما قامت المعارضة باستغلال الحدث لما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة برئيسها.
إذاً فإن المعارضة تسعى لإيجاد مناخ عام ضاغط ورافض لنتنياهو وحكومته عبر الخطوات التالية:
استمالة جنود وضباط الجيش الإسرائيلي من مختلف القطاعات والإضاءة على هذا الأمر بما يؤثر على إدارة نتنياهو للأزمة.
الاستثمار بالأحداث الإقليمية والدولية بما يخدم تحركات المعارضة.
ربط إجراءات نتنياهو بأمن إسرائيل وتحميله مسؤولية انحلاله تدريجياً.
رفع وتيرة الاحتجاجات والتصادم مع القوى الأمنية.
تعطيل البنية التنفيذية من خلال الإضرابات في المؤسسات الأمنية والجيش والنقابات والمنتديات الحكومية والمؤسسات المعنية بالبنى التحتية.
المناكفة السياسية المرتفعة في سبيل الإبقاء على التوازن في الصراع:
لعرقلة جهود نتنياهو الآخذة في التزايد على الصعيد السياسي داخلياً، تعمل المعارضة على الوقوف كند سياسي صعب أمام رئيس الحكومة وحلفائه، وذلك من خلال خطوات أظهرت عمق الفجوة السياسية الحاصلة، فراحت الأحزاب المعارضة باتجاه كيل الاتهامات ومحاولة تعطيل القوانين والتعديلات المطروحة من قبل نتنياهو واليمين الحليف له، بالإضافة إلى حثّ باقي الأحزاب للوقوف إلى جانب المعارضة. ويمكن تلخيص أساليب الضغط السياسي المعتمد من قبل المعارضة على الشكل التالي:
المعارضة الدائمة في الكنيست لأي قانون أو مشروع صادر عن نتنياهو وحلفاؤه.
الضغط على الأحزاب السياسية بهدف استمالتها.
كيل الاتهامات بحق نتنياهو والشخصيات اليمينية.
في المحصلة، يمكن تلخيص إدارة المعارضة للاحتجاجات والمعركة السياسية في الكيان المؤقت على الشكل التالي:
منع نتنياهو من استمالة مؤيدي المعارضة، وإرساء جو من السلبية الدائمة إعلامياً حوله:
الرد الدائم والسريع على أي تصريح صادر عن الائتلاف الحاكم.
اعتماد خطاب الترهيب والتخويف من نتنياهو وسياساته.
رفع الشعارات التعبوية والمثيرة للغضب خلال الاحتجاجات.
الاعتماد على الصحف والمواقع في كتابة التحليلات التي تنذر من المخاطر الكبيرة التي ستقع على الكيان إزاء سياسيات "بنيامين نتنياهو".
خلاصة: تحديد المخاطر
وعليه، وبعد تحديد الإجراءات المتبعة من قبل المعارضة الإسرائيلية داخل الكيان يمكن استنتاج المخاطر المترتبة إزاء ما يحصل خاصةً وأن درجة الاقتتال السياسي الداخلي آخذة متصاعدة وهو ما يزيد من حدة الإجراءات والأساليب المتبعة بشكل أكبر، والمخاطر المتوقعة هي:
تراجع مصداقية الإعلام في الداخل الإسرائيلي لدى الجماهير.
ازدياد التشدد الديني- السياسي لدى الأحزاب اليمينية ومخاطر انعكاس ذلك على الأرض.
الانقسام في الصف الواحد بين أحزاب اليمين.
ازدياد حدة التوتر في الشارع وإمكانية حصول أعمال شغب عالية الخطورة.
التأسيس لانقسام سياسي طويل الأمد تتفرع منه العديد من المشاكل السياسية (مثل الحالة اللبنانية).
ازدياد التحريض الإعلامي وعدم القدرة على ضبط الخطاب والتراشق في أي مواجهة قد تحصل.
حصول انشقاق في الجيش بشكل تدريجي يؤدي إلى انقسامه بين مؤيد ومعارض لسياسات الحكومات القادمة أيضاً.
تآكل الردع الإسرائيلي تدريجياً نتيجة الانشغال الكبير بالداخل والانقسام بالجيش والمؤسسات الأمنية.
تراجع اعتماد الإدارة الأمريكية على الكيان المؤقت والبحث عن بدائل أكثر نجاعة.
حصول اغتيالات أمنية في الداخل الإسرائيلي تطال شخصيات من الطرفين المتخاصمين.
حصول انقسام داخل الشرطة والقوى المعنية بالحفاظ على الأمن.
توقف جلسات انعقاد الكنيست وحصول فراغ على الصعيد التشريعي.
حصول تباعد كبير بين قيادة الجيش والأمن والأحزاب والمؤسسات الحكومية.
مصدر: العالم
شهر رمضان، والحياة في مناخ القرب
لماذا يزداد بكاء الإنسان في شهر رمضان؟ لأنه مسرور جدّا. الإنسان الكئيب لا يبكي بل يبحث عن فرص الضحك واللعب، بينما الإنسان المسرور فيودّ أن يبكي. كالآباء والأمّهات بعدما زوّجوا أولادهم، فترى أعينهم تفيض من الدمع فرحا إذ قد أينعت ثمارهم.
كلّ من يدخل في مجالس ذكر الله أو مجالس ذكر أهل البيت (عليه السلام) يجب أن يعرف أن هؤلاء المؤمنين الحاضرين في المجلس هم في حالة سرور وبهجة شديدة. وهذا ما يدركه الناس في مجالس عزاء الحسين (عليه السلام)، إذ يدركون أنك أكثر من أن تحزن على الحسين (عليه السلام) تفتخر به وتعتزّ به! تفتخر وتقول: «حسين أميري ونعم الأمير»! فعينك تحكي عن مدى لذّتك وأنسك بذكر الحسين (عليه السلام) وهذا ما يدركه أكثر الناس. فعندما تبكي أو تصرخ أو تلطم على الحسين (عليه السلام) يدرك الناس أن وراء هذا الحزن الجميل الذي لا يؤدي إلى كآبة وعقد نفسية، سرور ممتدّ في أعماق قلبك. كالعقيلة زينب (سلام الله عليها) التي قالت: «مَا رَأَیْتُ إِلَّا جَمِیلا»([1]).
إن شهر رمضان لهو أفضل فرصة للتقرّب إلى الله سبحانه. وإنّ الحياة في مناخ القرب حياة مختلفة تماما!
أودّ أن أسألكم أيها الصائمون: أليس الإفطار فيه طعم خاص يختلف عن باقي وجبات الطعام؟! فهذا ما أشار إليه النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِینَ یُفْطِرُ وَحِینَ یَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَل»([2]) كما أن حالة الحزن التي تعتريكم عند انتهاء شهر رمضان وفي عيد الفطر بسبب انتهاء هذا الشهر العظيم، يحكي عن هذا الشعور الجميل وهذه الفرحة التي يشعر بها الصائم في أيام شهر رمضان وعند الإفطار. فعزّزوا هذا الشعور في قلوبكم.
كيف نستطيع أن نتقرّب في شهر رمضان أكثر من الحدّ الأدنى الذي يتقرّب فيه كلّ مؤمن أو مسلم؟ إذا أحيينا شهرَ رمضانٍ ولائيِّ سياسيِّ ثوريِّ حماسيّ. وإذا كان شهر رمضاننا مصحوبا بانتظار الفرج والنشاط الثوريّ، عند ذلك نتقرّب أكثر.
لماذا كان المجاهدون في جبهات الدفاع المقدّس يصلّون صلاة الليل؟ ولماذا كانوا يذوقون حلاوة صلاة الليل؟ لأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله. فإنكم إذا كرّرتم نفس الأذكار التي كان يردّدها المجاهدون لن تصلوا إلى ما وصلوا إليه، إلّا أن تصلّوا وتذكروا الله مثل المجاهدين. لقد كان المجاهدون يذكرون الله ويتوسّلون به لينجحوا عمليّاتهم. وكانت عمليّاتهم في الواقع عملا في سبيل الإسلام والمجتمع الإسلامي. فبإمكان الإنسان أن يحصل على هذا النور في ساحة النشاط الثوريّ والعمل السياسي والاجتماعي، وحريّ به أن يصلّي صلاة الليل ليوفّقه الله للنجاح في تلك الساحات. يقوم الليل ويصلّي لينجز مهمّته السياسيّة والاجتماعية بنجاح، فيتزوّد نورا بهذه الصلاة التي أقامها في جوف الليل.
يقول الله سبحانه: ﴿وَالَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾([3]) وهداية الله ليست سوى الحياة في أجواء القرب، فترى يدك صارت يد الله وعينك عين الله وأذنك أذن الله، طبعا في مرتبتك وبحسب شأنك.
سماحة الشيخ علي رضا بناهيان
([1]) اللهوف / 160
([2]) من لا يحضره الفقيه / 2 / 75
([3]) سورة العنكبوت: 69
خمسة أمور نستعد من خلالها لشهر رمضان المبارك
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان: "أيّها الناس إنّه قد أقبل إليكم شهر الله تعالى بالبركة والرحمة والمغفرة.. وهو شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله.. فاسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة، وقلوب طاهرة، أن يوفقّكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإنّ الشقيّ من حرم غفران الله في هذا الشهر"[1].
يمكن التهيُّؤ لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر الأمور الآتية:
1- الاستعداد النفسيّ
ينبغي الاستعداد النفسيّ المسبق لشهر رمضان، وذلك بالالتفات إلى أهمّيّته وقيمته وآثاره الدينيّة والحضاريّة، قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته تلك: "إنّه قد أقبل عليكم شهر الله، شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة..."[2].
2- استغلال أجواء المناسبة
ينبغي الاستغلال الكامل لأجواء هذه المناسبة في إحداث التغييرات اللازمة في شخصيّاتنا، كلّ بحسب وضعيّته وأحواله، وما يجده في نفسه من الضعف والحاجة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: "... فاسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة، وقلوب طاهرة، أن يوفّقكم لصيامه، وتلاوة كتابة، فإنّ الشقيّ من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم..."[3].
3- التوبة
شهر رمضان المبارك شهر التوبة، كما جاء في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام حيث قال: "اللهمّ إنّ هذا شهر رمضان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر الإنابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة"[4]. وقد ورد الحثّ على التوبة في الكتاب والسنّة، ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[5].
﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾[6] وروي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾، قال: "هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً"، قلت: وأيُّنا لم يعد؟ فقال: "يا أبا محمّد إنّ الله يحبّ من عباده المفتن التوّاب"[7].
4- معرفة مقاصد الصوم
النظر في مقاصده وأهدافه كفريضة دينيّة تنطوي على الكثير من الحكم والمصالح والمقاصد العليا. فقد روي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلّا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال: أوّلها: يذوب الحرام في جسده. والثانية: يقرّب في رحمة الله عزّ وجلّ. والثالثة: يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه. والرابعة: يهون الله عليه سكرات الموت. والخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة. والسادسة: يعطيه الله البراءة من النار. والسابعة: يطعمه الله من طيّبات الجنّة"[8].
وعن حمزة بن محمّد أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السلام لم فرض الله الصوم؟ فورد الجواب: "ليجد الغنيّ مسّ الجوع فيمن على الفقير". وفي رواية أخرى: أنّه قال: "ليجد الغنيّ مضض الجوع فيحنو على الفقير"[9].
5- مراعاة حرمة شهر رمضان
إنّ شرافة هذا الشهر تجعل له حرمة وقداسة خاصّة أكثر من حرمة غيره، فانتهاك هذه الحرمة أقبح من انتهاك غيرها، فالعقوبة المستحقّة أكبر وأشدّ. كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: "فَأَبَانَ فَضِيلَتَه عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَه مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ، والْفَضَائِل ِالْمَشْهُورَةِ، فَحَرَّمَ فِيه مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِه إِعْظَاماً"[10].
زاد الهدى في شهر الله، دار المعارف الإسلامية الثقافية
[1] الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج7، ص227.
[2] الشيخ الصدوق، الأمالي،مصدر سابق، ص154.
[3] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج4، ص75.
[4] سورة النور، الآية 31.
[5] سورة هود، الآية 3.
[6] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج4، ص432.
[7] الصدوق، الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاريّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المشرّفة، إيران - قم، لا.ت، ط2،ج2، ص74.
[8] الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج7، ص3.
[9] المصدر نفسه.
[10] المصدر نفسه.
آداب نهار الصيام
لنهار الصيام آداب ذكرتها الرِّوايات الشَّريفة، كما ذكرها علماؤنا الأعلام في كتبهم الفقهيَّة والأخلاقيَّة، وسنتطرق في هذا الباب إلى أهمِّ آداب نهار الصيام:
1- صوم الجوارح عما يكرهه الله
فمن المعيب على الإنسان الصائم أن يقوم بما يكرهه الله تعالى، سواء كان حراماً أو مكروهاً، وهو جالس على مائدته، وفي ضيافته، لهذا نجد في الأحاديث الكثير مما يدعو لكفِّ الأذى وترك ما يكره الله تعالى، ومن هذه الأحاديث ما رُوِِِيَ عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام ورداً من ليله وعفَّ بطنه وفرجه، وكفَّ لسانه، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر ما أشدَّ هذه الشروط!؟"1.
وهذا ما أسماه علماؤنا العظام بصوم الجوارح، فقد رُوِِِيَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة تسبُّ جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام، فقال لها:"كلي، فقالت: إنِّي صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك، إنَّ الصوم ليس من الطعام والشراب فقط" 2.
ورُوِِِيَ عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام:"إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك...قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك"3.
2- كظم الغيظ
فحتى لو تعرَّض الإنسان للأذيَّة والشتم في نهار الصيام فليصبر وليكظم الغيظ طمعاً برضوان الله تعالى، وقد رُوِِِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"ما من عبد صائم يُشتَم فيقول: إنِّي صائمٌ سلامٌ عليك، لا أشتمك كمَا تشتمني، إلا قال الربُّ تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شرِّ عبدي، قد أجرته من النَّار"4.
3- عدم السفر
فالإقامة في الشهر الكريم وعدم قطعه بالسفر، ولا سيَّما قبل الثلاثة وعشرين منه، مكروه من غير ضرورة كما جاء ذلك في الرِّوايات الشَّريفة عن أهل البيت عليه السلام ونصَّ على ذلك فقهاؤنا العظام، فعن أحد أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال:"سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرَّة فقال:"يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بدَّ له من الخروج فيها أو يتخوَّف على ماله"5.
وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال:" إذا دخل شهر رمضان فللَّه فيه شرط، قال الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾6 ، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حجِّ، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء"7.
4- إخراج الدم المضغث
لما فيه من إضعاف للبدن، واحتمال أن يغشى عليه، فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر 8.
وفي الرواية عن أحد أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال:"سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إنِّي أتخوَّف عليه، أما يتخوَّف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوَّف عليه؟ قال الغشيان أو تثور به مرَّة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخشَ شيئا؟ قال: نعم إن شاء"9.
وفي رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم، قال:" نعم إذا لم يخف ضعفاً"10.
يقول الإمام الخميني فدس سره:" ومنها أي مكروهات الصائم إخراج الدَّم المضعِّف بحجامة أو غيرها، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سبباًّ لهيجان المرَّة"11.
بل ورد كراهة ما يخشى منه الضعف ولو كان ذلك هو الإستحمام، فعن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنَّه سئل عن الرجل يدخل الحمَّام وهو صائم؟ فقال:" لا بأس ما لم يخشَ ضعفاً"12.
ويقول الإمام الخميني فدس سره:" ومنها دخول الحمام إذا خشيَ منه الضعف"13.
5- السواك بالعود الرطب
فقد نهت العديد من الرِّوايات عن ذلك، منها ما رُوِِِيَ عن الإمام الصادق عليه السلام قال:" لا يستاك الصائم بعود رطب"14.
ولعلَّ ذلك لكي لا يدخل من الرطوبة إلى فمه ما يحتمل أن يسبِّب له الإفطار.
6- ابتلاع الرِّيق بعد المضمضة
فقد يتمضمض الصائم للوضوء، أو لجفاف حلقة، فحينها يكره له ابتلاع ريقة بعدها، إلا أن يبزق ثلاث مرات، فعن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال:"لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات"15.
7- كراهة المداعبة
وخصوصا لمن يخاف على نفسه أن تسبقه الجنابة، لما ورد في الرِّوايات من كراهة هذا الأمر في نهار الصيام، فعن أبي عبد الله عليه السلام أنَّه سئل عن رجل يمسُّ من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال:" إنَّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني"16.
8- كراهة شمِّ الرَّياحين
وبالأخصِّ منها النرجس، وأما بالنسبة للعطور فهي مستحبة للصائم كما لغيره سوى المسك، ففي الرواية سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس للصائم 17.وفي الرواية عن غياث بن إبراهيم عن جعفر،عن أبيه: أنَّ عليَّاً عليه السلام كرِهَ المسك أن يتطيَّب به الصائم.
ويقول الإمام الخميني فدس سره:" ومنها شمُّ الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيِّب الريح، نعم لا بأس بالطيِّب فإنَّه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيُّب به للصائم"18.
9- فصل القيلولة
وهي النوم قبل حلول الزوال، أي وقت صلاة الظهر، فهذا النوم كما في الرواية تقوِّي المؤمن على قيام اللّيل، فعن أبي الحسن عليه السلام:"قيِّلوا فإنَّ الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه"19.
هذا فضلاً عن أنَّ النوم في شهر رمضان يحتسب عبادة للإنسان، كما رُوِِِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً"20.
*اداب الصوم , سلسلة الاداب والسنن, نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- م.س- ج 10- ص 162
2- م.س- ج 10- ص 163
3- م.س- ج 10- ص 161
4- م.س- ج 10- ص 167- 168
5- م.س- ج 10- ص 181
6- البقرة: 185
7- الحر العاملي- محمَّد بن الحسن- وسائل الشيعة- مؤسسة أهل البيت- الطبعة الثانية 1414 ه.ق.- ج 10- ص 182- 183
8- م.س- ج 10- ص 79
9- م.س- ج 10- ص 78
10- م.س- ج 10- ص 78
11- الخميني- روح الله الموسوي- تحرير الوسيلة- دار الكتب العلمية- اسماعيليان- قم- ج 1- ص 288
12- الحر العاملي- محمَّد بن الحسن- وسائل الشيعة- مؤسسة أهل البيت- الطبعة الثانية 1414 ه.ق.- ج 10- ص 81
13- الخميني- روح الله الموسوي- تحرير الوسيلة- دار الكتب العلمية- اسماعيليان- قم-ج 1- ص 288
14- الحر العاملي- محمَّد بن الحسن- وسائل الشيعة- مؤسسة أهل البيت- الطبعة الثانية 1414 ه.ق.- ج 10- ص 84
15- م.س- ج 10- ص 91
16- م.س- ج 10- ص 97
17- م.س- ج 10 ص 92
18- الخميني- روح الله الموسوي- تحرير الوسيلة- دار الكتب العلمية- اسماعيليان- قم- ج 1- ص 288
19- الحر العاملي- محمَّد بن الحسن- وسائل الشيعة- مؤسسة أهل البيت- الطبعة الثانية 1414 ه.ق.- ج 10- ص 136
20- م.س-ج 10 ص 137
كيف نجعل استغفارنا مؤثراً؟
يتحدّث الإمام الخامنئي دام ظله عن الاستغفار المؤثِّر وكيفيّته قائلاً: "المسألة الأخرى هي أنّ الاستغفار الّذي يُسهِّل الأمور هو الاستغفار الحقيقيّ والجدّيّ والمتضمّن للطلب الحقيقيّ. افترضوا أنّ أحدكم ابتُلي بمشكلةٍ كبيرة وأراد أنْ يسأل الله رفع ذلك البلاء عنه، كأنْ يواجه أحد أعزّائه مشكلة لا سمح الله، وسعى لحلِّ المشكلة بالطرق العاديّة فلم يُفلح، ثُمّ توسّل بربِّ العالمين ودعاه وتضرّع إليه، لنفترض أنّ إنساناً أُصيب أحد أعزائه بمرض، وتوجّه إلى بيت الله الحرام ليدعو، فكيف وبأيِّ حالٍ سيطلب من الله؟ اطلبوا من الله غفران ذنوبكم بنفس تلك الحال، اطلبوا المغفرة حقيقةً، وقرّروا أنْ لا تُعاودوا ارتكاب ذلك الذنب".
"قد يُقرِّر الإنسان أنْ لا يعود لذنب كان قد ارتكبه وتاب عنه، لكنّه يزلّ مجدّداً ويرتكبه، عليه حينها أنْ يُعاود التوبة منه أيضاً، فلو عاد الإنسان عن توبته مائة مرّة، فإنّ باب التوبة مفتوح أمامه للمرّة الواحدة بعد المائة أيضاً، لكنْ عندما تتوب وتستغفر يجب أنْ لا تنوي منذ البداية أنّني استغفر ثُمّ أعود لارتكاب نفس الخطأ والمخالفة، لا يصحّ ذلك.
في روايةٍ لأحد الأئمّة عليهم السلام قال: "من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه"([1]). أنْ يفرح الإنسان بذنبه ويردّد بلسانه (أستغفر الله) فهو يسخر بذلك من نفسه، وأيّ استغفار هو ذاك؟! إنّه ليس استغفاراً، فالاستغفار يعني أنْ يعود الإنسان، وأنْ يطلب من الله تعالى بجدٍّ أن يعفو عن عمله السيّئ، فكيف يُقرِّر الإنسان أنْ يعود لمثل ذلك؟ هل يجرؤ في مثل هذه الحالة أنْ يطلب من الله العفو؟ السبّحة في الكفّ، والتوبة على الشفة، والقلب كلّه شوقٌ للمعصية.
تضحك المعصية ساخرة من مثل هذا الاستغفار.
أيُّ استغفار هذا؟ إنّه استغفارٌ غير كافٍ. ينبغي أنْ يكون الاستغفار جدّيّاً وحقيقيّاً. والاستغفار ليس مختصّاً بفئةٍ من الناس لنقول على الّذين أكثروا المعاصي أنْ يستغفروا، بل على جميع الناس حتّى في مستوى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عليه أنْ يستغفر "لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر"([2]) فحتّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يستغفر...
الاستغفار للجميع. لذا لاحظوا الأئمّة عليهم السلام أيّ تحرّق وتململٍ لهم في هذه الأدعية، وبعض الناس يظنّ أنّ الإمام السجّاد صلى الله عليه وآله وسلم تضرّع هكذا ليعلّم الآخرين ذلك، نعم هناك تعليم بالشكل والمضمون، لكنْ الأساس ليس كذلك، أساس المسألة هو حالة الطلب لدى هذا العبد الصالح والإنسان السامي والعظيم، وهذا التضرُّع لله كان منه لنفسه، وهذا الخوف من عذاب الله والميل للتقرّب إلى الله ورضوانه كان منه لنفسه، وهذا الاستغفار والطلب من الله كان حقيقة منه لنفسه.
قد يكون الاهتمام بالمباحات في حياتهم كالّلذّة المباحة والأعمال المباحة الأخرى تُصبح في نظر الإنسان الّذي سما إلى تلك الدرجة، تبدو سقوطاً وانحطاطاً، وهو يرغب أنْ لا يقع في إطار الضرورات المادّيّة والجسديّة، وأنْ لا يُعير هذه المباحات وقضايا الحياة العاديّة نظرة أو لمحة، وأنْ يغور أكثر في طريق المعرفة وفي الوادي اللامتناهي للسير نحو الرضوان الإلهيّ وجنّة المعرفة الإلهيّة، وعندما يرى أنّه حرم نفسه من بعض ذلك فإنّه يستغفر، لذا فإنّ الاستغفار للجميع.
ليستغفر الجميع، ليستغفر أهل العبادة، والمتوسّطون في العبادة، والذين يكتفون بأقلّ الواجبات، وحتّى أولئك الّذين يتركون أحياناً بعض العبادات الواجبة لا سمح الله، ليلتفت الجميع إلى أنّ علاقتهم هذه مع الله تيسّر أمورهم وتدفعهم إلى الأمام.
اسألوا الله تعالى العفو والمغفرة، اسألوا الله أنْ يُزيح عنكم الذنوب المانعة، أنْ يُزيل هذه السحب من أمام شمس فيض لطفه وتفضّله، حتّى يشعّ لطفه على هذه القلوب والأنفس. عندها سترون السمو والعزّة"([3]).
توجيهات أخلاقية، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
([1]) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، طبعة دار الوفاء، الثانية المنقحة، ج75، ص 356.
([2]) سورة الفتح، الآية: 2.
([3]) من خطبة صلاة الجمعة. (18/1/1997م)