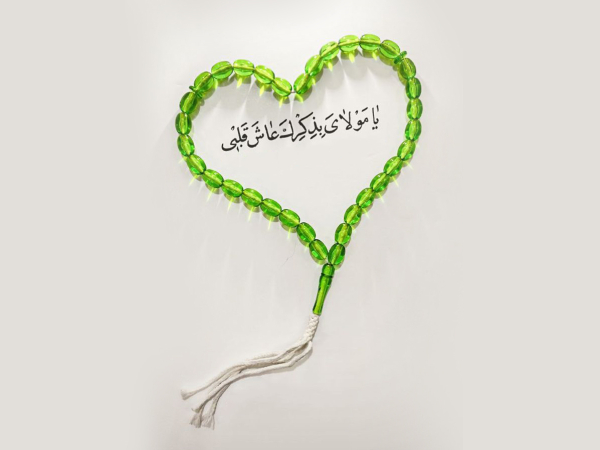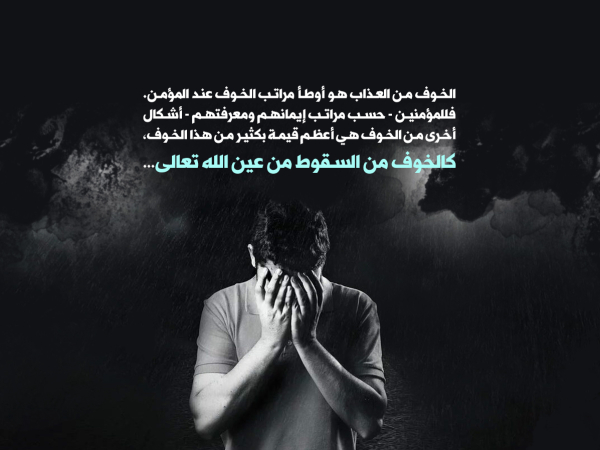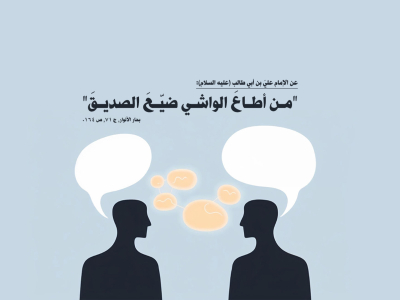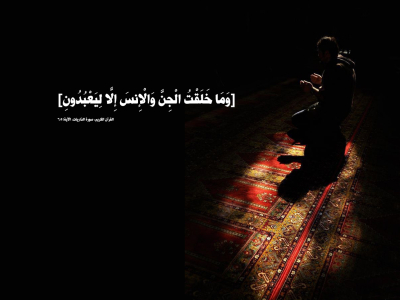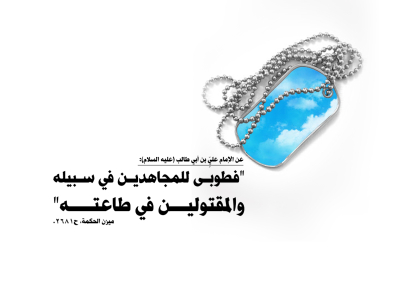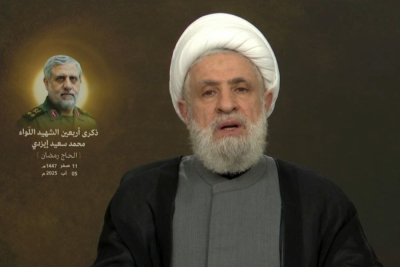emamian
السيدة رُباب زوجة الحسين ودمعة كربلاء الخالدة
زواج السيدة رباب بالإمام الحسين عليه السلام
قالَ عَوفُ بنُ خارِجَةَ : إنّي عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ في خِلافَتِهِ ، إذ أقبَلَ رَجُلٌ أصعَرُ يَتَخَطّى رِقابَ النّاسِ ، حَتّى قامَ بَينَ يَدَي عُمَرَ ، فَحَيّاهُ تَحِيَّةَ الخِلافَةِ ، فَقالَ عُمَرُ : ما أنتَ؟ فَقالَ : اِمرُؤٌ نَصرانِيٌّ ، وأنَا امرُؤُ القَيسِ بنِ عَدِيٍّ الكَلبِيُّ ، فَلَم يَعرِفهُ عُمَرُ ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ القَومِ : هذا صاحِبُ بَكرِ بنِ وائِلٍ ، الَّذي أغارَ عَلَيهِم فِي الجاهِلِيَّةِ يَومَ فَلَجٍ .
قالَ عُمَرُ :فَما تُريدُ؟ قالَ : اُريدُ الإِسلامَ ، فَعَرَضَ عَلَيهِ فَقَبِلَهُ ، ثُمَّ دَعا لَهُ بِرُمحٍ ، فَعَقَدَ لَهُ عَلى مَن أسلَمَ مِن قُضاعَةَ ، قالَ : فَأَدبَرَ الشَّيخُ وَاللِّواءُ يَهتَزُّ عَلى رَأسِهِ . قالَ عَوفُ بنُ خارِجَةَ : ما رَأَيتُ رَجُلاً لَم يُصَلِّ سَجدَةً ، اُمِّرَ عَلى جَماعَةٍ مِنَ المُسلِمينَ قَبلَهُ!.
قالَ : ونَهَضَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ومَعَهُ ابناهُ الحَسَنُ وَالحُسَينُ عليهم السلام مِنَ المَجلِسِ حَتّى أدرَكَهُ ، فَأَخَذَ بِرَأسِهِ ، فَقالَ : أنَا عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ، ابنُ عَمِّ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله وصِهرُهُ ، وهذانِ ابنايَ مِنِ ابنَتِهِ ، وقَد رَغِبنا في صِهرِكَ فَأَنكِحنا .
قالَ : قَد أنكَحتُكَ يا عَلِيُّ المُحَيّاةَ بِنتَ امرِئِ القَيسِ ، وأنكَحتُكَ يا حَسَنُ سَلمى بِنتَ امرِئِ القَيسِ ، وأنكَحتُكَ يا حُسَينُ الرَّبابَ بِنتَ امرِئِ القَيسِ . وهِيَ الَّتي يَقولُ فيهَا الحُسَينُ عليه السلام :
لَعَمرُكَ إنَّني لَاُحِبُّ دارا
تَحُلُّ بِها سُكَينَةُ وَالرَّبابُ
اُحِبُّهُما وأبذُلُ بَعدُ مالي
ولَيس لِلائِمي فيها عِتابُ
ولَستُ لَهُم وإن عَتَبوا مُطيعا
حَياتي أو يُغَيِّبَنِي التُّرابُ (1).
تزوّج الإمام الحسين عليه السلام من رباب، وكان ثمرة هذا الزواج طفلان: عبد الله الرضيع (علي الأصغر) ، وسكينة بنت الحسين عليها السلام.
هذا التصريح يُظهر عمق العلاقة العاطفية التي جمعت بين الإمام الحسين عليه السلام ورباب، علاقة تميّزت بالمودّة لا بالهيمنة أو السياسة، كما كانت بعض الزيجات آنذاك.
عاشت السيدة رباب في أجواء بيت النبوّة، وتشرّبت تعاليم الإسلام من مصدرها الأصيل، ويُستفاد من سيرتها أنها كانت عاقلة، ديّنة، فصيحة، صابرة، شاعرة، متعلّمة.
السيدة رباب في كربلاء
رافقت السيدة رباب الإمام الحسين عليه السلام في مسيره من المدينة إلى كربلاء سنة 61 هـ، وكانت معه في مكة، ومنها إلى كربلاء. وفي المعركة، كانت شاهدة على أكبر فاجعة في التاريخ الإسلامي، ففقدت زوجها الإمام، وطفلها عبد الله الرضيع، في ساعاتٍ قليلة.
مصرع عبد اللّه الرضيع ابن الحسين عليه السلام على يد حرملة بن كاهل الأسدي
تقدم الإمام الحسين عليه السلام إلى باب الخيمة و قال: ناولوني ولدي الرضيع لأودعه. فأتته زينب عليها السلام بابنه عبد اللّه و أمه الرباب بنت امرئ القيس، فأجلسه في حجره و جعل يقبّله و يقول: بعدا لهؤلاء القوم، إذا كان خصمهم جدك المصطفى. ثم أتى عليه السلام بالرضيع نحو القوم يطلب له الماء، و قال لهم: لقد جفّت محالب أمه، فهل إلى شربة من ماء سبيل؟. ثم قال لهم: يا قوم، إذا كنت أقاتلكم و تقاتلونني، فما ذنب هذا الطفل حتى تمنعوا عنه الماء؟!. (و في رواية) أنه قال: إذا لم ترحموني فارحموا هذا الطفل. فمنهم من رقّ قلبه للطفل، و قال: اسقوه شربة من ماء، و منهم من قال: لا تسقوه و لا ترحموه!.
فخاف عمر بن سعد أن يدبّ النزاع في صفوف جيشه، فقال لحرملة بن كاهل الأسدي و كان راميا: اقطع نزاع القوم. فسدد حرملة سهمه نحو عنق الصبي، فرماه بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد، و هو لائذ بحجر أبيه. فأخذ الطفل يفحص من ألم الجروح، و يرفرف كما يرفرف الطير المذبوح، و دمه يشخب من أوداجه، و الحسين عليه السلام يتلقّى دمه من نحره حتى امتلأت كفه، ثم رمى به نحو السماء.
قال الإمام الباقر عليه السلام: فما وقع منه قطرة إلى الأرض، و لو وقعت منه إلى الأرض قطرة لنزل العذاب.
ثم قال عليه السلام: هوّن ما نزل بي أنه بعين اللّه تعالى. اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي إن كنت حبست عنا النصر من السماء، فاجعله لما هو خير منه، و انتقم لنا من الظالمين و اجعل ما حلّ بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمّد صلى الله عليه و آله و سلم. فسمع عليه السلام مناديا من السماء: دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة.
ثم نزل عليه السلام عن فرسه، و حفر له بجفن سيفه، و دفنه مرمّلا بدمه، و صلّى عليه. و يقال: وضعه مع قتلى أهل بيته (2).
وكان هذا الرضيع هو ابن السيدة رباب، وهي التي شاهدت هذا المشهد المفجع، وهي تعلم أن لا قبر له إلا صدر أبيه، ولا كفن له إلا الدم، ولا ضريح له إلا الرمضاء.
بعد المأساة: من الحزن إلى الذوبان
بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وأسر النساء إلى الكوفة ثم الشام، عادت السيدة رباب إلى المدينة المنورة. وقد أجمع المؤرخون أنها لم تذق طعم الراحة بعد الواقعة، ولم تستظلّ بسقف بيت، حزناً على الحسين، بل عاشت في البكاء والمراثي حتى وافتها المنية بعد عام من الطفّ.
وهذا التصوير يعبّر عن أعلى درجات الوفاء، والذوبان في ذكرى الحبيب الشهيد.
مراثيها لشهيد كربلاء
و قال هشام الكلبي: كانت الرباب من خيار النساء و أفضلهن، و خطبت بعد قتل الحسين عليه السلام فقالت: ما كنت لأتخذ حما بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله.
و روي أنه رثت الرباب زوجها الحسين عليه السلام حين قتل فقالت:
ان الذي كان نورا يستضاء به
بكربلاء قتيل غير مدفون
سبط النبي جزاك اللّه صالحة
عنا و جنبت خسران الموازين
قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به
و كنت تصحبنا بالرحم و الدين
من لليتامى و من للسائلين و من
يغني و يأوي إليه كل مسكين
و اللّه لا أبتغي صهرا بصهركم
حتى أغيب بين الرمل و الطين (3).
ويلاحظ في أبياتها عمق الحزن الذي لا يُقاوم، واستحضار تفاصيل الكارثة في نبرة حزينة مليئة بالأسى والافتقاد.
في مجلس الطاغية عبيد الله بن زياد
و عرض عليه علي بن الحسين عليهما السلام فقال له: من أنت؟ فقال: أنا علي بن الحسين. فقال: أ ليس قد قتل اللّه علي بن الحسين؟ فقال له علي: قد كان لي أخ يسمى عليا قتله الناس. فقال له ابن زياد: بل اللّه قتله. فقال علي بن الحسين عليه السلام: اللّه يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب ابن زياد و قال: و بك جرأة لجوابي و فيك بقية للرد علي اذهبوا به فاضربوا عنقه، فتعلقت به زينب عمته و قالت: يا بن زياد حسبك من دمائنا، و اعتنقته و قالت: و اللّه لا أفارقه فإن قتلته فاقتلني معه. فنظر ابن زياد إليها و إليه ساعة ثم قال: عجبا للرحم، و اللّه إني لأظنها ودت إني قتلتها معه، دعوه فإني أراه لما به.
و في تذكرة السبط: و قيل إن الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين عليه السلام أخذت الرأس و وضعته في حجرها و قبلته و قالت:
وا حسينا فلا نسيت حسينا
اقصدته أسنة الأدعياء
غادروه بكربلاء صريعا
لا سقى اللّه جانبي كربلاء (4).
رُباب في الذاكرة الشيعية
تمثّل رباب عند الشيعة نموذجًا للمرأة المؤمنة، الصابرة، التي واجهت الظلم بالصبر، والخذلان بالوفاء، والحزن بالدموع الصامتة. لم تكن شخصية هامشية، بل كانت شريكة الإمام الحسين في مشروعه الرسالي، حين اختارت أن ترافقه رغم علمها بالمصير.
وقد خلدت الذاكرة الشيعية اسمها في المجالس الحسينية، لا بصفتها "أرملة"، بل "الوفية الصامتة"، و"الناطقة بدموعها"؛ المرأة التي لم تخرج عن حدود الإسلام رغم الفاجعة، ولم تتلفظ بكلمة تسيء، بل تحمّلت الألم على نهج الزهراء وفاطمة بنت أسد وزينب بنت علي.
وفاتها ومثواها
توفيت السيدة رباب سنة 62 هـ، أي بعد عام تقريبًا من واقعة الطف، وقيل إنها دُفنت في المدينة المنورة، قرب بقيع الغرقد، ولا يُعلم على وجه الدقة موضع قبرها، شأنها شأن كثير من نساء أهل البيت اللواتي أُخفيت قبورهن.
وتبقى سيرتها سيرة امرأة لم تُعرف بمنزلتها فقط، بل بصمتها الإنسانية والعاطفية، وهي الصفة التي خلدتها في ضمير الأجيال.
خاتمة
إن الحديث عن السيدة رباب حديث عن الحبّ الخالص والوفاء الذي لا يُحدّ. لقد آمنت بمشروع الإمام الحسين عليه السلام، ورافقته بكل وفاء، وتحمّلت الفقد والشهادة، حتى باتت واحدة من رموز الحزن في الوجدان الشيعي.
فكما خلد التاريخ زينب بنت علي عليها السلام لخطابها وموقفها، خلّد رباب لصمتها وحزنها. وإن الوفاء ربما لا يكون بالكلمات فقط، بل أحيانًا في دمعةٍ لا تجف، وصبرٍ لا ينهار.
1. تاريخ دمشق / المجلّد : 69 / الصفحة : 119 ؛ وراجع : الأغاني / المجلّد : 16 / الصفحة : 147.
2. موسوعة كربلاء / لبيب بيضون / المجلّد : 2 / الصفحة : 147.
3. نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم: الشيخ عباس القمي / المجلّد : 1 / الصفحة : 480.
4. نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم: الشيخ عباس القمي / المجلّد : 1 / الصفحة : 372.
لماذا اصطحب الإمام الحسين عليه السلام أهل بيته إلى كربلاء؟
قد يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: كيف يمكن لرجل يعلم أنه ذاهب إلى الموت، أن يأخذ معه نساءه وأطفاله؟ أليس الأولى أن يتركهم في مأمن بعيدًا عن الخطر؟
لكن عندما ننظر بعين القلب والإيمان، ندرك أن في هذا القرار حكمة ورسالة. إن أسر أهل بيت النبوة لم يكن مجرد حدث مأساوي، بل كان جزءًا من تخطيط إلهي عظيم، كشف زيف بني أمية، وفضح ادّعاءاتهم بالدفاع عن الدين.
فما السرّ في هذا القرار العجيب؟ ولماذا أراد الإمام عليه السلام أن تكون زينب وسكينة وأم كلثوم عليهن السلام وسائر النساء حاضرات في كربلاء؟ أكان في ذلك إيصالٌ لرسالةٍ مدوّية، أم أداء دور بعد الاستشهاد؟
في هذا المقال، نفتح معًا أبواب هذه الحكاية المؤلمة والعظيمة، ونقترب خطوة من فهم سرّ اصطحاب الإمام الحسين عليه السلام لأهل بيته في مسيره إلى كربلاء.
القضاء الإلهي:
كيف يمكن لإنسانٍ يعرف أن طريقه سينتهي بالذبح، أن يصرّ على الرحيل؟ وكيف يرضى أن تأسره يد العدو، ويُسبى أهل بيته، دون أن يتراجع خطوة واحدة؟ هذه ليست قصة رجلٍ هارب من خطر، بل هي حكاية عبدٍ مُسلِّم أمره لقضاء الله، عالمٍ أن الموت ليس نهاية الطريق، بل بداية الرسالة. لم يكن خروج الإمام الحسين عليه السلام مجرد قرار شخصي، بل نداءٌ من السماء، وامتثالٌ لأمر إلهي أراده الله، ليُبعث الإسلام حيًّا من جديد بدمه ودموع أهله. فهل تود أن تعرف كيف أجاب الحسين نداء السماء؟ اقرأ هذه الرواية المؤثرة التي نقلها لنا التاريخ، لنكتشف معًا أن كل خطوة خطاها كانت بوحي، وكل دمعة ذُرفت كانت جزءًا من مشيئة الله سبحانه وتعالى.
جاء محمد ابن الحنفية إلى الحسين عليه السلام في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة فقال له: « يا أخي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فان رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه، فقال: يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت، فقال له ابن الحنفية: فان خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به، ولا يقدر عليك أحد، فقال: أنظر فيما قلت.
فلما كان السحر، ارتحل الحسين عليه السلام فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ بزمام ناقته - وقد ركبها - فقال: يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما فارقتك فقال: يا حسين اخرج فان الله قد شاء أن يراك قتيلا فقال محمد ابن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال: فقال [لي صلى الله عليه وآله]: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، فسلم عليه ومضى » (1).
كتب العلماء في حكمة هذا الموقف أن الإمام عليه السلام كان يعلم بأنّ بني أمية قد عزموا على هدم الإسلام والإنسانية، لكنهم كانوا يُخفون ذلك تحت قناعٍ مزيف من الدفاع عن الدين، ووحدة الأمة، ومحاربة "مخالف خليفة رسول الله ومُفرِّق الجماعة".
وكان لا بد من إسقاط هذا القناع وكشف وجه بني أمية الحقيقي، ليعرف الناس حقيقتهم، وتُسجَّل في التاريخ. ولهذا، كان لا بد أن تكون حركة الإمام عليه السلام خالية تمامًا من أي شبهة طلب للسلطة أو ميل للحرب، حتى لا يستطيع أحد أن يتّهمه بذلك.
ومن هنا، نرى أن الإمام عليه السلام، منذ لحظة خروجه من المدينة وحتى يوم شهادته، كان يُصرّح بوضوح أن نهاية هذه المسيرة هي الموت والشهادة، لكي لا ينضمّ إليه أحد طمعًا في حكمٍ أو غنيمة.
وقد اصطحب معه أهل بيته ونساءه وبناته، لكي يَظهر للناس بعد استشهاده، كيف سيتصرف هؤلاء الوحوش من بني أمية مع ذرية رسول الله وحرائره. وكان يريد للعالم أن يرى بوضوح أن من يدّعي الدفاع عن دين النبي وسنته ووحدة الأمة، لا يمتّ لا إلى الإسلام ولا إلى الإنسانية بصلة.
الإمام عليه السلام وضع أهل بيته عن وعي في طريق الأسر، لكي يسجّل التاريخ قبح أفعال شيعة بني أمية، ولا يُمكن بعد ذلك لأي أحد أن يُخفي هذه الصورة القبيحة خلف أقنعة الخداع والرياء.
وفي الوقت نفسه، كان هدفه أن يتمكن أهل بيته من نقل رسالته من كربلاء إلى الكوفة، ثم إلى الشام، ومنها إلى المدينة؛ تلك المراكز الثقافية والسياسية في العالم الإسلامي آنذاك، حتى لا تُدفن رسالته كما دُفن جسده الشريف في كربلاء، بل تبقى حيّة في قلوب الأمة وضمير التاريخ.
رسالة في قلب القصر
ليست قصة كربلاء مجرّد معركة انتهت باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بل كانت بداية لرسالة عظيمة حملها الإمام السجاد عليه السلام، والعقيلة زينب عليها السلام وأخواتها، والأطفال الذين رافقوها.
لقد شاء الله تعالى أن تدخل بنات الوحي إلى قلب الحكم الأموي، إلى قصر يزيد نفسه، لتفضح الزيف، وتكشف القناع، وتهزّ أسس الباطل من الداخل. كانت مشيئة الله أن تُسبى زينب، لتتحوّل من سجينة في قصر الطغيان إلى منبر من نور، تزرع الوعي في قلوب الناس، وتقلب فرحة الشام إلى غضبٍ عارمٍ على يزيد، حتى بدأت علامات السقوط تلوح في أفق بني أمية.
ومن بين المشاهد التي هزّت وجدان الحاضرين، مشهد ذلك الرجل النصراني الذي حضر مجلس يزيد ورأى رأس الحسين عليه السلام مرفوعًا بين كؤوس الخمر… فماذا حصل؟
يروي الإمام زين العابدين عليه السلام أنه حين أُتي برأس الإمام الحسين عليه السلام إلى يزيد، كان الأخير يعقد مجالس الشرب واللهو، ويضع الرأس الطاهر أمامه متفاخرًا.
وذات يوم، دخل مجلسه رسولٌ من قِبَل ملك الروم، وكان رجلاً نصرانيًا من كبار القوم وأشرافهم. نظر إلى الرأس وسأل يزيد: "يا ملك العرب، هذا رأسُ مَن؟"
فقال يزيد: "ما شأنك بهذا الرأس؟"
أجابه الرجل: "حين أعود إلى ملكي، يسألني عن كل ما رأيت، وأحببت أن أخبره بقصة هذا الرأس حتى يشاركك الفرح!"
قال يزيد متبجّحًا: "هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب، ابن فاطمة بنت رسول الله."
فتغيّر وجه النصراني، وقال بمرارة: "تبًّا لدينكم! أنا من نسل داوود عليه السلام، وبيننا عشرات الأجيال، ومع ذلك، يقدّسني النصارى، ويأخذون من تراب قدمي تبرّكًا بي، لأني فقط من نسله. وأنتم تقتلون ابن بنت نبيّكم، الذي لا يفصله عن رسولكم سوى أمّه؟! أيّ دينٍ هذا؟!"
ثم أضاف مخاطبًا يزيد: "هل سمعتَ عن كنيسة الحافر؟"
فقال يزيد: "قل، لأسمع."
قال النصراني: "بين عمان والصين بحر طويل فيه جزيرة كبيرة، لا يملكها أحد سوى النصارى، وهي مليئة بالكنائس. أعظمها كنيسة الحافر، وفيها قطعة ذهبية يُقال إنها تحمل أثر حافر الحمار الذي كان يركبه عيسى عليه السلام. يطوف الناس بها، ويقبلونها، ويتبركون بها، ويطلبون حاجاتهم عندها. كل هذا لحافر دابة نبيّهم! وأنتم تقتلون ابن بنت نبيّكم! لا بارك الله فيكم ولا في دينكم!"
فأمر يزيد بقتله حتى لا يفضحه في بلاد الروم.
فقال له الرجل: "أتريد أن تقتلني؟ لقد رأيت نبيكم البارحة في المنام، وقال لي: يا نصراني، أنت من أهل الجنة."
ثم نطق الشهادتين، وقال: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله."
وانقضَّ على رأس الحسين عليه السلام، وضمه إلى صدره، يقبّله ويبكي حتى قُتل على يد جلاوزة يزيد. (2)
خُطبة هزّت الشام
ولم تكن زلزلة عرش يزيد مقتصرة على كلمة النصراني، بل جاءت الصاعقة الكبرى من قلب بيت النبوة، حين نهض الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد وخطب خطبةً رجّت أركان القصر، وكشفت للناس من هو الحسين، ومن هم أعداؤه، وبيّن نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفضائل أهل البيت ومظلوميتهم. خطبة أيقظت قلوب الشاميين الذين كانوا قد زيّنوا شوارعهم لاستقبال أسرى كربلاء، فصاروا بعد الخطبة يبكون ويندبون، حتى تحوّلت الزينة إلى مأتم، والفرح إلى حزن، واضطُرّ يزيد المفضوح إلى إطلاق سراحهم.
خلاصة خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد
بعد إلحاح الناس، صعد الإمام زين العابدين عليه السلام منبر يزيد، رغم تردّده وخوفه من الفضيحة. بدأ الإمام خطبته بحمد الله، ثم قدّم نفسه للجمهور، مبيّنًا فضل أهل البيت عليهم السلام، فقال: "أُعطينا ستّاً وفُضّلنا بسبع..."، وذكر أنّه من نسل النبي محمد صلى الله عليه وآله، ومن أبناء مكة وزمزم وصفا، ومن سلالة علي وفاطمة والحسن والحسين.
ثم بدأ بتكرار جملة: " ابن مكة ومنى، زمزم والصفا، من طاف وسعى، من عُرج به إلى السماء"، في وصف نسبه الشريف ومكانة آبائه في الإسلام، حتى ضجّ الناس بالبكاء والنحيب.
ولما خشي يزيد من انقلاب الناس عليه، أمر المؤذن أن يقطع الخطبة. ولكن الإمام لم يسكت، بل علّق على كل جملة من الأذان، حتى بلغ المؤذّن: "أشهد أنّ محمداً رسول الله"، فقال الإمام:
"يا يزيد، هذا محمد جدّي أم جدّك؟ إن زعمتَ أنه جدّك فقد كذبت، وإن قلتَ إنه جدّي، فلِمَ قتلتَ عترته؟!" (3)
فكانت تلك الكلمات كالصاعقة التي أيقظت أهل الشام، وقلبت المجالس، وأسقطت هيبة يزيد.
1. اللهوف في قتلى الطفوف للسيد بن طاووس / الصفحة: 53 - 56.
2. : اللهوف في قتلى الطفوف للسيد بن طاووس / الصفحة: 112.
3. مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمي / المجلد : 2 / الصفحة : 78.
الحج؛ حق إلهي على عاتق المستطيعين
ويقول القرآن الكريم في الآية 97 من سورة آل عمران المباركة "فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ."
وتظهر هذه الآية أن أداء مناسك الحج هو واجب إلهي على الذين لديهم استطاعة.
وكلمة "استطاعة" في هذه الآية لا تقتصر فقط على البُعد المالي، بل تشمل الأبعاد الجسدية، وأمان الطريق، والصحة، وإمكانية إدارة الحياة بعد العودة.
كما أن استمرار الآية بعبارة «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» يذكر أن ترك الحج عمداً هو نوع من الكفر وعدم الاكتراث بأمر الله.
وفي آية الحج، يتم التعبير عن ترك الحج بالكفر والبعض يرى أن الكفر في هذه الآية يتعلق بالشخص الذي ينكر وجوب الحج، ويعتبر ذلك خروجاً من الإسلام.
لكن البعض الآخر يعتقد أن ترك الحج (حتى لو لم يكن مصحوباً بإنكار وجوب الحج) هو خروج من دائرة الإسلام، كما يعتقد البعض أن كلمة الكفر تشمل أي نوع من المخالفة للحق.
ومن منظور بعض المفسرين فإن عبارة "آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ" في الآية الـ97 من سورة آل عمران المباركة، أي الآيات الواضحة لبيت الله، هو ردّ على اليهود الذين کانوا یعتبرون بیت المقدس أعظم من الكعبة. ومن الأمور التي تعدّ من العلامات الواضحة للکعبة المشرفة في آية الحج هي "مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ"، وَ"مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا"، وَ"لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
شعائر الله في الحج؛ رموز معنوية وتوحيدية
ويُحذّر القرآن الكريم في الآية الثانية من سورة المائدة المباركة، من عدم احترام شعائر الله والأشهر الحرم وأيضاً الأضاحي والزوار الذين يقصدون بيت الله.
وجاء في هذه الآية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا".
كما ذُكرت الأضاحي في سورة الحج، الآية 36، كـ جزء من شعائر الله "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ" هذا التأكيد على الشعائر يدلّ على أن مناسك الحج الظاهرة ليست مجرد أعمال رمزية، بل لها ارتباط عميق بالمعاني الروحية والتوحيدية. إن الاهتمام بهذه العلامات يعدّ من علامات تعظيم الشعائر وتقوى قلوب المؤمنين.
من وجهة نظر القرآن الكريم، فإن مناسك الحج تُظهر آثار عظمة الله، لذلك يجب الحفاظ على جميع الخصائص والميزات لهذه الحدود والشعائر بدقة شديدة والالتزام بها.
كما يجب الحذر من أن يتم تنفيذ أي عمل بشكل غير صحيح؛ لأن مثل هذا الخطأ يُبطل العمل في الظاهر وفي الباطن.بلا شك، فإن العناية بهذه الحدود تُعتبر من علامات تقوى القلوب ومن مظاهر الإحسان في سبيل الله.
الشكرُ على نِعَمِ اللهِ
الشكرُ على نِعَمِ اللهِ
قالَ تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا * مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾[1].
جعلَ اللهُ عزَّ وجلَّ للإنسانِ مقامَ الخلافةِ الإلهيَّةِ، فَسخَّرَ لهُ ما في السَّماواتِ والأرضِ للرُّقيِّ بهِ نحوَ الكمالِ. وهيَ نِعمةٌ لا تَدومُ ولا تَزيدُ إلَّا بوجودِ أسبابِها وأداءِ الواجبِ نحوَها؛ لذا كانَ لا بُدَّ للإنسانِ من أنْ يقومَ بما يَفي لِهذهِ النِّعَمِ الإلهيَّةِ، ولو بالقليلِ منَ العملِ الآتي:
1. أداءُ الشُّكرِ للهِ على هذهِ النِّعَمِ؛ لأنَّ الشُّكرَ يُزيدُ في النِّعَمِ والبَرَكاتِ، ومَظهرُ ذلكَ هوَ التَّصرُّفُ في هذهِ النِّعَمِ بما أمرَ اللهُ بهِ، قالَ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[2]، وعنِ الإمامِ الصادقِ (عليهِ السلامُ): «مَنْ أُعْطِيَ اَلشُّكْرَ أُعْطِيَ اَلزِّيَادَةَ، يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾[3]»[4].
ومِن أهمِّ أبوابِ الشُّكرِ الامتِناعُ عن ظُلمِ النَّاسِ أوِ الاستعانةِ بنِعَمِ اللهِ على معاصيهِ، ولا سِيّما التَّكَبُّرُ على عبادِهِ، فَعنِ الإمامِ عليٍّ (عليهِ السلامُ): «مَا أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً، فَظَلَمَ فِيهَا، إِلاَّ كَانَ حَقِيقاً أَنْ يُزِيلَهَا عَنْهُ»[5]، وعنِ النبيِّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ): «يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَابْنَ آدَمَ، مَا تُنْصِفُنِي، أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ، وَتَتَمَقَّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي!»[6].
2. ذكرُ نِعم اللهِ وعدمُ الغفلةِ عنها، قالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾[7]، وعن رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ) في قولِهِ تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾[8]: «بنِعَمِ اللهِ وآلائِهِ»[9]، وعنِ الإمامِ الصادقِ (عليهِ السلامُ) في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾[10]، قالَ: «اَلَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِمَا فَضَّلَكَ، وَأَعْطَاكَ، وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ»، ثمَّ قالَ: «فَحَدَّثَ بِدِينِهِ، وَمَا أَعْطَاهُ اَللَّهُ، وَمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْه»[11].
ومن ذلكَ إظهارُ النِّعمِ الّتي أنعمَ اللهُ بها على الإنسانِ، فعنِ الإمامِ الصادقِ (عليهِ السلامُ): «إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِه بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَيْه، سُمِّيَ حَبِيبَ اللَّه مُحَدِّثاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ، وإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْه، سُمِّيَ بَغِيضَ اللَّه مُكَذِّباً بِنِعْمَةِ اللَّهِ»[12].
3. القناعةُ بنِعَمِ اللهِ تعالى وعدمُ الإسرافِ فيها، فعنِ الإمامِ الكاظمِ (عليهِ السلامُ): «مَنِ اِقْتَصَدَ وَقَنِعَ بَقِيَتْ عَلَيْهِ اَلنِّعْمَةُ، وَمَنْ بَذَّرَ وَأَسْرَفَ زَالَتْ عَنْهُ اَلنِّعْمَةُ»[13].
4. السَّعيُ في قضاءِ حوائجِ الناسِ، فالمرويُّ عن أميرِ المؤمنينَ (عليهِ السلامُ): «يَا جَابِرُ، مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ مَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيْهِ عَرَّضَهَا لِلدَّوَامِ وَاَلْبَقَاءِ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي مَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيْهِ عَرَضَّهَا لِلزَّوَالِ وَاَلْفَنَاءِ»[14].
إنَّ مِن أعظَمِ الأيّامِ عندَ اللهِ يومَ الخامسِ والعشرينَ من ذي القَعدةِ، وهوَ يومُ دَحوِ الأرضِ، وهوَ أحدُ الأيّامِ الأربعةِ الّتي خُصَّتْ بالصِّيامِ بينَ أيّامِ السَّنةِ، وفيهِ أعمالٌ خاصّةٌ مُستحبّةٌ، على المؤمنينَ السَّعيُ للقيامِ بها، والدُّعاءُ لِوليِّ أمرِ المسلمينَ بالحِفظِ، ولِلمُجاهدينَ بالتَّوفيقِ والنَّصرِ.
[1] سورة النازعات، الآيات 30 - 33.
[2] سورة الأعراف، الآية 96.
[3] سورة إبراهيم، الآية 7.
[4] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص95.
[5] الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص482.
[6] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج2، ص28.
[7] سورة فاطر، الآية 3.
[8] سورة إبراهيم، الآية 5.
[9] السيوطيّ، الدرّ المنثور، ج4، ص70.
[10] سورة الضحى، الآية 11.
[11] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص94.
[12] المصدر نفسه، ج6، ص438.
[13] ابن شعبة الحرّانيّ، تحف العقول، ص403.
[14] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام)، ص403.
كيف يكون الله حاضراً في حياتنا؟
إذا كان كمال الإنسان وسعادته الحقيقيّة تكمن في التقرّب إلى الكمال المحض وصيرورته عند الله كما هو حال الشهداء، فإن تحقّق ذلك إنما يكون من خلال أمرين أساسيّين هما: المراقبة والمحاسبة. فالإنسان إذا أدرك أنه في محضر الله لا بد له من مراقبة أعماله والانتباه لتصرّفاته من جهة، ومن جهةٍ أخرى عليه أن يحاسب نفسه باستمرار. فالمراقبة الدائمة والحساب المستمرّ هما اللذان يوصلان الإنسان إلى المكان الذي لا ينظر فيه إلا إلى الله. ويبيّن القرآن الكريم هذين الأصلين في سورة الحشر المباركة بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[1]. فهذه الآية تدعونا إلى أصلين أخلاقيين، الأوّل المراقبة، والثاني المحاسبة. فكلّ إنسانٍ مكلّفٌ بمراقبة نفسه ومحاسبتها، فيراقبها في أفعالها وتصرّفاتها وأقوالها ويحاسبها، فإذا عمل خيراً شكر الله، وإذا عمل سوءاً استغفر الله وتاب إليه.
1- المراقبة:
معنى المراقبة مشتقّ من "الرقبة"، فالذي يرفع رقبته ليشاهد أكثر يكون مراقباً. وعلى الإنسان أن يراقب كلّ شيء في حياته من الكلام والفعل والنّظر وغيرها... لكي لا يقع فيما لا يرضي الله، وما يخالف أمره، فهو عزّ وجلّ ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾[2]، ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾[3]، وهو مستعدّ وجاهز ليسجّل كلّ شيء ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾[4]، والإنسان الذي يراقب نفسه باستمرار سوف يحرص على أن لا يرتكب أية مخالفة، فعن أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبة له قال: "فرحم الله من راقب ربه، وخاف ذنبه، وجانب هواه، وعمل لآخرته، وأعرض عن زهرة الحياة الدنيا"[5]. ومما وصّى به إمامنا الصادق عليه السلام: "واقصد في مشيِك، وراقب الله في كل خطوة، كأنك على الصراط جائز، ولا تكن لفّاتا"[6].
2- المحاسبة:
وأما المحاسبة فأن يحاسب الإنسان نفسه من خلال البحث والتدقيق في أعماله ليرى إن كان قد أدّى التكاليف الإلهية على أكمل وجه أم لا، فإذا اكتشف أنه ارتكب ما يخالف أمر ربّه استغفر وأناب إليه نادماً عازماً على أن لا يعود إلى معصيته مطلقاً، وسعى مباشرة لإصلاح الأمر وجبران ما فاته. وإذا اكتشف أنه أدّى ما عليه حمد الله وشكره على ما وفّقه إليه، وهو مدرك أنه لا مجال للمقارنة بين طاعاته ونعم الله السابغة عليه، لذا يجد نفسه مقصّراً دائماً في محضر الحق، ولا يفتأ عن إظهار العجز والضّعف أمام ساحته، فلا يبتعد عن العبودية له قيد أنملة، ولا يجد نفسه في محضره إلّا عبداً. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه قال: "أيها الناس لا يشغلنّكم دنياكم عن آخرتكم، فلا تؤثروا هواكم على طاعة ربكم، ولا تجعلوا أيمانكم ذريعة إلى معاصيكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهّدوا لها قبل أن تعذّبوا، وتزوّدوا للرحيل قبل أن تُزعَجوا، فإنّها موقِفُ عدل، واقتضاء حقّ، وسؤالٌ عن واجبٍ، وقد أبلغ في الإعذار من تقدّم بالإنذار"[7].
وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ووازنوها قبل أن توازنوا، حاسبوا أنفسكم بأعمالها، وطالبوها بأداء المفروض عليها والأخذ من فنائها لبقائها"[8].
[1] سورة الحشر، الآية: 18.
[2] سورة غافر، الآية: 19.
[3] سورة ق، الآية: 18.
[4] سورة يس، الآية: 12.
[5] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 75، ص 18.
[6] م.ن: ج 73، ص 167.
[7] م. س، ج74، ص183.
[8] الطبرسي، الميرزا حسين النوري، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 154، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلاملإحياء التراث، 1988م، الطبعة 2، باب وجوب محاسبة النفس كل يوم...، ح 5.
كيفيّة التحقّق بمقام الصّبر؟
إنّ من النتائج الكبيرة والثمار العظيمة لتحرّر الإنسان من عبودية النفس، الصّبر في البلايا والنوائب. فالإنسان إذا أصبح مقهوراً لهيمنة الشهوة والميول النفسية، كان رقّه وعبوديته وذلّته بقدر مقهوريّته لتلك السلطة الحاكمة عليه. ومعنى العبودية لشخصٍ هو الخضوع التّام له وإطاعته. والإنسان المطيع للشهوات المقهور للنفس الأمّارة يكون عبداً منقاداً لها. وكلّما أوحت هذه السلطات بشيءٍ أطاعها الإنسان وخضع لها منتهى الخضوع، حتى يغدو عبداً خاضعاً ومطيعاً أمام تلك القوى الحاكمة. ويبلغ به الأمر إلى مستوى يفضّل طاعتها على طاعة خالق السماوات والأرض، وعبوديتها على عبودية مالك الملوك الحقيقيّ.
وفي هذه الحالة تزول عن نفسه العزّة والكرامة والحرية، ويحلّ محلها الذلّ والهوان والعبودية، ويخضع لأهل الدنيا، وينحني قلبه أمامهم وأمام ذوي الجاه والحشمة، ولأجل بلوغ شهواته النفسية يتحمّل الذلّ والمنّة، ولأجل الترفيه عن البطن والفرج يستسيغ الهوان، ولا يتضايق من اقتراف ما يخالف الشرف والفتوّة، عندما يكون أسيراً لهوى النفس والشهوة.
وينقلب إلى أداةٍ طيّعة أمام كل صالحٍ وطالح، ويقبل امتنان كلّ وضيعٍ عنده لمجرّد احتمال نيل ما يبتغيه حتّى إذا كان ذلك الشخص أحطّ وأتفه إنسان. إنّ عبيد الدنيا وعبيد الرغبات الذاتية، والذين وضعوا رسن عبودية الميول النفسية في رقابهم، يعبدون كلّ من يعلمون أنّ لديه الدنيا أو يحتملون أنّه من أهل الدنيا، ويخضعون له، وإذا تحدّثوا عن التعفّف وكبر النفس، كان حديثهم تدليساً محضاً، وإنّ أعمالهم وأقوالهم تكذب حديثهم عن عفّة النفس ومناعتها.
إنّ هذا الأسر والرّق للشهوات وأهواء النفس، من الأمور التي تجعل الإنسان دائماً في المذلّة والعذاب والنصب. ويجب على الإنسان ذي النبل والكرامة أن يلتجئ إلى كلّ وسيلةٍ لتطهير نفسه منها. ويتمّ التطّهر من هذه القذارات والتحرّر من كلّ خسّةٍ وهوانٍ بمعالجة النفس، وهي لا تكون إلَّا بواسطة العلم والعمل النافع.
أمّا العمل: فيكون بالرياضة الشرعية وبمخالفة النفس فترةً يتمّ فيها صرف النفس عن حبّها المفرط للدنيا والشهوات والأهواء حتّى تتعوّد هذه النفس على الخيرات والكمالات.
أمّا العلم: فيتمّ بتلقين النفس وإبلاغ القلب بأنّ الناس الآخرين يضاهونه في الفقر والضعف والحاجة والعجز، وأنّهم يشبهونه أيضاً في الاحتياج إلى الغنيّ المطلق القادر على جميع الأمور الجزئية والكليّة. وأنّهم غير قادرين على إنجاز حاجة أحدٍ أبداً، وأنّهم أتفه من أن تنعطف النفس إليهم ويخشع القلب أمامهم. وإنّ القادر الذي منحهم العزّة والشرف والمال والوجاهة قادرٌ على أن يمنح الجميع.
ومن العار حقيقةً على الإنسان أن يتذلّل وينحطّ في سبيل بطنه وشهوته ويتحمّل الامتنان من مخلوقٍ فقيرٍ ذليلٍ لا حول له ولا علم ولا وعي. إذا أردت أيّها الإنسان أن تقبل المنّة فلتكن من الغنيّ المطلق وخالق السموات والأرض، فإنّك إذا وجّهت وجهك إلى الذات المقدسة، وخشع في محضره قلبك، تحرّرت من العالمين[1]، وخلعت من رقبتك طوق العبودية للمخلوق لأنّ العبودية لله وحده لا شريك له.
[1] أي كل ما سوى الله عزّ وجل.
كيف استشهد الإمام الجواد (عليه السلام)؟
لقد ابتُلي الإمام محمد الجواد (عليه السلام) بابتلاءات عديدة:
منها: اليتم، فقد فارقه أبيه الإمام علي الرضا (عليه السلام) وهو صغير حينما أشخصه المأمون إلى خراسان، وقد آلم هذا الموقف قلب إمامنا محمد الجواد (عليه السلام) فكان يبكي لفراق أبيه..
ومنها: الغربة حيث أُخرج من مدينة جدّه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُبعد عنها، فقد ودّع الإمام أهله وولده وترك حرم جدّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذهب إلى بغداد بقلبٍ حزين. ويُروى أنّه لمّا خرج من المدينة في المرّة الأخيرة، قال: "ما أطيبك، يا طيبة! فلست بعائد إليك".
ومنها: السجن، إذ سجنه المعتصم، ولم يأذن لأحد بالدخول عليه.
ومنها: السمّ، فقد كان المعتصم يتربّص بالإمام ويعمل الحيلة في الفتك به، إلى أن سنحت له الفرصة فدسّ إليه السمّ، وقد اختلفت الرواية في كيفيّة سمّه له:
فمن قائل: أمر فلاناً (من كتّاب وزرائه) بأن يدعو الإمام إلى منزل الوزير، فدعاه، فأبى أن يجيبه، وقال: "قد علمت أنّي لا أحضر مجالسكم"، فقال: إنّي إنّما أدعوك إلى الطعام، وأحبّ أن تطأ ثيابي، وتدخل منزلي فأتبرّك بذلك، فقد أحبّ فلان بن فلان (من وزراء المعتصم) لقاءك. فصار إليه، فلمّا طَعِمَ منه أحسّ بالسمّ، فدعا بدابّته، فسأله ربّ المنزل أن يقيم، قال: "خروجي من دارك خير لك". فلم يزل يومه ذلك وليله في خِلفَةٍ2 يتقيّأ ذلك السمّ ويعاني آلامه في بطنه، حتّى قُبض (عليه السلام).
وقائل: إنّه أنفذ إليه شراب حماض الأترج- شبيه بالليموناضة- وأصرّ على ذلك، فشربها (عليه السلام) عالماً بفعلهم.
وقال آخرون: إنّ التي سمّته زوجته أمّ الفضل بنت المأمون لمّا قدمت معه من المدينة إلى المعتصم:
فلمّا انصرف أبو جعفر الجواد (عليه السلام) إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبِّرانِ ويعملانِ الحيلة في قتله، فقال جعفر لأخته أمّ الفضل- وكانت لأمّه وأبيه- في ذلك، لأنّه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه لتفضيله أمّ أبي الحسن ابنه عليها مع شدّة محبّتها له، ولأنّها لم تُرزق منه بولد، فأجابت أخاها جعفراً، فرُوي أنّها وضعت السمّ في منديل وأعطته إيّاه فمسح به، ورُوي أنّهم جعلوا سمّاً في شيء من عنب رازقيّ وكان يعجبه العنب الرازقيّ، وقدّمته له، فلمّا أكل منه ندمت وجعلت تبكي. فقال لها: "ما بكاؤك؟ والله ليضربنّك الله بفقر لا ينجبر، وبلاء لا ينستر"، فبُليت بعلّة في أغمض المواضع من جوارحها، صارت ناصوراً3 ينتقض في كلّ وقت فأنفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلّة حتّى احتاجت إلى رِفْد الناس. وتردّى جعفر في بئر فأخرج ميتاً وكان سكرانَ.
ورُوي عن الإمام علي الرضا (عليه السلام)، أنّه قال في حقّ ولده الإمام الجواد (عليه السلام): "يُقتل غصباً فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوّه وظالمه فلا يلبث إلّا يسيراً حتّى يعجّل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديد.."
وعلى أيّ حال فقد جرى السمّ في بدن الإمام عليه السلام، وبقي يتقلّب في فراشه، يعاني حرارة السمّ في يومه وليلته، يتقيّأ ذلك السمّ ويشكو آلام بطنه، حتّى دنا أجله..
ورُوي عنه (عليه السلام)، أنّه قال في العشيّة التي توفّي فيها: "إنّي ميّت الليلة"، ثمّ قال: "نحن معشر إذا لم يرض الله لأحدنا الدنيا نَقَلَنا إليه".
ويقال إنّ الإمام لمّا تناول السمّ تقطّعت أمعاؤه وأخذ يتقلّب على الأرض يميناً وشمالاً من شدّة الألم، ويجود بنفسه والتهب قلبه عطشاً- فقد كان الوقت شديد الحرّ والسمّ يغلي في جوف الإنسان- فطلب جرعة من الماء، والتفت إلى تلك اللعينة قائلاً: ويلك إذا قتلتِني فاسقيني شربة من الماء، فكان جوابها له أن أغلقت الباب ثمّ خرجت من الدار، فبقي الإمام يوماً وليلة يعالج ألم السمّ.. ولا يجد أحداً يسقيه شربة من الماء..
ولمّا بلغت روحه التراقي صعد سطح الدار، ورمق السماء بطرفه، وتشهّد الشهادتين، وغمّض عينيه، وأسبل يديه ورجليه، وعرق جبينه، وسكن أنينه، وفارقت روحه الدنيا..
من هي سمات خير الإخوان؟
حدّدت لنا الروايات الشريفة صفات عديدة للأصدقاء والإخوان، وأرشدتنا إلى كيفية اختيار أفضلهم، وأقربهم إلى الله، لأنَّ القرين والصاحب يؤثّر على دين المرء وسلوكه، فالمرء على دين خليله كما ورد في الروايات الشريفة.
لذا ينبغي أن نختار من توفّرت فيه الملامح التي رسمها وحدّدها المعصومون عليهم السلام على الشكل الآتي:
1- الدَّاعي إلى الله تعالى:
والمراد منه من كانت دعوته بالعمل، إضافة إلى القول، كما عبّرت عن ذلك النصوص الشريفة حيث ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام): "خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبِرّ وأعانك عليه"[1].
2- المعين على الطّاعة:
الطّاعة هدف خلقة الإنسان الحقيقي في هذه الدُّنيا، وخير الأصدقاء من يُعين على هذا الهدف السّامي. ورد عن رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لمَّا سُئل من أفضل الأصحاب: "من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكّرك"[2].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: "المعين على الطّاعة خير الأصحاب"[3].
وعنه (عليه السلام) أيضاً أنّه قال: "إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه"[4].
3- الصَّادقون:
وهم الّذين ينبغي معاشرتهم، كما يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "وعليك بإخوان الصِّدق فأكثِر من اكتسابهم، فإنّهم عُدّة عند الرَّخاء وجُنّة عند البلاء"[5].
وعن الإمام الحسن (عليه السلام) في وصيِّته لجنادة في مرضه الّذي توفّي فيه: "اصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلتَ صدّق قولك، وإن صلت شدّ صولك، وإن مددتَ يدك بفضلٍ مدّها، وإن بدت عنك ثلمة سدَّها، وإن رأى منك حسنةً عدّها، وإن سألتَه أعطاك، وإن سكتّ عنه ابتداك، وإن نزلت إحدى الملمَّات به ساءك"[6].
4- من يُذكّرنا بالله والآخرة:
عن النّبيّ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما سُئِل أيّ الجلساء خير؟ فقال: "من ذكّركم بالله رؤيته وزادكم في علمكم منطقه. وذكّركم بالآخرة عمله"[7].
5- مصاحبة العلماء:
أكّدت الرّوايات المباركة على صحبة العلماء ومجالستهم، لأنّهم قادة الركب الرَّبَّانيّ الّذين يأخذون بيد المرء إلى العالم العلويِّ ويصلون به إلى حيث أراد الله سبحانه، من خلال بثّ معارفهم وممارسة دورهم في الهداية والتّربية، والدِّفاع عن مبادىء الدِّين وصيانة الشَّريعة من أن تدخلها البدع والانحرافات. وممّا ورد في ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: "جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك"[8].
وما في وصية لقمان الحكيم لابنه: "يا بنيّ جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإنَّ الله عزّ وجلّ يُحيي القلوب بنور الحكمة، كما يُحيي الأرض بوابل السَّماء"[9].
وفي المقابل، فإنّ ترك مجالسة العلماء موجب للخذلان، لأنَّ الابتعاد عنهم معناه الابتعاد عن المدرسة الإلهيّة الّتي أمر المولى سبحانه بالتَّربّي في كنفها وتحت ظلالها، وهذا ما جاء صريحاً في دعاء الإمام علي السجّاد (عليه السلام) أنّه قال: "أو لعلّك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني"[10].
6- مصاحبة الحكماء والحلماء:
وهناك روايات أكّدت أيضاً على مصاحبة الحكماء ومجالسة الحلماء، لِما في هذين الصنفين من النّاس من مواصفات عالية تترك آثارها في الجنبة العلميّة والعمليّة بما يُساعد الإنسان عبر العلاقة بهم في طريقه إلى الكمال.
فعن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) أنّه قال: "أكثر الصَّلاح والصَّواب في صحبة أولي النُّهى والصَّواب"[11].
[1] م.ن، ص284, الحديث الحكمة - 9534.
[2] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 138.
[3] الآمدي، غرر الحكم، ص 284, الحكمة - 9508.
[4] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 164.
[5] م.ن، ج 71، ص 187.
[6] م. ن، ج 44، ص 139.
[7] م. ن، ج71، ص186.
[8] الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص430، نشر مكتب الاعلام الاسلامي، قم , 1407هـ.
[9] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 1، ص 204.
[10] م.ن، ج 95، ص 87.
[11] الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص429.
خوف أهل الآخرة؟
الخوف من العذاب هو أوطأ مراتب الخوف عند المؤمن. فللمؤمنين - حسب مراتب إيمانهم ومعرفتهم - أشكال أخرى من الخوف هي أعظم قيمة بكثير من هذا الخوف، كالخوف من السقوط من عين الله تعالى. فالذين يشكون من ضحالة في المعرفة لا يعرفون قيمة لطف الباري عزّ وجلّ، ولذا لا يحظى هذا الأمر بأهمّية عندهم. فعندما يريد القرآن الكريم أن يوضّح عاقبة أهل الشقاء فإنّه يقول: ﴿..وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..﴾[1]، فهل فكّرنا يوماً بأنّه ما الذي سيحصل إذا لم ينظر الله إلينا يوم القيامة؟ وهل يتمتّع هذا الأمر بأهمّية عندنا أساساً، أم إنّ المهمّ عندنا هو الحصول على نعم الجنّة؟ فالأطفال الذين يتمتّعون بفطرة سليمة يُدركون هذا النمط من العذاب، فإنّ أقسى أنواع العذاب للطفل هو أن تستاء أمّه منه فلا تلتفت إليه، لكنّ قليلي المعرفة من الناس لا يُدركون مثل هذه العلاقة مع الله، فكيف لهم أن يعرفوا ما الذي سيحصل إذا استاء الله منهم. لكنّه في اليوم الذي يكونون فيه بحاجة لمثل هذه النظرة فسيُدركون مدى شدّة العذاب الناجم من حرمانهم منها. فبعض عباد الله يخشون استياء الله منهم وعدم تحدّثه إليهم، ولا يخافون من جهنّم. وهذا أيضاً نمط من أنماط الخوف من الله. فكلّ مَن حاز حبّ الله في قلبه كان خوفه من استياء الله أكثر، وحتّى إذا كان متنعّماً بألطاف الله تعالى فإنّه يخشى انقطاع تلك الألطاف.
فإذا أمعنّا النظر في أحوالنا وسلوكيّاتنا الاختياريّة فسنُلاحظ أنّ العامل من وراء حركاتنا ونشاطاتنا الاختياريّة هو إمّا خوف الضرر أو رجاء النفع. وإنّ اختلاف الناس في سلوكيّاتهم ناشئ عن اختلافهم في تشخيص الضرر أو النفع، وإلاّ فأيّ تصرّف يقوم به أيّ امرئ فإنّ الغاية منه هو دفع ضرر ما عن نفسه أو جلب نفع ما لها. فلا بدّ أن يكون أحد هذين العاملين الاختياريّين مؤثّراً في جميع أفعالنا الاختياريّة. حتّى العاشق فإنّه يشعر - بسبب سلوكه مع معشوقه - بلذّة عقلانيّة ولطيفة في روحه وهو يسعى عن غير وعي وراء هذه اللذّة. إذن فهو أيضاً يُفتّش عن لذّة نفسه من خلال عدّة وسائط.
إذن فسلوكنا الاختياريّ هو إمّا لدفع ضرر أو لكسب فائدة. فعندما نحتمل وجود الضرر تصدر منّا ردّة فعل طبيعيّة لهذا الاحتمال تُدعى "الخوف". فالخوف إذن هو حالة طبيعيّة تحصل عند احتمال الضرر، ولا نكاد نجد في عالم الطبيعة إنساناً لا يكون الضرر محتملاً بالنسبة له. أمّا بالنسبة للمؤمن فهناك أضرار أهمّ من تلك وهي الأضرار الأخرويّة. ومن هنا فإنّ من أهمّ العوامل التي تدفعنا للمضيّ في طريق الكمال هو الالتفات إلى الأضرار التي تُهدّد سعادتنا الأبديّة. فالالتفات إلى هذه الأضرار يوجب الخوف، وهو حالة الانفعال التي تحصل للإنسان في مقابل احتمال الضرر. وإنّ تأكيد القرآن الكريم على مفاهيم من قبيل الخوف، والخشية، والتقوى، والوجل، والرهبة، وأمثالها ثمّ الإطراء عليها بأشكال شتّى يأتي من باب أنّ هذه الحالات هي أهمّ العوامل لحركة الإنسان التكامليّة. وبالطبع فإنّ هذه الحالات تقترن برجاء النفع أيضاً، وإنّ كلا العاملين مهمّ، غير أنّ تأثير الخوف يفوق تأثير الرجاء. نفهم من ذلك أنّ الخوف يُعدّ عاملاً مهمّاً من عوامل السعادة، هذا - بالطبع - إذا كان الخوف من الأخطار المعتنى بها، وليس ثمّة من ضرر يُمكن أن يُعتنى به بالنسبة للمؤمن أشدّ من الأخطار الأخرويّة، وهي الأخطار المتعلّقة بالساحة الإلهيّة المقدّسة. ومن هنا فلا بدّ من تقوية هذا الخوف[2].
[1] القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 77.
[2] من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ألقاها في مكتب الإمام السيد علي الخامنئي(دام ظله) في قم بتاريخ 18 آب، 2011 م.