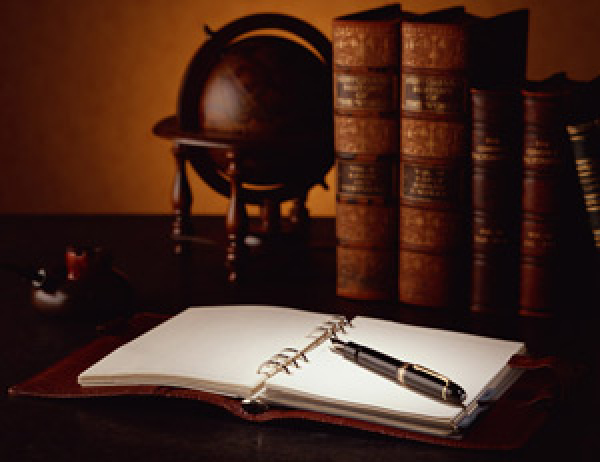Super User
اتفاق روسي أميركي على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا
وكالة "رويترز" للأنباء تنقل عن مسؤول أميركي قوله إن أميركا وروسيا ودولاً أخرى في المنطقة توصلت لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، وسيرغي لافروف يؤكد أن موسكو واشنطن مستعدتان للإعلان عن وقف النار اعتباراً من 9 تموز/يوليو الحالي.
قال مسؤول أميركي الجمعة لوكالة "رويترز" إن أميركا وروسيا ودول أخرى في المنطقة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا.
وفي وقت لاحق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وواشنطن مستعدتان للإعلان عن وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا اعتباراً من 9 يوليو/تموز المقبل، وأن الشرطة العسكرية الروسية ستعمل على حماية الأمن حول مناطق تخفيف التصعيد بتنسيق مع واشنطن.
فيما قال نظيره الأميركي ريكس تيلرسون "أعتقد أن الاتفاق مؤشر أولي على قدرة الولايات المتحدة وروسيا على العمل معاً في سوريا"، ولكنه أشار إلى عدم التوصل لاتفاق ثنائي حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى مهام تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكداً أن "للولايات المتحدة وروسيا مصالح مشتركة في مستقبل سوريا التي ينبغي أن تنعم بالاستقرار"، مشيراً إلى عقد جلسات نقاش مقبلة بين الجانبين للبحث في مصير قيادة البلاد.
وفي هذا الشأن بالذات قال تيلرسون إن "الولايات المتحدة لا ترى أي دور في الأجل الطويل لعائلة الأسد في سوريا"، وأضاف "لم نحدد كيفية رحيل الأسد بعد، لكن في مرحلة ما في العملية السياسية سيكون هناك انتقال لا يشمله ولا أسرته".
وأوضح تيلرسون أن بلاده وروسيا وافقتا على البحث في توسيع نطاق مناطق خفض التصعيد في سوريا حالما يتم القضاء على داعش.
وكان الجيش السوري أعلن الخميس تمديد العمل بوقف الأعمال القتالية الذي بدأه مطلع الأسبوع، وذلك حتى السبت، دعماً للعملية السلمية والمصالحات الوطنية.
وكانت المعارك اشتدت في محافظتي درعا والقنيطرة بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة الشهر الماضي، حيث حاولت المجموعات المسلحة السيطرة على مدينة البعث القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة لكن الجيش تمكن من صد الهجمات وأعاد خارطة السيطرة إلى ما كانت عليه.
وتحررت الموصل..
إقليمياً ودولياً، أكبر المستفيدين من دحر داعش عن الموصل هي إيران في السر والعلن. يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية مبتهجة في العلن من تحقق التحرير في الموصل، لكنها لا تخفي هواجسها الكبرى من إعادة إخراج قواتها من العراق على غرار ما جرى قبل ثماني سنوات.
أنجزت المهمة عسكرياً، لم يبق سوى الإعلان الرسمي عن النصر على داعش في الموصل، هذا يتم الاثنين.
خلافة داعش باتت في خبر كان، ثبت أنها خلافةُ وهمٍ زائف وخرافة مزيّفة. هذا لا يعني أن داعش انتهى. المقصود هو نهاية ما سماها أصحابها بخلافة وتنصيب زعيمهم أبو بكر البغدادي خليفة وأميراً للمؤمنين، من هنا يكتسب تحرير الموصل بهزيمة داعش أهمية مضاعفة وخاصة.
رمزياً، يشكل تحرير الموصل بعداً خاصاً، ففي الموصل أُعلنت الخلافة وفيها تنتهي، في الموصل أطلَّ البغدادي منتحلاً صفة خليفة وفيها تُسحب منه لينتهي كلّياً دينياً وفقهياً. بهذا المعنى يصبح تحرير الموصل ضربة رمزية فعلية في الصميم الداعشي.
معنوياً وتعبوياً، تحرير الموصل يشكل خسارة فادحة لحملات داعش المستمرة في تجنيد الأتباع واحتواء الشباب العرب المضلَلين واليائسين والغاضبين، والباحثين عن تنظيم أو أي إطار يحتضنهم ويشبع غرائزهم في الانتقام والتمرد باسم الدين.. داعش انتهى كهيكل جذب يبعث على الاطمئنان كما حصل معه خلال السنوات الماضية بعد احتلال الموصل وبقاع أوسع من العراق وسوريا.
سياسياً، تحرير الموصل تشكل انتكاسة كبرى لمشاريع وقوى ودول راهنت وموّلت ودعمت ووفرت غطاءً إعلامياً وسياسياً لداعش في حربهم على العراق وسوريا، يزداد التحرير أهمية بالتزامن مع العاصفة الخليجية التي تضرب دولاً شكلت رافعة عملية وحقيقية لداعش، تشريعاً وفقهياً وتحريضاً إعلامياً وفتنة مذهبية وسنداً مالياً.
عسكرياً، أثبت تحرير الموصل صواب الخيار العسكري في مواجهة داعش والتطرف والإرهاب. صواب ضروري من دون أن يلغي إلحاحية إيلاء أهمية لإصلاح أي خلل بنيوي وثغرات فكرية وثقافية ودينية كي لا يخرج داعش من الشباك ويعود من النافذة.
القوات العراقية المسلحة بتشكيلاتها المتعددة أثبتت جدارة عالية. لديها غرفة عمليات مشتركة مركزية، استفادت بقوة من إمكانات حلفائها وداعميها. تحرير الموصل لقي إجماعاً دولياً، لأن حرب التحرير من قبل الشرعية العراقية كانت لدحر تنظيم إرهابي، لذا فإنّ من حقّ الشرعية السورية ضرب داعش وأخواته في حرب تحرير ضد الإرهاب أيضاً.
إقليمياً ودولياً، أكبر المستفيدين من دحر داعش عن الموصل هي إيران في السرّ والعلن. يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية مبتهجة في العلن من تحقق التحرير في الموصل، لكنها لا تخفي هواجسها الكبرى من إعادة إخراج قواتها من العراق على غرار ما جرى قبل ثماني سنوات.
هنا تحديداً يأتي البعد الاستراتيجي في عملية تحرير الموصل، ماذا بعد تحرير الموصل ميدانياً وسياسياً واستراتيجياً على المستوى العراقي والإقليمي والأميركي والدولي .
تحرير الموصل هو مكمّل للانتصارات الناجزة الكبرى التي حققها الحشد الشعبي في بقاع شاسعة جداً في العراق المحتل من داعش ومَن وراءَه. لم تكن واشنطن راغبة في أدوار متقدمة وميدانية حقيقية على الأرض، لكن خيار واشنطن لم يتحقق وبات الحشد الشعبي قوة ورقماً صعباً في أية معادلة، عراقية محلية وربما إقليمية إيرانية. بما يعنيه ذلك من مكاسب لمحور المقاومة والمواجهة في المنطقة وانتكاسة للمحور الأميركي المقابل. كذلك ليس خافياً أن واشنطن لم تكن متحمسة مطلقاً في البداية بتحرير الموصل كاملة، وكانت تفضل الاكتفاء بتحرير الساحل الأيمن فقط للموصل لكن القوات العراقية رفضت هذا مطلقاً.
يبقى السؤال الأصعب: ماذا بعد داعش في الموصل؟ يتحضر العراق لتهدئة داخلية محلية يسميها البعض بالتسوية الكبرى، وهذا يلقى تشجيعاً عاماً، لكن اليوم يشكل لحظة نصر كبير تستحق التركيز عليها في طريق تحقيق الانتصار الكامل على داعش والإرهاب في العراق.
ايفاد اول دفعة من الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة حجة الاسلام قاضي عسكر ان أول دفعة من الحجاج الايرانيين سيتم ايفادهم في الـ 31 من تموز / يوليو الحالي الى الديار المقدسة.
حجة الاسلام قاضي عسكر قال في تصريح صحفي له الاحد، لحد الان لم نواجه مشاكل بشان الحجاج ، ولحد الان أقيم تعاون جيد، ونأمل باداء مناسك الحج لهذا العام من دون أية مشاكل.
واشار ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الى تجمع عدد من عوائل شهداء حادثة منى امام منظمة الحج و الزيارة وقال: اليوم ونحو ساعتين كنا بخدمة العوائل الاعزاء حيث قدمنا تقريرا اليهم عن مسار العمل منذ البدء و حتى الان.
لفت الى موضوع دية شهداء منى وقال: لقد أرسلنا تقاريرنا الى السلطات السعودية وننتظر نتيجة لجنة التحقيق، ومن المحتمل ان يحل هذا الموضوع في حج هذا العام.
وفي رده على سوال بشان عدم اداء السفارة الايرانية في السعودية نشاطاتها خلال موسم الحج قال: ان 10 اشخاص من وزارة الخارجية تم منحهم تراخيص من قبل السعودية باعتبارهم ممثلين قنصليين لممارسة نشاطاتهم في جدة و مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحول كيفية التعاون السعودي مع منظمة الحج والزيارة قال: الحمد لله لحد الان لم نواجه مشكلة وهناك تعاون جيد، نأمل باقامة حج هذا العام دون وقوع اية مشاكل، مبينا ابرام العقود اللازمة مع السلطات السعودية.
واضاف: لدينا شعور بان يقام حجنا لهذا العام في أجواء هادئة.
وشائج الدم : مصر وفلسطين
حقائق التاريخ والجغرافيا، تؤكد أن ثمة خصوصية لعلاقات مصر بفلسطين، خصوصية، تجعل من فلسطين قضية مصرية بامتياز، فماذا عن هذه الحقائق ؟ .
حقائق التاريخ والجغرافيا تؤكد أن ثمة خصوصية لعلاقات مصر بفلسطين
بعد أزمة قطر والخليج وصراع حماس مع السلطة الفلسطينية وخلافات الجميع مع الدول المحيطة بفلسطين، في هذه الأجواء يتجدد الحديث هذه الأيام عن علاقات الدول المركزية المحيطة بفلسطين، بالقضية، مصيراً ومساراً، وهل أضحت هذه العلاقات اليوم (2017) ضعيفة بحكم انشغال تلك الدول بقضايا الإرهاب والربيع العربي الزائف؟ سؤال نحاول الإجابة عليه من خلال علاقات إحدى أهم دول المنطقة بفلسطين، إنها مصر .
إن حقائق التاريخ والجغرافيا، تؤكد أن ثمة خصوصية لعلاقات مصر بفلسطين، خصوصية، تجعل من فلسطين قضية مصرية بامتياز، فماذا عن هذه الحقائق ؟ .
أولاً: يحدثنا التاريخ أن الترابط التاريخي بين (فلسطين) ومصر، ممتد لأزمان ما قبل التاريخ، لعصور الفراعنة، صحيح أن الإدارات السياسية في البلدين اختلفت وتغيرت، لكن ظل التواصل والترابط قائماً بين الأرض والتاريخ انطلاقاً من وحدة الخطر الذي كان يهدد كلا البلدين من قبل الغزوات الخارجية، والتي أشهرها ما جاء من الهكسوس القدامى والهكسوس المعاصرين، لقد كانت المصلحة واحدة، والأمن واحد ومن ثم المصير تحدد، علي أن يكون واحداً، ما يجري في مصر ولها، يؤثر على فلسطين ومستقبلها السياسي والإنساني، والعكس صحيح، ما تتعرض له (فلسطين) سيؤثر حتماً على أمن مصر القومي، هكذا يحدثنا التاريخ الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد، ولألفي عام بعدها دون دخول في تفاصيل الرواية التاريخية لتلك السنين الطوال وتجاربها المهمة.
ثانياً: وإذا ما قفزنا إلى تاريخنا المعاصر، ومع الغزوة الصهيونية لفلسطين والتي بدأت إرهاصاتها في القرن الثامن عشر الميلادي مع مجيء حملة نابليون بونابرت (1798-1802) وما تلاها من سنين استعمارية عجاف؛ كانت الأطماع الصهيونية حاضرة مباشرة أو محمولة على روافع بريطانية وفرنسية وأمريكية استعمارية شديدة العداء لتلك اللحمة التاريخية بين (فلسطين) و(مصر)، فلعبت أدوارها الخبيثة في تفكيكها وفي زرع (الكيان الصهيوني) كالشوكة في خاصرة الوطن العربي الكبير وبالأخص في خاصرة مصر وبوابتها الشرقية للعالم ولآسيا.
ثالثاً: مع ثورة تموز/يوليو 1952، بدأت مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الفلسطينية – المصرية مرحلة قائمة على المشاركة الكاملة سياسياً وعسكرياً من قبل مصر في كافة ملفات القضية، وهي مرحلة اتسمت بالتوحد المصري الكامل مع فلسطين، وكان (الدم) عنوانها، وبدءاً من العمليات الفدائية التأسيسية لمصر في قطاع غزة على أيدي الشهيد البطل مصطفي حافظ في النصف الأول من الخمسينات، مروراً بعدوان 1956 وما تلاه حتى حرب الأيام الستة (1967) انتهاء بحرب الاستنزاف (1968-1970)، وإعداد عبدالناصر لجيش مصري جديد حقق به خلفه (أنور السادات) انتصار تشرين الأول/أكتوبر 1973، في كل هذه المراحل عبر الفترة الناصرية (1952-1970) كانت فلسطين هي العنوان، وكانت المشاركة بالدم هي الوسيلة والسمت، وكان الخطاب الناصري المحفز والمناهض للمشروع الصهيوني، هو اللغة الوطنية السائدة والمهيمنة علي الشارع العربي.
مصر في زمن عبدالناصر، وتحديداً خلال الفترة (1956-1967)، نظرت إلى فلسطين وما يجرى فيها كقضية أمن قومي، تؤثر على الاقتصاد والسياسة والثقافة، تأثيراً مباشراً، فلا تنمية حقيقية، أو تغيرات اجتماعية جذرية يمكن أن تحدث في البلاد دونما موقف حازم ومباشر من (العدو الصهيوني)، هكذا تقول أدبيات تلك المرحلة كما أصلتها ووثقتها (موسوعة مصر والقضية الفلسطينية) للمفكر والمؤرخ المصرى المحترم (الذي رحل عن دنيانا قبل أيام) د. عادل حسن غنيم في مجلدها الرابع – الجزء الثانى (467 من القطع الكبير) الصادرة قبل أيام عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر، والذي تشرفت بمناقشته ضمن نخبة من أساتذة التاريخ والسياسة في ندوة موسعة عقدها المجلس الأعلى للثقافة يوم 30/3/2017.
رابعاً: لقد جرت تحت النهر (الذي هو هنا فلسطين) مياه كثيرة بعد وفاة عبدالناصر عام (1970)، فلقد تحولت النظرة الرسمية المصرية إلى موقف متحفظ ثم معادي لكل ما هو فلسطيني خاصة بعد توقيع اتفاقات في كامب ديفيد عام 1978 على أيدي أنور السادات وبدء رحلة التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني طيلة زمن حسني مبارك (1981-2011) في (الزراعة – التجارة – السياحة – السياسة – الاقتصاد – الإعلام ..وحتى في الدين) [ انظر موسوعة التطبيع والمطبعون في مصر 1979 – 2011 إعداد وتوثيق د. رفعت سيد أحمد – الناشر مركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة – عدد الصفحات 2500 صفحة ] ، ورغم هذا الموقف الرسمي المتراجع والمتخاذل والمتفرد في حلوله مع إسرائيل، إلا أن موقف الشعب ونخبته المثقفة وعلماءه وأحزابه الوطنية وجمعياته الأهلية كان مغايراً، كان موقفاً ضميرياً بامتياز، كان ضد التطبيع علي طول الخط واستطاع رغم الضغوط الرسمية واسعة النطاق، أن يحصره في (السلطة ونخبتها المتواطئة) وأن تظل فلسطين حاضرة وبقوة من خلال فاعليات وأنشطة، ودعم غير محدود للانتفاضتين الأولى (1988)، والثانية (2000) ومن خلال التواصل الإنساني والسياسي مع كل ألوان طيف المقاومة العربية سواء في فلسطين أو في لبنان (من خلال دعم حزب الله والقوى الوطنية اللبنانية المقاومة) أو سوريا ودولة الأسد التي ظلت حاضنة للمقاومات العربية (وليس القضية الفلسطينية فحسب) طيلة أربعين عاماً (منذ انتصار أكتوبر 1973 وحتي بدء المؤامرة على سوريا عام 2011)، كان الشعب المصري خلال فترة حكم كل من السادات (1970-1981) ومبارك (1981-2011) في جانب، والنظام الرسمي في الجانب النقيض من القضية الفلسطينية.
خامساً: بعدما سمى بالربيع العربي والذي يحلو للبعض بتسميته بـ(الربيع العبري) تراجعت نسبياً المواقف والسياسات المساندة للقضية الفلسطينية في مصر، ورغم العدوان الصهيوني المتتالي على غزة (2009-2012-2014) إلا أن مستوى ردات الفعل الرسمية والشعبية كانت أقل منها عما جرى في العقود السابقة، ربما لانشغال الشعب المصري و(العربي) بملفات الإرهاب والمؤامرات التي أسماها البعض زيفاً (بالثورات)، ولكن ورغم هذا التراجع الذي لم يستفد منه سوى العدو الصهيوني، وبقايا صناع خيار أوسلو ظلت القضية، حية في الضمير الشعبي، ونحسبها رغم النكبات المتتالية ورغم أزمة قطر والخليج التى انعكست ظلالها على حماس والسلطة ومصر، رغم كل ذلك ستظل علاقة مصر بفلسطين حية!! لأن فلسطين بحكم الجغرافيا والتاريخ والدم قضية مصرية بامتياز شاء من شاء وأبى من أبى.
مجلس النواب المصري يرفض المشاركة في مؤتمر "مجاهدي خلق" ويعاقب نوابه الحاضرين
مجلس النواب المصري يعلن رفضه المشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية الذي يعقد في باريس، ورئيس المجلس يحيل على التحقيق 5 نواب حضروا المؤتمر دون الحصول على إذن مسبق.
أعلن مجلس النواب المصري رفضه المشاركة في مؤتمر مناهض للنظام الإيراني يعقد في باريس.
ورفض الأمين العام للمجلس في بيان له الموافقة على حضور المؤتمر السنوي العام لمنظمة "مجاهدي خلق"، إضافةً إلى رفض إعطاء الإذن بالسفر للنواب لحضوره.
ونفى البيان وجود أي تمثيل برلماني رسمي في المؤتمر، حيث كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن عدداً من النواب تلقوا دعوات للمشاركة في المؤتمر.
ولاحقاً قال مراسل الميادين في مصر إن رئيس مجلس النواب المصري أحال 5 نواب حضروا مؤتمر مجاهدي خلق في باريس إلى مكتب التحقيق لعدم حصولهم على إذن مسبق.
تأتي الخطوة البرلمانية المصرية في وقت تشارك مصر في حملة على قطر، من بين أهدافها قطع علاقات الدوحة مع إيران.
بوصله مصر تعود للتأثير فى الإقليم تحيه لمجلس النواب الذى منع أعضاءه من حضور اى اجتماعات لمنظمة مجاهدى خلق المعارضه الايرانيه مصر نظيفه اليد!
هل تراجعت سوريا عن هجومها الكيماوي كما زعمت امريكا؟
صرحت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي" أن "تحذير ترامب هو من أوقفت الاسد، يمكنني ان أقول لكم بفضل حزم الرئيس ترامب لم نشهد هجوما كيميائيا".
وفي هذا الشأن قال وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيز ، "المسؤولون السوريون يبدو انهم اخذوا التحذير الامريكي على محمل الجد".
جاءت تلك التصريحات بعد ان زعم البيت الابيض انه حصل على ادلة وشواهد تشير الى عزم الحكومة السورية على القيام بهجوم كيماوي جديد في سوريا.
هذه المواقف المتشددة لكبار المسؤولين السياسيين والامنيين الامريكيين تصدرت اخبار وسائل الاعلام العالمية حيث بدأت جميعها بالحديث عن عدوان امريكي جديد على مواقع الجيش السوري، وتذكرنا هذه المواقف بالعدوان الامريكي على العراق في عهد صدام الذي تم تحت ذريعة وجود اسلحة كيماوية ومن ثم تبين على لسان المسؤوليين الامريكين ان الاسلحة الكيماوية كانت مجرد ذريعة لاغير.
وفي المقابل، ردت ايران وروسيا بقوة على مواقف المسؤولين الامريكيين، حيث حذرت ايران على لسان امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني من تبعات المغامرات الامريكية وتجاهل مبادىء حقوق الانسان الدولية والسيادة الوطنية السورية، قائلا، دون شك ان تصرفات ومغامرات امريكا الحمقاء في سوريا دليل بارز على "اللعب بالنار"، والميدان السوري ومجرياته كفيل بإنهاء استمرار العدوان الأمريكي الأحادي على سوريا، وإنهاء الإفلات من تلقي الرد المقابل، وتغيير هذه المعادلة".
كما اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو سترد بشكل مناسب ومكافئ على الاستفزازات الأمريكية الممكنة ضد الجيش السوري.
والان يطرح السؤال التالي، في ظل الظروف الراهنة التي تسيطر فيها الحكومة السورية على الميدان في حربها ضد الارهاب، ما هي حاجتها لاستخدام هكذا اسلحة في الوقت الذي كان سيضرها فيه استخدام هذه الاسلحة وستتوفر الذريعة اللازمة للتدخل العسكري للقوى العظمى في سوريا؟
لذلك، ومن حيث المنطق ان الحكومة السورية ليست بحاجة الى استخدام هكذا اسلحة في ظل الظروف الراهنة، وفي المقابل، الارهابيون الذين يتلقون هزائم كبيرة في الميدان هم من بحاجة الى هكذا اجراءات وذلك لرفع معنوياتهم العسكرية، ومن جهة اخرى قامت الحكومة السورية في خطوة ذكية بإتلاف مخرونها الكيماوي الذي لديه جانب ردعي وذلك تحت اشراف الامم المتحدة من اجل سلب ذريعة الاعتداء عليها من الاعداء.
ويؤكد الكاتب الأميركي الشهير سيمور هيرش في مقالة له هذه المواقف، حيث كتب في مقالة نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، ان الاستخبارات الامريكية اكدت للرئيس ترامب انها لا تملك أي ادلة على ان الحكومة السورية تقف خلف الهجوم الكيماوي في "خان شيخون" قرب مدينة ادلب في نيسان (ابريل) الماضي.
واكد الكاتب هيرش نقلا عن مصادر عسكرية ان الرئيس ترامب اعطى اذنا بإطلاق 59 صاروخا على قاعدة "الشعيرات" العسكرية في حمص رغم هذه التحذيرات من اجهزة مخابراته، الامر الذي أصاب المسؤولين في المؤسسة العسكرية الامريكية بالاسى الشديد.
يرى بعض المحللين السياسيين ان التهديات الامريكية في العدوان على سوريا قبل ان تكون موجهة للحكومة السورية كانت موجهة للروس والهدف منها ممارسة ضغوط اقتصادية وعسكرية على روسيا للحصول على مكاسب ميدانية ومالية وهذا ما صرح به احد المسؤولين الروس، حيث أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات الاستفزازية الأمريكية عن تحضير دمشق لـ"هجمة كيميائية"، موجهة ليس فقط ضد سوريا، بل وضد روسيا أيضا.
كما يحكى عن ان امريكا تمارس الضغوط على روسيا من اجل اعادة تنشيط اتفاقها السابق حول التنسيق الجوي في سوريا، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت تعليق قناة الاتصال التي أقامتها مع البنتاغون لمنع حوادث اصطدام جوية في سوريا بعد اسقاط امريكا طائرة سو 22 تابعة للجيش السوري شرق سوريا.
بالتأكيد ان جدول اعمال أمريكا يختلف عن جدول اعمال ايران وروسيا وتركيا الذي يتابع مناطق تخفيض التوتر في سوريا، حيث يحاول البنتاغون عبر الغاء داعش ان يمهد الارضية لقوات سوريا الديمقراطية الكردية في الرقة، الامر الذي لاقى اعتراضا شديدا من قبل تركيا.
القضية واضحة جدا، ان الامريكان لم يكونوا ينوون منذ البداية القيام بهجوم عسكري واسع في سوريا، وفي حال وقوعه لكان محدودا وما تمكن من تغيير الوضع في الميدان، ذلك اضطروا بالاكتفاء بهذا القدر، حيث اعلنوا ان السوريين اخذوا التحذير الامريكي على محمل الجد واضطروا على الامتناع عن استخدام الكيماوي.
وتمكنت امريكا عبر تلك الوسيلة ان تظهر نفسها منتصرا في الميدان، حيث زعمت أولاً ان تهديداتها اجبرت الحكومة السورية على التراجع، وثانياً توجيه رسالة الى المجموعات المسلحة انها لاتزال ملتزمة بدعمهم من أجل مواصلة الحرب في سوريا الامر الذي يمكنه رفع معنويات المجموعات الارهابية عقب هزائمها المستمرة في ساحة الحرب، وثالثاً واخيراً ان امريكا تريد القول انها هي التي لاتزال صاحبة الكلمة الاولى في التطورات السورية وليس الدول الداعمة للحكومة السورية.
خصائص المجتمع النامي، خصائص المجتمع الإسلامي
خصائص المجتمع النامي، خصائص المجتمع الإسلامي
خصائص المجتمع الاسلامي
﴿ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطَۡٔهُۥ فََٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ..﴾1. يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة مثلًا للمسلمين الّذين يتّبعون التعاليم النبويّة الشريفة، وهذا المثل له علاقة وطيدة مع موضوع بحثنا.
يقول القرآن الكريم: إنّ هؤلاء المسلمين قد ذُكِروا في الإنجيل كالزرع الّذي يخرج ورقه بادىء ذي بدء، وهو لا شكّ رقيق ﴿ أَخۡرَجَ شَطَۡٔهُۥ ﴾، لكن لا يبقى هذا الورق على حاله، إذ كلّما انتشر في الأرض وأصبح له سويق، قوي وكانت له صفة أخرى أي يقوي الورقة الأولى الّتي بدأت في الظهور ﴿ فََٔازَرَهُۥ ﴾، بعد ذلك يقوى أكثر ويكون سميكًا ﴿ فَٱسۡتَغۡلَظَ ﴾ ثمّ ينتصب قائمًا على سويقه ﴿ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ ﴾، وحينما ينظر إليه الزرّاع يغمرهم العجب وينبهرون. وهذه هي نفسها حالة النمو والاستقلال والسموّ الّتي تغضب الأعداء وتكون شوكة في عيونهم، وحينما ينظر الكفّار إلى تلك الفئة المؤمنة فإنّهم يزدادون غيظًا.
ما هو هذا المثل المذكور؟ يجيبنا القرآن نفسه أنّ هويّة أصحاب هذا المثل، أنّهم ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا ﴾.
أرجو منكم أن تنتبهوا إلى هذا الموضوع في ضوء الآية الكريمة المذكورة، وهو أنّ العبادة لا تنفصل عن صميم الإسلام، وأنّ بعض الأشخاص ممّن اطّلع على الفكر الإسلاميّ قد سبّب لهم هذا الاطّلاع أن ينظروا إلى العبادة نظرة ازدراء وامتهان، ولكنّ هؤلاء على خطأ لأنّ العبادة جزءٌ لا يتجزّأ من الإسلام على الصعيد النظريّ والعمليّ في آنٍ واحد، فلا العبادة لها نكهتها دون الفكر والتعاليم الاجتماعيّة الإسلاميّة، ولا الفكر والتعاليم لهما طعمهما دون العبادة، فلا بدّ من اجتماع الاثنَيْن.
وقبل هذا يقول القرآن الكريم في وصف تلك الثّلة المؤمنة: ﴿ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ ﴾ أي أنّهم يريدون من الله الكثير، ولا يقنعون بما عندهم، بل يريدون أكثر علمًا أنّ ما يريدونه ليس من الأشياء الّتي يطلبها المادّيون الّذين يلهثون وراء المال والمادّيات فقط.
إنّ هؤلاء المؤمنين، في الوقت الّذي يطلبون فيه الكثير من الخير، فهم يقرنونه بمرضاة الله تعالى، أي يطلبون رضاه (جلّ شأنه) مقرونًا مع الخير الكثير، فطلبهم الكثير يصبّ في طريق الحقّ والحقيقة.
بعد ذلك يقول: ﴿ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ﴾، فالإسلام ظاهر على ملامح وجوههم، وآثار العبادة بارزة على محيّاهم، وليس المقصود من هذا كثرة السجود الّذي يؤدّي إلى ظهور ثفنات في جباههم، بل المقصود هو أنّ خصوصيّة العبادة تترك أثرًا على سيماء الإنسان العابد وتؤثّر في سلوكه. وهناك علاقة عظيمة بين روح الإنسان وجسده. وأفكار الإنسان، وأخلاقه، وآراؤه، وملكاته تترك بصماتها على محيّاه، فمحيّا الإنسان المصلّي ليس كمحيّا تارك الصلاة.
ما أعظمه من مثل ضربه الله تعالى للمسلمين الأوائل! إنّه مثل الوعي والتكامل، إنّه مثل المؤمنين الّذين يرتقون سلّم الرقي والتطوّر، ووجودهم شطر الكمال والتقدّم دومًا وأبدًا.
والمثل هو تشبيههم بالزرع الّذي تتفتح أوراقه، ثمّ يكون له سويق سميك ذو أوراق كثيرة، ويكون شجيريًا لا كسائر الشجيرات. إنّه الزرع الّذي يبهر الزرع أنفسهم بل ويبهر الذين لهم باع في التربية الإنسانيّة كافّة، إذ حينما ينظرون إليه يملأ العجب كلّ وجودهم من نموّ بهذه السرعة، وجودةٍ بهذه الدرجة، ويملأ العجب كيان سقراط وأمثاله. أجل، فإنّ من الأمور المحيّرة للبشريّة على الصعيد العالمي تلك السرعة الفائقة لنمو المسلمين واستقلالهم، والّذي يعبّر عنه القرآن الكريم بالآية: ﴿ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ ﴾، أي يقف وحده على أقدامه.
شخصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القياديّة
قال أحد الأوروبيّين: إنّنا لو أخذنا بعين الحسبان ثلاثة أشياء، فإنّنا سنعترف عندها أن لا وجود لشخص في العالم كمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قيادة فيه كقيادته. وهذه الأشياء هي:
أوّلًا: عظمة الهدف وأهميّته. نعم، لقد كان الهدف عظيمًا ومُهمًّا للغاية، إذ حدث انقلاب في الروح العامّة للناس ومعنويّاتهم وأخلاقهم وآرائهم ونظمهم وتقاليدهم الاجتماعيّة.
ثانيًا: ضآلة حجم الإمكانيّات والوسائل آنذاك. ماذا كان عنده من أدوات ووسائل؟ لقد كانت معه عشيرته الأقربون، فلم يكن لديه مال ولا قوّة، ولا مساند ولا ناصر. إنّها أعجوبة حقًّا أن يتمكّن شخص واحد من كسب الناس، وجعلهم يؤمنون به، ويلتفّون حوله، حتّى أصبح أكبر قوّة في العالم.
ثالثًا: سرعة الوصول إلى الهدف، إذ أصبح أكثر من نصف النّاس في العالم مسلمين خلال أقلّ من نصف قرن. عند ذلك يثبت ما ذكرناه من أنّه لا وجود لقيادة في العالم كقيادته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو قصد القرآن من قوله: ﴿ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ ﴾، إذ أنّ الأخصّائيّين والخبراء في التربية الإنسانيّة ينبهرون إلى الأبد بسرعة بظهور المسلمين ونموّهم واستقلالهم ونتاجاتهم. وهذا المثل قد ذكر في القرآن المجيد للأمّة الإسلاميّة.
خصائص الإسلام التنمويّة
أوّد أن أطرح هنا سؤالًا، وهو: هل إنّ هذه المواصفات الّتي ذكرها القرآن الكريم تخصُّ المسلمين الأوائل، وإنّهم يجب أن يتّصفوا بها؟ وهل إنها من خصوصيّاتهم بالذات أو خصوصيّات الإسلام نفسه؟ وبعبارة أخرى، إذا وجد أناسٌ في أيّ زمان ومكان كانوا، واعتنقوا الإسلام، وعملوا بأحكامه، فإنّهم سيحملون المواصفات المذكورة ذاتها من نمو، وتكاثر، وكمال، واستقلال، ونيل إعجاب الآخرين وانبهارهم. فالخصائص إذًا هي خصائص الإسلام وليست خصائص الناس، وهي نابعة من الإيمان بالإسلام واتّباع تعاليمه. وما جاء الإسلام ليعطّل طاقات المجتمع ويقف حائلًا دون تفتقها، أو يُرغم المسلمين ليعيشوا في دوّامة من المراوحة الرتيبة. كلا، إنّه دين التّنمية والتحرّك والنشاط، ودين برهن من الناحية العمليّة أنّه قادرٌ على الأخذ بيد المجتمع إلى الإمام حيث الرقيّ والتقدّم. ولاحظوا ماذا أحدث الإسلام من ثورة، وماذا قدّم من عطاء في القرون الأربعة الأولى من حياته!
يقول "ويل ديوارنت" في "تاريخ الحضارة": "لا حضارة تبعث على الانبهار كالحضارة الإسلامية". إذًا، الإسلام كشف عن خصوصيّاته على الصعيد العملي، ولو كان الإسلام من دعاة الجمود والانكماش والرتابة لظلّ يراوح في مكانه بين العرب! ولو لم تكن له حضارة لما تقدّم، ودعا إلى التطور والتقدّم، وما تلك الحضارة الباهرة الرائعة الّتي صنعها على مرّ التاريخ، وما تلك المعطيات الحضارية والثقافية ال!تي زخرت بها حضارته الأولى، إلّا دليل على أنّه لا يتعارض مع تطور الزمن وتقدّمه!
نظرة الغربيّين للإسلام السياسيّ
إنّ من الإنصاف القول إنّ "للغوستاف لوبون" دراسات متعدّدة حول التاريخ الإسلامي، وكتابه قيّم للغاية. ولكن يتطرّق أحيانًا إلى مواضيع تبعث على العجب والدهشة، ولا غرو فهذا هو ديدن الغربيّين وأسلوبهم. إنّه عندما يصل به المقام إلى الحديث عن أسباب انحطاط المسلمين وأفول الحضارة الإسلاميّة، يذكر - غباءً - تعارض الإسلام مع متطلّبات العصر كأحد الأسباب. وهذا هو فهمه كإنسان غريب عن الإسلام وحضارته، حيث ينظر إليه من زاويته الخاصّة فيقول: "إنّ الزمن في تطور، لكنّ المسلمين يريدون أن يبقى الإسلام في كلّ عصر على حالته التّي كان عليها في عصره الأول، وهذا أمر لا يمكن تحققه. وكذلك فهم بدل أن يتركوا الإسلام جانبًا، ويسايروا تطوّرات العصر، نراهم بقوا على تمسّكهم بالإسلام فانحطّوا وتخلّفوا".
في ضوء ما تقدّم، فكلّ شخص يرغب أن يتعرّف إلى المثال الذي يذكره هذا المستشرق الكبير لدعم مزاعمه! يا للعجب العجاب، فأيّ مبدأ من مبادئ الإسلام تمسّك به المسلمون فتخلّفوا ولم يواكبوا التطوّرات الحاصلة في كلّ عصر؟ وأيّ مبدأ في الإسلام وجده "غوستاف لوبون" لا يلائم متطلّبات العصر ومستلزماته؟ وأيّ شيء لمسه من المسلمين حتّى قال: إنّهم كشفوا عن جمودهم وتحجّرهم من خلال عدم مسايرتهم لتطوّرات العصر، والمفروض - على حدّ قوله - أن لا يتحجّروا ويكونوا ضيّقي الأفق، بل عليهم أن يواكبوا تلك التطوّرات ويكيّفوا أنفسهم معها؟.
ويستطرد قائلاً: "إنّ من المبادىء الإسلامية الرائعة المعطاءة مبدأ المساواة الّذي أتى أكله في عصر صدر الإسلام، ومهّد السبيل للشعوب الأخرى لتدخل في دين الله أفواجًا، ولا سيّما من غير العرب كالفرس الّذين اكتووا بنار ظلم حكّامهم وعلمائهم من المؤبدين. وهؤلاء عندما اطّلعوا على ذلك المبدأ العظيم انفتحوا على الإسلام واعتنقوه؛ لأنّهم لم يجدوا فيه تمييزًا عنصريًّا أو طبقيًّا، وراقت لهم تعاليمه الساميّة. لقد كان هذا المبدأ في بادئ الأمر يصبّ في خدمة المجتمع الإسلاميّ، وظلّ المسلمون الّذين جاؤوا فيما بعد على إصرارهم وتعنتهم في الاستمرار بتطبيق هذا المبدأ في العصور اللّاحقة في حين أنّهم لو نبذوه جانبًا لظلّت زمام الأمور بأيديهم، وكانت لهم السيادة والحاكميّة. وعندما تسلّم العرب مقاليد الأمور، ودخلت الشعوب الأخرى في الإسلام، كان عليهم أن يفضّلوا السياسة على الدّين، ويقدّموها عليه؛ لأنّ السياسة تقتضي ترك مثل هذه المفاهيم والمبادئ، واستغلال الشعوب الأخرى، وجرّها لتكون تحت نيرها وسلطتها حتّى تستطيع توطيد أركان حكومتها. هذه هي السياسة، أمّا هؤلاء فكانوا لا يفهمون، إذ تشبّثوا بمبدأ المساواة، ولم يفرّقوا بين العرب وغيرهم، وفتحوا الطريق أمام الأعاجم وكسبوهم إلى صفوفهم، وعيّنوهم قضاة من الدرجة الأولى بعدما هيّؤوا لهم الفرصة للتزوّد من التعاليم الإسلاميّة. وجاء هؤلاء بالتدريج، وأصبحوا في موضع قوّة وقدرة، فسحبوا البساط من تحت أرجلهم أي أرجل العرب. وأوّل من كان لهم قصب السبق في ذلك هم الفُرس الذين سيطروا على الوضع إبّان الحكم العباسي مثل البرامكة وآل سهل. وعيّنوا أقاربهم ومعارفهم في مناصب الدولة المختلفة بعدما عزلوا العرب عنها. كانت هذه الحوادث في أوائل القرن الثاني، ومرّت سنون كانت السيادة فيها للفرس، ولا سيّما في عصر المأمون إذ بلغت أوجها وذلك لأنّ أمه كانت فارسيّة حتّى يُنقل أنّ المأمون كان مارّاً ذات يوم في طريق، فاعترضه إعرابيٌّ قائلًا له: "اعتبرني واحدًا من الفرس وأغثني". وظلّت هذه الحالة حتّى عصر المعتصم حيث تغيّرت الأوضاع تمامًا، وانقلبت ضدّ الفرس والعرب في آن واحد بلحاظ أنّ أم المعتصم كانت تركيّة، لهذا تعامل المعتصم بقسوةٍ وفظاظة مع الاثنَيْن محافظة منه على منصبه، فكان سيِّئ المعاملة مع العرب لأنّه كان يعتبرهم من أنصار بني أميّة، وكانت سياسة هؤلاء عربيّة، وكانوا يفضّلون العرب على غيرهم. نعم، كان العرب من أنصار بني أميّة، وكان العباسيّون - على العموم - ضدّ العرب لأنّهم كانوا يعتبرونهم أنصار بني أميّة وحماتهم. وقد عمل العباسيّون على إحياء اللّغة الفارسيّة؛ لأنّهم كانوا لا يرغبون في تذويب الفرس بالعرب، وقد أصدر إبراهيم الإمام أوامره إلى مناطق إيران كافّة بقتل كلّ عربي (وقد ذكر هذه التعليمات جرجي زيدان وغيره من المؤرخين). نعم، وكان المعتصم ينظر إلى العرب على أنّهم أنصار الأمويّين، وإلى الفرس على أنّهم أنصار العباسيّين ومؤيّدو العبّاس نجل المأمون، لذلك سافر إلى "تركستان" فجلب أقارب أمّه من هناك، وفوّض لهم كثيرًا من أمور الدولة، وبهذا يكون قد أبعد الاثنَيْن: العرب والفرس، عن زمام الأمور، وقلّدوها قومًا آخرين وهم الأتراك".
هذا هو كلام "غوستاف لوبون"، وكلّ ما فيه هو لماذا أعرض العباسيّون عن اتّباع السياسة الأمويّة العربيّة مع أنّهم كانوا عربًا، ولا يدري هذا الرجل فقد غاب عن ذهنه أنّه رأى في فضيلة من فضائل الإسلام عيبًا ونقصًا فيه، ودليلًا على عدم انسجام الإسلام مع متطلّبات العصر، وشاهدًا على جمود المسلمين وتحجّرهم.
إنّه يقول: "إنّ هذا المبدأ جيّد من الناحية الأخلاقية، ولكنّه من الناحية السياسيّة قد يكون كذلك وقد لا يكون، وقد يكون مناسبًا لزمن معيّن، حيث يساعد على كسب الشعوب الأخرى للإسلام، ولكنّه قد لا يكون كذلك في زمن آخر، حيث ينبغي على المسلمين أي العرب في تلك الفترة أن يتخلوا عن مبدأ المساواة سياسيًّا؛ لأنّ الظروف لا تساعد على وجوده".
حقًّا، لقد وقع "غوستاف لوبون" في خطأ؛ لأن التوجه السياسي في الإسلام غير في أوروبا.
النظرة الصحيحة لمتطلّبات العصر
أولًا: لأنّ المسلمين لو اتّخذوا من الإسلام ألعوبة للسياسة، لما كان له هذا الأثر الّذي هو عليه، ولما كان المسلمون أمّة بهذا الشكل.
ثانيًا: إنّ هدف الإسلام هو إقرار المساواة بين النّاس بشكل تامّ، ولو شرّع الإسلام مبدأ نفعيًّا على النحو المؤقّت، أي: مثلًا، لكسب بعض الناس والاستفادة منهم، ثمّ بعد ذلك نقضه لما كان إسلامًا حقيقيًّا بمعنى الكلمة. ولا شكّ، فإنّ هذا هو دأب السياسة الأوروبيّة أنّها تسنّ مبدأ، ثمّ تنسفه من وحي الدوافع المصلحيّة. فمثلًا، تصدر وثيقة حقوق الإنسان لتنضوي بقيّة الشعوب تحت سلطتها وهيمنتها كما حدث ذلك، وإذا ما انضوت فإنّها تقول لها: كلّ هذا الكلام لا طائل تحته ولا قيمة له.
هذا هو أسلوب التفكير السائد عند هؤلاء. أنّهم يقولون: إنّ الإسلام فظٌّ غير مرن ولا ينسجم مع متطلّبات العصر، وبعبارة أخرى مع السياسة. ونحن نقول: إنّ الإسلام جاء لمحاربة أمثال هذه السياسة المنحرفة في العالم. إنّه لا يعتقد بمتطلّبات العصر الّتي يريدها هؤلاء، ولا يقرّ بها كمستلزمات حقيقيّة للتطوّر والتقدّم. إنّه يعتبرها انحرافات العصر لا متطلّباته، ويعلن محاربته لها ووقوفه ضدّها.
إنّ ما ذكره "غوستاف لوبون" وأمثاله هو نفس المؤاخذة الّتي تشدّق بها البعض ضدّ سياسة أمير المؤمنين عليه السلام، فقالوا عنه: "إنّ كل شيء فيه حسن، إذا كان رجل علم وعمل وتقوى وعاطفة وإنسانيّة وحكمة وخطابة، لكنّ عيبه الوحيد والكبير أنّه لم يكن سياسيًّا!". لماذا لم يكن سياسيًّا؟ لأنّه - على حدّ زعمهم - لم يكن مرنًا أي: كانت تعوزه المرونة، وكان متشدّداً للغاية حيث لم يهتمّ ولم يفكر بالمصالح السياسيّة للدولة. إنّ الشخص السياسي - برأي هؤلاء - ينبغي أن يكذب ويزوّر الحقائق، ويعد ولا يفي بوعوده، ويوقّع على ميثاق أو حلف، ثمّ ينقض توقيعه بل وينكره، ويظهر البشاشة والطلاقة بوجه شخص ما حتّى إذا استسلم له قتله. [هذا هو السياسيّ في عرف هؤلاء دون سواه، فما أجهل هؤلاء وما أغباهم! إنّ هؤلاء يرون أبا جعفر المنصور سياسيًّا لأنّه تحالف مع أبي مسلم الخراساني وفوّض إليه بعض الأمور، وأبو مسلم هذا نهض لصالح المنصور ولم يترك جريمة إلّا وارتكبها لصالح بني العباس]. علمًا أنّ بعض الإيرانيّين - ويا للأسف - يعبّرون عنه بالبطل الوطني. علينا أن نكون حذرين ونعرف أنفسنا حيث يردّدون دائمًا هذا اللقب. وما أدرى الإيرانيّين كم قتل أبو مسلم منهم؟ لقد قتل أكثر من ثلاثمئة أو أربعمئة ألف، وفي خبر آخر ستمائة ألف. فكم كان مجرمًا! وإلى أي حدّ يصل الإجرام بالإنسان؟ [لقد كان المنصور سياسيًّا - من وجهة نظر هؤلاء المتشدّقين - والسياسة الّتي يقصدونها تعني استعمال الخداع ومختلف الحيل، وتعني البطش والتنكيل، وتعني استغلال الآخرين لتحقيق مآربهم كما نرى المنصور قد استغلّ أبا مسلم للفتك بأعدائه، وقد نفّذ الأخير ما أُريد منه، وبمجرّد أن أراح الخليفة من خصومه ومناوئيه، برز نجمه وعلا كعبه تدريجيًّا حتّى أصبح يدًا للمنصور نفسه، فرأى فيه المنصور خطرًا على حكومته. ففي إحدى السنين، ذهب أبو مسلم إلى مكة على رأس جيش جرّار، وحينما عاد منها، ووصل مدينة الريّ استدعاه المنصور قائلًا له: "عندي معك شغلٌ". لكنّ أبا مسلم لم يذهب، وكتب له مرّة ثانية وثالثة فلم يذهب أيضًا وأخيراً كتب له رسالة هدّده فيها. فتردّد أبو مسلم بين الذهاب وعدمه، واستشار الكثيرين فأشاروا عليه بعدم الذهاب لوجود خطر عليه. ولكن، كما يقال أتتك بخائن رجلاه، فذهب وحده بناءً على أوامر المنصور نفسه، فدخل عليه وسلّم معظّمًا إيّاه، وبعد أن سأله المنصور عن أحواله، طفق يغيّر معه لهجته ويؤنّبه، طارحًا عليه بعض الأسئلة منها: لماذا لم تنجز العمل الفلانيّ؟ ولماذا عصيتني في الأمر الفلانيّ؟ وهكذا، ولمّا رأى أبو مسلم أنّه قد وقع في مأزق، وأنّ المنصور مصمّم على قتله، عرض عليه أن يعفو عنه ليقضي على أعدائه، أي أعداء المنصور، فقال له المنصور: "لا عدوّ لي هذا اليوم أشدّ منك". وكان المنصور قد وضع خلف الباب عددًا من جلاوزته مع أسلحتهم، وأوصاهم أنّه بمجرّد أن يعطيهم إشارة متّفق عليها يهجموا على أبي مسلم ويقتلوه. وبينما كان مشغولًا في تعنيفه وتقريعه، أعطى تلك الإشارة، فهجم الجلاوزة على أبي مسلم وقطّعوه إربًا إربًا، ثمّ لفّوه في خرقة. نعم، فإنّ المنصور - برأي هؤلاء - سياسيٌّ كبير، لأنّه يعرف كيف يقضي على مناوئيه.
أمّا الإمام عليّ عليه السلام فإنّهم ينتقدونه لأنّه لم يتعامل مع الأحداث كتعامل المنصور، مثلًا يقولون: لماذا لم يداهن الإمام معاوية؟ ولماذا لم يكتب له كتابًا يستغفله فيه؟ ولماذا لم يتركه على حاله؟ وما هو السبب الّذي دعاه أن لا يبقيه على السلطة ويخدعه بذلك، ثم يستدعيه إلى مركز الخلافة ويقتله وفق خطّة مدبّرة؟ لماذا لم يكذب في سياسته، ولم يفرّق بين أحد، ولم يرشِ أحدًا؟ ولماذا لم يعمل الإمام في بيت المال كما عمل معاوية؟، وأمثال ذلك من الأسئلة الّتي يثيرونها مدّعين أنّ نقض الإسلام يكمن في كونه متشدّدًا، ولا ينسجم مع متطلّبات العصر. وإذا ما أراد السياسيّ أن يعمل وفق الإسلام فلا يمكنه أن يكون سياسيًا عندئذٍ.
وكما ذكرنا، فإنّ الإسلام ما جاء إلّا ليكافح هذا اللون من السياسة، ويعمل كلّ ما في وسعه لخدمة البشريّة وإسعادها، وهو - بلا شكّ - الحارس الأمين لها، ولو كان قد أبدى شيئًا من المرونة والتنازل، فلا يعدو أن يكون إسلامًا، بل حيلة ومكرًا. إنّ الإسلام هو الحافظ الصحيح للأمور، وهو الحقيقة ذاتها، والعدالة نفسها. وأساسًا، فإنّ فلسفته في مثل تلك المواقف المذكورة ينبغي أن تكون قويّة متصلّبة.
إنّ سياسة علي عليه السلام هي الّتي جعلت منه حاكمًا على قلوب الناس قرونًا عديدة. إنّه دافع عن أفكاره في عصره، وظلّت أفكاره بمثابة مبادئ ثابتة ودروس ذات مغزى في العالم، لهذا فإنّ منهجه صار عقيدة وإيمانًا بين الناس، فلم يخسر في سياسته إذًا، ولو كانت سياسته وهدفه أن يستعذب متاع أيّام قلائل (كما كان معاوية الّذي كان يصرّح بأنه غرق في نعم الدنيا ومباهجها)، لقلنا أنّه خسر، لكن بما أنّه كان رجل إيمان وعقيدة وهدف فلم يندحر ولم يخسر أبدًا. إذًا، من التوقّعات الخاطئة الّتي ينتظرها هؤلاء فيما يخصّ الانسجام مع متطلّبات العصر، هي أن يتلّون السياسيّون بلون كلّ عصر، ويتّصفوا بالدّهاء والمكر والخديعة؛ كالثعلب الماكر، مطلقين على ذلك اسم المرونة والذكاء والانسجام مع الزمان. ويتوقّعون من الإسلام أن يكون كذلك، وأن يسمح لمعتنقيه بأن يكيّفوا أنفسهم مع الزمن، مدّعين أنّ نقص الإسلام يكمن في عدم مرونته وانفتاحه على التطوّرات الحاصلة في كل عصر. وقد غاب عنهم أنّ من دواعي فخر الإسلام واعتزازه أنّه وقف بكلّ صلابة، أمّا هذه الأباطيل ولنا أن نسأل هؤلاء: أين تكمن عظمة الحسين عليه السلام؟ هذا الإمام الّذي أخذ بمجامع القلوب، وخلّدته الدهور. إنّها تكمن في أنّه لم يكن متلوّنًا انتهازيًّا، ولم يكن ماكرًا مخادعًا، بل كان صادقًا نزيهًا عفيفًا في توجّهاته وممارساته، ولم يتأثّر بظروف عصره، كما لم ينتحل نحلة حكّام عصره، فلم يكن أمويًّا، مثلًا عندما حكم معاوية أو ولده يزيد، وهذه قمّة النزاهة والصدق، ولمَ لا يكون ذلك؟ وهو لم يألف الوصوليّة والنفعيّة والانتهازيّة أساليب للانسجام مع كلّ عصر! ولذلك عندما عرض عليه الوزغ الدنيء مروان أن يبايع يزيد، لم يفكّر بمصلحته الشخصيّة بل فكّر بمصلحة دينه ورسالته، وكانت لا تهمّه مصلحة أخرى غير هذه المصلحة، وذلك لأنّه الإمام الهادف المسؤول، ولذلك أجاب قائلًا: "على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمّة براعٍ مثل يزيد"2.
* الإسلام والحياة، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
حملة لدعوة المواطنین في مدينة "شيكاغو" الأمريكية لقراءة القرآن
أطلق المسلمون في مدينة "شيكاغو" الأمريكية حملة یطلبون خلالها من المواطنین أن یتعرفوا علی الدین الإسلامی من مصدره الرئیسي أي القرآن الکریم.
هذه الحملة التي تم إطلاقها تحت عنوان "أعرف الإسلام من مصدره" وتم خلالها رفع العدید من اللافتات في الشوارع وتخصیص أرقام إتصال یستطیع کل من یرغب في الحصول علی مصحف مترجم الی الإنجلیزیة أو الفرنسیة الإتصال بها.
وتستمر الحملة لـ 8 أسابیع وتهدف الی تعلیم الشعب الأمریکی حول التعالیم الرئیسیة للدین الإسلامی وحثّهم علی الحوار.
وقال المدیر التنفیذی لجماعة "مشروع إنشاء السلام" الإسلامیة وهي الجهة المنظمة للحملة "سبیل أحمد" ان الهجمات الأخیرة تستهدف مسلمي شیکاغو ومسلمي جمیع أنحاء أمریکا.
وأضاف أن الإسلاموفوبیا مصدره الجهل بالإسلام أو أخذ المعلومة من المصادر الغیر موثوق بها.
وأکد أحمد اننا من خلال هذه الحملة نرید أن نعطي الفرصة للمواطن الأمریکی لیتعرف علی التعالیم الحقیقیة للدین الإسلامی من خلال مصدره الرئیسي وهو القرآن الکریم.
الحسد
عن الإمام الصادق عليه السلام: "أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد"1.
إنّ الكفر بالله تعالى ودينه لا ينطلق دائماً من خلفيّة فكريّة، بل قد يكون منطلقُهُ آفّةٌ نفسيَّةٌ قد تُغطَّى بثوب آخر، ومن تلك الآفات النفسيّة الباعثة على الكفر: الحسد، الذي حذّر الله تعالى منه، ودعا إلى الاستعاذة بالله لتجنّبه فقال عزّ وجلّ: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾2.
تعريف الحسد
الحسد هو حالة نفسيّة يتمنّى بها الحاسد زوال النعمة التي يتصوّرها عند الآخرين، ويكره وصول تلك النعمة إليهم، فيصيبه غمٌّ إنْ وصلت3. فقد ينظر التلميذ إلى رفيقه في الصفّ فيجده مجدًّا في درسه، متفوِّقاً في مدرسته، بخلاف حالته، فيغتمّ لذلك، ويحسده على ما يرى فيه من نِعَمٍ، فيتمنّى له زوال الهمَّة والرسوب في الامتحانات.
وقد يُصاب الإنسان بهذا الغمّ، وتنطلق من نفسه تلك الأمنية السيّئة حينما يرى الآخر صاحب مال، أو ذا جاه، أو مشهوراً، أو عالماً، أو مرزوقاً بأولاد كثر، فيتمنى زوال هذه الأمور، لا سيّما حينما يقارن ما يراه بحالته الخاصّة التي لم تتلقَّ تلك النعم المتصوَّرة.
وقد قيَّدتُ النعم بــ "المتصوَّرة"، لأنّها في الحقيقة قد لا تكون نعماً حقيقيّة، بل قد تكون نقماً بصورة نِعم، فالمال والجاه والشهرة ونحوها قد تكون نعماً حينما يستثمرها الإنسان في مسيرة كماله، وقد تكون نقماً لكونها أسباباً لانحرافه عن كماله، وهذا ما أرشد إليه الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "إنّ الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة، ويذكّره الاستغفار، وإذا أراد بعبد شراً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة، لينسيه الاستغفار"4.
وليس المقصود هنا التدخّل الإلهي الأوّلي ليبعد الإنسان عن الاستغفار، بل المراد أنّ الإنسان يصل في انحطاطه وبُعده عن الله إلى درجة ينسى الله فيها لتكون عاقبته نسيان اللجوء والعودة إلى الله تعالى.
الحسد والغبطة
هناك حالة نفسيّة إيجابيّة قد يخلط البعض بينها وبين الحسد، وتكون حينما يتمنّى الإنسان أن ينعم الله عليه بما أنعم على غيره، دون أن يتمنّى زوال تلك النعم عن صاحبها، وهذا يُسمّى بــ "الغبطة" التي لم يُنه عنها في الدين، بل ورد في الحديث: "انّ المؤمن يغبط ولا يحسد"5.
الحسد من منظار شرعيّ
اتّفق العلماء على السلبيّة الكبيرة الكامنة في آفة الحسد، كما اتّفقوا على ما تؤدّي إليه من حرام حينما يفعِّل الحاسد حسده من خلال العمل، كمن يحسد رفيقه في الوظيفة فيتآمر عليه ليزيله من موقعه.
أمّا حينما تكون هذه الآفة في النفس فقط من دون أن يتظاهر بها ويفعّله في عمله، فقد تعدَّدت وجهات نظر الفقهاء إليها بين عدم حرمتها، وحرمتها وكذلك في درجة حرمتها، فالشهيد الثاني اعتبرها معصية كبيرة، واعتبرها المحقق الحلي معصية صغيرة، بينما اعتبر بعض الفقهاء ان الحاسد اذا التفت إلى لوازم الحسد كالسخط على الله فهو معصية فوق الكبيرة، وان لم يتظاهر فهو كالمنافق6.
الحسد مواكب لمسار المخلوق المختار
تحدّثت النصوص الدينيّة عن قدم آفة الحسد مع وجود المخلوق المختار:
- ففي بداية خلق آدم حسده إبليس واستكبر عليه، فعصى الله لأجل ذلك، وقد عبَّر عن حسده بقوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾7.
- وفي العائلة البشرية الأولى بعد آدم وحواء، حسد قابيل ابن آدم أخاه هابيل، بسبب تقديم الله له في موقع الولاية، ممّا أدّى به إلى قتل أخيه ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ * فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾8.
- وهكذا استمرّ الحسد بين الأمم اللاحقة إلى أن جاء رسول الإسلام ليحذِّر أمَّته من هذه الآفة بقوله: "ألا إنّه قد دبَّ إليكم داء الأمم من قبلكم وهو الحسد، ليس بحالق الشعر، لكنه حالق الدين"9.
لماذا الحسد من أصول الكفر؟
تقدّم الكلام الخطير عن الحسد بأنّه من أصول الكفر، ولعلَّ السبب في كونه كذلك ما أشار إليه حديث قدسيٌّ يقول الله تعالى فيه: "إنّ الحسود يشيح بوجهه عمَّا قسمته بين العباد، وهو ساخط على نعمي"10.
إذاً الحسد هو حالة تعبِّر عن الاعتراض على عدالة الله تعالى، فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "قال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران عليه السلام: يا ابن عمران، لا تحسدنّ الناس على ما آتيتهم من ضلي، ولا تمدَّنّ عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإنّ الحاسد ساخط لنعمي صادّ لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني"11.
على هذا الأساس وردت أحاديث عديدة حول التضاد بين الحسد والدين أو الإيمان وما ينتج عنهما من طاعات، كالحديث النبوي الشريف: "لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب امرئ"12، والحديث النبويّ السابق. "..لكنه حالق الدين"، وكذا ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب"13.
وما يُؤكِّد هذا التضادّ بينهما هو أنّ آفة الحسد هي من أمّهات الرذائل، فبسببها قد يقع الإنسان في الكذب والغيبة والنميمة والخداع، والإضرار بالآخرين، لذا حذَّر الله تعالى عن هذا التفعيل السلبي للحسد القلبي بقوله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾14.
علاج الحسد
يمكن مقاربة علاج الحسد من خلال الأمور الآتية:
١- تعميق الاعتقاد بعدالة الله تعالى في قسمة نعمه بين عباده، وبحكمته تعالى في العطاء والمنع بين خلقه، وأنّ التفاوت بين الناس، منه ما يكون منطلِقاً من الفعل التكويني لله تعالى بحسب مصلحة الكمال الإنساني فرداً ومجتمعاً، ومنه ما يكون من فعل الله من خلال الإرادة الاختياريّة للإنسان التي بها يتكامل الإنسان ليصل إلى مرتبة قد تفوق الملائكة، وعليه، فلا بدّ للإنسان أن يسعى لتحصيل كمالاته دون تقصير، فإن فعل ذلك، فإنّ ما وصل إليه هو بإرادة الله التي لا بدّ أن تنصبّ في مصلحته، فلا ينزعج ممّا يرى من تفاوت بينه وبين غيره.
وما يعزِّز هذا الأمر أن ينظر إلى من لم ينعم الله عليهم بتلك النعم التي أنعمها عليه، فإن كان بصيراً فلينظر إلى الضرير، وإن كان سليم الجسد، فلينظر إلى المُعاق، وإن كان حسن الاعتقاد، فلينظر إلى المنحرف عن الدين، وهكذا..
٢- التأمّل في مضارّ الحسد وآثاره السلبيّة التي منها:
أ- شقاء الحاسد، فإنّ الأثر السلبي الأول للحسد يطال الحاسد نفسه، إذ يُشعره الحسدُ بالغمّ، ويبعده عن اللذة والراحة، وهذا ما أشار إليه الإمام علي عليه السلام في العديد من الأحاديث منها:
- "أقلّ الناس لذّة الحسود"15.
- "لا راحة لحسود"16.
- "الحسود مغموم"17.
ب- آثاره التي قد تؤدّي إلى هدم البنيان الاجتماعيّ، والإضرار بالآخرين بما يطال الحاسد في ذلك، والعبرة بما تقدَّم في قصة إبليس وقابيل، وما جرى على البشريّة بسبب تلك الآفة.
ج- عاقبة الحاسد في الآخرة، فعن الإمام الصادق عليه السلام "والله لو قدَّم أحدكم ملء الأرض ذهباً على الله، ثمّ حسد مؤمناً لكان ذلك الذهب مما يكوى به في النار"18.
3- الالتجاء إلى الله تعالى في رفع الحسد.
4- أن يعمل الحاسد في علاقته مع المحسود خلاف هواه، بأن يظهر له المحبَّة والاحترام، ويذكره في المجالس بمحاسنه.
5- أن يستحضر ثواب الإنسان الذي جنّب نفسه من الحسد، فقد روي أنّ كليم الله موسى رأى رجلاً عند العرش فغبطه، وقال: "يا ربّ، بمَ نال هذا ما هو فيه من صنعه تحت ظلال عرشك، فقال: انّه لم يكن يحسد الناس"19.
استكمال الكمال لرفع الحسد
بما أنّ الحسد آفة تمثّل عاقبة في مسار التكامل الإنساني الذي يريده والله تعالى للمجتمع البشريّ، فإنّ على المؤمن أن يساعد الآخرين في دفع الحسد عنهم ورفعه، ولعلّ من أبرز المواقع التي عليه أن يدفع ويرفع الحسد فيه هو في مقام التربية للأولاد، فلا يقوم بتصرّف مع بعض أولاد بما قد يحرِّك حسد الآخرين نحو بعضهم البعض وكذا بالنسبة إلى زملائه في مقاعد الدراسة، ومكاتب العمل، ومراكز المسؤولية.
فرحم الله من أعان غيره على طاعة الله والبعد عن معصيته.
* لا تقربوا، سماحة الشيخ أكرم بركات، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- الكليني، محمد، الكافي، ج٢، ص ٢٨٩.
2- سورة الفلق، الآية ٥.
3- أنظر: المرتضى، عليّ، رسائل المرتضى، تحقيق أحمد الحسينيّ ومهدي الرجائيّ، لا،ط-، قم، دار القرآن الكريم، ١٤٠٥هـ، ج٢، ص٢٦٩.
4- الكليني، محمد، الكافي، ج٢، ص ٤٥٢.
5- المصدر نفسه، ج٢، ص ٣٠٧.
6- انظر: الكلبيكاني، محمد، كتاب الشهادات، ط١، قم، سيد الشهداء، ١٤٠٥هـ، ص١٢٣.
7- سورة الأعراف، الآية ١٢.
8- سورة المائدة، الآيات ٢٧ - ٣٠.
9- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج٧٠، ص ٢٥٣.
10- نقله الإمام الخميني في كتابه الأربعون حديثاً، ص١١٤.
11- الكليني، محمد، الكافي، ج٢، ص ٣٠٧.
12- الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل، ج١٢، ص ١٨.
13- الكليني، محمد، الكافي، ج٨، ص ٤٥.
14- سورة الفلق، الآية ٥.
15- الصدوق، محمد، الأمالي، ص٧٣.
16- المالكي، علي، الفصول المهمة في معرفة الأئمة، تحقيق سامي العزيري، ط١، قم، دار الحديث، ١٤٢٢هـ، ج٢، ص١١٨٩.
17- الواسطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، ص١٩.
18- الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل، ج١٢، ص ١٩.
19- الديلمي، الحسن، إرشاد القلوب، ط٢، قم، انتشارات الشريف الرضي، ١٤١٥هـ، ج١، ص١٣٠.
الإسلام والعلم
الإسلام والعلم1
هيكليّة البحث حول الإسلام والعلم
موضوعنا هو الإسلام والعلم. وبعبارة أُخرى، هو البحث في نظرة الإسلام إلى العلم. كما كان بحثنا السّابق يدور حول نظرة الإسلام إلى الدنيا والحياة والنزعات الطبيعيّة. فهل الدّين والعلم يتّفقان أم يختلفان، كيف ينظر الدّين إلى العلم؟ كيف ينظر العلم إلى الدّين؟ إنّه لبحث طويل كُتبت فيه كتب قيّمة عديدة.
هناك طبقتان من النّاس تسعيان إلى إظهار أنّ الدّين والعلم متخالفان:
الأولى: هي الطّبقة المتظاهرة بالتديّن ولكنّها تتميّز بالجهل، تعيش على الجهل المتفشّي في الناس وتستفيد منه. إنّ هذه الطبقة، لكي تُبقي الناس في الجهالة، وتسدل باسم الدّين ستارًا على مثالبها هي، وتُحارب بسلاح الدّين العلماء لتُخرّجهم من ميدان المنافسة، كانت تُخيف النّاس من العلم بحجّة أنّه يتنافى مع الدّين.
الثانية: هي الطبقة المثقّفة المتعلّمة، ولكنّها ضربت بالمبادىء الإنسانيّة والأخلاقيّة عرض الحائط. ولكي تُبرِّر هذه الطبقة لامبالاتها وأعمالها المنكرة، تتذرّع بالعلم، وتدّعي أنّه لا يأتلف مع الدّين.
وهنالك طبعًا الطّبقة الثالثة - وهي دائمًا موجودة - لها حظٌّ من كلٍّ من العلم والدّين، ولم يُخالجها قطّ إحساس بأيّ تناقض أو تنافٍ بينهما، ولقد سعت هذه الطّبقة إلى إزالة الظّلم والغبار الّذي أثارته الطّبقتان المذكورتان لدقّ إسفين بين هذَيْن الناموسَيْن المقدّسَيْن.
إنّ بحثنا في الإسلام والدّين يُمكن أن يجري من جانبَيْن اثنَيْن؛ الجانب الاجتماعي، والجانب الدِّيني. فمن حيث الجانب الاجتماعي، يتوجّب علينا أن نبحث فيما إذا كان العلم والدّين ينسجمان معًا أو لا ينسجمان. هل يستطيع النّاس أن يكونوا مسلمين بالمعنى الحقيقيّ؛ أي أن يؤمنوا بأُصول الإسلام ومبادئه، ويعملوا وفق تعاليمه، وأن يكونوا علماء في الوقت نفسه؟ أم هل عليهم أن يختاروا واحدًا منهما؟ فإذا بُحِث الأمر على هذا النحو، أفلا نكون متسائلين عن رأي الإسلام في العلم، وعن رأي العلم في الإسلام؟ وكيف هو الإسلام كدين؟ هل يستطيع اجتماعيًّا احتواء الاثنَيْن؟ أم أنّه يجب أن يتغاضى عن أحدهما؟
الجانب الآخر هو أن نتعرّف إلى نظرة الإسلام إلى العلم، ونظرة العلم إلى الإسلام. وهذا، بالبداهة، ينقسم إلى قسمَيْن: الأوّل هو معرفة وصايا الإسلام وتعاليمه بشأن العلم. هل يقول إنّ علينا أن نتجنّب العلم جهد طاقتنا؟ وهل يرى في العلم خطرًا ومنافسًا له في وجوده؟ أم أنّه على العكس من ذلك، يُرحّب بالعلم بكلّ اطمئنان وشجاعة، ويوصي به ويحثّ عليه؟ ثمّ علينا أن نعرف رأي العلم في الإسلام. لقد مضى على ظهور الإسلام ونزول القرآن أربعة عشر قرنًا، وخلال هذه القرون الأربعة عشر كان العلم يتطوّر ويتقدّم ويتكامل، وعلى الأخصّ في القرون الأربعة الأخيرة، إذ كان تقدُّم العلم بصورة قفزات واسعة. والآن، فلنرَ هذا العلم بعد كلّ تطوّره ونجاحه، واضطراد تكامله، ما رأيه في العقائد والمعارف الإسلاميّة، وفي تعاليم الإسلام الاجتماعيّة والأخلاقيّة العمليّة؟ تُرى هل يعترف بهذه أم لا يعترف؟ وهل رفع من شأنها أم أنزله؟
إنّ كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة سيكون موضوع بحث، إلّا أنّ بحثنا هذا سيتناول قسمًا واحدًا منها، وهو ما يتعلّق بنظرة الإسلام إلى العلم.
الإسلام يوصي بالعلم
ليس هناك أدنى شكٍّ في كون الإسلام يؤكّد على العلم ويوصي به، بحيث إنّنا قد لا نجد موضوعًا أوصى به الإسلام وأكّده أكثر من طلب العلم.
في أقدم الكتب الإسلاميّة المدوّنة نجد أنّ الحثّ على طلب العلم يأتي كفريضة، مثل الفرائض الأُخرى؛ كالصلاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثمّ إضافة إلى الآيات القرآنيّة الكريمة، نجد أنّ أهمّ وصيّة يوصي بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسم في سبيل العلم هو الخبر الثابتة صحّته لدى جميع المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسم: "طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم"2. فطلب العلم واجب على جميع المسلمين، ولا يختصّ بطبقة دون أُخرى، ولا بجنس دون آخر. كلّ من كان مسلمًا يتوجّب عليه أن يواصل طلب العلم.
وقال صلى الله عليه وآله وسم أيضًا: "اطلُبوا العِلم ولَو بالصِّين"3، أي إنّ العلم لا يختصّ بمكان معيّن، فحيثما يوجد علم عليك بالسّفر لطلبه.
وقال صلى الله عليه وآله وسم أيضًا: "كَلِمة الحِكْمة ضالّةُ المؤمن فحيث وجدَها فهو أحقُّ بها"4، أي إنّ المؤمن لا يهتمّ بمن يتلقّى عنه العلم، أهو مسلم أم كافر، كمثل الّذي يجد ماله المفقود عند أحدهم، فلا يسأل عمَّن يكون، بل يأخذ منه ماله دون تردُّد. كذلك المؤمن، فهو يعتبر العلم ملكه، فيأخذه حيثما وجده، والإمام علي عليه السلام يوضح هذا الأمر بقوله: "الحِكمةُ ضالَّة المؤمن فاطلُبوها ولو عندَ المُشركِ تكونوا أحقّ بها وأهلَهَا"5.
فطلب العلم فريضة لا يقف في وجهه متعلِّم ولا معلِّم، ولا زمان ولا مكان أبدًا. وهذه أرفع توصية يُمكن أن يوصي بها وأسماها.
ما العلم الّذي يقصده الإسلام؟
إنّ هنالك كلمة لا بدّ أن تُقال وهي: ما العلم الّذي يقصده الإسلام؟ فقد يقول قائل إنّ المقصود من كلّ هذا الكلام عن العلم هو علم الدّين نفسه، أي إنّ الناس مطلوب منهم أن يطلبوا معرفة دينهم. فإذا كان العلم عند الإسلام هو علم الدّين، فإنّه يكون قد أوصى بنفسه، ولم يقل شيئًا عن العلم الّذي هو الاطّلاع على حقائق الكائنات ومعرفة أُمور العالم، وبذلك تبقى المشكلة كما هي، وذلك لأنّ أيّ مذهب من المذاهب، مهما يكن عداؤه للعلم والمعرفة، ويقف معارضًا كلّ اطّلاع وتقدّم فكريّ، فإنّه لا يُمكن أن يُخالف الاطّلاع على ذاته، بل يقول: تعرّفوا إليّ ولا تتعرّفوا إلى غيري. وعليه، إذا كان مقصد الإسلام بالعلم هو العلم بالدّين فحسب، عندئذٍ يكون توجّه الإسلام نحو العلم صفرًا، وتكون نظرته إلى العلم سلبيّة. كما توجد لدينا قرائن عدّة تدلّ جميعها على أنّ نظرة الإسلام لا تنحصر بالعلوم الدينيّة. وهذه القرائن هي:
نظرة الإسلام للعلم
إنّ العارف بالإسلام ومنطقه لا يُمكن أن يقول إنّ نظرة الإسلام إلى العلم تنحصر بالعلوم الدينيّة فقط. إنّ هذا الاحتمال قد ينسجم مع أسلوب عمل المسلمين في القرون المتأخّرة، فقد ضيّقوا من دائرة العلم والمعرفة وحدَّدوها. وإلّا فإنّ قوله: "العلم ضالّة المؤمن"6، عليه أن يأخذه حيثما وجده ولو عند المشرك، يُصبح لا معنى له إذا كان المقصود بالعلم هو الدّين. فأيّ دين هذا الّذي يأخذه المؤمن من المشرك؟ وكذلك الحديث "اطلبوا العلم ولو بالصين"7، فقد جيء بالصين بحسبان أنّها أبعد مكان معروف في العالم يومئذٍ، أو أنّها كانت معروفة بأنّها مركز من مراكز العلم والصناعة في العالم، ولكنّ الصين لم تكن قديمًا ولا حديثًا مركزًا من مراكز العلوم الدينيّة.
بصرف النظر عن كلّ هذه، فإنّ أحاديث الرسول الكريم تُحدِّد المقصود بالعلم وتُفسِّره، ولكن ليس بالتخصيص والنصّ على العلم الفلانيّ والفلانيّ، وإنّما بعنوان العلم النافع، العلم الّذي تنفع معرفته وعدم المعرفة به تضرّ. فكلّ علم يتضمّن فائدة وأثرًا يقبل بهما الإسلام، ويعدّهما مفيدَيْن ونافعَيْن، يكون ذلك العلم مقبولًا عند الإسلام ويكون طلبه فريضة.
إذًا، ليس من الصعب أن نتحقّق من الأمر. يتوجّب علينا أن نرى ما الّذي يراه الإسلام نفعًا، وما الّذي يراه ضررًا. إنّ كلّ علم يؤيّد منظورًا فرديًّا أو اجتماعيًّا إسلاميًّا، وعدم الأخذ به يُسبّب انكسار ذلك المنظور، فذلك علم يوصي به الإسلام. وكلّ علم لا يؤثّر في المنظورات الإسلاميّة، لا يكون للإسلام نظر خاصّ فيه. وكلّ علم يؤثّر تأثيرًا سيّئًا، يُخالفه الإسلام.
سيرة المسلمين
إنّنا من الشيعة، ونعترف بأنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسم، وأنّ سيرهم وأقوالهم سنّة لنا.
ومن المعلوم أنّ المسلمين في أواخر القرن الأوّل وأوائل القرن الثّاني الهجري قد تعرّفوا إلى علوم الدّنيا عن طريق ترجمتها عن اليونانيّة والهنديّة والفارسيّة، ونعلم من ناحية أُخرى، أنّ الأئمّة لم يتوانوا في توجيه النقد إلى أفعال الخلفاء، إذ إنّ كتبنا مليئة بهذه الانتقادات. فلو كانت نظرة الإسلام إلى العلوم نظرة سلبيّة معارضة، ولو كان الإسلام يرى في العلوم وسائل لتخريب الدّين وهدمه، لما توانى الأئمّة الأطهار في انتقاد عمل الخلفاء الّذين أوصوا بترجمة تلك العلوم، وأنشؤوا لذلك الدواوين وعيّنوا المترجمين والناقلين والناسخين؛ لترجمة أنواع الكتب في الفلك، والمنطق، والفلسفة، والطب، والحيوان، والأدب والتاريخ. لقد سبق لهم أن انتقدوا كثيرًا أعمال الخلفاء، فلو لم يرتضوا عملهم هذا لكان أجدر بالانتقاد لأنّه أعظم تأثيرًا وأبعد أثرًا، ولقالوا: "حسبنا كتاب الله"، ولكنّ شيئًا من هذا لم يحدث، ولم نعثر طوال المئة والستين سنة الّتي مضت على ذلك على أيّ أثر لانتقاده.
منطق القرآن الكريم
إنّ منطق القرآن بشأن العلم منطقٌ عامّ لا تخصيص فيه، فالقرآن يصف العلم بأنّه نور، والجهل بأنّه ظلام، وهو يرى النّور خيرًا من الظلام.
ولكنّ القرآن يطرح عددًا من المواضيع، ويطلب صراحة من الناس التأمُّل فيها. وما هذه المواضيع سوى تلك العلوم الّتي نُطلق عليها اليوم أسماء العلوم الطبيعيّة، والرياضيّة، والحياتيّة، والتاريخيّة وغيرها. فالآية تقول: ﴿ إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِوَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ﴾8، أي إنّ لكلّ من هذه الظواهر قوانين وأنظمة تُقرّبكم معرفتها من وحدانيّة الله.
فالقرآن يوصي النّاس صراحة بدراسة هذه الأمور؛ لأنّ دراستها تؤدّي إلى دراسة الفلك والنجوم، الأرض والبحار، والكائنات الجويّة، والحيوان وغيرها. وهذا واضح في الآية الثانية من سورة الجاثية، والآية 25 من سورة فاطر، وآيات أُخر.
إنّ القرآن كتاب بدأ أول نزوله بالكلام على "القراءة" و"العلم" و"الكتابة"، فكان مبدأ وحيه توجيه إلى هذه الأمور: ﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ * ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ * ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ﴾9.
التوحيد والعلم
الإسلام دين يبدأ بالتّوحيد، والتّوحيد قضيّة عقلانيّة لا يجوز فيها التقليد والتسليم التعبّدي، بل لا بدّ فيه من التعقّل والاستدلال والتفلسف.
ولو كان الإسلام قد ابتدأ بالثنائيّة أو التثليث لما استطاع إطلاق الحرّية في هذا البحث، وما كان له إلّا أن يُعلن عنه بوصفها منطقة محرّمة ممنوعة. ولكنّه إذ بدأ بالتوحيد، فقد أعلنه منطقة مفتوحة، بل واجبه الارتياد، ومدخل المنطقة، في نظر القرآن، هو الكائنات برمّتها، وبطاقة الدخول هي العلم والتعلّم، ووسيلة التنقّل في هذه المنطقة هي قوّة الفكر والاستدلال المنطقي. هذه هي المواضيع الّتي يوصي القرآن بدراستها. أمّا كون المسلمين لم يولوها اهتمامًا بقدر اهتمامهم بمواضيع أُخرى لم يوص القرآن بها، فذلك أمر آخر، وله أسبابه الّتي لا مجال هنا لبحثها.
خلاصة ونتيجة
كلّ هذه قرائن تدلّ جميعها على أنّ نظرة الإسلام لا تنحصر بالعلوم الدينيّة. لقد دار نقاش طويل قديمًا حول ما يقصده الإسلام بالعلم الّذي يرى التزوّد به واجبًا وفريضة. وراحت كلّ مجموعة تُحاول تطبيق ذلك على ذلك الفرع من العلوم الّذي تُمثّله هي. فكان علماء الكلام يقولون: إنّ المقصود هو علم الكلام، وقال المفسّرون: إنّه يقصد علم التفسير، والمحدّثون قالوا: إنّه علم الحديث. وقال الفقهاء: إنّه الفقه، وأنّ على كلّ امرىء إمّا أن يكون فقيهًا أو مقلّدًا لفقيه. وقال الأخلاقيّون: إنّه علم الأخلاق والاطّلاع على المنجيات والمهلكات. وقال الصوفيّون: المقصود هو علم السَّير والسلوك والتوحيد العملي. وينقل الغزالي في هذا الشأن عشرين قولًا غير أنّ المحقّقين يقولون: إنّ المقصود ليس أيًّا من هذه العلوم على وجه التخصيص، إذ لو كان المقصود علمًا معيّنًا لذكره رسول الله وعيّنه بالاسم، إنّما المقصود هو كلّ علم نافع يُفيد الناس.
هل العلم وسيلة أم غاية؟
إنّ الالتفات إلى نقطة معيّنة تحلّ لنا المسألة؛ بحيث نستطيع أن نُدرك منظور الإسلام، وذلك بمعرفة ما إذا كان الإسلام ينظر إلى العلم كهدف أو كوسيلة.
لا شكّ أنّ بعض العلوم هدف بذاته؛ كالمعارف الربوبية، ومعرفة الله وما يتعلّق بذلك؛ كمعرفة النفس والمعاد. فإذا تجاوزنا هذه، تكون العلوم الأُخرى وسائل لا أهدافًا. أي إنّ ضرورة علم ما وفائدته لا تتحدّد بمقدار أهمّيته كوسيلة لتحقيق عمل أو وظيفة، فكلّ العلوم الدينيّة باستثناء المعارف الإلهيّة؛ كعلم الأخلاق، والفقه والحديث، تدخل في ذلك المعنى، أي إنّها كلّها وسائل، وليست أهدافًا، ناهيك عن العلوم الأدبيّة والمنطق الّتي تُدَرَّس في المدارس الدينيّة كمقدّمات.
ولهذا يرى الفقهاء في اصطلاحهم أنّ وجوب العلم وجوب مقدّمي، أي إنّ وجوبه متأتٍ من كونه يُعدّ المرء ويُهيّئه للقيام بعمل ما متّفق مع منظور الإسلام، حتى أنّ تعلّم المسائل العلميّة في الأحكام، ومسائل الصلاة، والصوم، والخمس، والزكاة، والحج والطّهارة، ممّا هو مذكور في الرسائل العمليّة، ليس إلّا لكي يكون الإنسان متهيّئًا لأداء وظيفة أُخرى أداءً صحيحًا. فالمستطيع الّذي ينوي الحج يجب أن يتعلّم ما يتعلّق بأحكامه لكي يكون مستعدًّا لأداء مناسك الحج على وجهها الصحيح.
وبعد أن نُدرك هذا علينا أن نُدرك أمرًا آخر، وهو: أيّ دين هو الإسلام؟ ما أهدافه؟ ما المجتمع الّذي يُريده؟ ما مدى اتّساع المنظورات الإسلاميّة؟ هل اكتفى الإسلام بهذا العدد من المسائل العباديّة والأخلاقيّة؟ أم أنّ تعاليم هذا الدّين قد اتّسعت لتشمل كلّ شؤون حياة البشر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، وإنّ له في ذلك أهدافًا يبغي تحقيقها؟ هل الإسلام يُريد المجتمع مستقلًّا، أم لا يعنيه إنْ كان مستعمَرًا محكومًا؟ ما من شكٍّ في أنّ الإسلام يُريد مجتمعًا مستقلًّا، حرًّا، عزيزًا شامخ الرأس ومستغنيًا عن الآخرين.
وثمّة أمر ثالث لا بدّ من معرفته والاطّلاع عليه، وهو أنّ العالَم اليوم يدور على العلم، وإنّ مفتاح كلّ شيء هو العلم والمعرفة الفنّيّة، وإنّنا بغير العلم لا نستطيع خلق مجتمع غنيّ، ومستقلّ، وقويّ، وحرّ وعزيز. وهذا يؤدّي بنا إلى الاستنتاج بأنّ من الواجب والمفروض على المسلمين في كلّ زمان، وعلى الأخصّ في زماننا هذا، أن يتعلّموا ويُتقنوا كلّ علم من العلوم الّتي تكون وسيلة للوصول إلى الأهداف السامية المذكورة.
وعلى هذا الأساس، نستطيع اعتبار جميع العلوم النافعة علومًا دينيّة، كما نستطيع أن نعرف أيّ العلوم من الواجبات الكفائيّة وأيّ العلوم من الواجبات العينيّة، وكذلك نستطيع أن نعرف أنّ علمًا من العلوم يُمكن أن يكون في وقت ما من أوجب الواجبات، ولا يكون كذلك في وقت آخر. وهذا بالطبع يتعلّق بميزان ذكاء الأشخاص الّذين يكونون من المجتهدين في كلّ زمان، ويستنبطون الأحكام لذلك الزمان.
* الإسلام ومتطلبات العصر، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1 الشهيد مطهري قدس سره، مرتضى، الفكر الإسلامي وعلوم القرآن، دار الإرشاد، الطبعة الأولى، بيروت، 2009م ، ص534.
2 الكليني،الشيخ محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، مطبعة الحيدري، 1365هـ/ش، ط2، ح1، ج7، ص30.
3 فتال النيشابوري، محمد بن أحمد، روضة الواعظين وبصيرة المتعظين، نشر منشورات الرضي، إيران، قم، الطبعة الأولى، 1417هـ ، ج1، ص11.
4 الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، منية المريد، تحقيق وتصحيح رضا مختاري، نشر مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، 1409هـ ، ص173.
5 الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، نشر دار الثقافة، قم، الطبعة الأولى، 1414هـ، ص675.
6 العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج1، ص169.
7 الحر العاملي، وسائل الشيعة، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيتعليهم السلام لاحياء التراث، ط2، 1414ه، مطبعة مهر - قم، باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم، ح20، ج27، ص27.
8 سورة البقرة، الآية 164.
9 سورة العلق، الآيات 1 - 4.