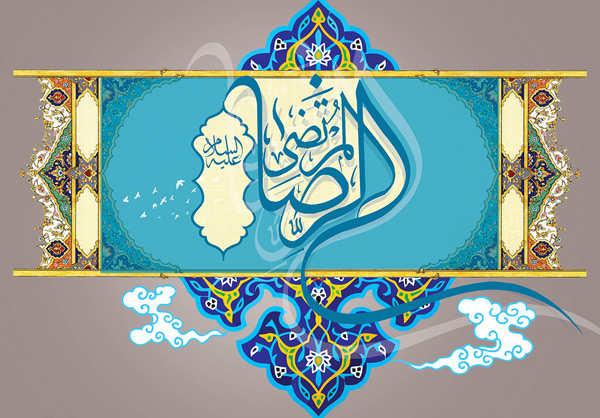Super User
أزمة الحكومة في تونس أم أزمة التبعية والحُكم؟
مع احتدام أزمة نظام الحُكم الوجودية في تونس التي تركّزت في أزمة عدم الخروج من تنازع صلاحيات ومصالح وتصوّرات رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، وشق من نداء تونس وبعض المنظمات الوطنية الأخرى مثل اتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين من جهة ورئيس الحكومة المُعيّن يوسف الشاهد وحركة النهضة من جهة أخرى، علاوة على الكتلة البرلمانية المساندة للشاهد والتي تكوّنت حديثاً من جملة انشقاقات وصراع سياسة حزبية، وحول التصرّف في شؤون الحُكم وتسيير البلاد وتحقيق تطلّعات الشعب، خاصة في واقع عدم الوصول إلى حلول دستورية أو توافقية، تتفاقم أضلع الأزمة الأخرى الأخطر، علاوة على الجانب السياسي منها، ونعني البعدين الأمني والاقتصادي.
تتفاقم تبعيّة تونس الأمنية والدفاعية نتيجة ما أقدمت عليه عن طريق رئيس الجمهورية الحالي السبسي، ورئيس حزب مشروع تونس الحالي مرزوق من إمضاء اتفاقية ما يُسمّى الحليف غير العضو من خارج حلف الناتو وعدم أخذها مسافة مما يُسمّى الحلف الأطلسي الذي يدّعي مكافحة الإرهاب هو ووكلاء المنطقة، والحال إن أمر صناعتهم للبؤر الإرهابية وتشكيلهم لمعسكرات العدوان الإرهابي بات مكشوفاً على طول الجغرافيا المقصودة بالتفكيك والإخضاع. هذا إضافة إلى موضوعات الهجرة غير النظامية وجريمة الاتّجار بالبشر وغيرها من الجرائم المنظمة، نتيجة تهيأة بيئة الفوضى الضرورية منذ العدوان الإرهابي العسكري الغربي على ليبيا، بما فيه من أدوار لعبت من عدّة دول وشبكات عربية وغير عربية، بما في ذلك الدور التونسي. وعليه، وهو أمر قديم جديد في الواقع، تتّجه السياسات الأمنية والعسكرية الأوروبية والأميركية وفق عقائدها الاستراتيحية إلى مزيد وضع تونس وحدودها تحت السيطرة والتبعية التي تصل حد تدخّل المارينز في التراب الوطني التونسي بعناصر ومهام وقواعد عسكرية حسب ماذكره موقع ناشونال انترست مؤخراً، فضلاً عن التحكّم الاستخباراتي. هذا ويرجّح مزيد تدخّل القوى البحرية الأوروبية (سوفيا) بدعوى مكافحة الهجرة من خلال توسيع الرقعة الجغرافية لهذا التدخّل طبقاً لتقرير اللجنة الأوروبية لتقييم ومتابعة السياسة الأوروبية في مجال مقاومة الإرهاب الصادر في 26 حزيران/ يونيو 2018، والذي يشير إلى حد إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن للعمل في مياه تونس الاقليمية، مستنداً أيضاً إلى اتفاق الشراكة من أجل الحركية الموقّع في آذار/ مارس 2014. وبلغة أخرى وبوجه عام، فإن اتجاه الأمور إلى مزيد إطلاق اليد الاستعمارية ومخطّطاتها في المنطقة هو الأرجح طالما هذه هي سياسة محور الإرهاب والانتداب هذا وهذه هي سياسة محور التبعية والتطبيع هذا بحكوماته وبلدانه وشبكاته.
أما على الصعيد الاقتصادي فإن كل المؤشّرات الاقتصادية فائقة السلبية وعالية التهديدات خاصة إذا ارتبطت بما يُسمّى برنامج الإصلاحات الكبرى (المفاسد والاستباحات في الحقيقة)، التي تمليها الصناديق الدولية وهي أدوات ستعمّق رهن وارتهان البلد وانهيار مقدّراته راهناً ومستقبلاً، وعلى وجه الخصوص في واقع زحف مفاعيل التفويت والتفريط وولاء الحكومات للمشغّل الغربي واللوبيات المحلية، ونذكر أساساً ما تُسمّى اتفاقية الشراكة المعمّقة مع الاتحاد الأوروبي والتي يجمع الخبراء الموثوقون أنها ستنزع سيادة البلد بشكل نهائي، وستقضي على فرص النهوض ويؤكّدون أنها قيد التنفيذ كسياسة أمر واقع لاسيما بأسسها القانونية والتشريعية، وبإجراءاتها التنفيذية إلى جانب التعهّدات، بدلاً من تبني سياسات اقتصادية ومالية وطنية بديلة في مجالات قيمة الدينار والمديونية والتوريد الفوضوي والشراكة غير المتكافئة...الخ. زيادة على سياسة حق الاعتراض وحق الرفض والتفاوض التي يؤكّد عليها العارفون الخبراء من نوع السيّدات والسادة جنات بن عبد الله وجمال الدين العويديدي وأحمد بن مصطفى وغيرهم في مقالاتهم ومحاضراتهم، في هبّة فكرية وطنية طليعية تستحق كل الاحترام. وهنا نشير أيضاً إلى جانب التونسيين، نشير إلى تقرير الجمعية الدولية للتقنيين والخبراء والباحثين إيتاك الصادر في نيسان/ أبريل 2016 تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي-تونس: ديكتات اللبرلة التجارية أم شراكة أصيلة؟" والذي يؤكّد في تشخيصه وتحليله وتوصياته على نفس التوجّهات والاستنتاجات المضرّة بتونس التي يسار بها نحو دولة فاشلة كما يريد الأميركان والأوروبيون ووكلاؤهم الخليجيون في المنطقة في صيغة ما يسمّى "النظام العربي الجديد" كما جاء في تقرير معهد كارنيغي في تقرير 16-8-2018.
في جو الأزمة الوجودية والانسداد السياسي هذا، وأمام استحقاق الإنقاذ الوطني نجد أنفسنا أمام سؤال المعارضة الوطنية ومسائلتها. والمقصود بالمعارضة الوطنية هنا تلك المعارضات التي ناضلت لعقود ضد استبداد وتبعية نظام بورقيبة وضد نظام بن علي وكذلك ضد حكومات ما بعد 2011 والتي تواصل نهج التبعية بنوع من الاستبداد الناعم المدعوم من المنظمات المالية والاقتصادية الدولية ودولها ، وكذلك بعض أنظمة الاقليم وشبكاتها. وتتألف هذه المعارضة من أحزاب وجبهات على غرار الحزب الجمهوري وحزب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي والجبهة الشعبية وأحزاب ومنظمات مدنية أخرى، تعاني كلها من غياب الفاعلية والتأثير ومن انعدام التنسيق الجماعي والعمل المشترك الأدنى في ظلّ أزمة نصفها بالأخطر في الأبعاد الثلاثية السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد والتي ذكرناها أعلاه.
وعليه، فإن إنقاذ المعارضة كخيار ضرورة حتمية للإنقاذ الوطني لا يمكن أن يتم إلا على أرضية أطروحة وطنية جامعة لا على أساس أي مشروع أحادي يدّعي ما يشاء أن يدّعي. وإن أيّ أمل ثوري وتحرّري ووحدوي لا يرى النور إلا بتحصيل سلطة معنوية للمعارضة تجعل منها قوّة معارضة أو قوّة أساسية قادرة على تحقيق ثقة غالبية المنهوبين والمهدورة حقوقهم والمعدمين ومقتدرة على قلب موازين القوى وتحقيق المهمات الوطنية المطلوبة.
بالمقابل، تظلّ أية معارضات قائمة في صورة اللامبالاة الشعبية بالمعارضة لكونها معارضة ولأسباب أخرى ذاتية وموضوعية طبيعية. نحن نظن أنه من حق الشعب مهما قلت عنه، من حقه مراقبة المعارضة واختبارها مرة وأكثر، لعلّها تبادر أو تغيّر أو تنجح في شيء ما. ومن حقه أيضاً الالتفات عنها وقتما يشاء. فهو مشدود بواقعه أما إلى المقاطعة وأما إلى أحزاب الحُكم وماكيناتها وارتباطاتها.
يبدو لنا على الأرجح أن تونس الحالية في أكبر اختبار وأصعب ظرف على منعرج سنة 2019. وفي الحقيقة، غالبية الشعب ليست هي المعارضة وليست معارضة كالمعارضة. والشعب ليس معارضاً بصفته شعباً. أما إذا عارض وانتفض في ظرف ما، فسيعارض الجميع بمّن فيهم المعارضة، وهذه حال تكاد تكون سائدة. إلا إذا نجحت المعارضة موحّدة وكمشروع معارض، إذا نجحت بالحد المطلوب في تمثيل كتلة وازنة منه (أي من الشعب) في تطلّعاته من دون أن يكون معها بالضرورة.
تبقى أسئلة مهمة وملّحة تتعلّق بقواعد إنقاذ هذه المعارضة لنفسها وفرض نفسها كمعارضة مشروع مقابل مشروع ومشروع مقنع مقابل مشروع فاشل، بالأحرى. هاهنا، ليس المشكل في الأفكار والأطر والآليات والحاجة والرغبة الشعبية، بل في إرادات المعارضات. هذا ونظن أن التعجيل بإمضاء ميثاق إنقاذ وطني للمعارضة وللوطن يضمّ أربع نقاط ويتباحث الآليات التنفيذية للضغط وفرض مسار تصحيحي أمر ضروري وممكن كما يلي:
1- إتمام بناء المؤسّسات الدستورية
2- وقف المضي في فرض اتفاقات التبعية
3- وقف النزيف الاقتصادي
4- إطلاق مؤتمر حوار استراتيجي للمعارضة الوطنية حول برنامج الحد الأدنى المشترك الاقتصادي والاجتماعي وخلق استقطاب وطني حوله.
صلاح الداودي كاتب وأستاذ جامعي تونسي، منسق شبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية.
روسيا أغلقت الأجواء السورية، فهل ستغير آليات منع الاحتكاك وقواعد الاشتباك مع إسرائيل؟
روسيا حددت أن معركة شرق الفرات ستكون آخر المعارك في الحرب من أجل سوريا، وقبل أن يأتي موعدها لا بد من إنجاز الكثير المتمثل بحسم معركة إدلب عسكرياً بعد أن حسمت سياسياً، ووضع قواعد جديدة للاشتباك مع "إسرائيل".
روسيا حددت أن معركة شرق الفرات ستكون آخر المعارك في الحرب من أجل سوريا
ما تريده روسيا لسوريا هو الأمن والاستقرار، لأنهما يضمنان مصالحها ليس في هذا البلد فحسب وإنما في المنطقة برمتها، ولهذه المصالح فروع وتشعبات، سواء اقتصادية أم جيوسياسية أم عسكرية.
روسيا جاءت إلى سوريا قبل أكثر من نصف قرن وتريد البقاء فيها نصف قرن آخر، على أقل تقدير، لأنها استأجرت قاعدتي حميميم وطرطوس من سوريا لهذه المدة. وبالمناسبة، القابلة للتمديد لمدة مماثلة تلقائياً.
وعلى هذا الأساس فإن كل ما تفعله روسيا، سواء في ميادين القتال أم على موائد المفاوضات، يصب في نهاية المطاف في تحقيق هذا الهدف.
بالأمس تركيا أسقطت طائرة السوخوي الروسية، واليوم بوتين وإردوغان يتفقان على التهدئة ويسيران دوريات عسكرية مشتركة في إدلب.
قبل أيّام كانت موسكو تغض الطرف عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على محور المقاومة في سوريا، واليوم تغلق الأجواء السورية أمام "إسرائيل" وتتهم تل أبيب بالعدوانية.
أما بالنسبة للكباش الروسي الأميركي فحدث ولا حرج.
روسيا حددت أن معركة شرق الفرات ستكون آخر المعارك في الحرب من أجل سوريا، وقبل أن يأتي موعدها لا بد من إنجاز الكثير.
معركة إدلب حسمت سياسياً في انتظار الحسم العسكري
- الحسم في إدلب أولاً: الاتفاق الروسي التركي على الرغم من أنه ليس مثالياً إلا أنه وضع أطراً للنفوذ التركي في سوريا جغرافياً وزمنياً، ومن هذا المنطلق فإن موسكو أصبحت الحَكَمَ على مدى مصداقية أنقرة.
الشريط الحدودي العازل الذي تريده أنقرة على أجزاء من حدودها مع سوريا سيؤدي وقتياً، في الاتجاه من تركيا إلى سوريا، وظيفة الممر لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وفي الاتجاه المعاكس، وظيفة المرشح (فلتر) لمنع تسلل الإرهابيين.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تركيا من جهة، ومن الجهة الأخرى روسيا، التي لا تمثل نفسها فحسب وإنما سوريا وإيران معاً، لم يتفقا بشكل نهائي على "من هم الإرهابيون ومن هم المعتدلون". في النهاية، الأتراك أنفسهم لا يريدون التورط مع متشددين في خاصرتهم الجنوبية، ومصلحة أمنهم القومي تملي عليهم أن يبدوا ليونة أكبر في هذه المسألة، ولا سيما أن الرئيس رجب طيب إردوغان لم يطهّر جيشه بالكامل من أنصار غولن، زِد على ذلك أن الأمزجة الأميركية في القوات المسلحة التركية ما زالت قوية.
على أي حال شاء إردوغان أم أبى، إلا أنه مرغم على إيجادِ حلٍّ للمجموعات المسلحة التي دعمها خلال سنوات الأزمة السورية والتي تقترب من الثماني. ثمة معطيات بأنه سينقل المقاتلين الأكثر تشدداً إلى معسكرات في جنوب شرق تركيا، ربما لاستخدامهم في معاركه مع الكرد. ووفق بعض التسريبات فإن الاتفاق الروسي التركي يقضي أيضاً بإتاحة الفرصة للمسلحين الأجانب العودة إلى بلدانهم إذا وافقت على ذلك حكوماتها.
أما القسم الأكبر من المسلحين فإما سيلقون السلاح أو ينخرطون في مراحل متقدمة من العملية السياسية في البنى العسكرية والأمنية والشرطية، لكنهم ملزمون حاليا بمحاربة الإرهابيين.
على أي حال، الكل يفهمون، سواء الروس أم الأتراك، أم السوريون، أم المسلحون أنفسهم أن الوقت المتاح ضيق للغاية، وأن العمل العسكري آتٍ لا مُحالَ، وأن الدولة السورية ستنشر مؤسساتها في إدلب قبل نهاية العام الجاري على الأرجح.
بعدوانها على اللاذقية.. "إسرائيل" أسقطت قواعد الاشتباك مع محور المقاومة في سوريا
روسيا رفضت التوضيحات الإسرائيلية لحادثة الطائرة "إيل 20"
- قواعد جديدة للاشتباك ثانياً: "إسرائيل" هي التي عقّدت المشهد على نفسها جراء عربدتها وصلفها وظنها أنها تستطيع أن تتصرف في الملعب كما تشاء. ولكن ليس في هذا الشوط المصيري من مباراة سوريا ضد أعدائها.
تاريخياً يعرف عن الروس باعهم الطويل وصبرهم الجميل وردهم البطيء؛ صبروا كثيراً على الحماقات الإسرائيلية، وعملوا كثيرا لتجنب شرهم، وقدموا لهم الخدمة بوضع قواعد اشتباك بينهم وبين محور المقاومة، ومع ذلك نكر الإسرائيليون الجميل وخرقوا هذه القواعد، بل حتى آليات عدم الاحتكاك مع الروس أنفسهم.
إفتعال حادثة طائرة الاستطلاع الروسية "ايل 20" هي تلك القشة التي قصمت ظهر البعير.
في المظهر الإسرائيليون لم يسقطوا الطائرة، وفي المضمون أرادوا ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد؛ إظهار أن يدهم طويلة وتصل إلى أي مكان في سوريا، حتى في مناطق مسؤولية القوات الروسية، إرباك الاتفاق الروسي التركي حول إدلب بتحريض أميركي وإعطاء إشارة خاطئة للمسلحين للقيام بأعمال استفزازية، إرسال رسالة إلى محور المقاومة بأن تل أبيب غير ملزمة باتباع قواعد الاشتباك.
لكن ماذا ستجني "إسرائيل" من مغامرتها الجديدة؟ روسيا التي قلنا إنها تريد الأمن والاستقرار لسوريا ستفوت على "إسرائيل" كل فرص الاستفادة من عدوانها الجديد: موسكو ستفرض شروطاً جديدة على آليات عدم الاحتكاك ليس مع "إسرائيل" فحسب، بل ومع كل من يحاول العربدة في الأجواء السورية.
إغلاق الأجواء فوق المياه الإقليمية السورية أصبح أمراً واقعاً نظراً للمناورات التي تجريها البحرية الروسية على مساحات واسعة شرقي البحر الأبيض المتوسط. لم يبق سوى أن يعلن الجيش الروسي رسمياً إغلاق هذه الأجواء حتى بعد انتهاء المناورات.
عملياً روسيا رفضت التوضيحات الإسرائيلية لحادثة الطائرة. أما المسألة الأهم فإن روسيا ستضطر لإعادة النظر في تفاهماتها مع "إسرائيل" ومحور المقاومة حول قواعد الاشتباك بينهما، تلك التفاهمات التي أنتجت التهدئة في الجولان السوري وعودة المراقبين الدوليين إليه. إعادة النظر في هذه القواعد لن تكون في مصلحة "إسرائيل" بالتأكيد. وردة الفعل الروسية الغاضبة على العدوان الإسرائيلي واتهام موسكو لتل أبيب بالطعن في الظهر ونكران الجميل خير دليل على ذلك. وعندما يعزّي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني بالاعتداء الاٍرهابي في الأهواز، ويؤكد أن روسيا تقف مع الشريك الإيراني في هذه اللحظة المأساوية ومستعدة لتعزيز التعاون معها في محاربة الاٍرهاب، بعد أن اتهم حسن روحاني واشنطن وتل أبيب بالمسؤولية عن هذه الجريمة، عندما يقال كل ذلك، فإن لهذا الكلام دلالات واضحة.
حرب السيادة السورية ستحسم في معركة شرق الفرات
روسيا باتفاقاتها وتحركاتها ومواقفها الأخيرة تنفض عن نفسها غبار معارك السنوات الثلاث الأخيرة، لأنها تستعد للتهديد الحقيقي لوحدة سوريا المتمثل، كما قال عميد الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف، في التواجد الأميركي في مناطق شرق الفرات، حيث وجدت ملاذاً لها فلول داعش وحيث ينتشر حلفاؤها من قوات سوريا الديمقراطية.
سوريا وحلفاؤها انتصروا في معارك كثيرة، لكن الانتصار التام في الحرب سيتوج بمعركة شرق الفرات التي سوف تستكمل بها السيادة السورية.
7 شهداء بينهم طفلان ومئات الإصابات في غزة برصاص الاحتلال في جمعة "انتفاضة الأقصى"
استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة المئات بجراح مختلفة خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على فعاليات "جمعة انتفاضة الأقصى"شرقي قطاع غزة، وشهود عيان يقولون إنه جرى إسقاط طائرة تصوير إسرائيلية "أكواد كابتر" شرقي رفح.
استشهد 7 فلسطينيين وأصيب المئات بجراح مختلفة خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الجمعة على فعاليات "جمعة انتفاضة الأقصى"شرقي قطاع غزة.
والشهداء هم الطفلين محمد نايف الحوم البالغ 14 عاماً وناصر عزمي مصبح (12 عاماً)، والشبان إياد خليل الشاعر (18 عاماً)ومحمد بسام شخصة (24 عاماً) ومحمد وليد مصطفى هنية (23 عاماً) ومحمد علي محمد انشاصي (18 عاماً) ومحمد اشرف العواودة (26 عاماً).
وأصيب 506 فلسطينيين بجراح مختلفة وتم تحويل 210 منهم للمستشفيات ومن بين الإصابات 90 بالرصاص الحي ومنها 3 حالات خطيرة.
كذلك من بين الإصابات 35 طفلاً و4 سيدات و4 مسعفين وصحفيّين.
ونقلاً عن شهود عيان فقد جرى إسقاط طائرة تصوير إسرائيلية "أكواد كابتر" شرقي رفح.
وقال مراسلون إن الطيران الإسرائيلي أغار على احد مواقع المقاومة شرق قطاع غزة.
وشارك في "جمعة انتفاضة الأقصى" قادة فصائل المقاومة في غزة على رأسهم قائد حركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار.
قيادات من الفصائل الفلسطينية تشارك في الجمعة السابعة والعشرين لمسيرات العودة الكبرى والتي تحمل اسم "انتفاضة الأقصى
الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة أعلنت أن مسيرة الأسبوع المقبل ستحمل عنوان "جمعة الثبات والصمود".
المشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة إنتفاضة الأقصى هي رسالة لكل من يهددها ويحاصرها ،بأنها لن تتراجع ولن تنكسر وستستمر وبكل قوة حتى كسر هذا الحصار، وأن كل من يفرض العقوبات عليها ويحاربها في قوتها و يحاول ضرب مقومات وعوامل صمودها سيفشل وسيدفع الثمن.
من جانبه، قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس إن المشاركة الجماهيرية الحاشدة في "جمعة انتفاضة الأقصى" هي رسالة لكل من يهددها ويحاصرها بأنها "لن تتراجع ولن تنكسر وستستمر وبكل قوة حتى كسر هذا الحصار وإنهاء المعاناة"، وأن "كل من يفرض العقوبات عليها ويحاربها في قوتها ويحاول ضرب مقومات وعوامل صمودها سيفشل وسيدفع الثمن".
وعلّقت حركة فتح على جريمة الاحتلال الإسرائيلي قائلة إنها "يجب أن لا تمر دون عقاب".
وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف ابو سيف "أن نضالات شعبنا واستبساله في الذود عن أرضه وحقوقه لن ترهبه ولن توقفها الة البطش والقمع الإسرائيلية وان جرائم دولة الاحتلال تأتي في ظل صمت دولي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ".
وأعادت الحركة التأكيد على ضرورة "استعادة الوحدة الوطنية لتوحيد الطاقات والجهود في حماية الحقوق الوطنية وانجاز المشروع الوطني".
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت إن جريمة جمعة "انتفاضة الأقصى" تمت "بتشجيع وغطاء الخطابات المسمومة أمام الأمم المتحدة العاجزة عن معاقبة القاتل السفاح وزمرة المجرمين الذين يقودهم نتنياهو".
شُبهات وتساؤلات حول المرأة (15)
هناك من الرجال من يضرب زوجته أو ابنته ويقسو عليها، وينسب ذلك للدين، حيث أجاز للرجل ضرب زوجته، وهذه إهانة وتحقير للمرأة، وهو مما يرفضه العقل، ويأباه التحضر والمدنية.
* * * * *
إكرام الزوجة
لا شك أن الإسلام كما يكرم الرجل يكرم المرأة (وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ)([1]) ويريد لهما الخير والوصول إلى الكمال الإنساني ويرفض الإهانة والتحقير لكل إنسان، وقد جاءت النصوص من الآيات والروايات لتؤكِّد إكرام واحترام الزوج لزوجته والأب لابنته، ولا مجال لذكر هذه النصوص في هذا البحث المختصر، ونكتفي بذكر بعضها، منها قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ)([2])، ومنها قول المشهور للنبي(ص): Sخيركم خيركم لنسائكم وبناتكم([3])R وقوله (ص): Sما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم([4])R.
لماذا ضرب الزوجة . . .؟!
زعم بعضٌ أن الإسلام يجيز للزوج ضرب الزوجة متى شاء، ولم يعرف أن ضربها إنما يجوز في حالة واحدة فقط، وهي حالة النشوز، قال تعالى: (وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)([5])، والنشوز عبارة عن خروج الزوجة عما يجب عليها من حق الزوج الخاص، وذلك لعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها، ومنع نفسها عنه، وحلاًّ لهذه المشكلة؛ على الزوج أن يبادر - إذا ما ظهرت علامات النشوز وأماراته - إلى وعظها وإرشادها بجميع السبل الممكنة التي من شأنها إرجاعها إلى أداء حقه، فإن لم ينفع مارس الأسلوب الثاني، وهو أن يهجرها في المضجع، لعلّها ترجع عن منع الزوج حقه، فإن لم ينفع عند ذلك ونشزت بالفعل، بأن منعته حقه بالفعل ضربها، لكن اشترط الفقهاء أن يكون ضرباً تأديبياً غير جارحٍ ولا مبرحاً، ليكون مؤذياً لعاطفتها وأحاسيسها أكثر من أذيته لجسدها، فهذه هي الحالة الوحيدة التي جوّز الإسلام فيها ضرب الزوجة مع مراعاة شرائط الضرب وكيفيته حينما يفشل أسلوب الموعظة والنصيحة،ولا يجدي أسلوب الضغط النفسي بالهجر والإعراض، ومع بقاء الزوجة مصرة على تمردها، فهل يظل الزوج مكتوف الأيدي وساكتاً عن تجاوز حقوقه؟ أو يرضى بالطلاق فوراً قبل تجربة أسباب الهداية لها كاملة، أو يرفع الأمر إلى الحاكم، وفي ذلك كشف لأسرار حياتهما الزوجية وخاصة مع تعذر النقل أو الإثبات في القضايا السرية والداخلية بينهما؟
وواضح أن تشريع الضرب في هذه الحالة لردعها عن تمرّدها على زوجها في سلبه حقه، حيث لم ينفع معها الوعظ والإرشاد والهجر، فلا حلّ لردعها إلاّ هذا النوع من الضرب، هذا لو كان يحتمل الزوج تأثير الضرب وإجداءه نفعاً، أما إذا علم بأنه لا يردعها عن ظلمها فلا يشرّع، لأنه لا فائدة منه.
قال مشهور الفقهاء: (... جاز له ضربها إذا كان يؤمل معه رجوعها إلى الطاعة، وترك النشوز ويقتصر منه على أقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الفرض منه، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدمياً ولا شديداً، مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون بقصد الإصلاح، لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب العزم).
وعلاوة على ذلك، لم يقتصر الإسلام في تشريع الضرب على المرأة خصوصاً، وفي هذه الحالة، بل له نظام واسع في عقاب المذنبين سواء أرجالاً كانوا أم نساءً، فشرّع الحدود عقاباً على الزنا واللواط والمساحقة و...، وجعل التعزير بيد القاضي للمعاقبة على بعض الذنوب التي لم يذكر لها حد في الإسلام، وجوّز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الضرب في حالة عدم انصياع المذنب وارتداعه بالوسائل العادية.. وهكذا.
وهذا النظام لا يخالفه العقل، بل سيرة العقلاء والأنظمة الوضعية، والأعراف البشرية قائمة على حساب المذنب وعقابه، ولم نر عبر التاريخ نظاماً لم يسن قوانين العقاب.
إذاً، فلم يتفرد الإسلام بهذا النظام، كما لم يقتصر على عقاب المرأة دون الرجل حتى يعاب على الإسلام بذلك.
نعم، يمكن أن يقال: لماذا كان الضرب بيد الرجل، فكما أن الغالب في العقاب يمارسه القضاء، فَلِمْ لا يكون ضرب المرأة موكولاً إلى القضاء؟
والجواب: أولاً: إن الضرب الجائز أمر بسيط ليس بدرجة العقاب في قانون الجزاء ورفع الأمر إلى القاضي، نعم، إذا حصل الخلاف إلى تلك الدرجة، فالأمر مرفوع إلى القضاء.
ثانياً: ما يمكن حله في داخل الأسرة أنسب للإحتفاظ بكرامة المرأة والأسرة من أن يحيل الأمر إلى الأجانب وتوكيل الأمر إلى القاضي.
وغالباً الزوج لا يرضى أن يمارس ضرب زوجته أحد غيرهُ من الرجال لغيرته عليها واختصاصها به، بمعنى أن من يتجرأ على ضربها فكأنما تجرأ على كرامته وتجاوز حده، فكان الأفضل ممارسته هذا الحق بنفسه.
لماذا لا يجوز ضرب الزوج؟!
ولعل قائلاً يقول: Sفلماذا إذا نشز الزوج وامتنع من أداء حقوق زوجته لا تضربه المرأة أو القاضي ليعود إلى رشده؟، كان الجواب عدم تشريع الضرب للزوجة على الزوج يخالف مع قيمومة الرجل ومضافاً إلى عدم تيسر ذلك غالباً للمرأة مع ما فيه من إثارة الخلاف والتمزيق في حياة الزوجية، إذ الزوج لا يطيق هذا العقاب من المرأة، لما يرى فيه من كسر لشخصيته وإذلاله، فلا يرغب بالبقاء مع هذه المرأة أبداً، وبالتالي يكون تشريع مثل ذلك موجباً لكسر الأسرة، وخراب العش الزوجي.
إضافة إلى ذلك، أن جميع الأعراف تستنكف ممارسة المرأة عقاب الزوج بالضرب سواءٌ أحقاً كان أم باطلاً؛ لأنه يتنافى مع رقتها، وموجب لكسر شخصية الرجل وإذلاله؛ إذ يسقط عن القيمومة، وبالتالي يؤثر في العلاقات الزوجية ويستوجب تفكيك الأسرة بكاملهاR.
نعم، في حالة نشوز الزوج يمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيجبره على أداء حقها، فإن أبى أجبره على ما يراه مناسباً، وقد يشرّع في حقه الضرب أو يفرض عليه الطلاق، تطبيقاً لقوله تعالى: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)([6]).
ومن مجموع ذلك، يتضح أن تشريع ضرب المرأة إنما هو في حالات خاصة، ولأجل صالح المرأة، وصالح الأسرة والحياة الزوجية، وهي حالة النشوز وعدم أدائها حق زوجها.
أما في غير هذه؛ فلا يجوز للرجل ضرب زوجته، ولا يحل له بحال، فعن النبي (ص): أنه نهى عن ضرب النساء في غير واجب([7])، وقال (ص): «إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها»([8]).
[1] ـ الإسراء: 70.
[2] ـ النساء: 19.
[3]ـ مستدرك الوسائل: 14: 255.
[4]ـ وسائل الشيعة: 14: 13.
[5] ـ النساء: 34.
[6] ـ البقرة: 229.
[7] ـ مستدرك الوسائل 2: 550.
[8] ـ سفينة البحار 2: 586.
شُبهات وتساؤلات حول المرأة (14)
قال بعضٌ: إن استعمال الرجل لزوجته في خدمتها المنزلية استغلال منه لها، فتكون عنده كالأجير، وفيما يلي نبحث هذه المسألة، ونجيب عن هذه الشبهة بنحوين:
* * * * *
أولاً: لا تكليف على المرأة في الخدمة المنزلية
مما اتفق عليه الفقهاء نظراً إلى ما وصلهم من الروايات الواردة عن النبي (ص) وأهل بيته، عدم وجوب الخدمة المنزلية على الزوجة، فلا يجب عليها طبخ ولا كنس ولا ترتيب فراش ولا غير ذلك، إلاّ إذا جعله الزوج شرطاً في ضمن عقد النكاح، فتصبح الخدمة المنزلية واجبة عليها بعنوان آخر، وهو الوفاء بالشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم، وقد قال الله تعالى: (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([1])، وقال (ص): «المؤمنون عند شروطهم»([2])، أما بدون ذلك فليس للزوج إلزامها بالخدمة.
إن حياة الزوجين حينما تكون قائمة على الحب المتبادل، فلا بدَّ أن تخضع للظروف المختلفة حسب وضع العمل والمعاش والبيئة، ولذا اكتفى الإسلام بجعل الحقوق للزوجين في أمور معدودة كحق القسم والإنفاق على الزوج للزوجة وحق مطاوعة المرأة للزوج في الاستمتاع، ولكن ترك تنظيم الحياة الأسروية على عهدتها وأوجب المعاشرة المعروفة (وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ)([3]) وحسن الصلة فيما بينهما لتسير الأمور على متطلبات الحياة كما فعل ذلك أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء(عليها الشلام) حيث تصالحا على أن يقوم علي (ع) بالعمل خارج المنزل، وتقوم السيدة الزهراء (عليها الشلام) بالعمل داخله، وعلى هذا قامت حياتهما الزوجية واستمرت، غير أن علياً (ع) كان في كثير من الأحيان يعود إلى المنزل ليعين الزهراء(عليها الشلام) في خدمة المنزل، وما كان ليتركها وعملها دون أن يسدي لها ذلك.
من نافلة القول أن نقول: إنه من الخطأ بمكان أن نتعامل مع الحياة الزوجية فقط في عالم القوانين والحقوق، وما يجب على أحد الزوجين وما لا يجب، فإن الحياة الزوجية ليست أي مصنع أو شركة أو دائرة يرجع موظفوها إلى الحقوق والواجبات، بل هي عيش قائم على أساس البذل والحب والمودة والاطمئنان، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً)([4])، فينبغي أن يكون الحكم السائد في هذه العلاقة المقدسة هي السكن والمودة والرحمة، وهو بدوره يفرز تفانياً بين الزوجين، وبذلاً عميقاً وتنازلاً عن الحقوق والواجبات، ولم يشرّع الإسلام الحقوق والواجبات لهذه العلاقة إلا لحالات الاضطراب التي قد تسود الأسرة، ولأجل الاختلاف الذي يحصل بين الزوجين فيرجع كل واحد منهما لما له وما عليه حلاً للخلاف وحسماً للاضطرار، لا أن هذه الحقوق واجب قائم، رضيا بتركها أم لا، فمثلاً من الواجبات إنفاق الرجل على زوجته، ولكن لو رضيت الزوجة بإسقاطه، بل لو أنفقت على زوجها وأولادها من مالها برضاها فلا يحرّم الإسلام عليها ذلك، كما أنه من الواجب على المرأة ألاّ تخرج من بيت زوجها إلاّ بإذنه، لكن إن أسقط الزوج حقه في ذلك وأجازها في أن تخرج متى بدا لها، فلا يمنع الإسلام من ذلك، وهذا وغيره يكشف بجلاء عن أن الحقوق والواجبات التي شرّعها الإسلام لهذه العلاقة المقدسة هي في الحقيقة خطوط حمراء يُرجع إليها عند الاختلاف، ولا يجب تطبيقها عندما يسود الاتفاق والود والحب والحنان بين الطرفين.
ومن هنا، فإن الخدمة المنزلية التي تقدمها الزوجة لزوجها وأطفالها ليست من باب الاستخدام والاستئجار أو الاستغلال، بل هي عنوان معاونتها له، ووقوفها إلى جنبه، وعربون محبة وإخلاص ووفاء، بغض النظر عما يجب وما لا يجب، ولذا نرى المرأة المؤمنة، والزوجة الصالحة تقدم هذه الخدمة الجليلة عن طيب نفس وراحة بال.
نعم، ينبغي على الرجل في أوساط أمتنا الإسلامية أن يتأسى بنبيه وأئمته العظام صلوات الله عليهم أجمعين، في معونة الزوجة في الخدمة المنزلية، وإسدائها لها فإنها أحق من يعان، وقد قال (ص): «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»([5])، وقد نقلت إحدى زوجاته أنه (ص): كان يأتي الى المنزل ويطهي الطعام ويضع الأطباق ويرفعها ولا يترّفع عن هذه الخدمة الجليلة، فكان عمله هذا سنة يستفاد منها استحباب الفعل وحبّ الشارع المقدس له.
ثانياً: الزوجة تؤجر على الخدمة المنزلية
إن ما تقدمه الزوجة من خدمة لزوجها وأطفالها تؤجر وتثاب عليبه ويدخره الله لها لآخرتها.
قال الصادق (ع) : سألت أم سلمة رسول الله (ص): عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال: «أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً، إلاّ نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه»([6]).
وقال الإمام الباقر(ع): «أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة، تدخل من أيها شاءت».([7]) وقال (ع): «ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إلاّ كان خيراً لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها»([8]).
[1] ـ المائدة: 1.
[2] ـ التهذيب 7: 371.
[3] ـ النساء: 19.
[4] ـ الروم: 21.
[5] ـ وسائل الشيعة 20: 171.
[6] ـ وسائل الشيعة 21: 451.
[7] ـ الكافي 5: 507.
[8] ـ وسائل الشيعة 14: 123، 302.
شُبهات وتساؤلات حول المرأة (13)
أثار المغرضون في عباراتهم أن الإسلام جعل الرجل حاكماً على المرأة بحيث يحكم ويتحكم عليها، وهذا يؤدي إلى سلب حريتها واختيارها سواء أكان المُنَصَّبُ للقيمومة أباها أم جدها لأبيها أم زوجها، فلا تكاد تخرج من سلطان أبيها حتى تدخل تحت ولاية الزوج.
* * * * *
القيمومة على ضوء القرآن:
لا شك في أن الإسلام جعل الولاية على المرأة بيد أبيها أو زوجها، وهذا ما أكده القرآن الكريم، وقد عبّر عن هذه الولاية بالقيمومة، بقوله تعالى: (الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَآءِ بِمَا فَضّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً))[1] ( ولكن لا يعني ذلك التحكم بإرادتها واستعبادها، ومنعها حريتها، بل ولاية الأب تعني ألاّ تتزوج إلا بإذنه فقط فيما إذا كان الأب مدركاً لمصلحة بنته ويشخص ما ينفعها وما يضرها)[2](، وأما في غير ذلك فليس له على البنت إلا البرّ، وكذا بالنسبة إلى الزوج حيث تنحصر ولايته في أمور جزئية، لا في جميع رغباتها وحرياتها، وفي هذا يقول العلامة الطباطبائي v في الميزان: «وليست قيمومة الرجل على زوجته بأن لا تنفذ لها فيما تملكه إرادة ولا تصرف، ولا أن لا تستقل المرأة في حفظ حقوقها الفردية والاجتماعية، والدفاع عنها والتوصّل إليها بمقدماتها الموصلة، بل معناها؛ أن عليها أن تطاوعه فيما يرتبط بالمعاشرة والاستمتاع حضوراً، وتحفظ غيبته فلا تخونه؛ بأن تمنع غيره من نفسها ما ليس له منها، ولا تخونه فيما وضعه تحت يدها من ماله، وسلّطها عليه في الحياة المنزلية والزوجية المشتركة»([3]).
فالقيمومة ليست استبداداً ولا استيلاءً، وإنما مسؤولية ملقاة على عاتق الرجل، وواضح حاجة الأسرة إلى وجود هذا المسؤول، إذ لا شك أن أيّة هيئة أو مؤسسة حتى المؤلّفة من شخصين، لابد أن يتولى أحدهما زعامة تلك الهيئة، فيكون رئيسها، بينما يقوم الآخر بمساعدته، وإلا سادت الفوضى تلك الهيئة أو المؤسسة، واختلت أنشطتها وأخفقت في تحقيق أهدافها المنشودة، وهكذا الحال في الأسرة، فلابد من إسناد إدارتها إلى شخص، وعلى هذا قامت الحضارات والدول، والأسرة واحدة من أعظم وأخطر مؤسسات الحياة، فتحتاج كغيرها إلى مسؤول عن إدارة شؤونها وحمايتها، وتوصيلها إلى أهدافها.
لماذا كان الرجل قيماً؟
قد يتساءل بعضٌ أنه: سلمنا حاجة الأسرة إلى المسؤول والقيّم، فلماذا كان الرجل دون المرأة مسؤولاً عن إدارتها؟! أفلا تصلح المرأة لذلك؟
إن إعطاء هذه القيمومة للرجل لكونه يتمتع بخصائص معينة، كالقدرة على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، وكذلك فإن الرجل يمتلك بنية داخلية وقوة بدنية أكبر، فيستطيع أن يقوم بحاجيات الأسرة بشكل أكمل وأوفى، ويستطيع بالقوة البدنية أن يدافع عن العائلة ويذب عنها، لذلك ربما قال تعالى في بيان علة قيمومة الرجل بقوله: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ)([4])، إذ ربما الملحوظ في التفضيل هذا الذي ذكرناه.
وأيضاً يستحق الزوج لما يتحمله من الإنفاق على الزوجة، ولقاء ما تعهده من القيام بكل التكاليف اللازمة من مهر ونفقة وإدارة مادية لائقة بالعائلة أن تناط به وظيفة القوامة والرئاسة في النظام العائلي، ولذلك قال تعالى: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ... .....وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ).
ومن غير الخفي أن إناطة مثل هذه الوظيفة بالرجل لا تدل على أفضلية ذات الرجل من الناحية الإنسانية على ذات المرأة، بل هي مجرد أفضلية من الناحية الإدارية والتنظيمية، ولا نظر لها إلى ذاتيهما، فالرجل أكفأ من المرأة في إدارة الأسرة، لا أنه أفضل منها وأكفأ من سائر الجهات.
وبتعبير آخر([5]): Sإذا سئلنا بأنَّ للأسرة لا بد من قيِّم، فإما هو الزوج أو الزوجة أو كلاهما، فإن كان كلاهما، فمعناه عدم وجود قيّم فلا يبقى إلا أمران فالرجل بما أنه يملك غالباً إرادة أقوى وقدرة أبلغ، وبما أنَّ عليه الإنفاق فهو أولى بقيمومة الأسرة وعليه رعاية مصالح الأسرة وأن لا يسخّر الأسرة إلا لصالحه فقط كما يكون الأمر في أغلب القيادات.
وما ورد من النصوص كما في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ)([6])، وما أمر باستشارة الزوجة، وما جاء في أنَّ المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل بشهوته، وما إلى ذلك من الإرشادات الأخلاقية، كلها تفيد هذا المعنى أنّ على الرجل القيم أن يراعي أحاسيس ومشاعر ومصالح الزوجة وجميع أفراد الأسرة.
جواز خروج المرأة من البيت أو عدمه
ومن فروع مسألة القوامة للرجل: مسألة عدم خروج المرأة من البيت إلا بإذن زوجها بحيث تكاد تكون هذه المسألة مورد اتفاق الفقهاء، ويمكن بيان هذه المسألة على نحوين:
أولاً: ما اتفق عليه الفقهاء هو عدم اشتراط جواز الخروج بإذن الزوج إلا إذا كان الخروج منافياً لحق التمتع، ولكن إذا خرجت بحيث لا ينافي تمتع الزوج فلا يشترط الإذن إلا عند بعضٍ.
ثانياً: لا يجوز الخروج في الأمور غير الواجبة ولكن الخروج لإتيان الواجبات كالتعلم الواجب والحج أو لمصلحة ضرورية وأمثال ذلك، فليس مشروطاً بالإذن.
ثم ما هو المبرر والمجوّز العقلائي للرجل في العمل بهذا الحق حتى على فرض كونه مسافراً وكون خروج الزوجة لغرض أداء فروض صلة الرحم والتعليم والعمل أو لغرض الترفيه المشروع عن النفس بما لا يتقاطع مع حقوقه في دائرة العلاقات الزوجية؟
والنتيجة أن هذا الحق للرجل وكيفية استخدامه قابل للنقاش، وينبغي أن يفسّر ويعرّف بدقة كي لا يساء استخدامه.
ومن البداهة بمكان أن يكون احترام الزوج لزوجته والتعامل معها وفق معيار المذكور في الأحاديث([7]) Sأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وأكره له ما تكره لهاR عاملاً مهماً في تقوية أواصر المودة وتعميق وشائج المحبة بينهما، وهذا النحو من التعامل الإنساني مع المرأة يقضي - على فرض أن يكون للزوج حق القوامة – ألاّ يحق له منعها من الخروج من البيت إلا فيما لو خاف عليها من خطر يهدد وجودها أو أخلاقها أو يفضي إلى تسيب الأطفال ويفقد الأسرة الدفء وحرارة العاطفة بين أفرادها وأمثال ذلك من المسوغات الموضوعية والمعقولة، وبعبارة أخرى: أن ينظر الرجل في مثل هذه الأمور إلى مصلحة الزوجة والأطفال أولاً، ومصلحته الشخصية المعقولة ثانياً، لا إلى رغباته الأنانية ونوازعه التي تنطلق من الذهنية المستعلية لدى الرجل وتدفعه إلى مخاطبة الزوجة بلغة القوة والتحقير والإذلال.. وحتى في صورة وجود محذور في خروجها إلى مكان معين، فإنه ينبغي على الرجل أن يتجنب الأمر والنهي بلهجة شديدة في مخاطبة الزوجة بل يشرح لها السبب في المنع ويبين لها المحذور في خروجها هذا، فإن ذلك أدوم للمودة وأحفظ للحرمة، وما عدا ذلك فالمرأة حرة في الخروج من البيت لأداء بعض الواجبات أو حتى مجرد الترفيه عن النفس إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، وينبغي للزوج ألاّ يضيق ذرعاً بأية محاولة من المرأة من هذا القبيل، ولا يعيش العقدة وضيق الأفق ويحسب أن هذا السلوك تعدٍّ على حقوقه ورجوليته وزعامته كما نرى مثل هذه الذهنية المتخلفة لدى بعض أصحاب الشخصيات المهزوزة والنفوس المتشنجة والعقول غير الناضجة.
ولاية الأب ومصلحة البنت
ولاية الأب والجد على البنت البكر البالغة الرشيد، في قرار زواجها – عند القائلين بذلك من الفقهاء -، سواء أكان على نحو استقلاله بالقرار، أم المشاركة فيه مع البنت، إنما ينطلق من مراعاة مصلحة البنت، فلأنها بكر لا تجربة لها في الحياة الزوجية، ولكونها غير مخالطة للرجال، فمعرفتها بصفاتهم وأخلاقياتهم محدودة، ولما قد يغلب عليها من الاندفاع العاطفي، لكل ذلك يخشى عليها من ألاّ يكون قرارها في اختيار الزوج موضوعياً مناسباً، فتتورط في حياة زوجية لا تسعد بها، ولا يمكنها الخلاص منها بسهولة، باعتبار أن قرار الانفصال والطلاق بيد الزوج.
كما أنها لو حصل بينها وبين زوجها أي مشكل، فستحتاج إلى وقوف أهلها معها، وإذا ما كان الزواج خلاف رأيهم، فستحرم من دعمهم ومساعدتهم عند اللزوم.
لهذه الحيثيات التي تصب في مصلحة البنت، كان لوليها دور في قرار زواجها، ويشير إلى ذلك بعض الروايات الواردة، وبعض كلمات الفقهاء. ففي صحيحة الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق (ع) قال: Sإذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها([8])R. أي هو أصوب نظراً لتحقيق مصلحتها، لخبرته الاجتماعية، وحرصه على مستقبل ابنته، ولموضوعيته في اتخاذ القرار، دون الوقوع تحت سيطرة الأحاسيس والعواطف.
ويقول المحقق الشيخ النجفي في الجواهر: Sالنهي كراهة عن الاستبداد وعدم الطاعة والانقياد، خصوصاً الأب الذي هو غالباً أنظر لها، وأعرف بالأمور منها، وأدعى لما يصلحها، وهو المتكلف بأمورها، وفي رفع الخصومة مع زوجها، لو حدث بينهما نزاع أو شقاق، فالذي يليق بها إيكال أمرها إليه([9])R.
ويقول الدكتور الزحيلي في تقريره لأدلة جمهور أهل السنة، على أن النكاح لا يصح إلا بولي: (الزواج عقد خطير دائم، ذو مقاصد متعددة، من تكوين الأسرة، وتحقيق استقرار وغيرها، والرجل بما لديه من خبرة واسعة في شؤون الحياة، أقدر على مراعاة هذه المقاصد، أما المرأة فخبرتها محدودة، وتتأثر بظروف وقتية، فمن المصلحة لها تفويض العقد لوليها دونها)([10]).
سقوط ولاية الأب وإذنه
لو أساء الأب استخدام صلاحيته في قرار زواج ابنته البكر الرشيد، ورفض الموافقة على تزويجها من خاطب كفءٍ ترغب فيه، دون مبرر مقبول، كما يحصل ذلك من قبل بعض الآباء، إما لانحراف مزاجه وأخلاقه، أو لتصفية حسابات مع البنت أو أمها، وخاصة حينما يكون هناك انفصال أو طلاق بين الأب والأم، أو لموقف شخصي أو عائلي ممّن خاطب ابنته، أو ما أشبه ذلك من الأسباب، التي لا تبرر تعويق زواج البنت مع رغبتها. ففي هذه الحالة تسقط ولايته، ويسقط اعتبار إذنه، بإجماع فقهاء المسلمين من مختلف مذاهبهم.
[1]ـ النساء: 34.
[2] ـ على خلاف بين الفقهاء في أن للأب الولاية في زواج ابنته، حيث إنه في المسألة أقوال خمسة، والمشهور منها، أن ولاية الزواج حق متبادل بين الأب أو الجد وبين المرأة، كما اتفق الفقهاء على أن الولي إذا منعها الكفء سقطت ولايته، وجاز له الزواج به دون الرجوع إليه.
[3] ـ الميزان 4: 344، ط بيروت.
[4] ـ النساء: 34.
[5] ـ هذا التعبير والاستدلال لأستاذنا سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني.
[6] ـ النساء: 19.
[7]ـ الكافي: 2: 169، وسائل الشيعة: 12: 205.
[8]ـ الكافي 5 :394.
[9]ـ جواهر الكلام 10 :448.
[10]ـالفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلي 7 :195.
ولادة الإمام علي بن موسى الرضا (ع) (11/ ذي القعدة / السنة 148 هـ)
الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا(ع) ([1]) ثامن أئمة أهل البيت، ولد في المدينة المنورة في الحادي عشر من ذي القعدة سنه (148 هـ)، أبوه الإمام موسى بن جعفر(ع) ، وأمه خيزران، وقيل نجمة، وتكنَّى بأم البنين، وقيل غير ذلك، استشهد (ع) بطوس متأثراً بسّم دسه إليه المأمون في نهاية صفر سنه (203 هـ) على المشهور، أو في السابع عشر منه كما في خبر آخر، وقضى أكثر عمره في مدينة جده، إلى أن استدعاهُ المأمون سنة (200 هـ) إلى خراسان، ليكون ولياً للعهد وخليفة من بعده، فعاش فيها ثلاث سنوات من عمره الشريف، إلى أن توفي ودفن فيها، ولم يترك الإمام (ع) إلا ولداً واحداً هو الإمام الجواد(ع) ، بناءً على (الإرشاد) للشيخ المفيد وله أربع بنون وبنت واحدة على رواية (كشف الغمة) للأربلي.
إمامة الإمام الرضا(ع) :
قام الإمام الرضا(ع) بعد أبيه بإمامة المسلمين عشرين سنة، قال الشيخ المفيد: كان الإمام بعد موسى بن جعفر: «ابنه علي بن موسى الرضا(ع) فضله على جماعة إخوته وأهل بيته وظهور علمه وحلمه، وورعه، واجتماع الخاصة والعامة على ذلك منه، ومعرفتهم به، ولنص أبيه (ع) على إمامته من بعده وأشار إليه بذلك دون إخوته وأهل بيته»([2])، وبالإضافة إلى النصوص العامة على إمامة الأئمة الاثني عشر من النبي(ص) ، فلقد كان كل إمام ينص على الإمام من بعده ويُبّينُه للمسلمين وشيعته، حتى لا يدَّعي الإمامة أحد من بعده.
من خصائص الإمام الرضا(ع)وصفاته:
لابد وأن يكون الإمام المعصوم، جامعاً لجميع العلوم والمعارف الإلهية والطبيعية، والفضائل والمكارم الأخلاقية، ليكون مناراً يهتدى به، وأسوة لجميع الناس يقتدى به، لأنّه حجة اللّه في أرضه على خلقه، ويجب أن يكون في جميع هذه الخصائص والصفات أعلى من غيره لتتم الحجة.
والإمام الرضا(ع) كجده المصطفى (ص) وآبائه الأئمة البررة، قد اتصف بجميع تلك الخصال والصفات الحميدة، ولم تكن صفة يسمو بها الإنسان نحو الكمال إلاّ وهي موجودة فيه.
أما أخلاقه؛ فيقول إبراهيم بن العباس الصولي: «ما رأيت أبا الحسن الرضا(ع) جفا أحداً بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما ردَّ أحداً عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل قط، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا خلا ونصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليه، وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر، وكان (ع) كثير المعروف والصدقة في السّر، وأكثر ذلك منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوه»([3]).
وأما علمه: فقد أحاط الإمام بجميع العلوم، وكان أعلم أهل زمانه، وذلك مما اشتهر وهو الشيء البارز في شخصية الإمام (ع) لا يستطيع أن ينكره أحد، وقد لقّب بعالم آل محمد، وقد اعترف المأمون بنفسه أكثر من مرة، وهو من العلماء البارزين، وفي مناسبات عديدة أن الإمام الرضا(ع) أعلم أهل الأرض.
ومن مظاهر علم الإمام ومعرفته التامة؛ إخباره عن كثير من الملاحم والأحداث قبل وقوعها، ومن جملة ما أخبر يحل بهم، وقتل الأمين على يد أخيه المأمون، وقتل المأمون له، وقد تحقق كل ما اخبر به.
ومن مظاهر علم الإمام (ع) مناظراته في البصرة، والكوفة وخراسان مع علماء اليهود والنصارى، والمسلمين، والتي اعترف له فيها جميع هؤلاء العلماء بالفضل والعلم والتفوق عليهم([4]).
أقوال العلماء وأهل السنة في الإمام الرضا(ع):
قال محمد بن عمر الواقدي (ت: 207هـ): «سمع علي الحديث من أبيه وعمومته وغيرهم، وكان ثقة يفتي بمسجد رسول الله(ص) وهو ابن نيف وعشرين سنة، وهو الطبقة الثامنة من التابعين من أهل المدينة»([5]).
وقال الإمام أحمد بن حنبل (ت: 241هـ)، معلّقاً على سند فيه الإمام الرضا(ع): «لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جنونه»([6]).
وجاء في كتاب (الثقات) لابن حيان (ت: 354هـ): «وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبي الحسن، من سادات أهل البيت وعقلائهم، وجلة الهاشميين ونبلائهم.. ومات علي بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته..
وقبره بسناباد خارج النوقان مشهور يزار، قرب قبر الرشيد، قد زرته مراراً كثيرة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جرّبته مراراً فوجدته كذلك، أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين»([7]).
وهكذا تحدث الحاكم النيسابوري (ت: 405) في تاريخه، ونقل قوله ابن حجر في تهذيب التهذيب([8])، وأثنى عليه الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: 597هـ)([9])، ومدحه عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت: 562هـ) فقال في الأنساب: «والرضا كان من أهل العلم والفضل مع شرف النسب»([10]).
وقال الفخر الرازي (ت: 604هـ) عند تفسيره الكوثر: «والقول الثالث في الكوثر، أولاده: فالمعنى أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم على مر الزمان، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم أنظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا..»([11]).
([1]) ورد عن الإمام الجوادA في وجه تسميته بهذا اللقب انه: «رضى به المخالف من أعدائه كما رضى به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائهA فلذلك سمي من بينهم الرضاA (عيون أخبار الرضا 1: 13) ويقال إنّ المأمون هو الذي لقبّ الإمام بهذا اللقب.
([3]) عيون أخبار الرضاA 2: 180.
([4]) راجع عيون أخبار الرضاA 2: 180 وبحار الأنوار 49: 95.
([5]) تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي: 315.
([6]) أورده ابن حجر في صواعقه المحرقة: 310.
فضل الطفل وأهميّته في الأسرة والمجتمع
تمهيد
سنُسلّط الضوء على أهمّية الطفل والمصلحة من وجوده في حياة الأسرة والمجتمع في ضوء الرؤية الإسلامية، ممّا يلعب دوراً مهمّاً كعنصر تحفيزيّ وترغيبيّ على إنجاب الأطفال.
العامل الفطريّ: فطرة الأمومة والأبوّة
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: "قال موسى بن عمران: يا ربّ، أيّ الأعمال أفضل عندك؟ فقال عزّ وجلّ: حبُّ الأطفال، فإنّي فطرتهم على توحيدي، فإن أمّتهم أدخلتهم برحمتي جنّتي"1.
كلُّ إنسانٍ يشعر في أعماق وجدانه بأنّه مجبول على غريزة حبّ الأطفال، ومعجون بالميل إلى إنجاب الأطفال، وحبّ أن يكون أباً أو أمّاً. ومهما حاول إنسان ما التنكّر لهذا الشعور الفطريّ فإنّه سيبقى معجوناً في طينته، وسيطفو في بعض اللحظات على السطح، ويلّح على الإنسان بالاستجابة لندائه وتلبية صوت هذا الشعور، وإلا سيبقى الإنسان يتحرّك في دائرة القلق والشعور بعدم الطمأنينة.
فالسعي نحو إنجاب الطفل هو إشباع لحاجة فطرية جُبلت عليها كلّ نفس بشرية في حبّ الأمومة والأبوة.
غريزة حبّ البقاء
إنّ من الخصائص الرئيسة التي تتميّز بها الكائنات الحيّة الواقعة في الطبيعة تحت الحسّ والاستقراء من حيوانات ونباتات هي التكاثر الجنسيّ، وهو عبارة عن حصول عملية اتّصال وتلاقح بين زوجين - ذكر وأنثى - ينبثق عنها كائن حيّ ثالث جديد مغاير لهما. وهذه الخصيصة الطبيعية أيضاً تُدغدغ في الإنسان غريزة حبّ البقاء فيسعى لتوليد كائنات حيّة جديدة تؤمّن استمرارية النوع البشريّ لحفظه عن الفناء والزوال.
عامل القوّة بالكثرة العددية
يعرض لنا القرآن الكريم العديد من الآيات التي تُشير إلى كون الكثرة العددية عامل قوّة وعزّة للمجتمع والأمة. يقول تعالى:
- ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرً﴾2.
- ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً﴾3.
وقد كانت وما زالت الكثرة العددية للأمم مثار فخر واعتزاز.
- ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرً﴾4.
- ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾5.
عامل الوراثة والخلافة
يقول تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا * يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾6.
وعن أبي عبد الله عليه السلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾، يعني أنّه لم يكن له وارث حتّى وهب الله له بعد الكبر7.
كلّ إنسان يرغب في استمرار وجوده الشخصيّ بمثال وشبيه له، يخلّد اسم العائلة، بنحو لا ينقطع ذكره بين الناس، ويُعبّر عن هذه الحالة بالوراثة أو الخلافة. وقد اعتبرت الروايات أنّ من محقّقات سعادة الإنسان أن يرى وريثه وخليفته.
وقد تقدّم ذكر العديد من الروايات - في الدرس السابق فقرة: تعليم أئمة أهل البيت الناس بعض الأعمال لإنجاب الأطفال - تُفيد هذا المعنى، منها:
- عن الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، قال لبعض أصحابه: "قل في طلب الولد: ربّ لا تذرني فرداً، وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي..."8.
- وعن بكر بن موسى الواسطي، قال:كُنتُ عند أبي إبراهيم - الكاظم - عليه السلام، فقال: إنّ أبي جعفراً كان يقول: "سعد من لم يمت حتّى يرى خلفه من نفسه".
ثم أومى بيده إلى ابنه عليّ - الرضا عليه السلام -، فقال: "وقد أراني الله خلفي من نفسي"9.
وعن أبي الحسن عليه السلام: "سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفاً من نفسه"10.
- وعن أبي الحسن عليه السلام: "إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً لم يُمته حتى يُريه الخلف"11.
سعادة الإنسان بالأطفال
اتّضح من بعض الروايات السابقة أنّ من سعادة الإنسان وجود الأطفال في حياته، ونُضيف إليها:
- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من سعادة الرجل الولد الصالح"12.
- وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أربعة من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون والولد البار..."13.
- وعن أبي جعفر عليه السلام، قال: "من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله"14.
عامل العون والخدمة والمساعدة للوالدين
يقول تعالى: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾15.
إنّ التدبّر في هذه الآية القرآنية الكريمة يُعطينا عدّة دلالات:
الأولى: أنّ إنجاب الأطفال أحد أهداف بناء بيت الزوجية.
الثانية: كما تُفيد الآية بقرينة سياق الآيات التي تسبقها - وهي في مقام عدّ النعم والآلاء الإلهية على الإنسان - أنّ الأولاد نعمة إلهية16.
والثالثة: أنّ الأولاد بالإضافة إلى كونهم هدفاً لتأسيس بيت الزوجية، ونعمة إلهية، هم مددٌ وعونٌ لوالديهم، كما تُشير إليه مفردة: ﴿وَحَفَدَةً﴾. فالحفدة لغة جمع حافد، وهو من الحفد، والحفد في اللغة: الخدمة17. وأصل الحفد يدلّ على الخفّة في العمل والتجمّع، فالحفدة الأعوان لأنّه يجتمع فيهم التجمّع والتخفّف18، والسرعة إلى الطاعة. ومنه قيل للأعوان حفدة، لإسراعهم في الطاعة19.
وقد اختلف المفسّرون في مصداق المعنى المراد من كلمة حفدة في الآية:
- قال بعضهم: إنّ بنين تُطلق على الأولاد الصغار، والحفدة تُطلق على الأولاد الكبار الذين يستطيعون إعانة ومساعدة آبائهم20.
- وتبنّى بعضهم: أنّ المقصود بها أولاد الأولاد.
- واعتبرها بعض ثالث: أنّها من باب العطف لتغاير الوصفين21، أي أنّ الأولاد جامعون للأمرين معاً، فهم بنون وهم حافدون أي يخدمون أهلهم ويعاونونهم22. أو من باب عطف الخاصّ على العامّ بحيث يكون المقصود بالحفدة خصوص البنين الذين يُعاونون والديهم ويُساعدونهم ويخدمونهم ويُسارعون إلى طاعتهم.
- وقد حملها بعض المفسّرين على كلّ المعاني السابقة23.
وعلى كلّ حال، بأيّ معنى أُخذت، يبقى الجامع المشترك هو جهة العون والمدد والخدمة والمساعدة للوالدين24.
يقول السيد الطباطبائي: "المراد بالحفدة في الآية الأعوان الخدم من البنين...، وجعل لكم من أزواجكم بالإيلاد بنين وحفدة وأعواناً تستعينون بخدمتهم على حوائجكم وتدفعون بهم عن أنفسكم المكاره"25.
وبعض الروايات يشهد على هذا الفهم للآية: فعن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن قول الله: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ قال عليه السلام: "هم الحفدة، وهم العون منهم، يعني البنين"26.
عامل المعاونة والمعاضدة في الروايات
وقد صرّحت الروايات بأنّ أحد أهداف وجود الولد في حياة الوالدين هو أن يكون عضداً لهما، وأصل العضد في اللغة: ما بين المرفق إلى الكتف، ويدلّ على العضو الذي يستعار في موضع القوّة والمعين27، وجمعه: أعضاد، و"أعضاد كلّ شيء ما يشدّ من حاليه من البناء وغيره"28. وقد شبّه الولد بأنّه عضد لوالديه لأنّه العامل الذي يفترض أن يستندون إليه ويعتمدون عليه في الحياة بكافّة جوانبها ومجالاتها، فعندما تشتدّ الظروف يجد الوالدان في الولد العنصر الذي يقف إلى جانبهم ويُعينهم على تجاوز صعابها.
- عن عيسى بن صبيح29، قال: دخل الحسن العسكريّ عليه السلام علينا الحبس، وكُنتُ به عارفاً، فقال لي: "لك خمس وستون سنة وشهر ويومان".
وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي، وإنّي نظرت فيه فكان كما قال.
ثم قال: "هل رُزقتَ من ولد"؟
قُلتُ: لا.
قال: "اللهم ارزقه ولداً يكون له عضداً. فنعم العضد الولد". ثم تمثّل عليه السلام: "من كان ذا عضد يُدرك ظلامته إنّ الذليل الذي ليس له عضد"30
قُلتُ: ألك ولد؟
قال عليه السلام: "أي والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، فأمّا الآن فلا"31.
- وعن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، قال: "من سعادة الرجل أن يكون له وُلْدٌ يستعين بهم"32.
نعم الشيء الولد
- روي عن الحسن البصريّ أنّه قال: بئس الشيء الولد، إن عاش كدّني، وإن مات هدّني. فبلغ ذلك الإمام زين العابدين عليه السلام، فقال: "كذب، والله نِعْمَ الشيء الولد، إن عاش فدعاء حاضر، وإن مات فشفيع سابق"33.
تُستعمل كلمة نِعْمَ في مقام المدح للشيء، ويظهر من أصلها الاشتقاقيّ في اللغة العربية أنّها من النعمة، ويرجع معناها إلى ما "يدل على ترفّه وطيب عيش وصلاح"34، ولا ريب في أنّ الولد نعمة من الله تعالى، فعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "البنون نعيم، والبنات حسنات..."35. وهذه النعمة الإلهية تجعل الإنسان يعيش حياة طيّبة، إذ بدون الولد يبقى الإنسان ناقص العيش، كما سيأتي في بعض الروايات اللاحقة.
إثقال الأرض بالتوحيد والتسبيح
إنّ الله عزّ وجلّ خلق الإنسان لهدف العبادة، وحقيقة العبادة متقوّمة بالتوحيد، ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾36، فعبادة الله تعالى وذكره وتسبيحه وحمده... هي الهدف الغائيّ لخلقة الإنسان كما ذكرنا في الدروس السابقة. ووظيفة التربية هي إيصال الإنسان إلى هذه المنزلة. وكي يصل الإنسان إلى هذه المنزلة لا بد من وجود الإنسان على الأرض، ووجوده رهن إرادة والديه، من هنا حثّت الروايات الأهل على إنجاب الأطفال من أجل تحقيق هذا الهدف الأعلى.
- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً، لعلّ الله يرزقه نسمة، تُثقل الأرض بلا إله إلا الله"37.
- وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "لمّا لقي يوسف أخاه، قال له: يا أخي كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي؟! قال: إنّ أبي أمرني، وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تُثقل الأرض بالتسبيح فافعل"38.
الأولاد أنس للوالدين
الإنسان كائن اجتماعيّ بالفطرة، أي يميل بأصل الخلقة إلى التشكّل داخل وحدات اجتماعية، لأنّه لا يستغني عنهم في تأمين متطلّبات حياته ووجوده، من جهة، كما أنّه يستأنس بالآخرين، ولذا لو بقي الإنسان بمفرده سرعان ما يشعر بالغربة والوحشة، وأصغر وحدة يتكوّن منها المجتمع هي الأسرة، التي تُظلّل حياة الإنسان، وتُخرجه من حالة الوحدة والفرادة التي تجعله يعيش الشعور بالوحشة، إلى حالة السكن والطمأنينة، فالولد يمنح حياة الإنسان أُنساً خاصاً، ويُعطيه إحساساً بالألفة.
- عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: "إذا أبطأ علي أحدكم الولد فليقل: اللهمّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن تفكري، بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً وإناثاً، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة..."39.
- وعن الإمام الصادق عليه السلام، قال: "خمس خصال من فقد واحدة منهنّ لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأوّلها: صحّة البدن، والثانية: الأمن، والثالثة: السعة في الرزق، والرابعة: الأنيس الموافق".
قُلتُ - أي الرواي -: وما الأنيس الموافق؟
قال عليه السلام: "الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والخليط الصالح".
والخامسة: وهي تجمع هذه الخصال، الدّعة"40.
الولد قرّة عين الإنسان وكبده وريحانة قلبه
الولد بضعة من الإنسان حقيقة لا مجازاً. وهذه البضعة على نحو الحقيقة تتقلّب في أعضاء الإنسان على نحو المجاز، فتارة يُعبّر الإنسان عن ولده أنّه عينه التي يرى بها، وأخرى أنّه يده التي تمدّه بالعون، وثالثة أنّه قلبه وفؤاده، ورابعة أنّه كبده...إلخ. ويلحظ في كلّ تعبير جنبة من الجوانب المناسبة للتعبير. وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ الإنسان لا يُمكنه الاستغناء عن الولد كما لا يُمكنه الاستغناء عن أيّ عضو من أعضائه. وهذا ما نُلاحظه بشكل واضح في الروايات.
- وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اطلبوا الولد والتمسوه، فإنّه قرّة العين وريحانة القلب"41.
- وعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد كبد المؤمن..."42.
- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "أولادنا أكبادنا"43.
- وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام يوماً لولده العباس لمّا كان صغيراً: "قل: واحد، فقال: واحد، فقال: قل: اثنان، قال: استحي أن أقول باللسان الذي قُلت واحد اثنان، فقبّل عليّ عليه السلام عينيه، ثمّ التفت إلى زينب، وكانت على يساره والعباس عن يمينه، فقالت:يا أبتاه أتُحبّنا؟ قال عليه السلام: نعم يا بني، أولادنا أكبادنا"44.
- عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده..."45.
العامل الأخرويّ
إنّ الولد ليس نعمة وأنساً وريحانة وعوناً وسنداً... لأهله في الدنيا فقط، بل الولد الصالح ذخيرة لأهله بعد موتهم، فباستغفاره ودعائه وقيامه بالأعمال الصالحة قد يكون نجاتهم من العذاب والنار.
- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم يُنتفع به"46.
- وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مرّ عيسى ابن مريم عليه السلام بقبر يُعذّب صاحبه. ثم مرّ به من قابل47، فإذا هو ليس يُعذّب. فقال عليه السلام: يا ربّ، مررت بهذا القبر عام أول وهو يُعذّب، ومررت به العام وهو ليس يُعذبّ! فأوحى الله جلّ جلاله إليه: يا روحالله، قد أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى يتيماً، فغفرت له بما عمل ابنه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ميراث الله عزّ وجلّ من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده..."48.
- عن معاوية بن عمار، قال: قُلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: "سنّة يسنّها يعمل بها بعد موته، فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الصالح يدعولوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدّق عنهما، ويعتق ويصوم ويُصلّي عنهما.
فقلتُ: أشركهما في حجّي؟
قال عليه السلام: "نعم"49.
- وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: "ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له..."50.
- وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد كبد المؤمن، إن مات قبله صار شفيعاً، وإن مات بعده يستغفر له فيغفر الله له"51.
فانتفاع الوالدين بالولد يوم القيامة ينبغي أن يكون عنصراً مرغِّباً في إنجاب الأطفال، وهذا ما نُلاحظه فيما رواه إسحاق بن عمار، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: "إنّ فلاناً - رجل سمّاه - قال: إنّي كنتُ زاهداً في الولد، حتّى وقفت بعرفة، فإذا إلى جنبي غلام شابّ يدعو ويبكي ويقول: يا رب، والدي والدي، فرغّبني في الولد حين سمعت ذلك"52.
ما للوالدين من الأجر في موت أطفالهم
يقول تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ﴾53.
قد يمتحن الله تعالى الإنسان ويبتليه بموت أطفاله قبل الولادة أو بعد الولادة، ولأنّ الله تعالى كتب على نفسه الرحمة بعباده فقد جعل لمن يفقد أحبّته من الأطفال عوضاً وأجراً وثواباً عظيماً يوم القيامة، فحتّى الطفل السقط يكون له أثر في نجاة والديه يوم القيامة.
- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اعلموا أنّ أحدكم يلقى سقطه محبنطئاً على باب الجنّة، حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يُدخله الجنّة، وإن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته"54.
- وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:... أما علمتم أنّي أُباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسقط، يظلّ محبنطئاً على باب الجنّة فيقول الله عزّ وجلّ: ادخل الجنّة، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي قبلي. فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ايتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنّة. فيقول: هذا بفضل رحمتي لك"55.
- وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ... أوما علمت أنّ الوِلدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم وتُربّيهم سارة، في جبل من مسك وعنبر وزعفران؟"56.
هذه النصوص الدينية بأجمعها، مؤشّر واضح على وجوب سعي الوالدين إلى حسن تربية أطفالهما كي تكون ثمرة تلك التربية وعاقبتها وجود ولد صالح. فالإنسان يأنس ويفتخر ويفرح ويسعد بطفله وولده إذا كان صالحاً، ويأسف ويحزن ويتألّم إذا لم يكن الطفل كذلك، فـ "ولد السوء يهدم الشرف، ويشين السلف"57، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام. وعنه أيضاً: "ولد السوء يعرّ الشرف"58. وعنه أيضاً: "أشدّ المصائب سوء الخلف"59.
* المنهج الجديد في تربية الطفل، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- المحاسن، ج1، ص200.
2- سورة الإسراء، الآية 6.
3- سورة نوح، الآيات 10-11-12.
4- سورة الكهف، الآية 34.
5- سورة سبأ، الآية 35.
6- سورة مريم، الآيات 5-7.
7- الكافي، ج6، ص3.
8- من لا يحضره الفقيه، ح3، ص474، ح4660.
9- الخزاز القمي، علي بن محمد، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، ص273. ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة، ص41، ح22.
10- الكافي، ج6، ص5.
11- من لا يحضره الفقيه، ج3، ص482، ح4690.
12- الكافي، ج6، ص3.
13- الرواندي، النوادر، ص110.
14- الكافي، ج6، ص4.
15- سورة النحل، الآية 72.
16- الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص297. يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الآية: "... النعمة هي جعل الأزواج من أنفسهم، وجعل البنين والحفدة من أزواجهم، فإن ذلك من أعظم النعم وأجلاها، لكونه أساساً تكوينياً يبتني عليه المجتمع البشري، ويظهر به فيهم حكم التعاون والتعاضد بين الأفراد، وينتظم به لهم أمر تشريك الأعمال والمساعي، فيتيسّر لهم الظفر بسعادتهم في الدنيا والآخرة .ولو أنّ الإنسان قطع هذا الرابط التكويني الذي أنعم الله به عليه وهجر هذا السبب الجميل وإن توسّل بأيّ وسيلة غيره لتلاشى جمعه وتشتّت شمله وفي ذلك هلاك الإنسانية".
17- العين، ج3، ص185.
18- معجم مقاييس اللغة، ج2، ص84.
19- أنظر: مجمع البيان، ج6، ص178.
20- يراجع: الطبرسي، مصدر سابق. والطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج14، ص191. والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج8، ص256 وما بعد.
21- البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي، ج3، ص411.
22- الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج2، ص419.
23- الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ج20، ص80.
24- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج8، ص257.
25- الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص297.
26- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج2، ص264. والحويزي، عبد علي بن جمعة العروسي، تفسير نور الثقلين، ج3، ص68. والبحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن، ج3، ص438.
27- معجم مقاييس اللغة، ج4، ص348.
28- العين، ج1، ص268.
29- وفي: الأربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج3، ص307: عيسى بن شج. وفي الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ص1087: عيسى بن الفتح.
30- نسب الدينوري ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، في عيون الأخبار، ج3، ص5، هذا البيت إلى عمرو بن حبيب الثقفي أحد شعراء الجاهلية، أسلم سنة 9 ه. والبيت الثاني منه:
تنبو يداه إذا ما قل ناصره ويأنف الضيم إن أثرى له عدد
31- الخرائج والجرائح، ج1، ص478.
32- الكافي، ج6، ص2.
33- الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات سلوة الحزين-، ص285.
34- معجم مقاييس اللغة، ج5، ص446.
35- الكافي، ج6، ص7.
36- سورة طه، الآية 14.
37- من لا يحضره الفقيه، ج3، ص382.
38- الكافي، ج6، ص3.
39- م.ن، ص7.
40- الخصال، ص284.
41- مكارم الأخلاق، ص224.
42- عوالي اللآلي، ج1، ص270.
43- بحار الأنوار، ج101، ص97.
44- مستدرك الوسائل، ج15، ص215.
45- الكافي، ج6، ص3.
46- عوالي اللآلي، ج1، ص97. ويراجع: النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي، ج6، ص25.
47- قابل: وقت لاحق.
48- الكافي، ج6، ص4.
49- نفس المصدر، ص57.
50- من لا يحضره الفقيه، ج4، ص246.
51- عوالي اللآلي، ج1، ص270.
52- الكليني، الكافي، ج6، ص3.
53- سورة البقرة، الآيتان 155-156.
54- من لا يحضره الفقيه، ج3، ص483.
55- م.ن.
56- الكليني، الكافي، ج5، ص334.
57- مستدرك الوسائل، ج15، ص215، ح18039.
58- عيون الحكم، ص503.
59- ميزان الحكمة، ج4، ص3671.
فطرة الطفل بين الخير والشرّ والحياد
تمهيد
إنّ تسليط الضوء على طبيعة الطفل وحقيقة فطرته يُعتبر من الأبحاث المهمّة من حيث الجواب عن السؤالين البنيويّين التاليين:
السؤال الأوّل: ما هي طبيعة التركيبة الفطرية للطفل بأصل الخلقة، هل هي طبيعة شرّيرة أم خيّرة أم حيادية؟ حيث إنّ تحديد الجواب عن هذا السؤال بأيّ من الافتراضات السابقة يُغيّر من المسار في كيفية تربية الطفل.
السؤال الثاني: هل طبيعة الطفل وفطرته ثابتة غير قابلة للتغيير أم أنّها تتبدّل من حال إلى حال؟ وبعبارة أخرى: هل الطفل الذي يولد شرّيراً بطبعه - بحسب بعض النظريات - يستحيل تغييره بالتربية أم يُمكن تغييره؟ لأنّه إذا كان الجواب بأنّ شخصية الطفل ثابتة لا تتحوّل فهذا يعني عبثية التربية للطفل.
في الجواب عن السؤال الأول يُمكن رصد ثلاث نظريات1:
النظرية الأولى: شريّة طبيعة الطفل
يرى أصحاب هذه النظرية أنّ طبيعة الطفل تميل إلى الأخلاق الذميمة، بمعنى أنّ نفس الطفل جُبلت بأصل الخلقة على الشرّ، وعُجنت طينته بالرذيلة والأطباع الخبيثة والسيّئة، فـ "الشرّ جزء من تكوينه النفسيّ، وبه يندفع إلى العدوان والانحراف. وقد عبّر عن هذه النظرة المتشائمة بعض رجال الدين المسيحي"2. ويترتّب على هذه النظرية أن "تقوم التربية باستخدام وسائل العنف والقسوة لانتزاع الشرّ منه"3.
النظرية الثانية: حيادية طبيعة الطفل
ترى هذه النظرية أنّ الطفل يميل بنحو متساوٍ إلى الخير والشرّ، وبعبارة أخرى إنّ نفس الطفل "من طبيعة محايدة، وإنّما يلحق الفساد بهذه الطبيعة نتيجة لفساد التربية التي يتلقّاها"4. يقول سعيد إسماعيل علي في هذا السياق: "الإشكالية التي شُغل بها الفكر الفلسفيّ والتربويّ والأخلاقيّ من حيث التساؤل عمّا إذا كان الإنسان بطبعه خيّراً أو شرّيراً هي إشكالية زائفة، ذلك أنّ الطبيعة الفطرية للإنسان محايدة، صفحة بيضاء، مثلها مثل المادّة الخام"5.
النظرية الثالثة: خيرية فطرة الطفل
يعتقد أصحاب هذه النظرية بعكس النظرية الأولى، أنّ طبيعة الطفل وفطرته جُبلت على حبّ الخير، فهو يميل إلى الخير والصلاح بأصل الخلقة.
وقفة مع النظريّات الثلاث
سنُحاول في هذه الفقرة التوقّف عند بعض النقاط التي ستُمهّد الطريق لتبنّي الرأي الذي نراه أقرب للصواب من ضمن النظريّات السابقة في الجواب عن السؤال الأول، وسيتّضح بنحو جليّ أيضاً موقفنا من الجواب عن السؤال الثاني خلالها بالتبع.
أولاً: لا ريب في أنّ الطفل في مراحل الطفولة المبكرة وما قبل سنّ التمييز، لا يعرف معنى الخير أو الشر، فإن سُلّم جدلاً بميل طبيعة الطفل نحو أيٍّ منهما فهو ميل فطريّ جبلّيّ غير واعٍ.
ثانياً: لا يُمكن إنكار وجود ردّات فعل طبيعية في الطفل بأصل الخلقة هدته إليها يد الله تعالى، والمقصود بها السلوكات الصادرة عن الغريزة والتي تُسبّبها القوى الطبيعية (الشهوية والغضبية) المجبول عليها الإنسان بأصل الفطرة، كالخوف أو الحبّ... إلخ. ولكن يُطرح السؤال: هل ردّات الفعل النفسانية الطبيعية هذه هي خير أم شرّ أم حيادية؟
في الحقيقة، إنّ النظر إلى ردّات الفعل هذه بلحاظ القوى النفسية الناشئة منها أي بالنظر إلى نفس القوّة الشهوية أو الغضبية لا بدّ من أن يدخل في دائرة الحسن والخير، لأنّ الله تعالى لا يخلق إلّا ما هو حسن جميل، يقول تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾6، فهذه القوى النفسية تعمل بأصل الفطرة بحسب ما يقتضيه طبعها المسخّرة له، إنّما تكمن المشكلة في كيفية توظيف هذه القوى النفسية وتسييرها في أيّ اتّجاه.
وبناءً عليه، وظيفة التربية ليست استئصال هذه الغرائز والانفعالات والأحاسيس النفسية واقتلاعها من جذورها، لأنّ ذلك مستحيل، فكلّ ما زرعته يد الله تعالى بأصل الخلقة يستحيل استئصاله، نعم، يُمكن التعمية عليه ودسّه ودفنه في دائرة الظلمة. فلا يُمكن للتربية إزالة فطرة حبّ الأنا من نفس الطفل، ولا استئصال القوة الداخلية المحرّكة له نحو الحبّ أو البغض أو الخوف أو الحياء أو... بل هو إيجاد حالة من التحكّم والقيادة والسيطرة على هذه الانفعالات بنحو ينضبط السلوك على ضوء التعاليم التربوية الحسنة والجميلة، لذا يُقال بأنّ التربية وظيفتها الدفع وليس الرفع والاستئصال7.
فليس من المعقول تربية الطفل بالطلب منه أن لا يغضب أو لا يشتهي بعض الأشياء، فإنّ هذه الحالات النفسانية أمور طبيعية في ذات فطرته غير قابلة للإزالة، وإنّما المطلوب هو ضبطها وتوجيهها وإرشادها، لا قمعها وكبتها. وإذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع.
ثالثاً: إذا كان المقصود بميل الطفل نحو الخير أو الشرّ بأصل الخلقة هو ذلك النحو من الميل الفطري الجبري الذي يُمانع الاختيار وإمكانية التغيير، فهذا ممّا لا يُمكن قبوله انطلاقاً من عقيدتنا بأنّ الإنسان كائن حرّ مختار، لذا لا بد من البحث عن الميل الفطري نحو الخير أو الشرّ بمعنى يُحافظ على اختيارية الطفل وإمكانية التغيير. لأنّنا نُنكر صحّة نظرية المذهب الطبيعيّ في الأخلاق، التي تعتقد بأنّ الملكات الأخلاقية في الطفل وبالتّالي السلوك الصادر عنها طبيعيّ بأصل خلقته، بمعنى أنّ كلّ طفل يولد مزوّداً بأخلاق تقتضيها طبيعة هويّته على نحو الضرورة، وبالتّالي فإنّ هذه الأخلاق الطبيعية ثابتة وغير قابلة للتغيير والتبديل، ويترتّب على ذلك عدم جدوائية وفعالية العمليات التربوية التي تهدف إلى إكساب الطفل ملكات أخلاقية وسلوكات على خلاف مقتضى طبيعته.
وقد ناقش فلاسفة الأخلاق المسلمون كمسكويه، الغزالي، الطوسي، الكاشاني، والنراقي، وغيرهم هذا المذهب في كتبهم بنحو تفصيليّ8، حيث ردّوا المذهب الطبيعيّ في الأخلاق، بأنّه لو كان صائباً لأُلغيت الشرائع والديانات، ولبطلت تعاليم ووصايا الأنبياء، ولكانت الدعوة إلى التهذيب والتزكية والتأديب وتحسين الأخلاق... عبثاً ولهواً، وجلّ الله تعالى وأنبياؤه عن اللغو والعبث.
كما أنّ التجربة التربوية العملية تفيد بإمكان إزالة الخلق بالأسباب الخارجية من التأديب والنصائح وغيرهما. فزرع القيم التربوية وتعديل سلوكات الطفل أمر ممكن فعلاً بالوصايا والمواعظ والنصائح والإرشاد.
يقول الإمام السيد عليّ الخامنئيّ دام ظله: "صناعة الإنسان وتشكيل وبناء الإنسان المطلوب في الإسلام هو أمر يحصل بالتربية. فإنّ كلّ الناس لديهم قابلية التربية. قد يتقبّل البعض التربية متأخّراً والبعض أسرع، فالبعض قد تترسّخ التربية لديه وتدوم أكثر والبعض قد تُفارقه بسرعة أكبر، لكن كلّ الناس معرّضون للتغيير والتبدّل الذي يحصل بالتربية"9.
رابعاً: وبذلك يظهر أيضاً أنّ الأخلاق والسلوكات الحسنة ليست وليدة الطبيعة لأنّ ما هو طبيعيّ لا تُمكن إزالته وتغييره. نعم الطبيعيّ والفطريّ هو مبادئ وقوى وقابليات واستعدادات تلك الأخلاق والأفعال، أمّا كيفية استخدام هذه القوى والمبادئ فهو خاضع لإرادة الإنسان وخاضع للتربية10.
يقول الشيخ جعفر السبحاني: "إنّ للإنسان ماهيّتين: أولاً: ماهيّة عامّة يتكوّن معها ويتولّد بها. وثانياً: ماهيّة خاصّة يكتسبها في ضوء إرادته عن طريق العمل... أمّا الطبيعة العامة، فهي عبارة عن الطاقات والمواهب الإلهية المودعة في وجوده وهي ميول طبيعية تسوقه إلى نقطة خاصّة فيها سعادته أو شقاؤه، وقد أعطى سبحانه زمامها بيد الإنسان المختار في كيفية الاستفادة منها كمّاً وكيفاً... وأمّا الطبيعة الخاصّة، فهي عبارة عمّا يتكوّن في نفس الإنسان من الروحيات العالية أو الدانية نتيجة استفادته من تلك المواهب الأوّلية، إفراطاً أو تفريطاً أو اعتدالاً"11.
وتربية الطفل في جعله يميل إلى أحد الاتّجاهين إنْ خيراً أو شرّاً إنّما تحصل من خلال تكرار الأعمال المتشابهة بالدربة والعادة لمدّة زمنية معيّنة وطويلة غالباً، فهو الذي يؤدّي إلى إيجاد الصفات الحسنة أو السيّئة في نفس الطفل، لا أنّ الصفات الحسنة بمعنى الملكات موجودة بالفطرة. وهذا يؤكّد أهمّية عدم الإهمال والإغفال للعادات السيّئة التي قد يكتسبها الطفل تحت عنوان أنّه ما زال صغيراً، بل ينبغي الانتباه واليقظة في إيجاد العادات الحسنة عند الطفل حتى لو لم يعِ حسنها، لأنّها ستتحوّل لاحقاً إلى طبيعة ثابتة فيه وتُصبح خلقاً تصدر عنه الأفعال بسهولة.
وبهذا يظهر أنّ التربية ليست مجرّد عملية إعطاء المعرفة وإكساب العلم، وبالتّالي يحصل السلوك تلقائياً، بل التربية هي عملية تنمية اتّجاهات وزرع وتفتّح قيم وتغيير سلوك وإكساب مهارات بالدربة والعادة كي يتّجه الطفل نحو الهدف المطلوب. فالمعارف التي يتلقّاها المتربّي لا تُحرّكه أوتوماتيكياً تجاه السلوك، وإن كانت المعرفة واحدة من مبادئ الفعل. وفي نفس الوقت حذراً من الوقوع في فخّ تحوّل الطفل إلى مجرّد آلة فيزيائية يصدر عنه العمل نتيجة العادة من دون الإحساس بالشحنة القيمية التي تُحرّكه، لا بدّ من إعطاء جرعة إضافية إلى جانب التعويد، وهي جرعة أن يكون العمل الذي تعوّد عليه الطفل صادراً عنه عن قناعة ورغبة وإرادة ذاتية وشعور بالمسؤولية.
وبمعنى آخر لا ينبغي تربية الطفل بنحو يصدر عنه الفعل تحت وطأة الشعور بالحاجة إلى العمل لمجرّد إلحاح تكرار العادة (الإدمان)، بل أن يصدر العمل عن الطفل في المرحلة العمرية التمييزية على أقلّ تقدير انطلاقاً من الوعي بالقيم وانتهاء إلى الوعي بالنتائج. وإلا فإنّ تعويده على قيم معيّنة موجبة أو سالبة من دون وعي وقناعة ورغبة قد يكون السبب في إضعاف الإرادة من ناحية توليد العجز عن مقاومة المتغيّرات، ممّا سيجعله يُعرض عنها بمجرّد أن يصل إلى مرحلة عمرية يُصبح فيها قادراً على الانتخاب والتمييز، أو عرضة لمؤثّرات بيئية معيّنة (مدرسة، صداقة...)، مما يؤدّي إلى انعطافة وتحوّل سريع في أخلاقه وسلوكه، أمّا العادة المنطلقة من إرادة ووعي تمنح الطفل القدرة على التغلّب على كلّ المتغيّرات، بل على طبيعته أيضاً12.
خامساً: يظهر من بعض العلماء المسلمين تعارض مجموع آرائه في كتاباته حول الموضوع13. وفي الحقيقة لا تعارض بين وجهات النظر الثلاث، فإنّ كلّ تعبير ناظر إلى حيثية من حيثيات طبيعة الطفل وإلى قوّة من قواه، فإنّ الطفل له قوى متعدّدة، وبلحاظ كلّ قوّة يُمكن التوصيف بالخير أو الشرّ أو الحياد، فإنّ نفس الطفل بلحاظ كونها من نور الله تعالى وروحه فهي خير وتميل إلى الخير، وبلحاظ قوّة الشهوة والغريزة تميل إلى الشرّ، وبلحاظ كونها مختارة هي مستعدّة لكلّ واحد من الطرفين، بمعنى أنّها غير مجبرة على أحدهما دون الآخر، وإنّما تسير باتّجاه الخير أو الشرّ نتيجة عوامل خارجية لا ذاتية، أي نتيجة التربية والتأديب والتعليم والبيئة... إلخ.
الرأي المختار في المسألة
انطلاقاً ممّا تقدّم، نقول إنّ طبيعة الطفل خيّرة بالطبع وبأصل الفطرة، كما تُفيده النصوص الدينية التي تتحدّث عن الفطرة التوحيدية. ولكنّ الطفل على الرغم من ميله الفطريّ بحسب الصبغة الإلهية إلى الخير ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَ﴾14، لا ينتفي ويرتفع استعداده النفسيّ للسير في الاتّجاهين معاً نتيجة عوامل خارجية كالتربية والبيئة وداخلية كالتفاعلات النفسية مع الأشياء ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورً﴾15، فبسبب عنصر الاختيار يكون لديه استعداد للسير في اتّجاه الخير أو اتجاه الشرّ وهو بهذا المعنى حياديّ، ولكن أيضاً بسبب ضعفه وحاجته وعدم إدراكه ووعيه ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ﴾16، "ضعف الإدراك والجسم في الأطفال"17 من جهة، ونتيجة قواه الحيوانية لأنّه لم يتشكّل على صورة إنسان بعد من جهة ثانية، وبفعل عدم وجود قيم عقلية ودينية تُسيّر تصرّفاته، سيتحرّك على مقتضى ما تُمليه عليه قواه الطبيعية، وبالتّالي سيميل إلى ما تأمره به قوّة الشهوة والغضب وحبّالأنا، ممّا يترتّب عليه آثار ونتائج سلبية وغير حسنة، فهو للسير في اتّجاه الشرّ نتيجة ضعفه وجهله ونقصه وحاجته أوفق ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً﴾18، ﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفً﴾19, ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾20. وهنا يأتي دور التربية في الأخذ بيد الطفل والسير به في أيّ اتجاه من الاتجاهات، فالطفل في المحصّلة هو صناعة التربية.
والتربية قبل ولادة الطفل لها دور في تكوين استعدادات خاصّة فيه، بحيث يولد مجهّزاً بتلك الاستعدادات حتى بالوراثة، ويُصبح فيما بعد من الصعوبة - وليس المستحيل - تدارك تلك الاستعدادات وتحويلها عن مسارها الذي رسم في شخصية الطفل.
وبناءً عليه، نفهم رأي نصير الدين الطوسي في أنّ الطفل يميل إلى الأخلاق الذميمة بسبب ما في طبيعته من النقص والحاجة21. فهذه النظرية التي يتبنّاها الطوسي ليست في مقام البيان من جهة الفطرة والجبلّة، وإنّما في مقام البيان من جهة العمل والسلوك، بمعنى أنّ الطفل لأنّه ليس كائناً عقلائيّاً ومتشرعيّاً، فإنه سيميل إلى طاعة الغريزة والشهوة، وهي بطبعها تُحرّكه نحو تحقيق ما فيه لذّته الشهوية والمادّية، وبعبارة أخرى إنّ الطفل لو خُلّي وقواه النفسية الشهوية والغضبية مع جهله وضعفه وعدم تزوّده بقضايا العقل العمليّ والوحي كضوابط للقيم والسلوك، سيجعل قواه تجذبه نحو تحقيق ما يُلائمها ويُنافرها، وهو بحسب الغالب يكون سيراً باتّجاه القبح أكثر منه نحو الحسن، لذا يُنبّه في هذا المجال فيقول الطوسي: "عندما تتمّ أيام رضاعه يجب الانشغال بتأديبه وتدريبه على الأخلاق الفاضلة قبل أن يتعوّد على الأخلاق الفاسدة، إذ يكون الطفل مستعدّاً لها، وأكثر ميلاً للأخلاق الذميمة بسبب ما في طبيعته من النقصان والحاجة"22.
وفي ذات السياق، يقول الفيض الكاشاني: "إنّ الصبيّ إذا أُهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأكثر رديّ الأخلاق، كذّاباً، حسوداً، سروقاً، نمّاماً، لجوجاً، ذا فضول وضحك، وكيّاد، ومجانة، وإنّما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب"23.
إذاً، لا تنافي بين النظرية التي ترى أنّ الطفل خيّرٌ بطبعه وبين ما يذهب إليه بعض الحكماء المسلمين في بعض كلماته من ميل الطفل إلى الشرّ والأخلاق الرذيلة، فإنّ النظرية الأولى تُفيد أنّ طبيعة الطفل بأصل الفطرة تميل إلى الخير والتوحيد وقبول الدين، ولكن هذا لا يعني أنّه تلقائياً لو خُلّي الطفل وطبعه وبيئته وتربيته ستذهب نفسه في هذا الاتّجاه، بل تسلك اتّجاهاً آخر يتناسب مع البيئة الاجتماعية والتنشئة والتربية، لأنّ الميل الفطريّ نحو الخير لا يُنافي الاستعداد الطبيعيّ بسبب قوّة الاختيار الكامنة فيه إلى الطرفين معاً. وبهذا التفسير نفهم قول الإمام عليّ - لولده الحسن - عليهما السلام: "إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما أُلقي فيها من شيء قِبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك"24، بنحو لا يتنافى مع قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "كلّ مولود يولد على الفطرة"25.
حقّ الطفل في الخطأ
نختم الدرس بنقطة بنيويّة في كيفية التعامل التربويّ مع الطفل، وهي أنّه سواء أكانت طبيعة الطفل خيّرة أم شرّيرة أم حيادية، فإنّ هذا لا يعني أنّ الطفل لن يقع فيما نراه نحن الراشدون أنّه خطأ أو خطيئة، لأنّ الطفل نتيجة جهله المطلق وضعفه ونقصه يسير في طور الاكتشاف لذاته وللمحيط من حوله، ومن الطبيعيّ أن يقع في الخطأ، فإنّه يتعلّم من أخطائه، لذا يُمكن تأسيس قاعدة عامّة في سياق تربية الطفل، وهي مراعاة حقّه في أن يقع في الخطأ.
عن الإمام الباقر عليه السلام: "أنّ علياً عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ..."26.
وعن الإمام الصادق عليه السلام، قال: "عمد الصبيّ وخطؤه واحد"27.
وقد وقع الاختلاف في وجهات النظر عند الفقهاء في كون هذه الروايات مختصّة بباب الديات والجنايات أم أنّها عامّة ومطلقة. وقد استظهر بعض الفقهاء منها عدم الاختصاص بباب الجنايات، منهم الشيخ الأنصاري حيث قال: "كل حكم شرعيّ تعلّق بالأفعال التي في ترتّب الحكم الشرعيّ عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن الصبيّ28 قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد"29. وهذا مؤشّر إلى أنّ الفعل العمديّ الصادر عن الطفل - حتى المميّز، فكيف بالطفل دون سنّ التمييز - يُنزّل في الشريعة الإسلامية منزلة الخطأ، ويتمّ التعامل معه كالتعامل مع المُخطئ.
هذا، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المعنى السابق من أحاديث: "رفع القلم30 عن الصبيّ حتّى يحتلم"31. يقول الشيخ محمد حسين النائيني: "إنّ الظاهر من قوله عليه السلام: "رفع القلم عنه"، ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم: من أنّ فلاناً رفع القلم عنه، ولا حرج عليه، وأعماله كأعمال المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أنّ عمله كالعدم، ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله، ولا يمضي عنه، فإنّ ما صدر عنه لا يُنسب إليه"32.
وهذا يُشعر بأنّه من حقّ الطفل الوقوع في الخطأ. والمقصود بالحقّ هنا الحقّ القانونيّ والأخلاقيّ والطبيعيّ، لكون وقوع الطفل في الخطأ سنّة طبيعية في مراحل نموّه، فما نُصّنفه نحن الراشدون في دائرة الخطأ لا يُصنّفه الطفل في مراحل طفولته المبكرة كذلك، خصوصاً في مرحلة ما دون التمييز، لعدم معرفته بمعنى الصواب والخطأ33.
يبقى أن نُشير إلى نقطة أخيرة - ستتضح ملامحها خلال درس التربية بالعقوبة - وهي أنّ حقّ الطفل في الوقوع بالخطأ لا يعني إقراره على خطئه، أو عدم تنبيهه وإرشاده وتوجيهه إلى الصواب، أو التساهل والتسامح معه في كلّ خطأ كان وبأيّ مرحلة عمرية كانت.
* المنهج الجديد في تربية الطفل، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- يراجع: العطاران، محمد، تربية الطفل وفقاً لآراء ابن سينا والغزالي والطوسي، ص27-30.
2- أبو دف، محمود خليل، مشكلة العقاب البدني في التعليم المدرسي وعلاجها في ضوء التوجيه التربوي الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد السابع، العدد الأول، يناير 1999.
3- تركي، عبد الفتاح ابراهيم، فلسفة التربية- مؤتلف علمي نقدي، ص32.
4- تركي، فلسفة التربية- مؤتلف علمي نقدي، ص32.
5- علي، سعيد إسماعيل وفرج، هاني عبد الستار، فلسفة التربية رؤية تحليلية ومنظور إسلامي، ص299.
6- سورة السجدة، الآية 7.
7- جامع السعادات، ج1، ص49.
8- يراجع مثلاً: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ج8، ص101. والنراقي، جامع السعادات، ج1، ص46-49.
9- من كلمة للسيد علي الخامنئي في لقاء المعلمين والتربويين بمناسبة أسبوع المعلم بتاريخ:07/05/2014. على الرابط التالي: htt p://www.almanar.com.lb/wa padetails. php?eid=840376.
10- أرسطو، أخلاق نيكوماخوس، ص36-37.
11- المكي، حسن محمد، الإلهيات على ضوء الكتاب والسنة العقل محاضرات الشيخ جعفر السبحاني-، ج1، ص681.
12- يراجع: الطوسي، نصير الدين، أخلاق ناصري، ص101-103.
13- فمثلاً نرى الغزالي في موضع يقول: "حبّ الإنسان للحكمة والخالق عزّ وجلّ والمعرفة والعبادات لن يُماثل الرغبة في الأكل، إذ إنّه من مقتضيات طبيعة الإنسان، وذلك لأنّ قلب الإنسان من الأمور الربّانية فيما يعد اندفاع الإنسان إلى الرذائل من مقتضيات الشهوة، ولا علاقة له بالطبيعة". كيماء السعادة، ج3، ص499. وفي موضع آخر من نفس الكتاب، ص37، يقول: "اعلم أنّ النفس مجبولة على الابتعاد عن الخير والتعلّق بالشر، وترغب في التقاعس والشهوة". وفي كتاب آخر يقول: "إنّ الصبيّ أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كلّ نقش وصورة، وهو قابل لكلّ نقش ومائل إلى كلّ ما يمال به إليه، فإن عوّد الخير وعلّم نشأ عليه، وسعد في الدّنيا والآخرة، شاركه في ثوابه أبواه، وكلّ معلّم له ومؤدّب، وإن عوّد الشرّ وأهمل شقي وهلك". إحياء علوم الدين، ج8، ص130. وهذا الرأي يظهر منه أن الطفل مجبول على الخير بمعنى أن نفسه تميل إلى الخير أكثر من الشر.
14- سورة الشمس، الآية 8.
15- سورة الإنسان، الآية 3.
16- سورة الروم، الآية 54.
17- مغنية، محمد جواد، التفسير المبين، ص538. ومغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، ج6، ص151. قال:" ضعف البنية والإدراك في الطفل".
ويراجع: مجمع البيان، ج8، ص485. في تفسير الآية: "خلقكم أطفالاً لا تقدرون على البطش، والمشي، والتصرفات". وشبّر، عبد الله، تفسير القرآن الكريم، ص390، قال: "أي ابتدأكم أطفالاً ضعافاً". والميزان في تفسير القرآن، ج16، ص215، قال: "أي ابتدأكم ضعفاء، ومصداقه على ما تفيده المقابلة أول الطفولية".
18- سورة الأحزاب، الآية 72.
19- سورة النساء، الآية 28.
20- سورة يوسف، الآية 53.
21- أخلاق ناصري، ص280-284.
22- أخلاق ناصري، ص280.
23- الفيض الكاشاني، محمد بن المرتضى، المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، ج5، ص125.
24- نهج البلاغة، من وصية له لولده الحسن كتبه إليه بحاضرين منصرفاً من صفين، رقم269، ص526.
25- الصدوق، محمد بن علي، التوحيد، ص363.
26- تهذيب الأحكام، ج10، ص233، ح921.
27- م.ن، ص233، ح920.
28- الصبي من باب التغليب، وإلا فهو يشمل كل طفل سواء أكان ذكراً أم أنثى، ولا خصوصية للطفل الذكر.
29- الأنصاري، مرتضى، المكاسب، ج3، ص282.
30- المقصود برفع القلم هو إما: رفع الأحكام الإلزامية، أو رفع مطلق الأحكام الإلزامية والترخيصية، وبالتالي رفع المؤاخذة والعقاب، وإما رفع المؤاخذة والعقوبة، وإما رفع الاثنين معاً، أي الأحكام والمؤاخذة.
31- روي الحديث بألفاظ مختلفة، مثل: "عن الصبي حتى يدرك"، "عن الصبي حتى يبلغ"، "عن الصبي حتى يحتلم"، "عن الصبي حتى يكبر"، "عن الصبي حتى يعقل"، "عن الصبي حتى يشب". يراجع: الطوسي، الخلاف، ج2، ص41. وسائل الشيعة، ج1، ص20. والبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج6، ص169. والسجستاني، أبي داود، سنن أبي داود، ج2، ص338. والترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج2، ص438.
32- الخوانساري، موسى بن محمد، منية الطالب في شرح المكاسب، تقرير بحث الميرزا محمد حسين النائيني، ج1، ص359.
33- أنظر: عجمي، سامر، عقوبة الطفل في التربية الإسلامية، ص240 وص305.
نهاية حلم السلام في أرض الزيتون
تستمر مغامرة إكمال لغز "صفقة القرن" مع وضع القطع الأخيرة في مكانها حيث تتضح مخاطر هذا المخطط المعادي للفلسطينيين أكثر فأكثر، إلا أن أحدث قطعة من هذا اللغز مكّنت من فكّ شيفرة المشروع النهائي بشكل كبير، وهو إقرار قانون "الدولة القومية اليهودية" في الكنيست خلال الأيام الماضية، ولقد تم إقرار القانون الجديد في 19 يوليو 2018 بأغلبية 62 صوتاً ومخالفة 55 صوتاً من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست. وكان مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في 10 مايو 2017 بأغلبية 48 صوتاً من أعضاء التحالف الحكومي ومخالفة 41 صوتاً في البداية، محاولة بدأها الجناح اليميني الصهيوني في عام 2011 من أجل "تكريس اليهودية"، وفي النهاية وبعد مرور 7 سنوات تمكّنوا من تمرير القانون في الكنيست.
في النسخة الأولية لقانون "الدولة اليهودية القومية" كان بإمكان مجالس المستوطنات والمناطق اليهودية منع توطين العرب وغيرهم في هذه المستوطنات من أجل "حفظ وحدتها"، وقد واجه هذا المبدأ والمبادئ الأخرى منذ البداية معارضة قوية حتى من قبل رئيس الجمهورية والمدعي العام للكيان الصهيوني، كما أن العرب الذين يسكنون في المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرة هذا الكيان يعارضون بشدة هذا المبدأ ما أدّى إلى إجراء بعض التعديلات في النسخة النهائية للتصديق عليها في الكنيست.
وتعتبر الحكومة توسيع الأجزاء اليهودية في النسخة المُصوّت عليها "قيمة وطنية" يجب تعزيزها كذلك يضمن قانون "الدولة اليهودية القومية" "حق جميع اليهود في العالم بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على التبعية الإسرائيلية"، وكذلك "تعزيز علاقات إسرائيل مع يهود العالم" و"الحفاظ على التراث الثقافي واليهودي والتاريخي للأمة اليهودية في العالم".
ومن ناحية أخرى، تعتبر القدس كلها بموجب القانون ملكية يهودية يجب أن تكون بالكامل تحت سيطرة الكيان الصهيوني، وستكون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة، وتوضّح البنود المهمة في هذا القانون بداية عهد جديد في الكيان الصهيوني يقوم على إعطاء الأولوية للشعب اليهودي على جميع القيم المُسماة بالديمقراطية، ويبين هذا القانون الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وسياسييه الذين لبسوا على مرّ السنين نقاب الديمقراطية على وجوههم، ومع ذلك ما يطرح نفسه حالياً هو تأثير قانون "الدولة اليهودية" على وضع الفلسطينيين وكيف سينتهي الأمر بعقود طويلة بين الكيان الصهيوني والمسلمين في الأراضي المحتلة ردّاً على هذا السؤال المهم يمكننا أن نذكر ثلاثة تأثيرات مهمة.
ضياع الآمال الواهية للصلح وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى موطنهم الأساسي
أهم تبعات سنّ قانون "الدولة اليهودية القومية" يمكن مشاهدتها في القضاء على عقود طويلة من الأمل في المصالحة والسلام بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وفي الواقع بعد إقرار هذا القانون خاب ظن جميع الحركات السياسية وحتى الشخصيات السياسية العربية في البرلمان والحكومة الصهيونية بمستقبل السلام والتطورات المستقبلية في الكيان الصهيوني، وتحدثوا بصراحة عن عنصرية القانون.
وفي السياق ذاته، اتضح أيضاً أن النواب الفلسطينيين العرب في البرلمان الإسرائيلي الذين كانوا من أشدّ المعارضين لهذا القانون رأوا في التصويت على القانون "موت الديمقراطية وظهور العنصرية ضد غير اليهود"، وقد بادروا في خطوة رمزية بتمزيق مشروع القانون وهددوا بالاستقالة وإسقاط حكومة نتنياهو.
ومن ناحية أخرى، فإن إقرار القانون يضفي الشرعية على عنصرية الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وسيوقف قضية عودة النازحين التي طُرحت في جميع المفاوضات منذ قيام الكيان الصهيوني عام 1948، بل يمكن القول أيضاً إن مبادئ بعض التيارات المُصلحة ستكون طي النسيان فإذا كان هناك القليل من الأمل في الماضي من أجل عودة النازحين وعملية السلام، فقد أصبحت هذه القضية الآن تحت ظل التمييز العرقي والعنصري للكيان الصهيوني.
تكريس العنصرية في الكيان الصهيوني
من التبعات الأخرى في سنّ قانون "الدولة اليهودية" هو تكريس الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، وفي الواقع هناك مليون و800 فلسطيني، بمن في ذلك العرب الفلسطينيون والمسيحيون والدروز والشركس واتباع الأحمدية والعرب في البادية في الأراضي المحتلة، وهم يمثلون 21٪ من مجموع السكان البالغ 9 ملايين نسمة في حين يشكّل العرب الإسرائيليون 17.5٪ من السكان، والآن بموجب القانون الجديد سيتم التخلي عن اللغة العربية التي كانت من قبل واحدة من اللغات الرسمية في الكيان الصهيوني، وستحلّ محلّها اللغة العبرية حصراً، إضافة إلى ذلك، فإن فكرة الأمة والدولة الواحدة القائمة على تفضيل اليهود على الشعوب هي بوضوح تمييز عنصري عظيم في تل أبيب ضد غير اليهود، وفي المستقبل يمكن أن تشكّل ظلماً أكبر للأقليات.
انتهاء مشروع "قيام دولتين" وتجلّي الخيانة في محادثات السلام
إن من عواقب قانون "الدولة اليهودية القومية" الإعلان عن انتهاء مشروع قيام الدولتين بناءً على الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبموجب القانون الجديد فإن مدينة القدس بالكامل (غير مقسّمة إلى أجزاء شرقية وغربية) ستكون عاصمة الكيان الصهيوني، وسيكون لليهود الحق في إنشاء أماكن خاصة بهم في المدينة.
في حقيقة الأمر تم تمرير القانون في ظروف جعلت من إنشاء دولتين أمراً مستحيلاً إلى حد كبير بسب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومع إقرار القانون الجديد في الكنيست يمكن التعبير عن نهاية قيام الدولتين، وبعد كل المجريات يمكن الآن التحدث بملء الفم عن خيانة أمريكا وبعض الدول العربية، والتي نتيجة لدعمها تل أبيب، وفّرت الأساس لإقرار مثل هذا القانون المناهض لحقوق الإنسان والمخالف للقوانين الدولية.