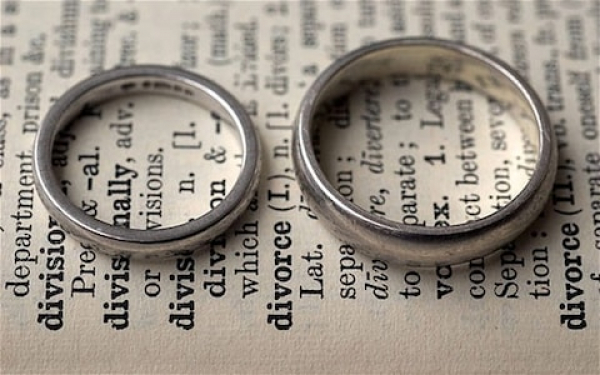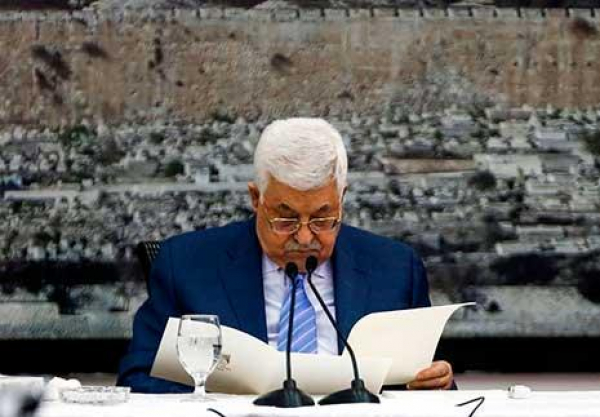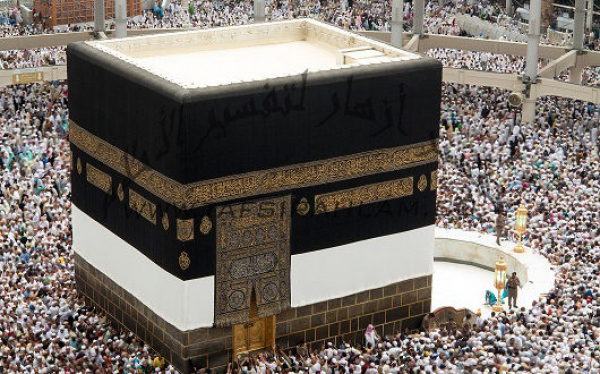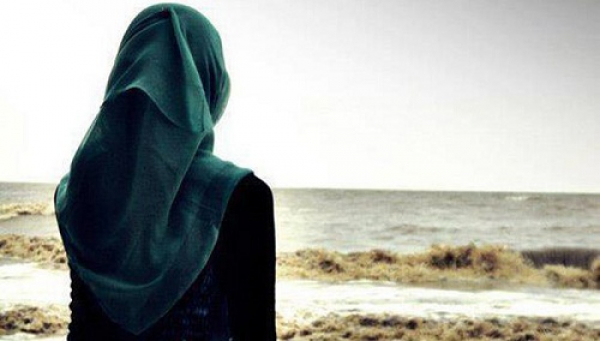Super User
الحقوق الزوجية المشتركة في الشريعة
لكي تكون العلاقة بين الزوجين واضحة المعالم وحتي لا يكون هناك أدني غموض أو التباس في تحديد المسؤوليات والواجبات.. رسم الإسلام حدود هذه العلاقة وأقام أساسها علي مبادئ جعلت للزوجين بمقابلها حقوقا مشتركة.. فما هي تلك الحقوق كما وردت في القرآن والسنة؟
للإجابة عما سبق يقول فضيلة الدكتور طه أبو كريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية: أمر الله تعالي عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها, فقال تبارك وتعالي: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, المائدة:1].ومن أغلظ العقود عقد النكاح, ولذلك قال الله عنه: وأخذن منكم ميثاقا غليظا, النساء:21].ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين, فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك, وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه, ومن أهمها:-( أولا):حق الإستمتاع والذي مهد التشريع الإسلامي الطريق الصحيح له في العلاقة الزوجية بل دعا إليه وحث عليه وجعل في ذلك أجرا ومثوبة حيث ثبت من الحديث قالوا يا رسول الله: أو يأتي أحدنا أهله بها أجر؟, قال صلي الله عليه واله: نعم وهل إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلي. قال كذلك إن وضعها في الحلال له بها أجر. وبهذا المقصد ارتفعت الشريعة بالعلاقة الزوجية عن الشهوة الحيوانية المجردة فكان الحب والوئام مصدرين من مصادر السكن والإنسجام حيث قال تعالي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آية21 سورة الروم.
( ثانيا):( المعاشرة بالمعروف):فلكل من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف; مصداقا لقوله- تعالي-: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, البقرة:228],, والمقصود من قوله- سبحانه-: بالمعروف, هو العطاء بلا من, والبذل للمودة والرحمة والمحبة, ومعاملة حسنة من كلا الطرفين للآخر,. وحسن الحديث حيث قال تعالي: وقولوا للناس حسنا واحترام الرأي فيما تقتضيه الحياة الزوجية من أسباب السعادة والإطمئنان.
(ثالثا): ثبوت النسب فهو من الغايات السامية التي يرنو إليها الزواج من بقاء النوع الإنساني عن طريق شرعي, فالأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية, فأوجبت الشريعة نسب كل فرد لأبيه حتي لا تختلط الأنساب وتضيع الأولاد فيتربون في ظل محبة وحنان وفي كفالة الأبوين حيث قال تعالي: وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفالبقرة.233 وقد أمر صلي الله عليه واله. الآباء بأن ينسبوا أولادهم إليهم ونهاهم عن إنكار أبوتهم حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه علي رءوس الأشهاد.
( رابعا) ومن الحقوق المشتركة كذلك حرمة المصاهرة والتي معناها علاقة الرجل والمرأة بسبب الزواج تقتضي تحريم الزواج بنوع معين من النساء, والمحرمات من النساء بسبب المصاهرة أربعة: الأولي بنات الزوجات وهي المسماة بالربيبة وهي التي تربت في حجر زوج أمها وتحرم بذلك بنات الربائب وبنات أولادهن وإن نزلن. والثانية: أم الزوج وأم ابنها أو أم الزوجة وجدتها من قبل أبيها أو أمها وإن علون نسبا ورضاعة سواء دخل العاقد بالزوجة أو لم يدخل متي كان العقد صحيحا عند الجمهورحيث قالوا: العقد علي البنت يحرم الأم. والثالثة:زوجة الإبن وابن الإبن وإن نزل سواء كان الإبن صلبا أو من الرضاع, فزوجة الإبن محرمة علي أبيه دخل بها أو لم يدخل حيث قال تعالي:وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكمالنساء.23 وتعبيره سبحانه وتعالي بقوله من أصلابكم لإسقاط تحريم زوجة الإبن بالتبني.والرابعة: زوجة الأب والجد وإن علا من نسب أو رضاع حيث قال تعالي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا النساء.22
(خامسا): وأخيرا من الحقوق المشتركة بين الزوجين ثبوت التوارث: فقد أصبح لكل من الزوجين- بموجب الزوجية- حق في مال الآخر, وهذا بلا شك طبيعي لما في الحياة الزوجية من المشاركة والود والوئام.
لماذا تتغير المرأة بعد الزواج؟
"أنت تغيرت، هذه ليست الفتاة التي تزوجتها" كلمات يقولها أغلب الرجال لزوجاتهم، ولكن تختلف في توقيتها؛ فالبعض يقولها بعد أيام من الزواج، والبعض يقولها بعد شهور من الزواج، لكن.. كل الرجال يقولونها لزوجاتهم في يوم من الأيام، بعد سنوات قد تقل أو تكثر، فلماذا تتغير المرأة؟
معاني التغيير
والتغير الذي يطرأ على المرأة يقصد به معانٍ كثيرة منها:
- تغير عودة للأصل أو لطبيعة المرأة الحقيقية، فبعض الفتيات تعتقد أن الخطوبة فترة التجمل والتزين وإخفاء الحقيقة عن الطرف الآخر فتتجمل المرأة وتظهر بصفات غير صفاتها، ولكنها بعد الزواج لا تستطيع تكملة الكذبة خاصة أن هدفها تحقق، وهذا التغير صعب التغلب عليه؛ لأنه الحقيقة التي نجحت الفتاة في إخفائها في البداية والتي لا بد أن تظهر في النهاية، وعلى الرجل أن يتكيف مع المرأة الجديدة التي اكتشفها بعد الزواج.
- والتغير الآخر وهو المقصود في هذا التحقيق هو التغير الذي يسببه الزمن ومسئوليات الحياة، مثل التغير في الوزن، والتغير في الأهواء والميول، والتغير في الاهتمامات، والتغير في علاقة المرأة بزوجها.
- والتغير الثالث هو تغير يتمناه أغلب الرجال وهو تغير للأفضل، فبعد سنوات من الزواج الناجح تصبح الزوجة وزوجها كيانا واحدا يفهم كلاهما الآخر، ويكمل بعضهما البعض، وهذا التغير لا يتحقق إلا في البيوت التي يسودها الحب والتفاهم.
أسباب التغير
وعن أسباب التغيير التي تحدث للمرأة بعد الزواج تؤكد الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الزوجية
بشكل عام يتغير أغلب السيدات بعد الزواج، وهذه ليست ظاهرة طبيعية لها سبب علمي وإنما تعود أسباب المشكلة لشخصية المرأة وأسلوب نشأتها، فنحن لم نرب أطفالنا على أشياء مهمة منها:
حسن استغلال الوقت وتقسيمه بين المسئوليات المطلوبة منهم مثل المذاكرة، وممارسة الرياضة، والمساعدة في أعمال البيت؛ حتى تستطيع المرأة بعد الزواج تقسيم وقتها بين عملها وبيتها وزوجها وأولادها فلا تجور مسئولية على حساب الأخرى.
كما يعتبر تدريب الفتيات منذ الصغر على أعمال البيت تدريبا تدريجيا لهن على تحمل مسئولية بيوتهن بعد الزواج، وبالتالي تستطيع القيام بواجبها دون التقصير فيه أو في حق الزوج والأبناء.
تعليم الأولاد المشاركة والتعاون في أعمال المنزل يشجعهم على معاونة ومساعدة زوجاتهم أو على الأقل الاعتراف بالمجهود الذي تبذله الزوجة في أعمال البيت.
ولا ننكر أن مسئولية البيت والأولاد الملقاة على عاتق المرأة كبيرة وثقيلة -خاصة إذا كانت الفتاة لم تتعود دخول المطبخ أو الأعمال المنزلية سابقا- ويزداد ثقلها بعدم تعاون الزوج معها أو على الأقل تشجعيها بكلمات تحمل معنى الحب والاعتراف بمجهودها لتعطيها الدافع للاستمرار في العطاء دون كلل أو ملل، وإذا حدث العكس أي قامت المرأة بمسئوليتها تجاه بيتها وأولادها، ولم تجد الزوج المتعاون معها بدأ عليها علامات التغير، والمتمثل في إهمالها لمظهرها وعملها وأحيانا بيتها وزوجها ويظهر نتيجة التغير نفسيا وجسمانيا وجنسيا. ونفسيا أي ليس لديها الدافع في الاهتمام بهندامها ورشاقتها ما دام أنها في كل الأحوال لا تعجب زوجها، ولا تسمع منة كلمة إعجاب أو ثناء على أي عمل تقوم به، وجسمانيا متمثلا في الإرهاق البدني والشكوى من الآلام في العظام والضغط، وأخيرا جنسيا وهو وضع طبيعي لكل المعاناة التي تعانيها المرأة طوال النهار
كيف تسرقين قلب زوجك؟
عالم الرجل و المرأة، عالم مليء بالمشاعر و الأحاسيس المختلفة.. تبحث فيه المرأة عن طريقة ، ترضي بها الرجل لتجذبه إلى حديثها و تغريه بابتسامتها ، و تحافظ عليه في عشها.. فلا تعجب عيناه بغيرها ، و لا تمتد يده إلا لتضم أناملها الرقيقة.
لكن هل مازالت أنا ملك رقيقة كما عرفها؟ هل تركت نفسك فريسة سهلة أمام ظروف الحياة بين العمل خارج المنزل و داخله، و فقدت الأنثى بداخلك؟ هل تحولت إلى سيدة اهتماماتها و أولوياتها ، تنحصر في تجهيز الطعام ، و العناية بالأطفال ، و نظافتهم ، و تربيتهم ، و ترتيب المنزل ، و الاعتناء بنظاف ملابس الزوج فقط؟
الرجل ، يبحث عن امرأة تملأ عالمه و تلحق في سمائه.. معها لا يشعر بأعوامه التي تجري.. و يجد في اهتمامها به حنان أمه.. وفي مساندتها الصديق المخلص.. وفي عذوبة صوتها منتهي الدلال و الرقة..
إذا كانت الأنثى بداخلك تصرخ لتعلن عن وجودها.. اتركي لها مساحة اقرئي هذه الأسرار الصغيرة.. فقد تساعدك على الاستعادة الحب الضائع من حياتك الزوجية.
1- دبري له موعدا على العشاء
تخلصي من عناء يومك، و اكسري روتين الحياة اليومية الممل ، و دبري له موعدا غراميا ، تلتقيان فيه بمفردكما ، لتجمعكما طاولة واحدة على ضوء الشموع ، تسترجعان بها تفاصيل الحب ، الذي جمعكما يوماً ما ، بحثاً عن تجديده ، و إحياء تفاصيله الجميلة.. لكن انتبهي، لا تقضيا السهرة في الحديث عن العمل و لا تبدئيها بعتاب على موقف قام به وضايقك.. بل امسحي على أنامله برقة و دلال.. أطعميه من طبقك قطعا صغيرة.. و اهمسي في أذنه بكلمات حب رقيقة ، و حافظي على ابتسامتك و لا تدديها.
إجعلي موعد الغرام هذا في توقيت مختلف شهرياً حتى لا يتوقعه، و قومي بحجز طاولة مختلفة في مطعم جديد كل مرة، احرصي على أن تكون الأجواء دائما مناسبة و رومانسية.. هذا الموعد، لا بد أن يجمعكما دون الأطفال و دون أي فرد من العائلة، فقط أنت وهو على ضوء الشموع.
لا تختاري ملابسك العادية التي ترتدينها يومياً ، بل تميزي في هذا اليوم، و يمكنك في الموعد الأول شراء طقم جديد لتتألقي به.
يمكنك أن تقومي بالتخطيط لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في مكان مختلف ، و فكراً معاً ، و اختارا المكان الذي يعجبكما.
2- دعية يشعر بحاجتك إليه
يسعد أي رجل في العالم عندما يشعر أن زوجته تحتاج إليه أو إلى رأيه،
فكيف سيكون حال زوجك لو وجدك ، تبحثين عن نيل رضاه ، و أن لديك رغبة قوية في معرفة رأيه في شيء ما لتنفذيه؟
هل تتمتعين بشخصية مستقلة ،لا تعتمد على أحد؟ إذا كانت إجابتك بنعم، اكسري القاعدة ولو لمرة واحدة ،و تسللي إلى داخله ، لتعرفي رأيه في كتاب تريدين شراءه، أو قطعة من الملابس تعجبك ، و راقبي ردة فعله ، لتعرفي أهمية ، أن تكون له بصمة في اختياراتك.
كما أن شعور الرجل باحتاج امرأته له يسعده، دعيه يشعر أنك بين يديه تجدين الأمان و تشعرين بالسعادة و تحتاجين إليه.
3- حافظي على أنوثتك
تفقد المرأة الكثير من بريقها و أنوثتها في عيني زوجها عندما تهل نفسها ، و تترك أنوثتها فريسة للإهمال، فيراها زوجها بملابس غير متناسقة أو تفوح منها رائحة التوابل و الأطعمة، عليك الاهتمام بأنوثتك وجمالك ،حتى لا ينفر زوجك من مظهرك العام.
حافظي على جمالك في عينيه ، فصففي شعرك كما يحب ، و أحرصي على ترتيب ملابسك، و التحلي بزينة مناسبة، و ارتدي بلوزة أنيقة داخل المنزل أو تتورة قصيرة مرتبة، فلا تدعيه يراك بملابس النوم طوال مدة بقائه في المنزل ، حتى لا يمل منك ، كما أن عليك التطيب برائحة جميلة ، تخفي رائحة التوابل.
يعتبر الرجل الشرقي الشعر سر جمال المرأة، فلا تهملي شعرك، أطلقيه ليسترسل على ظهرك ، و احرصي على لون شعرك، فلا تتركي الشيب يغزوه ، لأنك مشغولة ، و لا تجدين الوقت الكافي لتصبغيه.. يمكنك تدبر أمرك ، و زيارة صالون التجميل ليلونه لك بسرعة و سهولة دون أن تجهدي نفسك.
فالأنوثة هي مظهر خارجي ملفت و جذاب مع صوت هادئ، و كلمات تحمل الحب و تزينها ابتسامه ، تشرح الصدر.
4- اهتمي بمجال عقلك
من الأسباب التي تدفع الرجل للهروب من حديث زوجته، هو أن يقتصر حديثها على الطعام و الشراب و مشكلات الأولاد و سعر الخضراوات و الفاكهة الذي لا يتناسب مع طعمها.
ينجذب الرجل إلى المرأة الواعية المثقفة ،التي تهتم بأمور الحياة ، و لا تعيش على هامشها، لذا عليك أن تتعرفي على القضايا ، التي تدور على الساحة و كوني وجهة نظر خاصة بك لتعبري بها عن مواقفک و نظرتك للأمور و ستجدين أن زوجك يتوق لمناقشتك و التحاور معك و الاستفادة من ثقافتك و التباهي بك.
5- لا تكشفي عن آثار العمر
بالطبع يعرف زوجك عمرك الحقيقي، ولكنه لا ينتبه إلى التفاصيل الصغيرة و الخطوط الرفيعة التي تعلو ملامحك.. فلا تلفتي انتباهه إليها.
يدعوك الخبراء إلى تجنب التحدث عن الزمن و الشباب الذي ضاع و العمر الذي جرى، كما أن عليك ألا تلفتي نظره إلى الخطوط الرفيعة التي تحتل مكانها إلى جانب عينيك، أو على طرفي فمك، حتى لا يشعر زوجك أنك تقدمت في العمر ، و أن مظاهر الشيخوخة ،بدأت تظهر عليك.
أخفي أسرارك صديقتي و اكتمي نبأ استعمالك كريما خاصا لشد البشر ة و إزالة الترهلات، و لا تفصحي له عن الريجيم الذي تتبعينه و اتبعيه في الخفاء حتى لا يواجهك إذا فشلت بالتهكم أمام الآخرين.. عليك أن تحرصي على كتم هذه الأسرار الصغيرة، و ألا تفصحي له عنها حتى تحفاظي على نظرته لك طوال الوقت.
6- حدثيه عن مشاعرك
هل فكرت يوماً في أن ترسلي لزوجك رسالة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لا الشوق و الحنين، تعبرين بها عن مشاعرك و تسرقين بها ابتسامته في وضح النهار؟
ستكتشفين بنفسك ، أن هذه التصرفات الرومانسية الرقيقة لها رد فعل تطالبينه فيها بشراء أي غرض، و لا تحملي سوى كلمة واحدة من كلمات الحب أو جميل ،كما أنها معبرة و مؤثرة، فالرجل يحب المرأة ، التي تحيره ، و ليست التي يعرف كل أسرارها ، فلا تستطيع أن تفاجئه أبداً. اشغلي عقله و ارسمي البسمة على شفتيه و كوني مبتكرة دائماً ، حتى تثيري قلبه وعقله.
7- اصنعا الذكريات المشتركة
اصنعا ذكرياتكما الجميلة، فالزيجات الناجحة ، هي التي تعتمد على مخزون كبير من الذكريات الجميلة، يمكن استعادتها إذا واجهتكما مشكلة ما، فتتذكران أوقاتكما الجميل معاً و بها تحاولان التغلب على ما يواجهكما من صعاب و مشكلات ، قد تبدو كبيرة ، ولكن الحب يفتتها.
الحج، رموزٌ وحِكَمْ
مظهر التوحيد
الخلوص شرط معتبر في تمام العبادات، إلاّ أنّ تجلّيه في بعضها يبدو أكثر ظهوراً، كما وطرد الشرك أكثر قوّةً ووضوحاً، ومن بين هذه العبادات الحجّ، الذي يتجسّد فيه التوحيد، ويظلّ من بدايته وحتى نهايته، أنموذجاً عن التوحيد ونفي الشرك، من هنا كان تركه كفراً (1).
ومعنى تجلّي التوحيد في الحج أن تنزّله في درجاته يصيّره حجاً، كما أنّ صعود الحجّ كذلك يبلغ به الله تعالى أو يتحوّل إلى التوحيد. يقول الإمام الصادق(عليه السلام) فيما ينقل عنه من دعاء سفر الحجّ: «… بسم الله دخلت، بسم الله خرجت وفي سبيل الله…» إلى أن يقول: «فإنما أنا عبدك وبك ولك» (2).
وعلى أساس هذه الرواية، يغدو الحج سيراً نحو الله سبحانه، ورحلةً إلى لقائه، وسعياً للقرب منه، ومن الواضح أنّ العبد لا يقدر على التقرّب من مولاه إلاّ بالتوحيد الدائم الأصيل، ونفي الشرك الجليّ والخفي.
الشاهد الآخر هنا كلام النبي(صلى الله عليه وآله) في سفر الحج بعد حمل الجهاز على الراحلة: «هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة»، ثم قال: «من تجهّز وفي جهازه علمٌ حرام لم يقبل الله منه الحج» (3).
وعليه، فالحج توحيد مجسّم وأنموذج من التوحيد الجامع، والتوحيد هو تلك الفطرة التي خلق الله الناس عليها، والتي لا تبديل لها…
الوحي المجسّم
الحجّ تمثيل للوحي، ذلك أن مناسكه تجلّت بالوحي وظهرت، وقد أخذها الأنبياء عن الملاك الأمين على الوحي جبريل(عليه السلام).
وتوضيح ذلك أنّ النبي إبراهيم(عليه السلام) طلب من الله سبحانه بعد بناء الكعبة أن يُبدي له كيفية العبادة في هذا البيت: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ (4)، وبعد هذا الطلب جاءه جبرائيل، وأنجز أمامه أعمال الحجّ، ودلّه على مناسكه بصورة عينية خارجية، ليقوم الخليل(عليه السلام)بتكرار هذه الأعمال بعده (5).
إنّ هذه الإراءة والتعليم لم يكونا شيئاً جديداً ولا من مختصات إبراهيم(عليه السلام)، بل قد تقدّمه آدم(عليه السلام) في هذا المضمار، حيث ظهر له جبرئيل، كما ظهر أيضاً على أفضل الأنبياء وخاتمهم (6)، حيث أخذ منه الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله) مناسكه.
يقول الإمام الصادق(عليه السلام) في هذا المجال: «إنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم، فقال: … إن الله أرسلني إليك لأعلّمك المناسك التي تطهر بها…» (7).
ويقول الإمام الصادق(عليه السلام) أيضاً: «كنت أطوف مع أبي، وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده، وقبّله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه، فقلت: جعلت فداك، تمسح الحجر بيدك وتلزم اليماني؟ فقال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ما أتيت الركن اليماني إلاّ وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه» (8).
وبعد أن اتضح أنّ الحجّ وحي ممثل، وأنّ باني الكعبة قد تعلّم مناسكه بالمشاهدة والعيان، لزم أن يكون الناس مأمورين بإقامة هذه المناسك التي ورثوها عنه، علّهم يرون بعضاً قليلاً مما كان رآه(عليه السلام)، قال تعالى: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ…﴾ (9); ذلك أن ما يفهم من كلمة (يأتوك) في هذه الآية هو مجيء الناس عند إبراهيم(عليه السلام)، وبلوغهم ما كان(عليه السلام)قد بلغه من قبل، لا مجرّد السفر إلى مكّة وزيارة الكعبة، ذلك أنّ هذا التعبير لا ينحصر بدائرة عمل المناسك والقيام بها.
فالوحيدون الذين يأتون إبراهيم(عليه السلام) هم أولئك الذين كانوا مثله في الوقوف بوجه عابدي الهوى والأصنام (10)، والتبرّي من الكفر والنفاق وما يعبدون (11)، مهيئين لتلقي ألوان المخاطر (12)، بعقيدة حنيفية وسلوك كذلك (13)، وقلب سليم (14)حاضر في محضر الله تعالى.
ومع الأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ﴾ (15)، من هنا قدّم رسول الله(صلى الله عليه وآله)قربانه الذي لم يقدّمه إبراهيم(عليه السلام) نفسه، ألا وهو الحسين بن علي(عليه السلام).
ومع ملاحظة النقاط المشار إليها يتضح أمامنا سرّ عرض إمام الزمان(عليه السلام)نفسه في بداية نهضته ضدّ الظلم ولأجل العدل على أ نّه أولى الناس بالأنبياء سيما إبراهيم الخليل ورسول الله(عليهما السلام): «إن القائم إذ خرج، دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة، ويجعل ظهره إلى المقام، ثم يصلّي ركعتين، ثم يقوم فيقول: يا أيها الناس! أنا أولى الناس بآدم. يا أيها الناس! أنا أولى الناس بإبراهيم…» (16).
ومن ذلك كلّه يتضح البُعد السياسي للحج، أي البراءة من المشركين وتجافيهم وإعلان الانزجار منهم، وقطع أيديهم وتدخلاتهم، ذلك كلّه بشكل واضح وعلني هو ما يمثل المناسك السياسية للحج.
المعاد المجسّم
لا يُعثر على الحج بمناسكه الخاصة به في أ ي عبادة أخرى، ولا يعلم تأويلها غير الله سبحانه، فهو معاد مجسّم، وحكاية عن يوم البعث والنشور، وكاشف واضح عن يوم الحشر، ذلك أن الناس تلبي هناك نداءاً واحداً على مابينها من اختلاف في اللغات والألوان، فتجيب أمراً واحداً، وتستجيب لصرخة واحدة، ولا آمر يُصدر أوامره لهم عدا الله الواحد القهار.
إن مناسك الحج أنموذج حيّ لأحداث القيامة والحشر الأكبر، وتمثُّل جلي لحشر الناس يوم القيامة عراة في يوم معاد.
ونشير هنا إلى نماذج من تجلّي المعاد في الحجّ:
1- اجتماع الحجاج في المواقيت وعند المواقف.
2- انفراد كل إنسان لوحده في ظلّ هذا الجمع، تماماً كما هو الحال يوم المعاد، فهو وإن كان «جمعاً» تلتئم الناس فيه وتلتف حول بعضها ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ (17)، ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ / لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ (18)، إلاّ أ نَّه يوم يعود الجميع فيه إلى الله فرادى، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (19).
3- فرار الناس من غير الله إلى الله تعالى، كما يقول الإمام الباقر(عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ (20): «حجّوا إلى الله عزّوجلّ» (21).
4- تعرّيهم من اللباس ومظاهر الحياة الدنيوية.
5- تجرّدهم عن زينة الدنيا وبهرجها.
6- رؤية الآيات الواضحة التي كانت مخفيةً عليهم في ديارهم.
7- خلعهم على أنفسهم لباس الإحرام، وهو لباس شبيه بالكفن، ويستحب للحاج أن تكون قطعتا الإحرام كفنه، كما كُفّن النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله) في لباس إحرامه (22).
8- تذلّل الحجيج وتواضعهم أمام الله سبحانه، حتى أ نّهم يحجون مشاةً حفاةً بأرجل عارية، ذلك أ نّه «ما عبد الله بشيء أفضل من المشي» (23).
من هنا، حجّ الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام) عشرين حجةً ماشياً (24)، وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق(عليه السلام): «جُعل السعي بين الصفا والمروة مذلّةً للجبارين» (25).
9- اعتراف الناس بذنوبهم التي ارتكبوها.
10- أمن الناس بل والوحوش والطيور.
11- حماية الحجاج من التعدّي والجدال، وكلّ ما يوجب أذية المحرم أو عذابه، وهو تجسيدٌ واضح لقوله تعالى: ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ (26).
وحصيلة القول: الحج مظهر المعاد وتجسيده، وحيث كان المعاد رجوعاً إلى المبدأ كان أساساً للإسلام الكلي والخالد، لذا غدا الحج من أهم مظاهر الإسلام وأركانه.
الولاية روح الحج
لا نفع للحج بدون الولاية، ولا لقصد الكعبة من دون الإمامة، ولا لحضور عرفات دون معرفة الإمام، ولا للأضحية في منى دون التضحية في طريق الإمامة، ولا لرمي الجمرة دون طرد شيطان الاستكبار الداخلي والخارجي، ولا للسعي بين الصفا والمروة دون السعي لمعرفة الإمام وطاعته… ذلك أ نّه وإن كان من أركان الإسلام ومبانيه، إلاّ أنّ الحج والصلاة والزكاة والصوم لا يضاهون الولاية في ركنيتها الراسخة والقوية للإسلام، «ولم يُناد بشيء كما نودي بالولاية» (27).
منشأ حرمة الكعبة وعزّتها
من جملة الأمور التي أقيمت عليها البراهين العقلية، ضرورة انتهاء كلّ ما بالعرض إلى ما بالذات، ووفقاً لهذا المبدأ الذي توافق عليه البرهان والقرآن، وكما أنّ كلّ عزّة- طبقاً لتصريح النص القرآني- تنتهي إلى عزّة الله سبحانه: ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (28) و ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (29)… وفقاً لذلك كلّه فإن حرمة الكعبة وعزّتها لابدّ أن تنتهي إلى حرمة الحقّ سبحانه وعزّته تماماً، كما إذا دار الأمر بين هدم الكعبة وهدم الحقّ فإن الكعبة تغدو حينئذ قرباناً فداءاً للحق.
ولتوضيح الأمر لابدّ من القول: للحرم أحكام تبيّن عزّته وفضيلته، وتمام هذه الأحكام ناتج عن حرمة الكعبة وعزتها، وشاهد ذلك ما جاء في الرواية عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)حول سرّ الوقوف في عرفات، وعدم وجوب الوقوف في الحرم حيث قال: «لأن الكعبة بيته، والحرم بابه، فلّما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون»، ثم سئل الإمام(عليه السلام) عن جعل المشعر الحرام من الحرم فقال: «لأنّه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلمّا طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجاباً بينهم وبينه أذن لهم بالزيارة على الطهارة» (30).
وعليه، فحرمة الأرض التي احترم الله كلّ ما فيها إنما جاءت من حرمة الكعبة نفسها، إلاّ أنّه مع كون الكعبة القبلة الوحيدة، ومطاف العالمين، وموت المسلمين جميعهم إلى جهتها، والقصد إليها قصدٌ للهجرة إلى الله سبحانه، وأيضاً رغم أنّ لمكّة خصائص فقهية وسياسية ثابتة، تفتقدها سائر الأماكن والبقاع والمدن، ورغم أن للحج ومواقفه أبعاداً سياسية- عبادية تفتقدها بقية العبادات… إلاّ أن تمام هذه الخصائص والمزايا مرهونة للولاية والإمامة.
وسرّ هذا الكلام أن الإرشادات والإدارات الملكوتية للأعمال والنيات، والأدعية، ومشاهدة الآيات البينات، وفهم الأسرار المعنوية للحج، وأمثال ذلك يتمّ جميعه في ظلال الولاية التكوينية للإمام المعصوم(عليه السلام)، كما أنّ الإدارة والرعاية السياسية للحج ومواقفه، وتوجيه حركة هذا الاجتماع العظيم للصالحين على محور البناء الطاهر الحر، والاستفادة من أفكار أقطار العالم، وارتواء عطاشى الاستقلال والنجاة من الاستعباد والاستكبار العالمي، إنما يكون بالأصالة تحت مظلّة إمامة الإمام المعصوم(عليه السلام) وبالنيابة في عصر الغيبة تحت شعاع نوّابه.
ارتباط الحج وشؤونه بالولاية
ترتبط الجوانب والشؤون المختلفة للحجّ بالولاية، ونعرض هنا شرحاً لكيفية هذا الارتباط بين الكعبة والولاية، وكذلك طبيعة العلاقة بين كلّ من عرفات والمشعر ومنى وزمزم والصفا و… وبين الإمام المعصوم(عليه السلام)، وذلك في ثقافة الوحي ووفق ماجاء على لسان الأئمة المعصومين(عليهم السلام).
1- تتمتع مدينة مكة ودائرة الحرم كلّه ببركة خاصة إثر دعاء الخليل إبراهيم(عليه السلام)، وقد جعلت بهذا الدعاء بلداً آمناً، تماماً كما يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (31).
إن هذا الأمن الاجتماعي، والاقتصادي وغيره، الذي جاء بيانه في آية ﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ (32) وآية: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ (33) إنما كان لما للكعبة من حرمة، إلاّ أنّ هذا الاحترام الخاص الذي كان أساساً لقسم الله سبحانه بهذا البلد إنما جاءها من بركات الوحي، والنبوة، والرسالة، والولاية.
وتوضيح ذلك، أن القرآن الكريم أقسم ببلاد وبقاع هامة وتاريخية، كما أقسم بالزمان والأوقات الحسّاسة والتاريخية، نظير عصر الوحي والرسالة (34)، قال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ / وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (35).
ففي هذه الآيات يقسم الله سبحانه بأرض مكّة، لكن قسماً مقيداً بكون نبي الإسلام(صلى الله عليه وآله)فيها، وإلاّ فإن مكة من دون النبي، والكعبة من دون قائد سماوي ليستا سوى أرض عادية وبيت عادي غدا تدريجياً بيتاً لعبادة الأصنام، وأصبح أسيراً في قبضة عبدة الأوثان والسائرين خلف ميولهم وشهواتهم حتى أن «أبو غبشان» سادن الكعبة ومن بيده مفاتيحها يبيع مفتاح الكعبة وغلقها إلى رجل يدعى قصي بن كلاب مقابل بعير وزق خمر، وذلك في ليلة ثملة (36).
2- ويعرّف الإمام السجاد(عليه السلام) نفسه وسائر الورثة الحقيقيين الإلهيين في المسجد الجامع بدمشق، بعد الحمد والثناء الإلهيين، والسلام على النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)فيقول: «.. أنا ابن مكّة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا» (37).
إن كلمة «ابن» وأمثالها في اللغة العربية تحكي عن علاقة شديدة وارتباط دائم ومستحكم، فالإنسان الكامل، وهو أصل حرمة المراكز العبادية، وفي الوقت عينه إبنها ووارثها، يرجع في طليعة الأمر إليها ويعمل طبق أحكامها، بل يجعل ذلك كلّه ضمن الشعارات الرسمية للموحدين، فيرغب فيها، ويرهب من الإعراض عنها أو الاعتراض عليها أو معارضتها، وفي المحصّلة النهائية: إنّه حافظ مآثرها وحارس آثارها، إن الأنبياء والأولياء الإلهيين(عليهم السلام) هم كذلك بالنسبة إلى مناسك الحج.
وبعبارة أخرى: إنهم أبناء هذه المواقف العبادية بلحاظ بعض النشآت الوجودية، وهم أمراؤها وأصلها ومصدرها بلحاظ نشآت وجودية أخرى.
ومعنى الكلام النوراني للإمام السجاد(عليه السلام) أن الابن الحقيقي لمكّة إنما هو حامي روح القبلة، وحارس قلب المطاف ونفسه، إن الابن الواقعي لمنى هو ذاك الذي لا يأسف على إيثار بدم أو نثار، بغية حفظ الوحي وما فيه، إنّه يُحكم علاقته بأرض التضحية عبر الفداء والعطاء.
إنّ المولود الحقيقي لزمزم إنما هو الذي يرشّ أفضل الدماء تحت أقدام غرس الإسلام حتى تنمو بذلك وتكبر، كما أن الابن الواقعي للصفا هو الذي لا سبيل للرجس والنجس والرجز إلى حرم قلبه، فهو منزّه- طبقاً لآية التطهير (38)- عن مختلف أنواع الرجس، وكل قذارة ولوث ودنس.
لانفع للحجّ بدون الولاية، ولا لقصد الكعبة من دون الإمامة، ولا لحضور عرفات دون معرفة الإمام الإنسان الكامل هو الإمام المعصوم(عليه السلام) والذي بدونه لا حرمة للحرم ومواقفه، من هنا، فالزائر الذي لا يعرف الإمام المعصوم، ويضع جانباً مسألة الإمامة، ويتخذ إدارة أمور المسلمين في العالم هذواً وباطلاً، ويفصل ما بين قيادة سواد الناس وبين الحج والزيارة وسائر العبادات، ويراها أمراً عادياً يرجع إلى خيار كل فرد من الناس، ولا يرى كرامةً لهداية خلق الله وتدبير أمورهم… لا يعرف في الحقيقة الإنسان، بل لم تطأ قدمه حريم الإنسانية، من هذا المنطلق يتحدّث الإمام الباقر(عليه السلام)عن مثل هذا الزائر والحاج فيقول: «أترى هؤلاء الذين يلبّون، والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير» (39).
ومع الأخذ بعين الاعتبار مقولة رسول الله(صلى الله عليه وآله): «من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتةً جاهلية» (40) و «كما تعيشون تموتون، وكما تموتون تبعثون، وكما تبعثون تحشرون» (41)، فإن حياة الإنسان الذي لا يعرف إمامه هي حياة جاهلية، وكلّ سننها وشؤونها إنما هي جاهلية في جاهلية، ومن المؤكد قهراً أن زيارة مثل هؤلاء للبيت وحجهم سيكون حجاً جاهلياً، ولن يكون لهم نصيب من الحج التوحيدي، وسيأتي مزيد توضيح.
3- لقد أعدّ الله سبحانه عذاباً لكل من أراد بالكعبة ظلماً وقصداً سيئاً: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (42)، من هنا وانطلاقاً من هذه السنّة الإلهية التي لا تبديل فيها، والحكم الإلهي الخالد، لم تكن واقعة الفيل، والتي تلقّى فيها جيش أبرهة عذاباً إلهياً، واقعةً حصرية لا تكرار فيها أو مجرد صدفة تاريخية.
الأمر الرئيس الذي لا ينبغي الغفلة عنه، وهذه الدراسة متكفلة لبيانه، هو أنّ الكعبة رغم قداستها الخاصة، وحمايتها- منذ قديم الأيام- من أذى حملات أصحاب الفيل وأمثال ذلك، إلاّ أنّه عندما التجأ إليها ابن الزبير وتحصّن فيها، أقدمت حكومة ذلك العصر الجبارة، وعلى يد المنحوس الحجاج الثقفي على قصف الكعبة بالمنجنيق وتدميرها، ثم اعتقال ابن الزبير (43)، دون أن تمتدّ يدٌ من الغيب لتفعل فعلها أو تتدخّل.
يتحدّث الشيخ الصدوق، المحدّث الشيعي الشهير، عن هذا الأمر فيقول: «وإنما لم يجر على الحجّاج ما جرى على تبّع وأصحاب الفيل; لأنّ قصد الحجاج لم يكن إلى هدم الكعبة، إنّما كان قصده إلى ابن الزبير، وكان ضدّاً لصاحب الحقّ، فلمّا استجار بالكعبة أراد الله أن يبيّن للناس أنّه لم يجره، فأمهل من هدمها عليه» (44).
وعليه، فاختلاف أبرهة عن الحجاج في أ نّه ظالم أراد تخريب الكعبة وتدمير القبلة، أما الحجاج فلم يكن يقصد الكعبة بسوء، بوصفها قبلةً ومطافاً، بل كان يريد- فقط- السيطرة على ظالم مثله لم يكن يعرف إمام زمانه، ألا وهو سيد الشهداء والإمام السجاد(عليهما السلام).
نعم، الحجاج كابن الزبير جرثومة لا تعرف الحق، وعنصر مناهض للولاية، وقد كان الطرفان ساعيين للإطاحة بنظام ولاية أهل البيت(عليهم السلام)، وكان خصامهم على حطام الدنيا، لا لعدم مساعدة ابن الزبير لسيد الشهداء والإمام السجاد(عليهما السلام).
ومن هذا الحدث يتضح جيداً أن معارضة الولاية والإمامة أمر منبوذ جداً إلى حدّ أنّ كلّ من يخالف قيادة الإمام(عليه السلام) ويذره وحيداً فريداً دون أن يساعده، بل يتخذ موقفاً مضاداً له، ثم يزعم لنفسه أنه داعية الولاية، لن ينعم بالأمان الخاص الإلهي حتى لو احتمى بالكعبة وقصدها.
ومن هذه الحادثة يعلم جيداً قدر الإمام وحرمة الولاية وعزّة الخلافة الإلهية، تماماً كما يعلم قدر حقه (الإمام) ونورانيته، وجماله، وجلاله، وكبريائه، ومشيئته، وقدرته جيداً بالتحليل العقلي، ذلك أن حرمة الحرم والبلد الأمين إنما تنتهي إلى الكعبة، وحرمة الكعبة تنتهي إلى الإمام الذي اختاره الله سبحانه للولاية، وحرمة الإمام تنتهي بدورها إلى الحق المطلق، أي الله تعالى الذي تخضع له تمام الموجودات وتخشع في حضرته ومكانته.
وعليه، فلو أمهل الله سبحانه ظالماً ليخرّب الكعبة، فلا ينتقض بذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (45).
تذكّر:
رغم أنهم قتلوا الإمام المعصوم(عليه السلام) وغدا على يديهم شهيداً، إلاّ أنّ حقيقة الإمامة قائمة بروحه الملكوتية التي لا مجال للشهادة فيها، ولا سبيل للموت إليها، على خلاف بدنه الذي يعرف الشهادة، وهذا ما يختلف الحال فيه مع الكعبة التي لا وجود فيها إلاّ للأحجار والأبعاد المادية.
4- ويشاهد الإمام الباقر(عليه السلام) الطائفين بالكعبة، فيقول: «هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية»، فلم يأت الإسلام لكي تستمرّ السنن الجاهلية، ثم يقول: «إنما أمروا أن يطوفوا، ثم ينفروا إلينا، فيعلمونا ولايتهم، ويعرضوا علينا نصرهم» ثم قرأ: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ (46).
وعليه، فثمة وظيفتان على كاهل القادمين من بعيد أو قريب للتشرّف بالكعبة المعظمة هما:
أ- أن يطوفوا ببدنهم حول الكعبة، بوصفها طيناً وأحجاراً.
ب- أن يطوفوا بأرواحهم حول «كعبة القلب» وحرم ولاية أهل بيت النبوة.
وعليه، فأولئك الذين جاؤوا بأرواحهم ليعرضوا ولايتهم على أهل البيت(عليهم السلام)، ويعلنوا جهوزيتهم للتضحية والفداء وتقديم النفوس والإيثار بالمال يحققون حينئذ «حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر» (47).
5- يقول الإمام الباقر(عليه السلام): «تمامُ الحجّ لقاءُ الإمام» (48)، بعرض الولاية عليه والإعلان عن الاستعداد للفداء والتضحية; وعليه فالحج الذي لا ظهور فيه للإمام والقائد والمرشد سيكون حجاً ناقصاً.
نعم، ذكر الحج في هذا الحديث الشريف إنما جاء من باب التمثيل، لا التعيين، أي أنّه ليس الحج فقط حاله «تمام الحج لقاء الإمام»، بل إنّ «تمام الصلاة والصيام والزكاة لقاء الإمام» أيضاً.
ويؤيد هذا الكلام، أي أن الصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات إنّما يتممها لقاء الإمام وتولّيه، ما جاء في قسم من الحديث المعروف الذي يتحدّث عن قيام الإسلام على خمسة أسس، إذ- وفي إطار التأكيد على مبدأ الولاية- يشير الحديث إلى دور «الوالي» وكونه حجةً ودليلاً على الأركان الأربعة الأخرى، فيقول: «والوالي هو الدليلُ عليهنّ» (49).
وهذه المسألة مستفادةٌ من الآية الكريمة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ (50)، فقد رضي الله سبحانه لنا الإسلام مع الولاية الإلهية، وعليه، فليس الحج وحده «تمام الحج لقاء الإمام» بل يمكن القول: «تمام الإسلام لقاء الإمام».
ونشير أخيراً إلى أنّه رغم انتهاء احترام الحرم بالكعبة، وحرمة الكعبة بالوحي والنبوّة والرسالة والولاية، إلاّ أنّه- وكما أشرنا مطلع هذا البحث- تختتم تمام هذه الحرمات بالحرمة الإلهية.
من هنا ذكر الله تعالى في إطار شرحه لسبب احترام الكعبة ما جعلها تنتسب إليه فقال: ﴿بَيْتِيَ﴾ (51)، أي أنّ الحرمة الذاتية لله سبحانه هي السبب وراء الحرمة العرضية للبيت الذي ينتسب إليه، حتى لو كانت الكعبة هي الأصل في حرمة الأشياء اللاحقة.
الحج والوجه السياسي
الحج مظهر الحكومة الإلهية السامية
الحج- كما تبيّن- مظهر لأصول الدين المتينة وتجسّدٌ للعقائد الثلاثة:
التوحيد، والنبوّة والعدل، تلك الأصول التي تعدّ ثماراً لشجرة الإسلام الطيبة.
وأحد أطهر هذه الثمار في هذه الشجرة الطيبة هو الحكومة الإسلامية، وهي من أهمّ مظاهر الإسلام، فالمجتمع الذي لا يديره الله ولا يسري فيه أمره مجتمع كفر وطغيان، ومعبود مثل هذه المجتمعات إنما هو الأهواء المختلفة والرغبات المتنوّعة.
بهذه المقدّمة، نصل إلى فهم أسرار بعض مضامين أدعية عرفة، فالمضمون المشترك لدعاء سيد الشهداء الإمام الحسين(عليه السلام)- وهو أهم دعاء في عرفة- مع دعاء الإمام السجّاد(عليه السلام) الذي اعتبر وجودَ الإمام العادل أساساً لإحياء آثار الدين… المضمون المشترك هو أهمية الولاية في النظام الإسلامي.
وثمة شواهد عدّة على أن الحجّ مظهر الحكومة الإسلامية، وأن لهذه الحكومة تأثيراً على بقائه واستمراره وتكرّره، نشير إليها هنا على الترتيب التالي:
1- كان من أدعية إبراهيم وإسماعيل(عليهما السلام) عند بناء الكعبة: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ (52).
وسرّ هذا الدعاء والطلب أن الموحدين قد دعوا للحج من تمام نقاط العالم المختلفة وفي تمام الأزمنة والعصور، إذاً فلابد أن يكون هناك من ينظم أمورهم، فعلاوةً على المناسك العبادية للحج لابد أن تكون لديهم أصول وأحكام أخرى تتعلّق بحياتهم السياسية، وهذه هي الحكومة الإسلامية عينها، التي تغدو ضرورةً لتنظيم أمور الحجيج وسياستهم وإرشادهم.
إنّ الدين الذي يقول: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم» (53)، حاشاه أن يذر الناس على حالهم هناك، ولا يضع على هذا الجمع العظيم الذي لا يحصى حاكماً أو آمراً، بل يتركهم يسيّرون أمورهم بأهوائهم ورغباتهم.
وبناءً عليه، كان لزاماً أن يكون هناك من يكون القائد لهم والرائد فيهم، حتى تنظم معاملاتهم، وتصوّب نزاعاتهم، وتنتهي خصوماتهم، وترتّب أنماط معيشتهم وعلاقاتهم ببعضهم بل وعلاقاتهم بسائر الملل والشعوب.
على هذا الأساس، يقول الإمام علي(عليه السلام) لواليه على مكّة: «أقم للناس الحج» (54)، والمستفاد من هذا الأمر أنّ الحجّ لم يقم بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وآله) طيلة خمس وعشرين عاماً، عنيت الحج الإبراهيمي والمحمدي (55).
2- يجب على مرشد الدولة الإسلامية وقائدها، أن ينفق قدراً من بيت المال لدفع الناس إلى الذهاب إلى مكة عندما يمتنع عامة المسلمين عن الذهاب إليها أو لا يكون ذلك في مقدورهم، فيدعم مالياً العاجز، ويجبر الممتنع على ذلك.
جاء في الحديث: «لو عطّل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج، إن شاؤوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج» (56).
وسرّ تعبير الإمام الصادق(عليه السلام) في هذا الحديث: «إن هذا البيت إنما وضع للحج»، هو أن للكعبة خصوصيات قيمة تدفع الناس للسفر إليها، فإذا لم يسافروا إليها- لقصور أو تقصير- ولم يؤدوا فريضة الحجّ عندها، كان على والي المسلمين أن يجبرهم حتى يتجهوا ناحية البيت الحرام، ويلتحقوا بدائرة الطواف، ولا يتركوا ذلك.
إن هذه هي الحكومة الإسلامية التي يديرها حاكم عادل، ويكون بيت مال المسلمين في يده.
جاء عن الإمام الصادق(عليه السلام) في حديث آخر: «لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي(صلى الله عليه وآله)لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» (57).
ويستظهر من هذه الرواية أن زيارة الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله) بمنزلة تجديد للبيعة معه والميثاق لتحكيم الحكومة الإسلامية.
3- قال الإمام الباقر(عليه السلام): «إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، فيطوفوا بها، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم، ويعرضوا علينا نصرهم» (58).
فإذا كانت الحكومة والولاية بغير معنى السياسة فلا حاجة لإخبار الإمام بالولاية وعرض النصرة عليه.
4- يتجلّى الإسلام الذي بعث به الأنبياء في التوحيد الذي يطرد مختلف أنواع الشرك وألوانه، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾ (59).
ولا ينحصر هذا الإبعاد للشرك والطرد له في مجرّد الاعتقاد القلبي أو الذكر القالبي، بل يستوعب إعلان الانزجار، ونداء التبرّي، وصرخة البراءة من الطغاة الأراذل وكل متجبّر متمرّد لئيم، وهذا ما يتحقق في الحج، ذلك أ نّه موضع «الإعلام» و «الأذان» بتبرّي الإسلام من ألوان الشرك، وأن المسلمين بريؤون من المشركين، وأ نّه لا مودّة ولا أُلفة بين المسلمين والمشركين: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (60).
ومفاد هذه الآية تبلور البُعد السياسي في الحجّ، وتجلّي الاستقلال الثقافي، حتى لا تبقى سيطرة لأحد من الكفار والمشركين على أيٍّ من المسلمين، فهل يمكن أن يكون ذلك غير تجسيد لأرفع مراتب الحكومة الإسلامية في الحج؟ وهل يمكن طرد رؤوس الإلحاد وتدمير مواقعهم ومتاريسهم إلاّ في ظلّ الحكومة الإسلامية؟!
إذا لم يكن للإسلام حضور سياسي في منى، وهي التي فسّر بها «الحج الأكبر» (61)، فلا يمكن إعلان البراءة من عمّال الجور وعبدة الطاغوت، تماماً كما لا يمكن قيام الناس والمقاومة بحجم العالم، ونشر الاستقامة وتعميمها على العالم- وهو ما بُنيت الكعبة لأجله- سوى بإقامة نظام إسلامي.
ولعلّه لهذه الأسباب أو سائر الأسرار الإلهية المستورة عنا، لم يحج سيد الشهداء الإمام الحسين(عليه السلام) عام 60 للهجرة رغم مجيئه إلى مكّة، فأدى عمرةً مفردةً احتراماً للكعبة (62)، ويؤيّد ذلك، ما جاء في كلامه(عليه السلام) في دعاء عرفة حول الحكومة الإسلامية.
ولمزيد من إيضاح فكرة ظهور الحكومة في الحج وتجلّيها فيه، لابدّ من التركيز المضاعف على ما قام به الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع، وما قاله للناس، وما قرّره لهم من القضايا السياسية الهامة وغيرها.
المظهر التام للتبرّي من الطاغوت
بُعث الأنبياء الإلهيون جميعهم كي لا يفرش نسر الشرك وطائره ريشه فوق قلّة هرم التوحيد، وأن لا يحرموا بشيطان الطاغوت والعصيان في حرم الوحدانية السامي (63)، فالكعبة والحج والزيارة محور التقوى، وأساس الاجتناب عن الطغيان، والتمرّد في وجه الطاغوت.
لقد أظهر المولى سبحانه مناسك الحج بالوحي لخليله إبراهيم (64)، ولا ثمر لذلك ولا نتاج سوى التوحيد، وهذه المناسك التوحيدية هي التي علّمها خاتم الأنبياء(صلى الله عليه وآله)لسالكي طريقه ومتّبعيه، حيث قال: «خذوا عني مناسككم» (65).
وحيث قام بناء التقوى الفولاذي على قاعدة التوحيد التي لاتهتز أو تختلّ، وكان الحج هو التجسيد الجلي للتوحيد; قال الله سبحانه- ضمن إصداره أوامر الحج -: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ… وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ (66).
وحول الأضحية، وهي من مناسك الحج، التي كانت ممتدّة في تاريخ السنن والعادات الجاهلية مشوبةً بالشرك، يكلّمنا الله تعالى في إرشاد تقوائي فيقول: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾ (67)، أي يناله الاجتناب عن الذنوب، والقيام ضدّ العاصي، والتورّع عن المعصية، والثورة ضدّ المذنبين المتمرّدين، والإمساك عن العصيان، والصرخة ضدّ العاصي، والاجتناب عن الطغيان، والهجوم على الطواغيت و… كلّ عبادة هي تبرؤ من الشرك وانزجار من الطاغوت، أما الحج فهو عبادة خاصة امتزجت بالسياسة واختلطت، وإن حضور مختلف شرائح المجتمع العالمي وطبقاته يمثل ظرفاً مناسباً لتجلي روح هذه العبادة- كسائر العبادات الإلهية- في هذا الجمع العظيم، وظهور هذه العبادة الممتازة في تلك الساحة ظهوراً تاماً.
من هذا المنطلق، أمر رسولُ الله(صلى الله عليه وآله)- بأمر من الوحي الإلهي- الناطقَ باسم الحكومة الإسلامية- وهو علي بن أبي طالب(عليه السلام)- أن يعلن البراءة من المشركين (68)، حتى تمتاز بشكل قاطع حدود التوحيد عن الطغيان والشرك، وتتخارج صفوف المسلمين المتناسفة عن صفوف الكفار، فتظهر- عبر ذلك- الصورة السياسية العبادية للحج، ويحمل زوّار الكعبة زاد التوحيد معهم مع استماعهم إلى قرار الحكومة الإسلامية الصادر بالانزجار من الشرك، وإعلان نبذ الصلح والمصالحة مع المشركين (69).
من هنا، ينتشر قرار التوحيد وإعلانه ببركة الكعبة في أقطار العالم المختلفة، تماماً كما يتوجه المسلمون كافة في الكثير من شؤون حياتهم ناحية الكعبة.
محور البراءة من المشركين
لا كمال أرفع ولا أسمى من نيل التوحيد الأصيل الخالص، ولا يمكن ذلك ولا يتسنّى إلاّ بالتنزه والتبرّي التام من مختلف ألوان الشرك والإلحاد، والرفض لكلّ مشرك وملحد.
من هنا، جعل الله سبحانه الكعبة بيت التوحيد، واعتبرها محوراً للبراءة من الذنوب والعصيان والتهاوي، بل مهّد لذلك وهيأ سبله عبر الأمور التالية:
أولاً: أصدر المولى سبحانه وتعالى أوامر لخليله إبراهيم(عليه السلام) بعد إتمام بناء البيت العتيق الطاهر، بيت المواساة والمساواة، وبعد تشريع قرار الأمن للحرم أمام الضيوف والزوار والركع السجود والعاكفين والطائفين، فقال: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (70).
والهدف من هذا الإعلان العام دعوة أولئك القادرين على الحضور بشكل طبيعي ومتعارف.
ثانياً: عندما يأتي الجميع، من الشرق والغرب، ومن الشمال والجنوب، ومن القريب والبعيد… فيشتركون في هذا الملتقى الشامل الواسع، تصل النوبة للإعلان المحمدي والأذان، من هنا قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (71).
كان هذا الإعلان الذي سبق مقدّمةً للإعلان الثاني، الذي هو الهدف النهائي لبناء الكعبة، وإعلامه هذا الهدف النهائي يعني الوصول إلى التوحيد متبلوراً على صورة إعلان براءة الله ورسوله الأكرم(صلى الله عليه وآله) من المشركين، ومادام الإنسان حياً يرزق على وجه البسيطة فإن الحج والزيارة يبقيان في عهدته وضمن مسؤولياته، ومادام ثمة مشرك في هذا العالم مادام إعلان البراءة منه جزءاً من أهم وظائف الحج.
من هنا، تتضح مسؤولية نهوض الأمّة لتطهير الكعبة المقدّسة من ولاية الطغاة والنفعيين الوصوليين، أولئك السرّاق الذين قال عنهم الإمام الصادق(عليه السلام): «أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم، فقطع أيديهم، وطاف بهم، وقال: هؤلاء سرّاق الله» (72)
إنّ القيام لتطهير الكعبة وتخليصها من يد الأشرار شريعة إبراهيمية، لا يصرف النظر عنها سوى فاقد العقل، ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (73).
وحيث كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) ومن اتبعه وآمن به أولى الناس بإبراهيم، وهو الذي طهّر الكعبة من ألوان اللوث والنجاسة والخسّة و… (74) فعلى الأمة الإسلامية اليوم أن تطهّر بيت الله سبحانه من مختلف القبائح والدنائس والنجاسات.
نعم، ليس المقصود مجرّد إبعاد الجسم المادي للمشرك حتى يُقال: لا مشرك في الحجاز اليوم كي يحصل التبرّي منه في موسم الحج! بل المراد من البراءة إعلان الرفض والتنديد والانزجار من كل فكر مشوب بالشرك، وكلّ تمدّن باطل لأولئك الذين تأثروا بهذا الشرك، وكل استعمار ظالم للملحدين، وكل استثمار طاغ للماديين، وكل استعباد قاس مجحف للمستكبرين، وكلّ استعمار سامريّ (75)للإسرئيليين، وكل استضعاف ماكر للدول العظمى.
والحج أهم الأمكنة التي يتجلّى فيها هذا الأمر، وقمم هذه النهضة، حيث يلزم على المسلمين فيه حفظ حرمة الله تعالى، والسعي لرفع عزة الحقّ عالياً، والتقوّي بقوّته، وأخذ المدد والعون منه، والتخلّق بالأخلاق الإلهية، حتى لا يصيروا موضعاً لظلم الظالمين وبطشهم، فالحج هجرة إلى الله تعالى، يقصده الناس لأداء مناسكه من مختلف نقاط الدنيا.
الشيخ عبدالله جوادي آملي
مجلة ميقات الحج
السنة الثانية عشر- العدد الرابع و العشرون- 1426ه-.
1– آل عمران: 97.
2– وسائل الشيعة 8: 279.
3– المصدر نفسه 8: 103.
4– البقرة: 128.
5– وسائل الشيعة 8: 160 ـ 171.
6– المصدر نفسه.
7– المصدر نفسه.
8– المصدر نفسه 9: 419.
9– الحجّ: 27.
10– الأنبياء 67.
11– الزخرف: 26.
12– الأنبياء: 68.
13– الأنعام: 79.
14– الصافات: 84.
15– آل عمران: 68.
16– بحار الأنوار 51: 59.
17– التغابن: 9.
18– الواقعة: 49 ـ 50.
19– مريم: 95.
20– الذاريات: 50.
21– وسائل الشيعة 8: 5.
22– المصدر نفسه 9: 37.
23– المصدر نفسه 8: 55.
للمرة الـ 60.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وفساد حكومته
اندلعت بعض المناوشات بين المئات من أتباع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومتظاهرين مناوئين له وسط تل أبيب، بحسب إعلام عبري
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، وسط مدينة تل أبيب، ضد ما وصفوه بالفساد الحكومي، مطالبين بتسريع التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستقالته، حسب الإعلام العبري.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "هذه التظاهرة الـ 60 منذ بدء التحقيقات مع نتنياهو، في ديسمبر/كانون ثان 2016".
وردد المتظاهرون شعارات ورفعوا لافتات، من بينها: "الشعب قرر أن نتنياهو لا فائدة منه"، "سوف يتم كسر الفساد"، و"حكومة فاسدة".
وحسب "يديعوت أحرنوت"، فقد تواجد المئات من مؤيدي نتنياهو أمام التظاهرة المناوئة له، واندلعت بعض المناوشات بين الطرفين، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب الإسرائيلية، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.
ومنذ ديسمبر 2016، حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو 7 مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين "1000" و"2000"، آخرها الشهر الماضي، في جلسة استمرت لنحو 4 ساعات، وفق الإعلام العبري.
وفي الملف 1000 يتهم نتنياهو بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين.
بينما يتهم في الملف 2000 ، بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
محاربة إيران والتخلي عن فلسطين في"صفقة القرن"
لم يكن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس حدثاً معزولاً. بل إنه رأس جبل الجليد الذي تحتويه "صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأميركية بإشراف جاريد كوشنير صهر الرئيس الذي يتولى ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ويتهيأ ترامب نفسه للإعلان عن تفاصيل تحقيق صفقته في النصف الأول من العام الجاري.
أتت قنبلة القدس من قبيل تمهيد الأرض أمام الصفقة، التي كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن بنودها قد نُقلت إلى السلطة الفلسطينية بواسطة السعودية، مشيراً إلى أنها تقوم على تصفية القضية الفلسطينية وإنشاء حلف إقليمي في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة تكون إسرائيل جزءاً منه.
وإذا كان مجدلاني قد كشف العنوان العريض للصفقة، فإن ذلك يكشف جانباً من الضغوط الهائلة التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية للقبول بها. ولم يتوانَ ترامب نفسه عن التلويح بقطع المساعدات للفلسطينيين بعد خفض المساهمة الأميركية في موازنة "الأونروا" رداً مناقشة مجلس الأمن لمشروع قرار يؤكد أن مصير القدس يجب أن يترك لمفاوضات الوضع النهائي وقد استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" لإسقاطه بعدما تبناه الأعضاء الـ 14 الآخرون في المجلس.
ويجد ترامب أن الساحة مفتوحة أمامه لممارسة أقصى الضغوط على الفلسطينيين لحملهم على الإذعان. فدول الخليج (الفارسي) شريك أساسي في "صفقة القرن" طالما تضمن لها إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران. والصحافة الغربية تعج بالتسريبات التي تفيد عن استعانة كوشنير بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كي يمارس الضغوط على القيادة الفلسطينية كي لا ترفض المقترحات الأميركية. ويبدو أن ما أوردته صحيفة "النيويورك تايمز" عن طلب محمد بن سلمان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القبول بضاحية أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بديلاً من القدس الشرقية، يأتي في سياق هذه الضغوط. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الأميركية تتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم، لكن في مناطق غير مترابطة في الضفة الغربية مع بقاء معظم المستوطنات، ومن دون تسليم الفلسطينيين إلا سيادة محدودة، ودون منحهم القدس الشرقية عاصمة لدولتهم، ومن دون السماح للمهاجرين الفلسطينيين بالعودة. ومقابل ذلك تحصل السلطة الفلسطينية على تعويضات مالية تصل إلى عشرة مليارات دولار.
هذه المقترحات تتجاوز كل ما سبق للإدارات الأميركية السابقة أن طرحته وتشكل إذا ما ثبتت معلومات "النيويورك تايمز"، تخلياً سعودياً عن المبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002. وتتحول القضية الفلسطينية بذلك مجرد بند يتيم في "صفقة القرن" المراد بها تغيير وجهة الصراع الدائر في المنطقة منذ 70 عاماً.
ويراهن ترامب على أن محمد بن سلمان الذي يرسي دعائم حكمه في السعودية، لن يخاطر بإغضاب الولايات المتحدة. وللتدليل على مدى العلاقة التي تربط ترامب ومحمد بن سلمان، تنقل صحيفة "التايمز" البريطانية عن كتاب "النار والغضب...في بيت ترامب الأبيض" للصحافي مايكل وولف، أن "محمد بن سلمان يستخدم احتضان ترامب له جزءاً من لعبة السلطة في المملكة". وفي المقابل تسعى الإدارة الأميركية إلى تسويق فكرة إنشاء تكتل عسكري-سياسي من الدول الإسلامية بقيادة السعودية على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو" يقيم جبهة واحدة مع إسرائيل وعلى جدول اعماله بند وحيد هو التصدي لإيران.
ومن الناحية النظرية، لن يكون في إمكان واشنطن إنشاء هذا التحالف العريض من الدول الإسلامية في مواجهة إيران، إذا ما بقيت القضية الفلسطينية من دون تسوية. ولذلك يبدو ترامب عازماً على خوض مغامرته في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية. ويجد أن الظروف التي تمر بها دول المنطقة منذ سبعة أعوام، والدمار الذي حل بسوريا والعراق على أيدي "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فضلاً عن استقالة مصر من دورها الإقليمي وحرب الاستنزاف التي يخوضها الإرهابيون ضد الجيش المصري، لن تسمح للفلسطينيين بإيجاد حليف حقيقي يعتمدون عليه إذا ما قرروا رفض الخطة الأميركية. وهنا يصير مفهوماً لماذا يضغط ترامب بكل قوة لزعزعة الاستقرار في إيران، وكيف أطلق سلسلة من التغريدات التي تحض المتظاهرين في عدد من المدن الإيرانية في الأيام الأخيرة، على عدم التوقف.
ويعتبر البيت الأبيض أن إشغال إيران في شؤونها الداخلية في المرحلة المقبلة، من شأنه أن يساعد على تمرير صفقة القرن، إنطلاقاً من أن إيران هي الوحيدة القادرة على تمويل انتفاضة فلسطينية جديدة. وهكذا تتعدى "صفقة القرن" الموضوع الفلسطيني بحد ذاته لتطرح إعادة صياغة الشرق الأوسط، على قواعد سياسية وثقافية جديدة، تشكل حال إنكار لأعقد صراع في العالم، وتتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
إن الشرق الأوسط بكامله يمر بلحظة مفصلية. وليس بالضرورة أن أميركا قادرة على إحداث كل هذا التحول الاستراتيجي في المنطقة.
سميح صعب
أركان الكعبة
وهي زوايا البيت من الخارج، وتُسمَّى:
أ. الركن العراقي الشمالي الشرقي ويقابل الركن اليماني.
ب. الركن الشمالي الشمالي الغربي ويقابل ركن الحجر الأسود.
ج. الركن اليمانيالجنوبي الغربي ويقابل الركن العراقي.
د. ركن الحجر الأسود الجنوب الشرقي وفيه الحجر الأسود.
وعندما يُقال: "الركن" من دون تحديد، فيُقصد به ركنُ الحجر الأسود، كما لو قيل: بين الركن والمقام.
الركن اليماني: هو الركن الذي يسبق ركن الحجر الأسود مباشرةً، وله فضلٌ عظيم.
وكان رسول الله صلى الله عليه واله لا يدع أن يستلمَ الركنَ اليماني والحجر الأسود في كل طوافة.
ولم يكن النّّبيُّ يمرُّ بالركن اليماني إلاَّ وعده مَلَكٌ يقول: يا محمد استلمْ.
والركن اليماني بابٌ من أبواب الجنَّة لم يُغْلِقْه اللهُ منذ فتحه. أنظر وسائل الشيعة، ج13، ص338، والكافي،ج4،ص409.
وكان الإمام الباقر عليه السلام إذا وصل إلى الحجر الأسود مسحه وقبَّله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه... وعندما سُئل عن ذلك، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه واله: ما أتيتُ الركنَ اليماني إلاَّ وجدتُ جبرائيل عليه السلام سبقني إليه يلتزمُهُ".
ورُوي أنَّ الله تعالى جعل مَلَكاً موكلاً بالركن اليماني، ليس له عمل إلاَّ التأمين على دعائكم يقول آمين، أي، يا ربِّ استجب1. راجع وسائل الشيعة، ج 13، ص338، والكافي،ج4، ص408..
________________________________________
1-معالم مكة والمدينة / السيد سامي خضرا.
هل يعطّل الحجاب الطاقات؟
من الاعتراضات على الحجاب أنه يؤدّي إلى تعطيل الفعاليّات النسويّة، الّتي خلق الله في المرأة الاستعداد لها.
فالمرأة كالرجل تتمتّع بذوق، وفكر، وفهم، وذكاء واستعداد للعمل. وهذه الاستعدادات منحها الله تعالى لها، ولم يكن ذلك عبثاً، وعليه يلزم استثمارها. فكلُّ استعداد طبيعيّ - من حيث الأساس - يدلُّ على وجود حقٍّ طبيعيّ. فحينما يُمنح كائن ما استعداداً ولياقة لعملٍ ما، فهذا يُمثِّل سنداً ودليلاً على أنّ لهذا الكائن حقّاً في تنشيط وترشيد الاستعداد، والحيلولة دون ذلك ظلم وعدوان.
لِمَ نقول إنّ لكلِّ أبناء البشر حقّاً في التعليم سواء كانوا رجالاً أو نساءً، ولم نُعط الحقّ للحيوانات؟
ذلك لأنّ استعداد التعلُّم موجود لدى البشر، دون الحيوانات. فالحيوان يتمتّع باستعداد التغذية والإنجاب، وحرمانه من ذلك يُعتبر عملاً مخالفاً للعدالة.
إنّ الحيلولة دون ممارسة المرأة للفعاليّات والاستعدادات الّتي منحتها لها يدُ الإبداع والخلق ليس ظلماً للمرأة فحسب، بل خيانة للأمّة أيضاً. فكلُّ عمل يؤدّي إلى تعطيل قوى الإنسان التكوينيّة، الّتي منحه الله إيّاها، فهو عمل ضارٌّ للجماعة. فالعامل الإنسانيُّ أكبر رأسمال اجتماعيّ، والمرأة إنسان أيضاً، فيلزم أنْ ينتفع المجتمع بعمل وفعاليّة هذا العامل وقواه الإنتاجيّة. فركود هذا العامل وتضييع طاقات نصف أبناء المجتمع يتناقض والحقّ الطبيعيّ الفرديّ للمرأة، كما يتناقض وحقّ المجتمع، ويؤدّي إلى جعل المرأة عالة وكَلّاً على الرجل.
الجواب: إنّ الحجاب الإسلاميّ - الّذي سنُوضِّح حدوده عاجلاً - لا يؤدّي إلى تضييع قُدرات المرأة وتعطيل استعداداتها الفطريّة. إنّ الإشكال أعلاه يَرِد على الحجاب الذي كان متداوَلاً بين الهنود والإيرانيّين قبل الإسلام أو الحجاب اليهوديّ. لكنّ حجاب الإسلام لا يقول: يلزم حبس المرأة في دارها، والحيلولة دون فعاليّاتها ونموّ استعداداتها. فأساس الحجاب في الإسلام - كما قلنا - هو: أنّ المتعة الجنسيّة يلزم حصرها في محيط المنزل وبالزوجة الشرعيّة، وأنْ يُترك المحيط الاجتماعيّ محيط عمل وإنتاج. ومن هنا لا يُسمح للمرأة حين خروجها من الدار أنْ تُهيّئ موجبات الإثارة الجنسيّة للرجال، كما لا يُسمح للرجل أنْ يتصيّد بنظراته النساء. إنّ هذا اللون من الحجاب لا يُعطِّل طاقات المرأة كما أنّه يؤدّي إلى تدعيم قُدراتها على العمل الاجتماعيّ أيضاً.
إذا قصر الرجل متعته الجنسيّة على زوجته الشرعيّة، وصمّم بعد خروجه من منزله ووطئت قدمه المحيط العامّ على أنْ لا يُفكِّر في مسائل الجنس، فمِنَ المقطوع به أنّه يستطيع العمل بشكلٍ أفضل ممّا لو كان جلّ همّه منصبّاً على ملاحقة الفتيات ومعاشرة النساء والتمتّع بهنّ.
هل أنّ خروج المرأة إلى ميدان العمل بوضع اعتياديّ غير مثير أفضل، أم خروجها بعد ساعات من التجميل والوقوف أمام المرآة، ثُمّ تخرج ليكون كلُّ سعيها باتّجاه جذب قلوب الرجال إليها، وتحويل الشباب - الذين ينبغي أنْ يُمثِّلوا المظهر الحقيقيّ لإرادة وحزم وفعاليّة الأمّة - إلى موجودات طائشة شهوانيّة لا إرادة لها؟
إنّه لأمر غريب، فبحجّة أن الحجاب يُعطِّل نصف أبناء المجتمع نركن إلى السفور والتحلُّل لنُعطِّل النصفين - الرجال والنساء!! فيضحى عمل المرأة التأمّل طويلاً أمام المرآة وصرف الوقت في التجمُّل، ويكون عمل الرجل في الركض خلف الشهوات وتصيّد الفتيات!.
إنّ ما لا يُريده الإسلام هو أنْ لا يكون عمل المرأة منحصراً في استهلاك الثروة وإفساد أخلاق المجتمع وتخريب بناء الأُسرة. إنّ الإسلام لا يُعارض - على الإطلاق - نشاط المرأة الواقعيّ في المجتمع والاقتصاد والثقافة، والنصوص الإسلاميّة وتاريخ الإسلام شاهدان على هذا الادّعاء.
ففي ظلِّ الأوضاع القائمة الّتي تنزع إلى تجديد لا منطق له، لا نعثر على امرأة تصرف طاقتها - واقعاً - في النشاطات الاجتماعيّة، أو الثقافيّة أو الاقتصاديّة المثمرة، إلّا في بعض القرى، ولدى بعض العناصر المتديّنة الّتي تلتزم بأحكام الشرع الإسلاميّ التزاماً حقيقيّاً.
نعم، هناك لون من النشاط الاقتصاديّ الرائج، الّذي يلزم أنْ نُعدّه ثمرة التحرُّر من الحجاب وهو: أنْ يسعى صاحب المعرض - بدلاً من تهيئة السلعة الجيّدة والأفضل لزبائنه - إلى استخدام فتاة بعنوان "البائعة"، فيستثمر قدرتها النسويّة ورأسمالها المتمثّل في العفاف والشرف، ويُحوِّلها إلى أداة لتحصيل المال، واستغلال زبائنه. فالبائع يعرض السلعة على الزبون كما هي، إلّا أنّ الفتاة البائعة الجميلة تجذب الزبون بألوان من التغنُّج النسويّ، وعرض مفاتنها الجنسيّة. فيُقبل العديد من الأفراد الّذين لا ينوون شراء شيء من المعرض، لأجل التحدُّث مع البائعة بعض الوقت، ثم يشترون شيئاً من المعرض!.
فهل هذا العمل فعاليّة اجتماعيّة؟ هل هذا العمل تجارة أم أنّه تحايل ورذالة؟
يقولون: لا تُعبِّئوا المرأة في كيس أسود.
نحن لا نقول لأحدٍ ضع زوجتك في كيس أسود. ولكنْ هل ينبغي للمرأة أنْ ترتدي لباسها، وتظهر أمام الملأ بحيث تثير نظرات الرجال الشهوانيّة؟ هل ينبغي للمرأة أنْ ترتدي تحت ثيابها الوسائل الاصطناعيّة الّتي تزيد في جمالها، لأجل سرقة قلوب الـرجـال؟ فـهل تـرتـدي الفتيات هذه الملابس لأزواجهنّ؟ لِمَ ترتدي الأحذية ذات الأكعاب؟ فهل هناك غير إظهار حركات ردفيها؟ وهل أنّ ارتداء الملابس الحاكية عن مواضع الحسن في الجسد يستهدف أمراً غير إثارة الرجال وتصيّدهم؟ وعلى الأغلب فالنساء الّلواتي يستعملن أمثال هذه الملابس والأحذية لا يضعن أزواجهنّ فقط في حسبانهنّ، دون سائر الرجال.
يُمكن للمرأة أنْ تستعمل ما تشاء من لباس وتجميل أمام محارمها، وأمام النساء، ـ بالحدود الشرعيّة ـ ولكنّ المؤسف أنّ تقليد الغرب يستهدف هدفاً آخر.
إذا ارتدت الفتيات ألبسة اعتياديّة في التجمّعات العامّة، وارتدينَ أحذية عاديّة وسترنَ شعورهن، ثُمّ ذهبنَ إلى المدرسة أو الجامعة، فهل أنّ تحصيلهنّ الدراسيّ أفضل، أم أنّه أفضل في الوضع القائم؟ لو لم تكن هناك متعة جنسيّة منظورة، فلِمَ هذا الإصرار على خروج المرأة بهذا الشكل؟ لِمَ يُصرّون على جعل المدارس الإعدادية مختلطة؟. سمعت أنّ العادة في باكستان - ولا أدري هل هي قائمة الآن أم لا - هي أنْ يُفصل قسم البنين بحاجز وبردة عن قسم البنات، ويبقى الأستاذ وحده مُشرِفاً على القسمين من وراء المنصّة، فأيُّ إشكال في ذلك؟
* الشهيد الشيخ مرتضى مطهري - بتصرف
غضب احتجاجات في تونس
لم تنجح الحكومات المتتالية على مدى سبع سنوات في مقاربة الوضع الاقتصادي بطريقة سيادية ذات عمق اجتماعي، واختارت الخضوع لشروط الجهات الدائِنة وقبلت بإملاءات الاتحاد الأوروبي، واستمرّت في ممالأة الفاسدين الذين يموّلون الأحزاب وغضّ النظر عن حالات التهرّب الضريبي بسبب بيروقراطية الدولة التي أعاقت أيضاً أنشطة القطاع الخاص.
تبدو تونس للمُراقب من بعيد البلد الوحيد الذي نجا من تداعيات "الربيع العربي". يقال ذلك عادة بسبب الانتقال السياسي السَلِس الذي حدث بعيداً عن إراقة الدماء.
صحيح أن تونس لم تغرق في المستنقع الأحمر، لكنها غرقت في مستنقع من نوع آخر هو مستنقع الفشل الاقتصادي. ظاهر المشهد يقول إن التونسيين نجحوا في صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية والحصول على قدر كبير من الحريات. غير أن ذلك كان نجاحاً عقيماً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، فلم تتمكّن الحكومات المُتتالية من حل أيّة مشكلة اقتصادية، وهو ما ضاعف حجم المآزق الاجتماعية.
أبدت الحكومات المُتعاقِبة فقراً مذهلاً في الرؤية الاقتصادية. ولم تفعل حكومة يوسف الشاهد غير تكريس نهج المديونية حيث بلغت نسبة التداين 63.7 % وعجز الميزانية 5.4 % من الناتج الداخلي الخام، حسب معطيات رسمية.. وقد صادق البرلمان على 18 مشروع قانون تتعلق بالقروض والتعهّدات المالية للدولة خلال الدورة العادية الماضية للمجلس.
أدّى ذلك الواقع الاقتصادي إلى تضاعُف نسبة البطالة التي وصلت إلى 15.3% من القوّة العاملة، أي ما يساوي 625 ألف عاطل. وارتفعت نِسَب الفقر والبطالة التي سبّبت غضب الشارع وأججّت الاحتجاجات. لم تستمع الدولة لشعبها ولم تهتّم بحاجاته بل استمعت إلى صندوق النقد الدولي المُختصّ في تخريب اقتصادات الدول، وهو ما جعل الناس يشعرون أنهم يدورون في حلقة مُفرَغة بعد أن خلا المشهد من قيادات سياسية يثقون بها.
لم تنجح الحكومات المتتالية على مدى سبع سنوات في مقاربة الوضع الاقتصادي بطريقة سيادية ذات عمق اجتماعي، واختارت الخضوع لشروط الجهات الدائِنة وقبلت بإملاءات الاتحاد الأوروبي، واستمرّت في ممالأة الفاسدين الذين يموّلون الأحزاب وغضّ النظر عن حالات التهرّب الضريبي بسبب بيروقراطية الدولة التي أعاقت أيضاً أنشطة القطاع الخاص. وبعد أن دخلت البلاد في جدار المديونية الذي يعني مباشرة تسديد أقساط الديون، ذهبت الحكومة إلى سدّ العجز الضخم في الميزانية من خلال قانون المالية الجديد الذي لم يجد ملجأ سوى زيادة الضرائب ورفع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية مثل المحروقات والغاز وبطاقات شحن الهاتف الجوّال والشامبو وحتى المساكن الجديدة..
وأمام عجز الحكومة في التصدّي للتضخّم وفقْد الدينار ثلث قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2014، واستفحال البطالة وتفاقُم عجز الميزان التجاري، لم يجد رئيس الحكومة والإعلام من جواب سوى اتّهام الجبهة الشعبية وجهات أخرى بالتورّط في الاحتجاجات والتخريب، والتحذير من المؤامرات الخارجية وتوظيف بعض الفصائل الداخلية الأحداث لتحقيق أهدافها الخاصة.
ليس مستبعداً وجود جهات، داخلية أو خارجية، مُحرِّضة على التخريب والعنف، غير أنه لابدّ من الفصل والتمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال التخريب. هما شيئان مختلفان، والذين يتظاهرون ويحتجّون يختلفون عن أولئك الذين يخرّبون وينهبون.
لم تتردّد الأحزاب والنُخَب في رفض هذه الأعمال التخريبية وإدانتها. غير أن حقائق التاريخ تقول إن التحرّكات الاحتجاجية الكبرى في تونس كانت دائماً مرفوقة بهذه الأعمال، من 26 جانفي/ كانون الثاني 1978 إلى 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، مروراً بانتفاضة الخبز 1984 وانتفاضة الحوض المنجمي 2008. وحتى في ظلّ حكومات "ما بعد الثورة" رافقت أعمال العنف والتخريب الاحتجاجات ضد حكومات حمادي الجبالي وعلي العريض ومهدي جمعة وحبيب الصيد.
واليوم لم يبقَ من عناوين تلك التحرّكات والانتفاضات إلا ما أحدثته من شروخ في نظامي بورقيبة وبن علي، وما أنتجته من إسقاط حكومات كثيرة. كانت أسباب تلك الاحتجاجات مشروعة، وما رافقها من أعمال عُنف وتخريب وتدخّل لقوات الأمن بقي مسائل فرعية في اهتمامات الباحثين والدارسين.
لا توجد احتجاجات أو انتفاضات وثورات من دون عُنف وتخريب. وهذا ليس تبريراً، لكنه توصيف لواقع تاريخي يتكرّر دائماً. ويمكن للمُختّصين في التاريخ وعِلم الاجتماع وعِلم الاجتماع النفسي والسياسي، الاشتغال عليه وتفكيكه. ومع ذلك من المشروع، أمنياً، البحث عن جهة مُحتملَة استغلَّت الاحتجاجات لممارسة أعمال النهب والتخريب التي طالت مؤسسات تجارية وبنكية وحكومية، ومحاسبتها.
لم يتخلّص الخطاب الرسمي من سرديّاته القديمة تجاه هذه الاحتجاجات من 26 جانفي/كانون الثاني 1978 حتى اليوم، التوصيفات ذاتها والاتّهامات نفسها. يتكرّر الحديث في كل مرة عن مخرّبين ومندسّين ومحرّضين .. مقابل نفي للأسباب المشروعة للاحتجاج. وحتى عندما يتم القبض على مخرِّبين أو لصوص ويتم التحقيق معهم، فإنه يتم التكتّم على الجهات التي حرّضتهم ودفعت بهم لممارسة تلك الأعمال.
هذه الأعمال ليست خاصيّة تونسية، فالاحتجاجات الكبرى في العالم لا تخلو من أعمال تخريبية. لا يتعلّق الأمر فقط بالبلدان العربية أو "العالم النامي"، بل يشمل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ترفض الحكومة الأعمال التخريبية الموازية لهذه الاحتجاجات، والتي قُتِل فيها متظاهر واحد حتى الآن هو خمسي اليفرني في طبربة، جنوبي العاصمة التونسية، وقُبِض على المئات. وهي ليست وحدها في ذلك. فأعمال من هذا النوع لا تعالج الأزمة. غير أن التوقّف عند تلك الأعمال لتصبح هي المشكلة بدل البحث في الأسباب التي فجّرت الاحتجاجات ليس إلا التفافاً على المأزق. تحتاج الحكومة أن تُقِرّ بالأسباب المشروعة لتلك التحرّكات وأن تعترف بخطأ منهجها وطريقتها في إدارة الشأن العام، من أجل التعاطي معه بجدية.
لا تختلف أسباب الاحتجاجات عن تلك التي أدّت إلى هروب بن علي منتصف جانفي/كانون الثاني 2011. بل إن الحكومات التي جاءت بعده لم تكن مُعالجاتها أفضل. فقد راكمت فشل النظام السابق وزادت عليه، واستغلّ كثيرون المناخ السياسي الجديد لتحقيق طموحات غير مشروعة ، فتم توظيفه لتحقيق مصالح فئوية وحزبية عبر الاستقواء بالأجنبي والإذعان لإملاءاته التي لا تريد سوى الإمعان في إغراق اقتصاد البلاد وتخريب نسيجها الاجتماعي. وإذا كانت هناك جدّية في معالجة الأزمة، فإن الحلول ليست خافية. يحتاج الأمر فقط جُرأة سياسية وقرارات سيادية.
يُطالب المحتجّون بإلغاء قانون المالية الجديد وتجميد الأسعار عند مستوياتها القديمة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع المال العام المنهوب ، وفرض ضرائب ملائمة على رؤوس الأموال والتوقّف عن الاستدانة المشروطة والبحث عن حلول داخلية تتحمّل الدولة فيها بناء مشاريع اقتصادية كبرى ، وتشجّع الاستثمار الزراعي والصناعي والمبادرات الخاصة.. قد يحتاج الأمر حواراً وطنياً جاداً، تشترك فيه الأحزاب والنقابات والمنظمات ذات الصلة، غير أن الإعلان عن تلبية تلك المطالب لا يحتمل التأخير وهو وحده الكفيل بإطفاء نيران الغضب الشعبي بطريقة مُرْضية.
قاسم شعيب
تونس، شُعلة “الربيعٍ العربي”، كي لا يَشتعِل زيتُونها
حتى ولو كانت الثورة التونسية هي البداية في مسلسل “الربيع العربي”، لكن المُفارقة، أن الشعب التونسي يكاد يكون الوحيد في محيط “الحماقة العربية” الذي يُدرِك لماذا ومتى يثور، وهو منذ إحراق محمد البوعزيزي نفسه في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010 وإنطلاق “الثورة الربيعية الأولى” التي أدَّت الى إسقاط الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهروبه الى السعودية، وصولاً الى كانون الأول / ديسمبر 2017 وبدايات “الثورة الثانية” واستمرارها حتى الآن، يبقى الشعب التونسي في تحركاته ضمن حدود الضوابط الوطنية والقومية، يثور كل فترة لأسباب معيشية بحتة، لكنه يتميَّز رغم التحركات الشعبية، بالحدّ المقبول من الرقيّ والوعي في ردود الفعل والتعامل مع الأزمات، والإصرار على اعتبار مشكلته داخلية ولم يسمح لليد الخارجية حتى الآن أن تمتدّ لإحراق “زيتون تونس الخضراء”.
مهما حصل في “مهد الثورات المعاصرة”، فإن تونس لا تشبه مثيلاتها من الدول العربية التي شهِدت غوغائية الأهداف والوسائل والنتائج للأسباب التالية:
أولاً: التحركات التونسية هي معيشية، ومن المؤسف القول، أن المستوى العلمي العالي للشباب التونسي الذي يُميِّزه عن سائر الدول العربية – التعليم في تونس مجاني من الروضة حتى الجامعة- هو السبب الرئيسي للأزمات، حيث يتخرَّج الطلاب ولا يجدون عملاً يتناسب مع مؤهلاتهم، ويلجأ البعض منهم الى الهجرة – خاصة الى أوروبا- والبعض الآخر يُمارس مهناً لا تتناسب مع المستوى العلمي، و”البوعزيزي” الذي أحرق نفسه على عربة الخضار كان نموذجاَ عن خريجي الجامعات الذين دفعت بهم البطالة الى اليأس وامتهان أية وسيلة من أجل لقمة العيش.
ثانياً: هذا المستوى العلمي الذي اقترن بالثقافة الأوروبية بحُكم الجوار، أعطى التونسيين ميزة انفتاحٍ حضارية، والشعب التونسي المُسيَّس والمُتحزِّب يعيش غنى التنوُّع الذي يقدِّس الحريات، ولم يسمح باستيراد الإديولوجيات الدينية والفكرية الغريبة عن المجتمع التونسي، حتى أن حزب النهضة الإسلامي، يُكرر قادته في كل المناسبات، أنهم ليسوا الفرع التونسي للأخوان المسلمين، وأنهم يعملون تحت سقف الدولة التونسية كما سائر الأحزاب التي لديها برامجاً جماهيرية للتنمية.
ثالثاً: هذه الواجهة الأوروبية عبر البحر المتوسط لتونس، والشراكة الأفرو- أوروبية، والثقافة الفرنسية للشعب التونسي، لم تنتزع تونس من محيطها العربي، وبقيت على الدوام طليعة رافعيّ لواء القضية الفلسطينية، ومن الداعمين الدائمين لحركات المقاومة بمواجهة العدوان الصهيوني، ولم تُشغلها متاعبها الداخلية عن الإلتزام القومي العربي، وما الزيارات الميدانية التي يقوم بها البرلمانيون والأكاديميون والناشطون الحزبيون التونسيون لمباركة الإنتصارات في لبنان وسوريا والعراق، سوى من منطلق قومي وإنساني وعاطفي يعكس رابط الإنتماء العربي لدى الشعب التونسي.
رابعاً: تونس التي لا تتمتع باقتصاد قوي، نتيجة اعتمادها بالدرجة الأولى على إنتاج الفوسفات الذي تراجع من 7 ملايين طن الى 3.5 ملايين خلال الأعوام من 2011 حتى 2017 بسبب الإضطرابات والإضرابات العمالية، رغم حرص”الإتحاد العام للشغل” على تهدئة الشارع والتخفيف من التداعيات، والمورد الزراعي الرئيسي المُتمثِّل بإنتاج زيت الزيتون لا تكاد عائداته تتعدى 280 مليون دولار من تصدير الإنتاج السنوي الذي يُقارب 150 ألف طن الى أوروبا، للتعويض عن نقص عائدات الفوسفات، كما أن السياحة التي تتطلب الحد الأدنى من الأمان غير قادرة على إنعاش إقتصاد أثقلته الديون الخارجية.
ورغم نسبة النمو التي بلغت 2.5% عام 2017، فإن تونس بحاجة الى المزيد من سياسات التقشف وضبط الإنفاق، لأنها ترزح تحت ديون خارجية ثقيلة و تتعرض لضغوط من المقرضين لتقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام، وعَمَدت الحكومة أخيراً الى زيادة 1% على الجباية العامة التي كانت 6% وذلك بناء لطلب وفد من صندوق النقد الدولي حثَّها على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي ومنع تفاقم خدمة الدين العام، لكن هذه الزيادة التي طالت مادة البنزين ومشتقات النفط الأخرى، جاءت ذريعة للتجار، الذين رفعوا اسعار السلع وتسببوا في هذه الأزمة التي أشعلت الإحتجاجات الشعبية، ودفعت بالحكومة الى استنفار الأجهزة الرقابية لضبط فلتان الأسعار وحماية المستهلك.
الحكومة التونسية أمام استحقاق معالجة فورية للوضع، فهل تكون بمستوى رقيّ الشباب التونسي المثقَّف الواعي، قبل أن تنحرف التظاهرات عن أهدافها عبر عناصر مدسوسة تُحرِّكها أيادٍ خارجية، سبق لها وأن أخرجت التظاهرات المطلبية في بلدانٍ عربيةٍ أخرى عن المرسوم لها بإخراجٍ أميركيٍّ مدمِّر؟. ويبقى على الشعب التونسي أن يتحلَّى بالوعي المعروف لديه، رأفة بتونس، وأن يرعى الشباب التونسي هذه المظاهرات ويرصد العائدين من ميادين الإرهاب بأفكار تكفيرية تدميرية وعزلهم عن الدخول في الحراك، لأن الإرهاب لدى الجارة الليبية عيونه على تونس، لإحراق كل ما هو أخضر نابض بالحياة في تونس وسواها من المغرب العربي الى مشرقه…
أمين أبوراشد