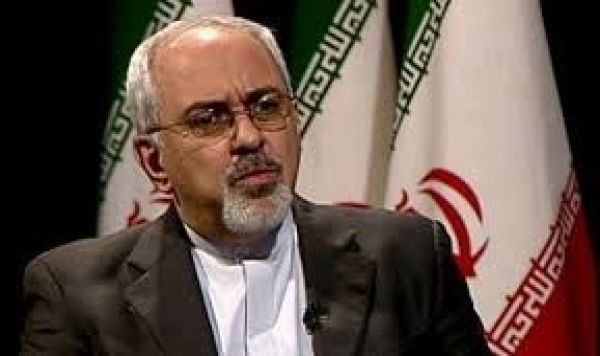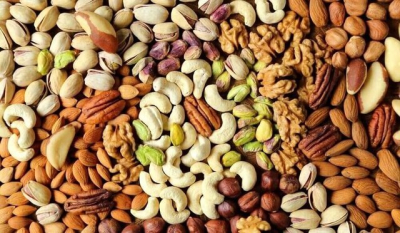Super User
دخلوا جنيف مجموعة ست... وخرجوا «6 + 1»

أعقب اتفاق جنيف -3، العديد من القراءات والتحليلات، التي قاربت الحدث من زوايا وخلفيات متعددة. الا ان أسلمها وأقربها الى محاولة قراءة الواقع هي تلك التي تنطلق من حقيقة أن الاتفاق ليس الا نتاجاً لتوازنات القوة وتقاطع المصالح
مع التأكيد على التأسيس القائل بأن أي تسوية سياسية قائمة على التنازلات المتبادلة، هي انعكاس لمعادلات القوة والمصالح، وبالتالي لا تعني بالضرورة غلبة لقوة على اخرى، الا أن ما جرى في حالة اتفاق جنيف النووي بين ايران والدول الست الكبرى، وعلى نفس قاعدة التوازن والمصالح، يشكّل انجازاً يصل الى حدود الانتصار، للجانب الايراني في مواجهة المعسكر الغربي المقابل، وعلى رأسه الولايات المتحدة.
فالتوازنات والمصالح، لم تجد نفسها بنفسها فجأة، ثم تحققت هذه النتيجة تلقائياً بين الجانبين، وإنما بعدما استنفد الأميركي ومعه الغربي والاسرائيلي، الكثير من الضغوط الاقتصادية والأمنية، اضافة الى التهويل بالحشود والضربات العسكرية، وبعدما بلغت ايران ما بلغته على مستوى التطور النووي الذي اوصلها الى دولة «حافة نووية». مع وجود فوارق أساسية، ذاتية وموضوعية، يشبه نجاح الجمهورية الإسلامية في ايران في جر الغرب الى توقيع الاتفاق، نجاح حزب الله في فرض معادلة ردع مضادة مع الكيان الاسرائيلي، ناتج من تطور قدراته العسكرية والصاروخية، وتحديداً بعد استنفاد تل أبيب كافة خياراتها ورهاناتها على سحق حزب الله او اضعافه او اخضاعه خلال السنوات الماضية.
لو كان الحديث عن اتفاق بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة، لأمكن الاكتفاء بقاعدة توازن القوة وتقاطع المصالح والظروف المؤاتية. الا ان الجانبين في اتفاق جنيف، ايران والولايات المتحدة تحديداً، هما خصمان متقابلان مع تفوق احدهما على الآخر من النواحي العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، مع محاولات وجهود غربية طوال ثلاثة عقود بهدف اسقاط النظام الايراني او احتوائه او اخضاعه. الى ان اضطر الغرب اخيراً، نتيجة فرض طهران توازن القوة والمصالح، على الاندفاع نحو تفاهم ينطوي على واجبات وقيود متبادلة، ضمن سياق حركة صراع متواصلة بينهما.
وبالتالي فإن قراءة اتفاق جنيف لا يمكن ان تقتصر فقط على ما قام به الجانبان من تنازلات نص عليها الاتفاق نفسه، من دون ملاحظة التنازل الكبير الذي اضطر اليه الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة، بالتسليم القسري بوجود وحضور نظام الجمهورية الاسلامية، بعد ماض طويل من محاولات اسقاطه، واحتوائه واضعافه.
لجهة ما قدمته ايران من تنازلات، وتحديداً ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم لدرجة 20 في المئة، في مقابل تنازلات غربية وأميركية، يُذكّر بمشهد فكاهي لأحد الممثلين الكوميديين الإيرانيين، تدور احداثه داخل احد بازارات مدينة أصفهان، حيث يدخل سائح غربي احد المحال لشراء سجادة معروضة في الواجهة أعجبت زوجته. لكن التاجر لم يكن يود بيعها، لذا، عرض عليه مجموعة متنوعة من البسط الأخرى، مثنياً على كل واحدة منها، فيما وجه انتقادات شديدة للاخرى التي تروق للسائح. وينتهي الحال بالسائح بشراء السجادة التي يريد التاجر تسويقها وبيعها، ويحتفظ التاجر بالسجادة التي لا يريد بيعها.. ثم يتحول هم السائح الى كيفية تبرير شراء السجادة والترويج لها امام زوجته.
هذا ما حصل بين ايران والسداسية الدولية، وبشكل أكثر تحديداً مع الرباعية الغربية، عندما وافقت طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وبالأخص ان ايران تجاوزت الحاجة الى هذه النسبة في كل متطلباتها النووية. وبعبارة اخرى، اعطت ايران ما لم تكن تريده، لأنها لا تحتاج إليه، واخذت ما تحتاج اليه بالفعل، وهو استمرار تخصيب اليورانيوم على اراضيها. ما كان يهم ايران هو التخصيب، تحديداً التخصيب، وهذا ما توصلت اليه، وهو ما كانت تعلنه طوال السنوات الماضية، وما رسمت حوله القيادة العليا في طهران خطاً احمر لا يمكن التنازل عنه.
وللتذكير ايضاً، فإن الأزمة بين ايران والغرب، على خلفية برنامجها النووي، بدأت قبل عشر سنوات، وقد تخللها فرض عقوبات اقتصادية قاسية، وحشود عسكرية، وتهديدات بالحرب، بسبب إقدام ايران على تخصيب اليورانيوم بدرجة أقل من خمسة في المئة. اي ان المشكلة لم تكن على درجة التخصيب، وإنما على مبدأ التخصيب نفسه. وهنا يكمن النجاح الايراني في اتفاق جنيف.
والاتفاق بين ايران والدول الست، في كل الأحوال، ورغم انه اتفاق تمحور حول القضية النووية، الا انه سحب اعترافاً بالموقع الندي لإيران بمعنى الموقع المتكافئ سياسياً، واقراراً بوزنها الاقليمي والدولي أيضاً، وعلى ذلك قد يؤسس مستقبل ومعادلات وتحالفات وموازين القوى في المنطقة. وبذلك تكون التركيبة الدولية «5+1» التي دخلت الى قاعة المفاوضات في مقابل ايران، خرجت منها وفق تركيبة «6+1».
علي حيدر
تراجع حقوق الإنسان في الغرب

بالرغم من امتداد الأفكار الليبرالية التي تقر حقوق الإنسان والمواطن خارج القارة الأوروبية، فقد عرفت هذه المبادئ تراجعا في البلدان التي نبعت منها وأحيانا من قبل باعثيها أنفسهم، إذ وقع خرقها أثناء الثورة الفرنسية ثم في أوروبا الرجعية بعد 1815م وكذلك على حساب الطبقة الشغلية خلال الثورة الصناعية وأخيراً في المستعمرات الأوروبية.
فقد تجاهل رجال الثورة الفرنسية جانبا من المبادئ التي حددوها في صائفة 1789م بإنكارهم للمساواة الفعلية، وذلك بإقصاء الفقراء عن الحياة السياسية، إذ اقتصر حق الاقتراع سنة 1791 على ما كان يدفع قدرا أدنى من الضرائب، أي على الفئات الميسورة، وبذلك أصبحت الامتيازات والحقوق تقوم على الحسب عوضا عن النسب، كما تجاهلت الطبقات البورجوازية الحاكمة في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وضع الرقيق، وأبقت على نظارم العبودية على الرغم من كونه يتنافى مع حقوق الإنسان، وذلك حتى 1848م بالنسبة إلى فرنسا و1863بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما انتصرت الأنظمة الرجعية بقيادة إنجلترا ـ حيث تغلبت المصالح على مبادئ ثورة 1688 ـ على الحركات الثورية في أوروبا في بداية القرن التاسع عشر، وذلك إثر تحالفها ضد الثورة الفرنسية ووارثها نابليون بونابرت سنة 1815م. فحاولت عندئذ تركيز نظام قوامه الملكية والكنيسة والتقاليد الاجتماعية القديمة، مع إقامة حلف ملكي ضد الانتفاضات الشعبية.
وانتهكت كذلك الطبقات البورجوازية في أوروبا الغربية، علاوة على الحقوق السياسية للمواطن الفقير: حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. وذلك في خضم الثورة الصناعية التي قامت على كاهل الطبقة الشغلية، إذ كانت حينئذ الأجور زهيدة وظروف العمل والسكن والحياة بصفة عامة قاسية جداً بالنسبة إلى الشغالين. فكان العامل يعمل في المصنع أكثر من عشر وحتى اثنتي عشرة ساعة يومياً، وذلك إلى جانب تشغيل النساء والاطفال في ظرروف لا إنسانية. وهكذا لم تتوان الطبقات البورجوازية الأوروبية في إنتهاك حقوق الإنسان والمواطن عندما اقتضت مصالحها ذلك.
وكان ذلك الشأن في البلدان المستعمَرة. فقد سلكت الدول الأوروبية الكبرى في القرن التاسع عشر سياسية توسعية على حساب شعوب القارات الأخرى، وأخضعتها لهيمنتها سياسياً واقتصادياً. فكانت معاملتها لها معاملة الغالب للمغلوب من دون أي اعتبارلحقتها في تقرير مصيرها، ولحقوق الإنسان بصفة عامة. فعلى المستوى السياسي أصبحت القوى الاستعمارية سيدة الأمر بالمستعمرات على حساب سيادتها واستقلالها. وعلى المستوى الاقتصادي فتحت البلدان المستعمرة عنوة للبضائع الأوروبية على حساب ضاعاتها المحلية، ووقع ابتزاز مواردها، وذلك بالهيمنة على أخصب أراضيها ونهب ثرواتها الطبيعية، وبالتالي انتهاك حقها في التنمية، إذ انتقل قسط كبير من هذه الموارد لفائدة القوى الأوربية وجالياتها القاطنة بالمستعمرات. إلى جانب سياسة التمييز أو سياسة المكيالين التي يقوم عليها النظام الاستعماري.
فعلى مستوى الأجور كان مرتب العامل أو الموظف أصيل البلاد المستعمَرة أدنى من مرتب نظيره من الأوروبيين، وعلى مستوى الجباية لم تكن الضرائب توزع على السكان حسب مداخيلهم بل كان أصيلو المستعمَرة ـ على رغم تدهور حالتهم ـ يخضعون للضرائب أكثر من الأوروبيين. مع أن القسم الأوفر يرصد مرتبات الموظفين الأوروبيين وتجهيز البلاد طبقا لحاجات المصالح الاستعمارية.
وتتجلى سياسة التمييز كذلك على مستوى التعليم، حيث يخصص جل المدارس الي أنشئت على كاهل ميزانيات للأوربيين المقيمين بها، في حين أنهم لا يمثلون سوى جزء نزير من سكانها. ومثل هذه السياسة تتنافى بطبيعة الحال مع مبدأ المساواة أمام القانون، وبالتالي مع حقوق الإنسان. ويتجلى ذلك بأكثر وضوح في المجال السياسي، حيث يتمتع الأوروبيون بجميع الحريات والحقوق والضمانات في حين يعاني السكان الأصليون القمع والفقر والاستبداد وشتى التجاوزات.
ولم يكن المعمرون يعدون عملية دمج الأهالي ـ أي المساواة بينهم وبين الأوروبيين ـ ممكنة ولا مرغوبا فيها، فمصير السكان الأصليين، حسب النظرية الداروينية السائدة آنذاك، هو الاضمحلال على غرار الهنود الحمر في أمريكا. فلم تجد إذن حقوق الإنسان والمواطن حظها، في المستعمرات. وبينما كانت القوى الاستعمارية ترفع شعار الرسالة الحضارية لتبرير الاستعمار؛ فإنها لا تتوانى في انتهاك حقوق الشعوب المستعمرة.
وقد نجمت عن كل ذلك حركات وطنية رفعت تدريجيا مبدأ حق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها، وطالبت بالمساواة أمام القانون لحماية الأهالي من جميع التجاوزات الاستعمارية، فكان ذلك الشأن في البلاد التونسية مثلا، حيث عملت الحركة الوطنية على التصدي للاستعماروالاستبداد والدفاع عن حقوق التونسيين وذلك بالمطالبة بالمساواة أمام القانون وكذلك في الأجور والضرائب والتعليم بينهم وبين الفرنسيين، والفصل بين السلطات وتوفير الحقوق السياسية والحريات العامة وجميع الضمانات ضد التجاوزات، كما كان هو الشأن بالنسبة إلى الأوروبين، ووضع حد لسياسية التمييز التي تتناقض مع المبادئ والقيم المستوحاة من ثورة 1789م التي يستند إلهيا النظام الجمهوري الفرنسي. وكانت تعتمد في كل هذا فلسفة التنوير ومبادئ الثورة الفرنسية لتبين مدى تناقض السياسة الفرنسية في تونس مع هذه القيم الليبرالية. وبهذه الصفة قاومت الحركة الوطنية التونسية في جميع أطوارها الاستعمار باسم القيم الفرنسية، التي كان الوطنيون التونسيون متشبثين بها، ويعيبون على سلطان الجمهورية الفرنسية خرقها والتلاعب بها. ولتبليغ رسالتهم هذه للرأي العام الفرنسي كانوا كثيراً ما يعبرون عن وجهة نظرهم في جرائد تصدر بالفرنسية، وبذلك كانوا يقاومون الاستعمار باسم قيم الجمهورية الفرنسية، وبلغتها(1).
ولقمع الحركات الوطنية ازداد الاستعمار ضراوة وتعسفا. وتفنن الجهاز الاستعماري في القمع والسجن والتعذيب دون أي اعتبار لحقوق الإنسان. ففي الكونغو مثلا بُتِرت أيدي المناهضين للهيمنة البلجيكية. وفي أنغولا ذهب الأمر بالسلطات الاستعمارية البرتغالية إلى حد ثقب شفاه الوطنيين وغلقها بقفل(2).
ويتضح من كل هذا أن حقوق الإنسان والمواطن وحق الشعوب في تقريرمصيرها، الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولسون في بداية 1918م، هي بضاعة غريبة غير قابلة للتصدير إلى بلدان الجنوب، وبالتالي لا تخص سوى الإنسان والشعوب في الشمال. فلم ينزعج الرأي العام الأوروبي والأمريكي إلا عند انتهاكها في القارة الأوروبية نفسها. وذلك مع صعود الحزب الفاشي للحكم في إيطاليا سنة 1922م، ثم الحزب النازي في ألمانيا في بداية 1933م، وانتصار الفاشية التي تقوم على مبادئ تتناقض تماما مع حقوق الإنسان والمواطن، إذ كانت بمنزلة رد فعل قوى وشرس على القيم والمبادئ الليبرالية التي قامت عليها الحضارة الغربية الحديثة، فبينما يعتمد النمط الليبرالي الحريات الديموقراطية وتعدد الأحزاب والمساواة أمام القانون، وبالتالي المواطنة وسيادة الشعب، وتكريس الدولة في خدمة مصلحة الفرد وضمان حقوقه، تنبذ الفاشية جملة هذه القيم لتعتمد الكليانية، أي نظام الحزب الواحد والزعيم الأوحد، وتكريس الفرد في خدمة الدولة، التي هي غاية في حد ذاتها. وقد فند زعيم الحركة الفاشية الإيطالية موسوليني بوضوح المبادئ الليبرالية التي تقوم على الحقوق الطبيعية للإنسان كما يلي: «إن الفاشية تؤكد على اللامساواة بين البشر، والتي لا يمكن محوها بعملية ميكانيكية خارجية مثل الاقتراع العام، فالفاشية ترفض ما في الديموقراطية من افتراء سخيف يقول بالمساواة السياسية.. إن المفهوم الفاشي للدولة مناقض للفردانية.. وبالنسبة إليه كل شيء يوجد ضمن الدولة ولا يوجد أي نشاط بشري خارجها. فلا المجموعات (أحزاب سياسية، جمعيات، نقابات..) ولا الأفراد يمكن لهم الوجود خارج الدولة..».
ولابد من أن تؤول مثل هذه المبادئ إلى انتهاك حقوق الإنسان والمواطن من طرف النظام الفاشي في إيطاليا والنظام النازي في ألمانيا اللذين لم يترددا لحظة في قمع كل الحريات واستعمال أشد العنف والتعذيب ضد كل من يعارضهما.
كما استمت الفاشية والنازية بالعنصرية والعدوانية والتوسعية من دون أي اعتبار لحقوق الإنسان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتجسم ذلك في احتلال إيطاليا الفاشية لأثيوبيا وألبانيا، والعمل على قمع المقاومة الليبية للاستعمار الايطالي بصفة وحشية وكذلك إلحاق النمسا واكتساح تشيكوسلوفاكيا وبولونيا من طرف ألمانيا النازية التي لم تتردد إلى جانب ذلك، في العمل على إبادة العنصر السامي، وبالخصوص اليهود المقيمون بألمانيا وبلدان أوربا الشرقية.
ومع تغيير موازين القوى في أوروبا بين الليبرالية والفاشية إثر صعود الحزب النازي إلى الحكم في ألمانيا في بداية 1933 أصبحت حقوق الإنسان ولمواطن مهددة بكامل البلدان الأوروبية. فإن فشلت الحركات الفاشية في الصعود إلى الحكم في فرنسا، حيث تسود ثقافة ديموقراطية عميقة يعود عهدها إلى ثورة 1789م، لم يكن الامر كذلك بالنسبة لإسبانيا التي خضعت منذ 1939م لنظام فاشي إثر حرب أهلية مريرة انتصر فيها الفاشيون على الجمهوريين بفعل مساندة كل من ألمانيا وإيطاليا.
ومثل هذا الوضع، من شأنه أن يزيد في وعي الأوروبيين بحقوق الإنسان والمواطن خصوصاً أن السياسة العدوانية للقوى الفاشية قد أسفرت في نهاية الأمر عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، التي بدت بمنزلة الصراع بين فلسفتين سياسيتين متناقضتين، أي الليبرالية والفاشية، والتي كثر في أثنائها الحديث حول حقوق الإنسان والمواطن، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وبرز ذلك خصوصاً في صفوف الحلفاء في سياق دعايتهم المناهضة للفاشية، وذلك لكسب تأييد الشعوب الأوروبية وحتى المستعمرة ضد قوى المحور.
وتجلى هذا الاتجاه في تصريحات رئيس الحكومة البريطانية تشرشل ورئيس الولايات المتحدة روزفلت، وخصوصا في المواثيق التي وقع إبرامها خلال وغداة الحرب العالمية الثانية، كالميثاق الأطلسي (14 أغسطس 1941م) وميثاق الأمم المتحدة (أكتوبر 1945م) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجميعة العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948م.
وقد وقع التأكيد في الميثاق الأطلسي الموقع من طرف روزفلت وتشرشل ـ على احترام «حق الشعوب كافة في اختيار نظام الحكم الذي يريدون أن يعيشوا في ظله» وعلى «عودة الحقوق الأساسية والحكومات المستقلة إلى أصحابها الذين انتزعت منهم بالقوة»، وكذلك على تحقيق، بعد القضاء التام على التعسف النازي، سلم يوفر لجميع الأمم أسباب عيشها بأمان داخل حدودها، ويؤمن الضمانة لكل الشعوب لتتمكن من العيش بحرية من دون خوف أو حاجة(3).
أما ميثاق الأمم المتحدة فقد أكد على الإيمان «بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد، وقدرة وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية» ووكذلك على ضرورة التسامج والسلم والأمن الدولي والعمل على «ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها»(4).
غير أن هذه القيم قد وردت بأكثر وضوح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو بمنزلة الحصيلة لهذه الحقوق وأسسها، منذ فلاسفة التنوير والإعلان الانجليزي عن الحقوق(1689م)، والإعلان عن استقلال الولايات المتحدة الأمريكية(1776م)، وإعلان الثورة الفرنسية عن حقوق الإنسان والمواطن(1789م). وقد جـُعـِل احترامها شرطا من شروط السلم في العالم الذي عانى ويلات الحرب العالمية الثانية بسبب تجاهلها.
وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في الحياة وسلامة شخصه، وكذلك في حرية التملك والرأي والفكر والتعبير والتجمع والتنقل والضمير والمعتقد والعمل، وعلى ضرورة حمايته من الإيقاف التعسفي والتعذيب وضمان قضاء عادل له يقوم على أساس أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»(5). وكل هذه الحقوق تستوجب إقرار المواطنة أي يكون «لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون اختيارا حرا»، باعتبار «أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، يعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت»(6).
كما تقوم هذه الحقوق على المساواة أي أن لكل إنسان حق التمتع بها «دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر من دون أي تفرقة بين الرجال والنساء»(7). وإلى جانب ذلك شجب الإعلان عن حقوق الإنسان العبودية والاستعمار وأقر المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق كل شعب في تقرير مصيره. فهذا الإعلان هو إذن بمنزلة الدفاع عن التراث البشري لحقوق الإنسان لضمان بقائه وخلوده ولمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وقع إنشاء لجنة حقوق الإنسان تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقد ساعد بروز هذه المبادئ بقوة إثر الحرب العالمية الثانية وانهيار الأنظمة الكليانية التي بالغت في انتهاكاتها في نمو الوعي الوطني لدى العديد من الشعوب المستعمرة، التي دخلت عندئذ بجرأة أكثر في صراع مع الاستعمار أسفر عن تحرير العديد من المستعمرات، منذ أواخر الأربعينيات إلى بداية الستينيات. وبقيت بعض البلدان تخضع للهيمنة الأجنبية من بينها فلسطين حيث حل منذ 1948م الاستعمار الصهيوني محل الاستعمار البريطاني من دون أي اعتبار لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. فبرزت عندئذ دول مستقلة عملت إجمالا، في بداية الأمر، على سن أنظمة سياسية تقوم على دساتير تقر الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون والحريات العامة وتضمن مبدئيا حقوق الإنسان والمواطن، طبقا للقيم التي اعتمدتها الحركات الوطنية في نضالها ضد الاستعمار. غير أنه تبين، فيما بعد، أن جل هذه الدساتير هو بمنزلة الحبر على الورق، إذ سرعان ما وقع خرقها من طرف واضعيها الذين سنوا قوانين تحد من جميع الحريات وتفرغها بذلك من فحواها. وتسنى لهم ذلك في غياب مجالس دستورية مستقلة تسهر على دستورية القوانين، وتقوم بإلغاء كل قانون يتنافى مع الدستور باعتباره القانون الأسمى الذي يعلو ولا يعلى عليه، فسادت عندئذ في جل بلدان الجنوب أنظمة سياسية تقوم على الحزب الواحد والقائد الأوحد، وبالتالي على الحكم المطلق الذي هو مجلبة للظلم لقمعه للحريات وخرقه لحقوق الإنسان والمواطن، وذلك بدعوى ضرورة إرساء دولة قوية قادرة على النهوض بالبلاد، وغياب النضج السياسي لسكان جلهم أميون، وباعتبار أن الأولوية في بلدان مختلفة اقتصاديا تكمن في العمل على توفير مرافق الحياة للمواطنين، أي الشغل والسكن والمدارس والمستشفيات، كأنما الديموقراطية وحقوق الإنسان عقبة أمام التنمية والتقدم. من ذلك رداءة أوضاع حقوق الإنسان والمواطن في جل هذه البلدان بالرغم من تعاقب الحكومات، ومن نضالات المدافعين عنها على حساب حريتهم وكرامتهم، فالتطور الوحيد في هذا المجال يكمن في تشدق هذه الأنظمة بالديموقراطية وحقوق الإنسان مع عدم التواني في خرقها. ولكي تضفي شرعية على ذلك توظف مجالس نواب موالية لها للمصادقة على قوانين، تبرر بها تجاوزاتها حرية المواطنين وحقوقهم. وكانت الغاية من ذلك خداع الرأي العام في بلدان الشمال، حيث تمثل حقوق الإنسان والمواطن العقيدة السياسية السائدة، وتحاشي حملات وسائل الإعلام الغربية ضدها.
العلاقات شمال ـ جنوب وحقوق الإنسان
غير أن العلاقات شمال ـ جنوب تقوم أساسا على مصالح القوى الكبرى، ولو تناقض ذلك مع حقوق الإنسان والمواطن، كما كان الشأن في عهد الاستعمار. وقد بقيت هيمنة الشمال على الجنوب في عديد البلدان ـ قائمة الذات إثر استقلالها وذلك في نطاق «الاستعمار الجديد» الذي حل محل الاستعمار التقليدي، والذي يكمن أساساً في محافظة الدول الكبرى على مصالحها الاقتصادية في مستعمراتها القديمة وفي مراقبة مواردها.
ثم إن القوى العظمى أحكمت سيطرتها على الاقتصاد العالمي طبقا لمصالحها وعلى حساب «العالم الثالث» واضعة بذلك علاقات لا متكافئة بين الشمال والجنوب، فهي التي تحدد الاستعمار العالمية لجميع المنتوجات وفقا لما تقتضيه مصالحها. وقد نجم عن ذلك انخفاض متزايد في أسعار منتوجات العالم الثالث، مقارنة بأسعار منتوجات القوى الكبرى، وبالتالي في اختلال التوازن في المبادلات التجارية بين الشمال والجنوب. ومثل هذا الوضع المتميز بعجز الميزان التجاري في جل بلدان العالم الثالث يجعل هذه البلدان الفتية تلجأ إلى الاقتراض لاستيراد التجهيزات اللازمة للنهوض باقتصادها، غير أن سياسة المديونية زادت في تبعية الجنوب الاقتصادية، وبالتالي السياسية للشمال، وأصبحت حاجزا أمام تنمية بلدان العالم الثالث التي هي ملزمة بتخصيص جزء لا يستهان به من مواردها لاستيفاء ديونها.
وكان لمثل هذه العلاقات انعكاسات وخيمة على بلدان الجنوب وعلى حقوق الإنسان والمواطن فيها، إذ إنها تحول دون النهوض بمجتمعات «العالم الثالث»، وبالتالي دون القضاء على الفقر والفاقة والأمراض والجهل فيها، وتتناقض بذلك مع حق الشعوب في التنمية وتقرير المصير. ولابد من أن يدفع مثل هذه الأوضاع إلى المزيد من الغضب والهيجان في صفوف الفئات الاجتماعية المتضررة منها، فتزيد عندئذ أنظمتها السياسية من مقدرتها الدفاعية لحماية نفسها، وتتدخل أجهزتها الأمنية بقوة لقمع المناهضين لها، والتنكيل بهم بجميع الوسائل المنافية لحقوق الإنسان والمواطن.
وقد استفحلت هذه الأوضاع منذ قيام العولمة، أي النظام العالمي الجديد الذي وضعته القوى الغربية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إثر انهيار الاتحاد السوفييتي، والذي يرمي أولاً، وبالذات، إلى خدمة مصالح الشمال على حساب الجنوب، إذ يقوم على حرية المبادلات التجارية بقصد فتح آفاق أوسع أمام بضائع بلدان الشمال ورؤوس أموالها، وذلك بإلغاء المكوس الجمركية تدريجيا وانتزاع السلاح الوحيد الذي يخول لبلدان الجنوب حماية صناعاتها الفتية وزراعتها من المنافسة الأجنبية. وهي الظاهرة نفسها التي عانتها بلدان الجنوب في القرن التاسع عشر عندما فرضت عليها القوى الكبرى معاهدات لامتكافئة تقوم كذلك على حرية المبادلات التجارية وتخفيض المكوس الجمركية. وأسفر ذلك عن تدهور الصناعات المحلية لهذه البلدان التي لم يعد بوسعها منع أو تحديد دخول البضائع الأجنبية إلى أسواقها، وحتى التحكم في سياستها الجمركية لحماية اقتصادها من المنافسة الغربية.
فالعولمة هي إذن امتداد للإمبريالية على مستوى الأهداف، وكذلك على مستوى النتائج، إذ كانت لها انعكاسات وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الجنوب. فقد انخفضت في البلاد التونسية مثلا مداخيل الخزينة 20%(8) نتيجة التخفيض تدريجيا في المكوس الجمريكية إلى حد إلغائها سنة 2008م، بمقتضى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995م في إطار فلسفة العولمة. هذا علاوة على إفلاس ثلث مؤسساتها الصناعية ومرور الثلث الآخر بصعوبات جمة من جراء المنافسة الأوروبية(9).
وقد يؤول منطق العولمة هذا إلى تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العديد من بلدان الجنوب وحتى إلى انفجاره ويسفر ذلك حتما عن تدخل جهاز الدولة لقمع الاضطرابات بالعنف الشديد، ومن دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان والمواطن. ثم إن البعد الثقافي للعولمة الذي يتمثل في غزو الثقافة الغربية لبلدان الجنوب وتهديد هوايتها بالذوبان، من شأنه توفير الظروف الملائمة لنمو الحركات السلفية المعادية للنمط الغربي، خصوصا في البلدان الإسلامية. فتكون هذه الحركات أمام الرأي العام بمنزلة المدافعة الحقيقية عن الثقافة والهوية الوطنية، وتجد دعوتها صدى كبيرا، خصوصا في صفوف ضحايا العولمة. وينجم عن ذلك حتما توتر سياسي يزيد في سياسة القمع ضد الحركات الإسلامية، في بداية الأمر، ثم كل من يناهض الأنظمة السياسية القائمة، فيتقلص بذلك مجال الحريات في جل بلدان الجنوب على حساب حقوق الإنسان والمواطن.
فالنظام العالمي الجديد يمثل في نهاية التحليل عقبة أمام تقدم بلدان الجنوب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو لذلك مجلبة لجميع أنواع التجاوزات لحقوق الإنسان والمواطن.
وعلى الرغم ذلك فإن المجتمع المدني في العالم الثالث ما زال يراهن على مساندة الغرب في الدفاع عن هذه الحقوق. غير أنه، علاوة على أن النضال من أجل المواطنة وحقوق الإنسان يخضع أولاً، بالذات إلى موازين القوى الداخلية. فإن العلاقات شمال ـ جنوب تقوم قبل كل شيء على المصالح. فالقوى العظيمة لا تناوئ الأنظمة الاستبدادية التي لا تتوانى في خرق حقوق الإنسان إذا كانت تتماشى مع مصالحها، بينما تتدخل ضد أنظمة وطنية وحتى ديموقراطية لكونها تناهض هيمنتها وتناوئ مصالحها. وهذا الاتجاه الذي تبلور في القرن التاسع عشر ما زال يطبع العلاقات شمال ـ جنوب إلى حد يومنا هذا.
فعندما أعلن الخديوي إسماعيل في مصر سنة 1879م تحت ضغط حزب الإصلاح عن دستور يقر المواطنة ويضمن بذلك حقوق الإنسان، تدخلت بريطانيا العظمى وفرنسا لإحباطه. فوقع خلع إسماعيل وتعويضه بابنه البكر توفيق ثم تعطيل الدستور. وعندما أعاد الحزب الوطني الكرة وأجبر الخديو توفيق سنة 1881م على تشكيل حكومة وطنية، وتأليف لجنة برلمانية لوضع دستور للبلاد، وقع الإعلان عنه سنة 1882م، أثار ذلك حفيظة بريطانيا العظمى وفرنسا اللتين احتجتا على هذا النظام الدستوري، الذي يقوم على مجلس نيابي له حق تقرير الميزانية، بدعوى أنه يتناقض مع التزامات الحكومة المصرية التي أوكلت، تحت الضغط منذ 1876م، التصرف في ميزانية الدولة إلى صندوق الدين العام أي إلى جهاز إنجليزي ـ فرنسي. فعوض أن يترك هذا الأمر ـ كما هو الشأن في البلدان الغربية ـ إلى برلمان ينبثق من الأمة، ويسهر على مصيرها وحقوقها، تدخلت بريطانيا العظمى عسكرياً سنة 1882م لإحباط النظام الدستوري وبسط نفوذها على مصر.
وقد تواصل هذا الاتجاه في القرن العشرين وتجسم، خصوصاً في طبيعة علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع بلدان أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. فهي لا تتوانى في دعم أنظمة سياسية مستبدة تتناقض ممارساتها مع حقوق الإنسان والمواطن، بينما تقر العداء لأنظمة تقدمية تعير الاعتبار لهذه الحقوق. فكان ذلك الشأن سنة 1952م في إيران، حيث تدخلت بواسطة وكالة مخابراتها ضد حكومة الدكتور مصدق التي عزمت على تأميم شركات النفط، وبالتالي على مناهضة الغرب ومصالحه، وذلك لفائدة نظام ملكي مستبد يخضع للقوى الغربية. كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينيات بتشيلي للإحاطة بنظام اللندي الذي انبثق من انتخابات ديموقراطية، وتعويضه بنظام عسكري فاشي لا يتوانى في خرق حقوق الإنسان والمواطن. وكذلك الشأن في البدان العربية حيث تقوم العلاقات مع القوى الغربية على أساس المصالح، ومن دون اعتبار المبادئ والقيم. فكأنما الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان بضاعة غربية صرفة لا تخص سوى سكان الشمال وغير صالحة للتصدير إلى بلدان الجنوب.
ويتجلى هذا المنهج بأكثر وضوح في وقتنا الراهن من خلال نظرة الغرب إلى القضية الفلسطينية. إذ يعتبر الصهيانة الذين اغتصبوا فلسطين عنوة بمعونته، بمنزلة الامتداد للحضارة والقيم الغربية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي جديرين بجميع الحقوق، ولو كان ذلك عل حساب الشعب الفلسطيني. ومن ذلك سياسة المكيالين التي تنتهجها القوى الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني. إذ يعد نضال الشعب الفلسطيني لتحرير بلاده وممارسة حقه في تقرير مصيره إرهابا، بينما تقر العدوان الصهيوني عليه باعتباره مشروعا ودفاعا عن النفس.
فلا جدوى إذن في الاعتماد على القوى الغربية لإرساء أنظمة ديموقراطية تضمن حقوق الإنسان والمواطن خصوصا في البلدان العربية، حيث يمثل الغرب في مخيلة الشعوب العدو الوراثي وذلك نظرا إلى الخلافات التاريخية بينه وبين العرب التي تعود إلى الحروب الصليبية وقد استفحلت هذه الخلافات في العهد الحديث والمعاصر من جراء هيمنة القوى الغربية على جل البلدان العربية. وجاءت القضية الفلسلطينية لتغذية كراهية الشعوب العربية للغرب الذي كان وراء قيام الكيان الصهيوني ودعمه، والذي تستفز مواقفه مشاعر العرب، باعتبارها، خلافا للمنطق المعهود، الجلاد على حق والضحية على باطل.
فلابد إذن في مثل هذا الوضع، من أن يفرز كل نظام ديموقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، مجالس نواب وحكومات تعكس شعور شعوبها وطموحاتها، وتكون بالتالي معادية للغرب ومناهضة لهيمنته ومصالحه.
وبطبيعة الحال، لا يمكن للقوى الغربية مساندة مثل هذه التيارات الديموقراطية، بل ستعمل جاهدة لتحول دون نجاحها، وتكون بذلك عقبة أمام تحقيق المواطنة وضمان حقوق الإنسان في البلدان العربية ما دامت الديموقراطية تتناقض مع مصالحها. فمسؤولية مثل هذا المشروع تعود بالدرجة الأولى إلى النخب العربية المثقفة التي هي كثيرة العدد وغالبا ما تكون مهمشة. إذ إنه بوسعها بعث ثقافة ديموقراطية في البلدان العربية وخلق المناخ الملائم لإرساء أنظمة سياسية تقوم على المواطنة واحترام حقوق الإنسان، وذلك يستوجب منها بطبيعة الحال المزيد من الشجاعة والعزيمة والتضحية، خصوصا أن كسب مثل هذا الرهان الذي يعين كذلك على تقارب البلدان العربية واتحادها، هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات العولمة وتحديات الصهيونية لتحرير العالم العربي من التبعية والتخلف والاستبداد والظلم، وبالتالي لإرساء المواطنة وحقوق الإنسان.
* د. علي بن حسين المحجوبي
***************
الهوامش:
(1) علي المحجوبي، النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر، تونس، 1999م: 191- 195.
(2) جان بول سارتر(Jean Paul Sartre) توطئة لكتاب «المعذبون في الأرض» لفرتز فانون (Frantz Fanon)، باريس، 1961م: 15.
(3) الميثاق الأطلسي (ورد شولنج: نصوص تاريخية، ج1: 271، تعريب لبيب عبد الستار(احداث القرن العشرين).
(4) ميثاق الأمم المتحدة.
(5) «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مادة 11، (ورد في كتاب الإسلام وحقوق الإنسان) للدكتور عبد الحسين شعبان، بيروت، 2001م: 75-80.
(6)الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 21(المصدر نفسه).
(7) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 2.
(8) Jacques Ould Aoudia – Financement et croissance. Magherb - Masherk, n hors serie, Decembre 1997.
(9) Roula Khalaf, skepticism over E.U accord, Financial - Times, 22 september 1999.
وجدت في الإسلام تكريما افتقدته في الغرب

ايريس صفوت ـ المانية ـ احدى الغربيات اللاتي دخل الايمان الى قلوبهن تعيش الآن في صفاء وسعادة لم تشعر بها من قبل، تعرفت على الاسلام في سن العاشرة عندما وجدت ان شيئا ما بداخلها يشدها نحو الاسلام وفي عام 1967 سافرت في رحلة الى لندن واشهرت اسلامها بالمركز الاسلامي هناك.
التقتنا هذه السيدة الالمانية على هامش المؤتمر الاسلامي الدولي الرابع عشر الذي انهى اعماله اخيرا بالقاهرة وفي الحوار التالي نتعرف على قصة اسلامها ورحلتها الايمانية.
* متى تعرفت على الاسلام وماذا كان شعورك وقت ذلك؟
ـ نشأت في اسرة مسيحية علمانية ابتعدت عن الكنيسة وعندما كنت في سن العاشرة شعرت بأن شيئا ينقصني في حياتي، وفطرتي دائما تشتد نحو الدين واخذت ابحث لي عن دين وكنت في ذلك الوقت اقرأ في الكتب عن الاسلام ووقتها شعرت بشيء يشدني بقوة الى الاسلام كدين سماوي يرفع من كيان الانسان ويحمل جميع الفضائل والاخلاق الفاضلة واخذت اهتم بهذا الدين وتحدثت الى زميلاتي في المدرسة وعن الاسلام وانني احب هذا الدين وحينئذ كنت بلغت الثانية عشرة من عمري وبالفعل اسلمت وكتمت اسلامي لان زميلاتي وصفنني بالجنون.
* ولكن ماذا كان موقف اسرتك وهل عرفوا بقصة اسلامك؟
ـ في البداية اعتبرت اسرتي انني امر بمرحلة اضطراب وتقلب في المزاج لكن عندنا في الغرب حرية واذا بلغ الابناء سن الثالثة عشرة فمن حقهم ان يتصرفوا كيفما شاءوا ومن حقهم ايضا ان يتركوا اهلهم وبالتالي فتركوا لي حرية الديانة وعندما وصلت للثانوية العامة وكان عمري حيئذ ثلاثة عشرة سنة وذلك عام 1967 وكنت في رحلة الى لندن وذهبت الى المركز الاسلامي هناك والتقيت بالشيخ محمد الجيوشي (عميد كلية الدعوة الاسبق بجامعة الازهر) وكان اماما للمركز وقلت له انني اريد ان اعلن اسلامي واذهب الى الازهر وادرس الدين الاسلامي واللغة العربية. كما التقيت بالشيح احمد حسن الباقوري (وزير الاوقاف المصري الاسبق) في ذلك الحين ووعدني بالدراسة في الازهر واعلنت اسلامي امام الشيخين ونطقت بكلمة التوحيد وفي عام 1969 سافرت الى مصر وتعلمت اللغة العربية ثم عدت الى المانيا لدراسة الماجستير في جامعة كيسين وفي اثناء دراستي للماجستير تعرفت على شاب مصري كان يدرس في مرحلة الدكتوراه وتزوجنا وسافرنا عام 1975 الى مصر وواصلت دراستي للغة العربية وزادت معرفتي بالاسلام.
* اكثر من ثلاثين عاما منذ ان اعتنقت الاسلام.. هذه الفترة بلا شك كفيلة بأن تجعل منك داعية لاهلك في المانيا فهل قمت بنوع من العمل الدعوي هناك؟
ـ نعم منذ اللحظة الاولى لاسلامي وانا انتمي لهذا الدين وادعو اليه والحمد لله استطعت ان اقنع اثنين من اقاربي بأن يسلما هم جدتي ورجل آخر من اقاربي والذين لم يسلموا كنت اعطي لهم فكرة عن الاسلام وهم عندما يسمعونني كانوا يحترمون الاسلام.
* ماذا عن علاقتك بأسرتك الان؟
ـ علاقتي بأسرتي في ألمانيا جيدة منذ ان اعلنت اسلامي لانه في المانيا يوجد تسامح واحترام لحرية العقيدة ويعتبرون ان الدين مسألة شخصية.
* أريد التعرف على حياتك قبل الاسلام وهل كان فيها نوع من الالتزام الديني أم غير ذلك؟
ـ الذي لم يعرفه العالم الاسلامي والعربي ان الدين في الغرب شيء هامشي الى اقصى درجة وليس هناك التزام ديني فالمسيحية ما هي الا اسم فقط فأنا على سبيل المثال نشأت في اسرة علمانية مسيحية ليس لها علاقة بالكنيسة ونشأت على الفطرة.
* ما هو اكثر شيء جذبك للاسلام؟
ـ قبل ان اعلن اسلامي كنت اقرأ عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته فأحببت هذه الشخصية كثيرا لما تتميز به من خصال لا توجد في بشر على وجه الارض.
* أرى ان الزي الذي ترتدينه فيه حشمة ووقار بخلاف الاخريات المتبرجات فهل هذا التزام داخلي؟
ـ شريعة الاسلام كما تعلمت امرت المسلمة بالاحتشام وهذا الزي اجد فيه نفسي وراحتي ولا ابالغ اذا قلت اجد فيه الاناقة بكل ابعادها ونحن في الغرب لا نقبل الاكراه على شيء بل نفعل ما نعتقده ونقتنع به وانا مقتنعة بهذا الزي.
* هل تعلمين ان الاسلام لم يكره احدا على اعتناقه لكنه يمنع من يدخله ان يرتد عنه؟
ـ انا دخلت الاسلام بقناعة شخصية ودون تدخل أو تأثير من أي مسلم لانه لم يكن في الريف الذي نشأت فيه مسلمون اطلاقا وكون ان الاسلام لم يجبر احدا على اعتناقه ويعاقب من يسلم ثم يرتد فهذا قمة العدل لان المرتد يكون ضد الاسلام ويعطي صورة سيئة عن الدين وهو من قبيل التلاعب بالاديان.
* ما هي امنيتك بعد اسلامك؟
ـ في البداية كانت امنيتي ان يكرمني الله بالحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله وسلم وقد اديت هذه الفريضة عام 1990 وبعدما اديت الحج كانت امنيتي وما زالت ان اكون داعية للاسلام وبعض الاصدقاء اقترحوا علي ان اقوم بالقاء دروس للسيدات في المساجد في مصر والبلاد العربية ولكن فضلت ان اخاطب الغرب واشرح للغربيين المفاهيم المغلوطة والمشوهة عن الاسلام لأنني أفهم ثقافة الغرب وأستطيع اقناعهم.
* لماذا يقف العالم الغربي موقف العداء من الاسلام؟
ـ الغرب لم يكره الاسلام كما هو متصور لكنه لديه فكرة خطأ عنه لانه عندهم الاسلام هو ارهاب وعنف. ومثلاً في ألمانيا نجد أن العنصرية أو الاضطهاد الذي يلقاه الأجانب سواء مسلمون أو غيرهم هو بسبب العوامل الاقتصادية لأن الألمان ينظرون الى أن هؤلاء الأجانب سيأخذون منهم فرص العمل وبالتالي يرفضون وجود الأجانب بينهم.
التحديات التي تواجه الإسلام في العصر الحديث

- تمهيد:
لا جدال في أن عصرنا يختلف اختلافاً جذرياً عمّا سبقه من حقب تاريخية، ولعله لا مجال هنا للمقارنة نظراً لما طرأ على عالمنا المعاصر من تطورات، وما جد فيه من متغيرات متسارعة، وما ظهر فيه من مخترعات باهرة لم تكن تخطر على بال أحد من كُتّاب روايات الخيال العلمي.
فالواقع المعاصر فاق كل التوقعات.. إنّه عصر الثورة العلمية والتكنولوجية وثورة المعلومات والإتصالات والإستنتساخ.. وكل يوم يشهد عالمنا المعاصر مزيداً من الإكتشافات والمخترعات والمفاجآت، ويخلق ما لا تعلمون.
والسؤال هو: أين عالمنا الإسلامي من ذلك كلّه؟
ألا يعد جزءاً من هذا العالم الذي نعيش فيه، والذي أصبح – كما يقال كثيراً – مثل قرية كونية صغيرة؟
ألا يتأثّر بكل ما يحدث في هذا العالم من متغيرات؟ وهل يستطيع أن يعزل نفسه عن ذلك كلّه؟
هل اكتفى عالمنا الإسلامي بدور المتفرج على ما يدور حوله من تطورات، وقنع بدور المستهلك لما ينتجه عالمنا المعاصر من منجزات في مجالات العلم والتكنولوجيا والترفيه؟
إنّ ما جد في العالم من تطورات، على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية، يحمل معه تحديات كثيرة لعالمنا الإسلامي، فهل استعدّ المسلمون لمواجهتها وبذل الجهد للتغلب عليها؟
وقبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، نودّ هنا أن نؤكِّد أنّ كل التحديات التي تحيط بعالمنا الإسلامي ليست تحديات تواجه الإسلام بوصفه الدين الخاتم، الذي تستطيع شريعته أن تواجه كل الظروف والمتغيرات في كل زمان ومكان لما تمتاز به من المرونة والإعتدال. فالتحديات القائمة واللاحقة هي في حقيقة الأمر تحديات للمسلمين، وليست تحديات للإسلام ذاته.
إنّها تحديات تواجه عقول المسلمين وقدرتهم على استيعاب تطورات العصر، والوعي بالزمن، والوعي بالتطور التاريخي.
والوعي بالزمن يعني وعياً بحركة الزمن من ماض إلى حاضر إلى مستقبل، وأنها دائماً في صعود. فالتاريخ يسير إلى الأمام ولا يتراجع إلى الوراء. أمّا الوعي بالتطور التاريخي، فإنّه يعني نقلة نوعية تشتمل على إضافة حضارية يسجلها التاريخ. وحتى يكون هذا الوعي حاضراً في الأذهان، لابدّ من التغلب على العقبات التي تعترض طريق هذا الوعي وتحجب عنه الرؤية الصحيحة والإدراك السليم.
وهذه العقبات تمثل تحديات أمام الأُمم. والأُمم التي تدرك ما يدور حولها بوضوح وتدرك متطلبات كل عصر، وتستجيب للتحدي وتتغلب عليه وتكون جديرة بالحياة والبقاء. أمّا الأُمم التي تنهزم أمام التحدي، فإنّها تفنى وتطوى صحيفتها في زوايا النسيان دون أن تقوى على التحرك نحو المستقبل.
إنّ التحديات التي تواجه المسلمين في عالم اليوم تحديات معقدة وفي حاجة إلى إرادة قويّة وعزيمة صادقة لتجاوزها والسير صعوداً نحو مستقبل مشرق إن شاء الله.
وعندما نتأمّل هذه التحديات، نجد أنها ليست كلها جديدة تماماً، فقد بدأ بعضها في الظهور في النصف الأخير من القرن العشرين، بوصفة خاصة في العقد الأخير منه، فقد حدثت في هذا العقد تطورات بالغة الأهميّة وعلى رأسها انهيار الإتحاد السوفيتي السابق، وظهور القطب الواحد في العالم، وانتشار الخوف غير المبرر من الإسلام في الغرب بوصفه العدو البديل أو الخطر القادم الذي يهدد الحضارة العالمية، والترويج لنظرية صدام الحضارات ونهاية التاريخ، والتطورات العلمية الجديدة مثل الإستنساخ وزراعة الأعضاء، وغيرها ممّا قد يزعزع المعتقد الديني في عالم القرن الواحد والعشرين.
وإذا كانت هذه التحديات خارجية، فهناك بالإضافة إلى ذلك تحديات داخلية عديدة، من أهمّها: التخلف الذي تعاني منه الأُمّة الإسلامية، وانتشار ظاهرة الإرهاب في العالم الإسلامي على نطاق واسع، رغم أنها تعد ظاهرة عالمية. ويرتبط بذلك كله أيضاً الفهم الخاطئ للإسلام، والتفسيرات المغلوطة لتعاليمه، وخطر الأصدقاء الجهال للإسلام الذين هم أشد ضرراً على الإسلام من خصومه. وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل يُبيِّن موقف الإسلام من ذلك كله.
- التحديات الداخلية:
التغلب على التحديات الداخلية يعد المدخل الطبيعي للتغلب على التحديات الخارجية، فترتيب البيت من الداخل يعني أن تكون له الأولوية، فضلاً عن أنه من ناحية أخرى مرتبط بشكل وثيق بتحديات الخارج، بمعنى أنه إذا تعافى العالم الإسلامي من أمراضه الداخلية وتغلب على تحديات الداخل، فإنّه يكون حينئذ في وضع يؤهله للتغلب على التحديات الخارجية.
وفيما يلي نلقي بعض الضوء على أهم التحديات الداخلية:
أ) التخلف:
يعد التخلف – الذي يسود المجتمعات الإسلامية – أخطر التحديات الداخلية التي تواجه العالم الإسلامي. وهذا التخلف ليس تخلفاً على المستوى المادي فحسب، وإنما هو تخلف شامل لشتى النواحي العلمية والفكرية والأخلاقية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية. ولا يغرن أحداً تلك القشرة الحضارية الظاهرية في عالمنا الإسلامي. فالمسلمون اليوم – للأسف الشديد – ليسوا أكثر من مستهلكين لمنجزات الحضارة المعاصرة وليسوا منتجين لها أو مشاركين فيها.
صحيح أنّ أسلافنا قد تركوا لنا رصيداً حضارياً ضخماً لازلنا نعتز به ونفخر، ولكننا وقفنا عند هذا الحد ولم نبذل أي جهد حقيقي يضيف جديداً إلى ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. ورحم الله جمال الدين الأفغاني الذي قال ذات مرّة: "إنّ الشرقيين كلما أرادوا الإعتذار عمّا هم فيه من الخمول الحاضر، قالوا: أفلا ترون كيف كان آباؤنا؟"، ويضيف الأفغاني قائلاً: "نعم، لقد كان آباؤكم رجالاً، ولكنكم أنتم أولاء كما أنتم، فلا يليق بكم أن تتذكّروا مفاخر آبائكم إلا أن تفعلوا فعلهم".
إنّ حالة التشرذم المسيطرة على العالم الإسلامي تعد أكبر دليل على مدى التخلف الذي تعانيه أُمّتنا الإسلامية في الوقت الذي يتجه فيه عالمنا المعاصر إلى التوحد في تكتلات دولية قوية.
وعلى الرغم من أنّ عالمنا العربي قد سبق أوروبا في محاولته التوحد في إطار الجامعة العربية، وعلى الرغم من تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي بعد ذلك بسنوات، فإنّ هذه الروابط العربية – الإسلامية لا تزال ضعيفة وغير مؤثرة، في الوقت الذي قطع فيه الإتحاد الأوروبي خطوات عملاقة. فقد أصبحت هناك عملة أوروبية واحدة، وتعاون اقتصادي قوي، وبرلمان أوروبي واحد، وتنقل حُر للأفراد بين دول الإتحاد، وغير ذلك من مجالات أخرى كثيرة للتعاون.
ويحاول خصوم الإسلام نسبة التخلف في العالم الإسلامي إلى الإسلام، ويزعمون أنه هو الذي يشد أتباعه إلى الوراء دائماً ولا يتيح لهم حرّية الحركة للإنطلاق نحو آفاق التقدم. وهذا اتهام لا يستند إلى أي أساس لا من العلم ولا من الواقع التاريخي. فالإسلام هو الذي دفع المسلمين في السابق إلى بناء حضارة مزدهرة استمرت ما يقرب من ثمانية قرون. ويُعبِّر المرحوم مالك بن نبي عن بطلان هذا الإتهام بقوله: "إنّ التخلف الذي تعاني منه الأُمّة الإسلامية اليوم ليس سببه الإسلام، وإنما هو بالأحرى عقوبة مستحقة من الإسلام على المسلمين لتخليهم عنه لا لتمسكهم به كما يظن بعض الجاهلين".
وإذا كانت الحضارة لا تقوم إلا بالعلم، فإنّ الإسلام قد جعل العلم فريضة لا تقل شأناً عن فرائض الصلاة والصوم والزكاة، وجعل مداد العلماء مساوياً لدماء الشهداء، ووصف العلماء بأنّهم أخشى الناس لله، لأنّهم الذين يدركون أسرار الخلق وجلال الخالق. وإذا كان الإسلام دين العلم والحضارة على النحو الذي أشرنا إليه، فكيف وصل الحال بالمسلمين إلى أن تكون نسبة الأُمية لديهم تصل إلى 5ر46% طبقاً لبيانات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وأن تصل هذه النسبة في أوساط النساء في بعض البلاد الإسلامية إلى 60%.
فإذا انتقلنا إلى مجال التجارة والإقتصاد، نجد أنّ عالمنا المعاصر يتجه – كما سبق أن أشرنا – إلى تكوين التكتلات الإقتصادية الكبرى والشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، وذلك في الوقت الذي نجد فيه أنّ حجم التجارة البينية في العالم الإسلامي والعربي لا يتجاوز نسبة 8% من مجموع تجارته مع بقية دول العالم، وذلك طبقاً لآخر التقارير الرسمية للبنك الإسلامي للتنمية. وهذا واقع مؤلم، فهذا التخلف سيظل قائماً طالما ظلّ اعتماد العالم الإسلامي في كل شيء – حتى في غذائه – على العالم الخارجي.
والمسلمون لديهم ثروات بشرية كبيرة وثروات مادية هائلة تتمثّل في البترول والمعادن المختلفة التي لا يزال الكثير منها مطموراً في باطن الأرض، ويعيشون في مناطق استراتيجية في العالم ولا ينقصهم إلا الإرادة القوية والعزيمة الصادقة.
وقد يميل البعض إلى تفسير ما نقوله في هذا الصدد بأنّه لون من ألوان جلد الذات، وليس هذا بالقطع ما نقصده. إنّنا في أمسّ الحاجة إلى نقد موضوعي للذات، وهذا ما نفتقده في واقع الأمر. ونقد الذات الذي نقصده هو الخطوة الأُولى على الطريق الصحيح.
إنّنا – نحن المسلمين – في أشدّ الحاجة إلى وقفة صادقة مع النفس نراجع فيها مواقفنا ونتأمّل أحوالنا بكل صراحة وموضوعية. نحن في حاجة إلى أن نتحسّس مواقع أقدامنا لنتأكّد بصدق ما إذا كانت الأرض التي نقف عليها ثابتة قويّة أم أنها قابلة للإنهيار عند أوّل خطوة. وليس عيباً أن نواجه أنفسنا بعيوبنا وأخطائنا، ولكن كل العيب أن نتجاهل ذلك كله ونكذب على أنفسنا معتقدين – خطأ – أن كل شيء على ما يرام.
ب) ظاهرة الإرهاب:
تعد ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات الداخلية التي تواجه العالم الإسلامي. وقد شهدت الأعوام الأخيرة على وجه الخصوص تطور هذه الظاهرة بشكل مخيف، إذ اتّجه الإرهاب إلى القتل والتدمير للأبرياء دون تمييز بين طفل وامرأة وشيخ وشاب، وتعدى ذلك إلى التمثيل بالقتلى دون سبب مفهوم، وفي كثير من الأحيان تحت شعار إسلامي، وبصيحات الله أكبر.
وعواقب هذا الإرهاب مدمرة لقدرات الشعوب الإسلامية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، كما تمثل عقبة أمام تنفيذ الخطط التنموية في البلاد الإسلامية، ولا شك في أنّ الإرهاب في العالم الإسلامي يتلقى الدعم والتخطيط من رؤوس الإرهاب في الخارج، وبخاصة في الدول الأوروبية، التي وفّرت لهم على مدى عقود الملاذ وحرّية الحركة، تحت مظلة الحماية المزعومة لحقوق الإنسان.
وفي تقديري أنّ مواجهة الإرهاب في العالم الإسلامي قد اتسمت بقصور شديد، إذ نظر الكثيرون إليها على أنها صراع بين الإرهاب والحكومات. ومن هنا لم يظهر الدور الشعبي في الصورة، وترك الأمر – في غالب الأحيان – للحكومات بأجهزتها الأمنية. وذلك خطأ فادح، فخطر الإرهاب يمس الشعب كله بجميع فئاته، ويمس مصالح كل فرد فيه، فالإرهاب يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع، وتهديد أمن الوطن والمواطنين.
ومن هنا، فإنّ التغلب على التحدي الذي يمثله الإرهاب يجب أن يكون مسؤولية المجتمع بأسره. فلم يعد مقبولاً ولا مقعولاً أن يعتمد الكل على المواجهة الأمنية فقط، أو أن تتحمّل أجهزة الشرطة دون غيرها كل المسؤولية. إنّ الأمر يتطلب وضع خطة قومية شاملة لمواجهة الإرهاب، تحدد فيها واجبات ومهام كل جهة – حكومية كانت أم أهلية – ويتم تنفيذ ذلك عن طريق خطط فرعية خاصة بمجالات عمل كل جهة، وذلك في إطار الخطة العامة.
أمّا ما يطلقه الإرهابيون من شعارات إسلامية، فإنها لا يمكن أن تخدع عاقلاً، لأنّ الأديان كلها والإسلام بصفة خاصة يرفض العنف والقتل والإرهاب، ويدعو إلى الرحمة والأخوّة والسلام.
والإسلام إذ يرفض العدوان رفضاً قاطعاً، فإنّه يعتبر قتل نفس واحدة كأنه قتل للإنسانية كلها (مَن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) (المائدة/ 32).
ولا يجوز أن يغيب عن الأذهان أنّ الرحمة هي الهدف الأساسي للرسالة الإسلامية، كما يخبرنا بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى مخاطباً نبيّه عليه الصلاة والسلام: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء/ 107).
ج) الفهم الخاطئ للإسلام:
إنّ الإسلام هو دين الإعتدال والوسطيّة، يكره التطرُّف والغلو في الدين، ويدعو إلى التيسير على الناس والرحمة بينهم. وعلى الرغم من تعاليم الإسلام الواضحة في هذا الشأن، فإنّ هناك اتجاهات تُفسِّر الإسلام على هواها، وتريد أن تشده ناحية اليمين أو ناحية اليسار بتفسيرات خاطئة تجعل منه إمّا ديناً جامداً منغلقاً متقوقعاً لا يقوى على مسايرة الزمن، ولا يراعي متغيرات الحياة، وبذلك يشدونه إلى فهمهم السقيم ويضيقون رحمة الله الواسعة، وإمّا أن يجعل منه فريق آخر ديناً دموياً عدوانياً متعطشاً لسفك الدماء. وكلا الإتجاهين لا مكان له من الحقيقة، ولا يعبر إلا عن الرؤى المريضة لمن يتحدّثون بها.
فالإسلام إذ يرفض الجمود والإنغلاق والتقوقع، فإنه من ناحية أخرى يرفض رفضاً قاطعاً كل شكل من أشكال العنف والعدوان أو القتل والتخريب، ويُسمِّي القرآن ذلك بأنه إفساد في الأرض يعاقب مرتكبوه بأشدّ العقاب في الدنيا والآخرة: (أن يقتلوا أو يصلَّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (المائدة/ 33).
والفهم الخاطئ للإسلام يرجع إمّا إلى جهل أصحابه بجوهر تعاليم الدين، كما هو الحال لدى الفريق الأوّل. أو خداع الجماهير برفع شعارات دينية لتحقيق أغراض دنيوية، كما هو الحال لدى الفريق الثاني.
والأمر يحتاج إلى كشف يزيف التفسيرات الباطلة في كلتا الحالتين، وإبراز قيم الإسلام السمحة التي تحض على الرحمة والتراحم والتسامح والعدل حتى مع الأعداء.
وربّما يكون الفريق الأوّل حسن النية في مقابل سوء نية الفريق الثاني. ولكن حسن النية قد يؤدي أيضاً إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. فالصديق الجاهل قد يكون أشدّ خطراً – دون أن يدري – من العدو العاقل، على الأقل لأنّ العدو يسفر عن عدوانه، وبالتالي يمكن أخذ الحذر منه والإستعداد لمواجهته. أمّا الصديق الجاهل المحسوب على الإسلام، والذي يبدي أشدّ الحرص على حمايته بأسلوبه المتخلف، فإنّه بذلك يمثل عقبة في طريق التقدم ولا يستطيع أن يفهم ما يدور حوله من تطورات، فضلاً عن عدم فهمه لجوهر الإسلام وروحه بوصفه ديناً حضارياً إنسانياً بكل معنى الكلمة. وحتى يستطيع الإسلام أن يتجه بخطى ثابتة وحثيثة نحو المستقبل، فلابدّ لأتباعه من التخلص من هذا المرض المزدوج وذلك عن طريق الفهم المستنير للإسلام وتعاليمه، والكشف عن الوجه الحضاري لهذا الدين الذي تتوافق تعاليمه مع كل زمان ومكان، وتثبت قدرته على التطور ومواجهة متغيرات الحياة، وقدرته الذاتية على الصمود أمام التحديات. وتاريخ الإسلام شاهد على ذلك.
وإذا اتضح لجماهير المسلمين أنّ الإسلام بريء من جهل أصدقائه ومن شذوذ مَن يدعون أنهم يقتلون دفاعاً عنه، فإنّ ذلك من شأنه أن يُمهِّد السبيل للتغلب على الصعاب والتحديات الأخرى الخارجية والتي تتخذ من الفهم الخاطئ للإسلام من جانب هذين الفريقين ذريعة لوصم الإسلام بكل الرذائل.
- التحديات الخارجية:
وإذا كان الأمر كذلك وهو أنّ التحديات الداخلية مرتبطة بالتحديات الخارجية، فإنّ علينا أن نُبيِّن أهم التحديات الخارجية وسبل التغلب عليها حتى يمكن الإنطلاق إلى آفاق المستقبل بخطى ثابتة:
أ) الخوف من الإسلام في الغرب:
أثناء الحرب الباردة كان الغرب ما يزال في حاجة ماسة إلى المعاونة من جانب الإسلام في صراعه مع الشيوعية، أو لنكن أكثر واقعية نقول: كان في حاجة إلى مهادنة الإسلام. فالغرب يعلم علم اليقين أنّ الإسلام والشيوعية نقيضان لا يجتمعان. ومن هنا، فقد كان من المفيد للغرب أن يتعاون مع الإسلام في هذا الصدد. ولكن بعد أن انتهت الحرب الباردة وسقطت الشيوعية بسقوط الإتحاد السوفيتي السابق في بداية التسعينات من القرن الماضي، لم يعد الغرب في حاجة إلى الإسلام، فانتهت سياسة التعاون والمهادنة، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل راح الغرب يبحث عن عدو بديل للشيوعية، ولم يجد إلا الإسلام ليكون هو العدو البديل، إذ يبدو أنّ الغرب لا يستطيع أن يعيش دون أن يكون له عدو، فإذا لم يكن هناك عدو حقيقي فليتصور عدواً. وكان العدو المتصور هو الإسلام.
وانتشرت في الإعلام الغربي فكرة الخوف من الإسلام، أو ما يطلق عليه "إسلاموفوبيا". ولم يستطيع كبار المسؤولين في الغرب أن يخفوا هذا التصور، فورد ذلك على لسان الأمين العام السابق لحلف الأطلنطي، وكان مايزال في منصبه المهم، كما ورد على لسان أحد الرؤساء في الغرب.
وبدأ الحديث في الغرب عن الأُصولية الإسلامية، والإرهاب الإسلامي، والخطر الذي يتهدد الحضارة الغربية من هذا الشر المدمر، والذي هو الإسلام في زعمهم. واختلطت الأوراق وتاهت الحقائق وسط التدفق الإعلامي الغربي في هذا التيار الجارف.
وقد ساعد على شيوع هذا التصور تزايد موجات العنف في بعض البلاد الإسلامية. ومن المفارقات الغريبة أنّ الغرب نفسه هو الذي وفّر الملجأ والملاذ والدعم وحرّية الحركة لرؤوس الإرهاب في العالم الإسلامي – كما سبق أن أشرنا إلى ذلك - .
وهذا التوجه الغربي يعني عدم السماح بتطوير قدرات العالم الإسلامي العسكرية، بل وحتى الإقتصادية والعلمية، رغم ما يغدقه الغرب من إمكانات هائلة على إسرائيل، التي زرعها شوكة في ظهر العرب لتعوق أي طموحات في تطوير قدراتهم، وتنمية بلادهم. ويعني أيضاً عدم السماح للعالم الإسلامي بأي نصيب من المشاركة في رسم سياسة العالم عن طريق تمثيل العالم الإسلامي بمقعد دائم في مجلس الأمن.
ب) صدام الحضارات:
ويرتبط بقضية الخوف من الإسلامي الترويج في الغرب لنظرية صدام الحضارات، وأنّ هذا الصدام أمر حتمي. وبطبيعة الحال، يوضع في الحسبان في هذا التفكير – بالدرجة الأولى – الصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. ويستعيد البعض ذكريات الماضي القريب والبعيد لهذا الصدام.
والهدف في النهاية هو ضرورة هزيمة الحضارة الإسلامية حتى تتمكّن حضارة واحدة هي الحضارة الغربية بأن تكون لها اليد الطولى والسيطرة على العالم كله، وتتأكد بصورة قاطعة فكرة العولمة التي سنتحدّث عنها بعد قليل. ولعل ذلك كله يشكِّل مقولة نهاية التاريخ التي يتمّ الترويج لها أيضاً.
وقد سبق للفيلسوف الألماني المعروف هيجل – الذي توفي عام 1831 – أن أشار في كتابه المعروف (فلسفة التاريخ) إلى أنّ الإسلام قد اختفى منذ زمن طويل من أرض التاريخ العالمي – أي: لم يعد له تأثير في توجيه أحداث التاريخ – بعد أن ركن إلى الإسترخاء واستسلم إلى السكون الشرقي -. وهنا – كما يحدث أيضاً في الكتابات الغربية المعاصرة عن الإسلام – يتمّ الخلط بين الدين الإسلامي وبين الواقع الحضاري المتخلف الذي تعيشه الأُمّة الإسلامية. وهذا الواقع يمثل مرحلة عارضة في تاريخ المسلمين وليس حكماً أبدياً بالجمود والتحجر على خمس سكان العالم.
وحقيقة الأمر أنه إذا كان البعض يتبنّى في الغرب نظرية حتمية صدام الحضارات، فإنّ الإسلام كدين لا يرى ذلك أمراً حتمياً لا مفر منه، لأنّ الصدام القائم بين البشر لا يقتصر على الصراع بين الحضارات. فهناك أيضاً صراعات تقع بين البشر داخل الحضارة الواحدة، وما أكثر مثل هذه الصراعات في عالمنا الذي نعيش فيه. وأوضح مثال على ذلك ما حدث في القرن العشرين من حربين عالميتين داخل الحضارة الغربية راح ضحيتهما أكثر من ستين مليوناً من البشر، الأمر الذي لا نظير له في التاريخ.
ولكن موقف الإسلام المبدئي الثابت يتلخّص في أنّ تعددية الأجناس في المجتمعات البشرية – أو بمعنى آخر تعددية الحضارات واختلافها – لا يجوز أن تكون مدخلاً للصراع والشقاق، وأن تمثل عائقاً أمام توحيد جهود الناس وتآلفهم فيما بينهم. فالتعددية ينبغي أن تفتح الطريق أمام التعارف والتعاون والتوحد. وهنا تكمن المهمة الإنسانية التي ينبغي على الإنسان حيثما كان موقعه أو معتقده أن يتحمّل مسؤوليتها. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) (الحجرات/ 13).
وهنا جعل القرآن الإختلافات بين البشر مدخلاً للتعارف والتآلف والتعاون لا مقدمة للنزاع والشقاق والصراع. فنظرية الصراع الحتمي للحضارات مرفوضة أساساً من الإسلام، الذي يقرر أنّ الناس جميعاً قد خلقوا من نفس واحدة، وأنّ العدوان على نفس واحدة يعد عدواناً على البشرية كلها وليس على طائفة معيّنة أو حضارة بعينها. ومن هنا، فإنّ التصور الإسلامي أوسع دائرة وأرحب أفقاً وأعمق في إنسانيته من تلك التصورات العنصرية التي تسعى إلى إعلاء شأن حضارة ما على غيرها من الحضارات والثقافات.
ج) العولمة:
ومنذ سنوات، ظهر الحديث عمّا يُسمّى بالنظام العالمي الجديد، وبخاصة بعد انهيار الإتحاد السوفيتي السابق، وأصبح الحديث عن العولمة (Globalization) أمراً مطروحاً. ولم يعد خافياً على أحد أنّ هناك تياراً جارفاً تقوده القوة الأعظم في العالم يتمثل في الترويج للقيم والمعايير التي تعتمدها الحضارة الغربية القائمة. وأنّ على الجميع في العالم أن يتواءم معها وأن يعتنق مبادئها ونظمها إذا أراد لنفسه مكاناً في مسيرة العالم المعاصر.
وهذا يعني أن تسود حضارة واحدة بقيمها ومثلها، وأن يترسّخ مفهوم العولمة أو القطب الواحد في الأذهان. وبذلك يختفي مفهوم التعددية الحضارية المتعارف عليه منذ فجر التاريخ. ومن ثمّ يصبح الخضوع لنظام العولمة أمراً لا مفر منه، ولا فكاك لأي دولة في العالم إلا أن تنضوي تحت لوائه، وإلا فإنّ الزمن والأحداث سوف تتجاوزها.
ويعد نظام العولمة – بالمفهوم المشار إليه – من التحديات الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي في العصر الحاضر. فهل يمكن إخضاع الإسلام والمسلمين لهذا النظام؟ حيث تختفي الحواجز الحضارية والثقافية في العالم الجديد؟
إنّ حقائق الدين الإسلامي وطبيعته ووقائع التاريخ تُبيِّن أنّ الإسلام لا يمكن أن يذوب في أي نظام آخر، فله ذاتيته المستقلة وكيانه الخاص. ولكن هذا التصور الإسلامي لا يتناقض مع أي كيانات أخرى، لأنّ التعددية الدينية والحضارية قد كفلها الإسلام منذ أن قامت للإسلام دولة، وترسّخت هذه التعددية في دستور المدينة الذي أعلنه الرسول محمّد (ص).
وقد كانت الحضارات في البلاد التي دخلها الإسلام روافد أثرت الحضارة الإسلامية. فالإسلام يعتبر الحضارات إنجازاً إنسانياً، وإضافات للتراث الإنساني الذي هو بطبيعته أخذ وعطاء. ولا توجد أُمّة عريقة في التاريخ إلا وقد أعطت كما أخذت من هذا التراث. وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ هدف نظام العولمة يعد مناقضاً لطبيعة الأُمور. فلا يمكن أن تذوب السمات الحضارية الأساسية للشعوب التي لها بصمات حضارية لا تمحى في سجل التاريخ.
والإسلام إذ يقر التعددية الدينية والحضارية، فإنه من ناحية أخرى يقر في الوقت نفسه بأنّ هناك قواسم مشتركة بين كل الحضارات. وهذه القواسم المشتركة تعد المدخل الحقيقي للتعاون بين الحضارات وليس الصراع فيما بينهما. ومن هنا كان تأكيد القرآن الكريم على أنّ الإختلافات بين الشعوب لا يجوز أن يكون عائقاً أمام التعارف والتآلف والتعاون بين الأُمم والحضارات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الآية الكريمة: (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا).
ومن ذلك يتضح أنّ الإسلام سيقف صامداً أمام كل محاولة لتذويبه في أي حضارة أخرى أو في أي نظام عالمي جديد. ولكنه في الوقت نفسه سيظل دائماً على استعداد لأن يكون شريكاً لأي نظام عالمي يسعى إلى خير الإنسان وتقدمه وازدهاره.
د) التطورات العلمية الحديثة:
وبالإضافة إلى هذه التحديات المشار إليها، نجد أنّ هناك تحدياً آخر يتمثّل في الإنجازات العلمية المتلاحقة على الأرض وفي الفضاء، والتي تسارعت خطاها على نحو مذهل ووصلت الآن إلى إتمام استنساخ كامل لبعض فصائل الكائنات الحيّة، ولعل السنوات القليلة القادمة ستشهد استنساخ البشر رغم المعارضة القوية لذلك في كثير من بلاد العالم.
ويعد العلم بصفة عامة سلاح العصر، فمن يملك العلم يملك القوة، ومَن يملك القوة يستطيع أن يفرض نفسه في عالم اليوم. أمّا الدول التي لا تملك العلم، فإنّها تقنع بأن تكون تابعة ومستهلكة لمنتجات الآخرين (وزبوناً دائماً في "سوبرماركت" الأقوياء).
فأين موقف الإسلام والمسلمين من ذلك كله؟ وهل استعدّ المسلمون للمشاركة الجادة في الجهود العلمية؟ وهل هناك أمل في أن يحتل المسلمون مكاناً في الخريطة المؤثرة للقرن الحادي والعشرين؟
لا شك في أنّ التوجهات الفكرية والدينية في أي أُمّة لها تأثيراتها البالغة في المواقف الحاسمة التي تتخذها الأُمم، والتي تحدد مصيرها ومكانها على خريطة العالم. وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من العمل وتطوراته – وهذا الموقف الديني ينبغي أن يكون له تأثيره على توجهات المسلمين - ، فإنّنا نجد أنّ الإسلام ينفرد بين الأديان المختلفة بجعله العلم فريضة من فرائض الإسلام، لا تقل في أهميّتها عن فرائض الصوم والصلاة والزكاة، لأنّ العلم هو السبيل إلى إعمار الكون. وإعمار الكون في الإسلام يعد من الأوامر الإلهية التي ينبغي تلبيتها على المستويين المادي والمعنوي، كما جاء في القرآن الكريم: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) (هود/ 61)، أي: طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها.
والإسلام بذلك يساند العلم ويدعم مسيرته. ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الإسلام وحقائق العلم بأي شكل من الأشكال. ومجال العلم في الإسلام غير محدود، فهو يشمل السماء والأرض وما بينهما. فليس هناك قيود ولا سدود في الإسلام تقف في طريق التقدم العلمي مادام ذلك في مصلحة الإنسان، وهذه المصلحة تحوطها القيم الأخلاقية بسياج يحميها من سوء الإستغلال. وكل تقدم علمي هو في الوقت نفسه دعم للدين من المنظور الإسلامي لأنه يُبيِّن قدرة الخالق. ومن أجل ذلك، أكّد القرآن على أنّ العلماء هم أخشى الناس لله لأنهم أقدر الناس على معرفة أسرار الخلق وجلال الخالق.
وقضية الإستنساخ إذا كان فيها مصلحة للإنسان في مجال النبات أو الحيوان، فلا يستطيع عاقل أن يرفضها بإسم الدين. أمّا الإستنساخ في مجال الإنسان، فإنه إذا اقتصر الأمر على استنساخ أعضاء معيّنة تنفع الإنسان وتقضي على كثير من آلامه، حينما يحتاج إلى عضو بديل عن عضو انتهت صلاحيته، فليس هناك من جانب الدين ما يمنع من ذلك.
أمّا الإستنساخ الكامل للإنسان، فليس هناك اتفاق على أنه يحقق مصلحة واضحة للإنسان، بل العكس هو الصحيح، وهو أنه ستترتب عليه مشكلات عديدة على المستويات الدينية والأخلاقية والقانونية والإجتماعية وغيرها.
إنّ المشكلة – إذن – ليست بين الإسلام والتطورات العلمية، ولا يمكن أن تشكل هذه التطورات تحدياً للإسلام. إنما المشكلة في مدى انسجام المسلمين مع تعاليم الإسلام المشار إليها ومدى ملاحقتهم للتطورات العلمية، ومشاركتهم في البحث العلمي مشاركة جادة يستطيعون من خلالها أن يعبروا إلى المستقبل في ثبات وثقة. فالمسلمون لا تنقصهم الإمكانات المادية أو البشرية، وهم ليسوا أقل ذكاء من غيرهم، فالله قد أعطى العقل لكل الناس، وكما قال الفيلسوف الفرنسي الشهير ديكارت: "إنّ العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس".
فهل يقبل المسلمون التحدي ويتحرّكون بخطى سريعة نحو آفاق العلم الواسعة ليثبتوا وجودهم وإسهامهم في مسيرة التقدم العلمي ليكونوا مؤهلين وجديرين بالدخول إلى عالم المستقبل لكي يحتلوا فيه مكانهم اللائق بهم ويثبتوا وجودهم عن طريق الأفعال وليس فقط عن طريق الأقوال؟ إنّ هذا ما سوف تكشف عنه السنوات القادمة إن شاء الله، وإنّ غداً لناظره قريب.
- خاتمة:
وقبل أن نختم حديثنا عن الإسلام وتحديات العالم، نودّ أن نؤكِّد مرّة أخرى أنّ هذه التحديات ليست في حقيقة الأمر تحديات للإسلام كدين، وإنما هي تحديات لأفهام المسلمين. فإذا ارتفعت هذه الأفهام إلى مستوى الأحداث وأدركت مقتضيات العصر، فستجد أنّ الإسلام من أشد أعوانها على التغلب على كل التحديات. فالإسلام دين للحياة بكل معنى الكلمة، وهو صالح في جوهره لكل زمان ومكان، ومتوائم مع طبيعة الإنسان.
أمّا إذا قصرت همم المسلمين وأفهامهم عن استيعاب تطورات العصر ومتغيرات الحياة، فإنّها ستكون أيضاً قاصرة عن فهم طبيعة التعاليم الإسلامية، وغير مدركة لما تشتمل عليه من مرونة. وهذه الأفهام السقيمة هي التي تجمد الإسلام، وتريد أن تشده إلى تخلفها الفكري وتحجرها العقلي وجمودها الديني، ومن ثمّ تكون أخطر على الإسلام من أي تحديات خارجية.
وينبغي على المسلمين أن يدركوا أنهم إذا أرادوا لأنفسهم الحياة، فإنه ليس أمامهم – في القرن الحادي والعشرين – خيار آخر غير خيار العلم والتقدم والحضارة، وأي طريق آخر سيستمر في جذبهم إلى التخلف والجمود، وينتهي بهم إلى أن تتجاوزهم الأحداث وينساهم التاريخ. فالقضية – إذن – قضية مصير: إمّا أن يكونوا أو لا يكونوا.
والأمل معقود على أن رصيد المسلمين الحضاري وتاريخهم المجيد في مضمار العلم والتقدم سيحفز همهم ليستعيدوا أمجاد أسلافهم، ويكونوا جديرين بالإنتساب إليهم.
وخلاصة القول: أنّ الإسلام بمبادئه السامية وتعاليمه الواضحة وقوته الذاتية، قادر على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة ومواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية. ولم يكن الإسلام – ولن يكون – سبباً في تعطيل مسيرة التقدم في العالم الإسلامي على جميع المستويات.
ومن هنا يمكن القول بأنّ الإسلام مؤهل بكل المقاييس لمواجهة تحديات العصر الحديث، ومؤهل للتعاون باستمرار مع كل القوى المحبة للسلام والتقدم في العالم من أجل خير الإنسان وسعادته في كل زمان ومكان.
المصدر: مجلة رسالة التقريب/ العدد 50
تايلاند | انخفاض حدّة التوتر لمناسبة عيد الملك

تمكن آلاف المتظاهرين أمس من الدخول لفترة قصيرة إلى مقر الحكومة، في محاولة من السلطات لتهدئة الأجواء على الأقل مؤقتاً، مع اقتراب عيد ميلاد الملك الموافق يوم غد الخميس.
وبعد محاصرة مقر الحكومة ــ رمز السلطة، لأيام، تمكن المتظاهرون من عبور الحواجز والتجوال فيه والتقاط صور داخله والتعاطف مع الشرطيين، قبل الخروج طوعاً، كما فعلوها قبل أيام مع مقر جيش المشاة. لكن قائد المتظاهرين سوثيب ثوغسابان لم يبد أي تراجع بعد أكثر من شهر على بداية الأزمة السياسية التي تحولت إلى مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع، وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى في ظروف غامضة وحوالى 250 جريحاً.
وقال سوثيب ثوغسابان أمام أنصاره «إنه انتصار جزئي، لكنه ليس نهائياً، لأن نظام ثاكسين ما زال قائما. لا يمكنكم بعد العودة إلى منازلكم، يجب علينا أن نواصل النضال»، مضيفاً «بعد عيد ميلاد الملك، سنستأنف النضال».
وتطعن المعارضة التي جمعت 180 ألف شخص في الشوارع في سلطة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا وتتهمها بأنها دمية بين يدي شقيقها ثاكسين الذي أطاحه انقلاب في 2006.
وقد لعبت رئيسة الوزراء حتى الآن ورقة عدم التدخل، وراهنت على تراجع تعبئة المتظاهرين، وأعربت عن استعدادها للتفاوض، لكنها رفضت بحزم تشكيل «مجلس من الشعب» غير منتخب، واعتبرته فكرة مناقضة للدستور.
وقالت في تصريح تلفزيوني «على رغم أن الوضع السياسي لم يعد بالكامل إلى طبيعته، فقد حصل تقدم».
وكانت مجموعة متشددة من بضعة آلاف المتظاهرين الذين يلجأون إلى العنف أحياناً قد أقدمت خلال الايام الأخيرة على نقل كتل الأسمنت المسلح والأسلاك الشائكة، لكسب مواقع أمام الشرطيين المحاصرين الذين يصدّونهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه، قبل تغيير استراتيجية السلطات أمس. وفتح رئيس شرطة بانكوك الجنرال كمرونويت ثوبكراجانغ أبواب مقره العام أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين أمامه، لأن المقر «ملك الشعب».
ويقف وراء التظاهرات الحزب الديمقراطي، وهو أكبر تشكيل معارض، لكنه يتمتع بالأغلبية في بانكوك وجنوب البلاد وتسانده عادة نخب العاصمة، الذين يرون في ثاكسين وحركة القمصان الحمر التي تدعمه خطراً على النظام الملكي. وقد تولّى الحزب الديمقراطي الحكم من 2008 إلى 2011 بفضل حل الحزب الحاكم أواخر 2008 بقرار اتخذه القضاء الذي أرغم رئيس الوزراء، صهر ثاكسين، على الاستقالة.
أوكرانيا | الحكومة صامدة على وقع التظاهرات

امتنع البرلمان الأوكراني خلال تصويت أجراه أمس، عن سحب الثقة من حكومة نيقولاي أزاروف، رغم إصرار المعارضة على ذلك بسبب الأوضاع السياسية المتدهورة في البلاد. وصوت 186 نائباً من أصل 450 على قرار سحب الثقة، بينما يجب ألا يقل عدد الأصوات المطالبة بإسقاط الحكومة عن 226. وتعهد رئيس الوزراء استخلاص العبر مما حدث وإجراء تعديلات واسعة النطاق في حكومته.
وفي كلمة أمام النواب قبل التصويت، اعتذر أزاروف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السبت الماضي من قبل القوات الخاصة، لكنه دافع عن موقف الحكومة من الأزمة ودعا النواب إلى العمل على الحيلولة دون تكرار «الثورة البرتقالية»، عندما أدت احتجاجات ومظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة عام 2004 إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها فيكتور يانوكوفيتش وإجراء جولة إعادة فاز فيها منافسه الموالي للغرب فيكتور يوشينكو.
وكان ازاروف قد وصف في وقت سابق ما يحصل في أوكرانيا بأنه «انقلاب».
وعلى الأثر، تقاطر آلاف المتظاهرين المؤيدين للتقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي إلى جوار البرلمان الذي فرض حوله طوق أمني.
وقال أحد قادة المعارضة أرسيني ياتسينيوك المقرب من رئيسة الوزراء السابقة المسجونة يوليا تيموشنكو، إن «ما نطلبه هو أولاً التصويت على نص حول رحيل الحكومة ومن ثم التصويت على الإفراج عن تيموشنكو وثلاثة ناشطين أوقفوا بشكل غير شرعي».
وتجمع معظم هؤلاء المتظاهرين مع الآلاف الذين انضموا إليهم صباح أمس حول البرلمان حيث انتشر مئات من عناصر قوات حفظ النظام. وكانت مواجهات جرت الأحد مع الشرطة قد أوقعت أعداداً من الجرحى بينهم نحو خمسين صحافياً ومئة شرطي. ويذكر أن أوكرانيا شهدت الأحد تظاهرة غير مسبوقة منذ الثورة البرتقالية عام 2004 حيث قضى أكثر من ألف شخص الليل في ساحة الاستقلال للمطالبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي وبرحيل السلطة.
من جهته رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن التظاهرات في أوكرانيا «ليست انقلاباً»، داعياً إلى الحوار «ورفض القمع» في هذا البلد.
كذلك أقر الرئيس الأوكراني في مقابلة مع محطات تلفزة أوكرانية بأن قوات الأمن «بالغت» في استخدام القوة بحق المتظاهرين.
ولمّح الرئيس الأوكراني الذي يزور موسكو قريباً لتوقيع «خريطة طريق للتعاون»، إلى أن الانضمام إلى أوروبا لا يزال مطروحاً، مطالباً رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو باستقبال وفد أوكراني لبحث «بعض جوانب اتفاق الشراكة».
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أيضاً نداءً إلى الهدوء والحوار، داعياً كل الأطراف «إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف جديدة واحترام مبادئ حرية التعبير والتجمع السلمي»، كما قال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي.
ويذكر أن الرئيس الأوكراني يتوجه إلى الصين بزيارة دولة، رغم الاحتجاجات في كييف، بغض النظر عن تطورات الأزمة، وأكد يانوكوفيتش أمس عزمه على التوجه إلى الصين في اليوم نفسه بزيارة دولة. ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة توقيع نحو 20 وثيقة بين البلدين، بما فيها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
من جهة أخرى، وصل الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند أمس، إلى أوكرانيا في محاولة لـ«خفض التوتر» و«النظر في إمكانية الحوار» بين المعارضة والحكومة، وفق ما أعلن المتحدث باسمه في ستراسبورغ.
هجوم إسرائيلي على أوباما: يجرّنا إلى كارثة

إدارة أوباما متراخية في مواجهة إيران وستتسبب في انهيار نظام العقوبات الدولي ضدها، موقف خلفيته انعزالية، محاولة انسحاب من المواجهات على الساحة الدولية. هذه باختصار رؤية إسرائيل للأداء الأميركي هذه الأيام
التاريخ يعيد نفسه في العلاقة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فقبل سنوات، حصل الاشتباك الأول بين الرجلين على خلفية عملية السلام في المنطقة عندما ثارت ثائرة تل أبيب من محاولات فرض سيد البيت الأبيض وقف الاستيطان عليها فوصفته بالكارثة على الأمن القومي الإسرائيلي. واليوم، تتكرر العبارة نفسها في أوساط الحكم الإسرائيلية لدى مقاربتها لسياسة الرئيس الأميركي، في ظل ما تقول هذه الأوساط إنها أزمة ثقة شديدة تنتاب العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، مع الفرق أن عنوان الاشتباك هذه المرة هو الملف النووي الإيراني.
وبعد هجوم سياسي مباشر شنّه نتنياهو الذي وصف اتفاق جنيف بين إيران ودول 5+1 بـ«الخطأ التاريخي»، ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي دعا إلى «ضرورة البحث عن حلفاء جدد بسبب تراجع التحالف مع الولايات المتحدة»، تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس تصريحات نُسبت إلى مسؤولين إسرائيليين كبار تضمنت تصعيداً في اللهجة ضد واشنطن بلغت حد القول إن أوباما «يقود المنطقة إلى كارثة». ونقلت الإذاعة العبرية والقناة العاشرة عن هؤلاء المسؤولين اتهامهم إدارة أوباما بالتراخي في مواجهة إيران وبالتسبب في انهيار نظام العقوبات الدولي ضدها، فيما ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن القلق يتزايد داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل من رغبة أميركية في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران بأي ثمن.
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إن هناك انقطاعاً عملياً بين صناع القرار في تل أبيب وبين الرئيس أوباما والدائرة القريبة منه. وأشار معلق الصحيفة للشؤون الأمنية، رون بن يشاي، إلى اعتقاد جهات إسرائيلية بأن تل أبيب فقدت قدرة التأثير على أوباما في الموضوع النووي الإيراني كما في مواضيع سياسية أخرى، كاشفاً عن وجود أصوات بدأت تُسمع في تل أبيب بعضها يقول بالفم الملآن إن أوباما يقود المنطقة إلى كارثة. وبحسب الكاتب، فإنه «كما تبدو الأمور الآن في إسرائيل، فإن هناك حلقة إيديولوجية ضيقة ومغلقة تتبلور حول أوباما تؤيد انتهاج سياسة شبه انعزالية والابتعاد عن المواجهة على الساحة الدولية، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضاً في شرق آسيا. وتؤيد هذه الحلقة في الشأن الإيراني التوصل إلى اتفاقية دائمة وإعطاء طهران الحق في الوصول إلى مجال الحافة النووية، وفي الوقت نفسه احتواء مشروعها النووي بحيث لا تستطيع تحقيق قدرة الاختراق باتجاه القنبلة من دون أن يلاحظ الغرب ذلك». وتقول مصادر إسرائيلية، وفقاً لبن يشاي، إنه في حال تحقق هذا الأمر، «فإنه سيشكل كارثة بالنسبة إلينا، وسيكون معناه العملي بقاء إيران على مسافة ثلاثة أشهر من إنتاج مواد انشطارية كافية لإنتاج قنبلة نووية». وتعتقد هذه المصادر أن «إدارة أوباما تواقة، وحتى مضغوطة، للتوصل إلى اتفاق، أكثر من الإيرانيين الذين يعانون من العقوبات». وتقدر هذه المصادر أن الحماسة الأميركية مردّها الرغبة لدى حلقة الأشخاص المحيطين بأوباما في إمضاء الأعوام الثلاثة المتبقية من حكمه من دون خوض أي مواجهة مسلحة. وأوضحت المصادر أن الاعتقاد السائد في إسرائيل، وليس فقط في إسرائيل، بل في دول شرق أوسطية أخرى، هو أن أعضاء هذه الحلقة المنتمين إلى الجناح الأكثر يسارية في الحزب الديموقراطي لاحظوا أن الرأي العام الأميركي متعب حالياً من الحروب في العراق وأفغانستان، وهو معني بأن يركز الرئيس وإدارته على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الداخل الأميركي. وفي هذا السياق، فإن أعضاء هذه الحلقة يريدون عدم تورط أميركا في أي حروب أخرى من أجل ضمان بقاء الرئاسة ضمن الديموقراطيين. ونتيجة لذلك، «تقدر محافل غربية أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على إدارة دبلوماسية ناجعة، بل حتى القدرة على تنفيذ عمليات سرية، مثل مساعدة المجموعات المسلحة في سوريا على سبيل المثال».
وبحسب بن يشاي، فإن صناع القرار الإسرائيليين متشائمون حيال إمكان وقوع تصورهم لحل المشكلة النووية الإيرانية على آذان صاغية في واشنطن، ويتملكهم الشعور بأن إسرائيل ستجد نفسها في نهاية المطاف تواجه إيران كدولة تمتلك قدرات نووية في ظل موافقة أميركية على ذلك. وأشار الكاتب إلى أن أزمة الثقة القائمة حالياً بين واشنطن وتل أبيب لم تشهد لها علاقات الجانبين مثيلاً منذ عقدين، أي على الأقل منذ جمّد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب الضمانات المالية الممنوحة لإسرائيل على خلفية سياسة الاستيطان التي انتهجتها حكومة إسحاق شامير مطلع تسعينيات القرن الماضي.
واستدعت حدة الهجوم الإسرائيلي تعليقاً من وزير الدفاع، موشيه يعالون، الذي وصف هذه التقارير بالمبالغ فيها، مشدداً على أن «العلاقات بيننا ممتازة وتستند إلى قيم ومصالح مشتركة، لكن بين الأصدقاء أيضاً يمكن أن يكون هناك خلافات». وقال يعالون، خلال زيارة للجولان المحتل، «من دون شك لقد نشب خلاف بيننا وبين الإدارة الأميركية حول الموضوع الإيراني، وقد أعربنا عن رأينا بما يتناسب، إلا أن علاقاتنا بالولايات المتحدة لم تتضرر والقنوات بيننا مفتوحة وكذلك الخط بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي». وكرر يعالون موقف إسرائيل من اتفاق جنيف، واصفاً إياه بالخطأ التاريخي «اعتقدنا أن هذا الاتفاق إشكالي وقد أسمعنا رأينا فيه».
وذكرت صحيفة هآرتس أن إحباطاً كبيراً يسود البيت الأبيض نتيجة الانتقادات العلنية التي تصدر عن مسؤولين إسرائيليين لأداء الإدارة الأميركية، سواء بنحو صريح أو موارب. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة رفضها لهذه الانتقادات وتشديدها على عدم صحة ما يشاع بأن أوباما مصمّم على الحؤول دون حصول مواجهة مع إيران بأي ثمن. ووفقاً للصحيفة، فإن البيت الأبيض لا يرى في التوتر الراهن بين نتنياهو وأوباما أزمة، «وفي واشنطن ببساطة تعودوا وتعلموا كيف يتعايشون مع الخلافات بين أوباما ونتنياهو في الموضوع الإيراني». وصرّح وزير المال الإسرائيلي «يائير لبيد» بأن الخلاف في وجهات النظر مع الولايات المتحدة هو ظاهرة صحية، ولكن «يجب أن يبقى هذا الخلاف في إطار العائلة»، حسب وصفه.
محمد بدير
أكثر من 500 قتيل في 12 يوماً: ضربة قاسية للمسلحين في الغوطة

على وقع التحضيرات لـ«جنيف 2»، يتحرّك الميدان السوري. كان يُفترض أن يزور رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان العاصمة الروسية، وفي جعبته تقدّم رجاله في المعارضة السورية، في منطقة الغوطة الشرقية والقلمون. لكن الواقع الميداني خذله. من موسكو، اعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين وبندر «تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا ولا سيما من منظار الاستعدادات لمؤتمر جنيف 2». تبادل لوجهات النظر يقابل تبادل النيران على الأرض السورية، في ريف دمشق الشرقي والشمالي. خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كانت السعودية تنتظر تقدماً لقوات المعارضة في منطقة القلمون، وفي الغوطة الشرقية. فرضت «جبهة النصرة» وبعض المجموعات الأخرى التابعة لـ«القاعدة» او السعودية، معركة في القلمون، لكنها لم تستطع الاحتفاظ بأي منطقة دخلتها. على العكس من ذلك، خسرت بلدتي قارة والنبك، بعد عجزها عن الاحتفاظ بصدد ومهين ودير عطية. إنجازها الميداني الوحيد كان احتلال بلدة معلولا، واختطاف 12 راهبة أرثوذكسية. بالتأكيد، سيكون من الصعب على بندر تسويق هذه العملية ــ كإنجاز ــ في «عاصمة الأرثوذكس» في العالم.
اما في الغوطة الشرقية، فيواصل الجيش السوري مواجهاته مع المسلحين، في كل من دير سلمان والنشابية وقيسا والبلالية، بينما أحرز تقدّماً من خلال بسط سيطرته على بلدة العتيبة ومحيطها التي سبق أن دخل المسلحون إلى جزء من أحيائها، بعد الهجوم الذي شنوه على دفعات خلال الأيام الـ12 الماضية.
وبحسب مصادر من الطرفين المتقاتلين، فإن المسلحين الذين أرادوا من الهجوم الذي شنوه ابتداءً من يوم 22 تشرين الثاني الماضي، فك الحصار عن الغوطة من خلال السيطرة على بلدة العتيبة، تلقوا ضربة قاسية في الهجمات المضادة التي شنتها عليهم قوات الجيش السوري وحزب الله. وقالت المصادر إن مسلحي المعارضة نعوا حتى اليوم أكثر من 500 مقاتل قضوا في هذه المعارك خلال الأيام الـ12 الماضية. وأكّدت مصادر رسمية سورية أن مسلحي المعارضة ظنوا في البداية ان تحقيق هدفهم سيكون سهلاً، لكنهم فوجئوا بالهجمات المعاكسة التي شُنّت عليهم، وأدت على سبيل المثال إلى إخراجهم من العتيبة ومحيطها خلال أقل من 12 ساعة من المعارك.
الراهبات المخطوفات
على صعيد آخر، لا يزال الغموض يلفّ مصير راهبات دير مار تقلا في معلولا المخطوفات من قبل مسلحي المعارضة الذي سيطروا على البلدة اول من أمس.
وأكد مصدر في «الجيش الحر» لـ«الأخبار» أنّ «معارك عنيفة شهدتها البلدة»، مشيراً إلى أنّ «خراباً كبيراً قد أصابها». واستصرخ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في نداء «الضمير البشري كله وكل ذوي النيات الحسنة لإطلاق راهباتنا المحتجزات واليتامى». وناشد «بذرة الضمير التي زرعها الله في كل البشر، بمن فيهم الخاطفون، لإطلاق أخواتنا سالمات».
من جهته، قال مبعوث الفاتيكان في دمشق، ماريو زيناري، إنّ «12 راهبة نقلن من معلولا إلى بلدة يبرود التي تقع على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال». وفي حديث مع وكالة «رويترز»، شرح زيناري أنّ «المسلحين أجبروا الراهبات على اخلاء المكان وعلى أن يتبعنهم إلى يبرود. في الوقت الراهن لا يمكننا القول إن كان هذا خطفاً أم إجلاء». وأضاف: «سمعت أنه يجري قتال بالغ الشراسة في معلولا».
بدورها، طالبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «بوقف الهجمات الإرهابية على دور العبادة ورجال الدين في سوريا». كذلك أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها في ظلّ «المعلومات التي تحدثت عن خطف 12 راهبة ارثوذكسية سورية ولبنانية أو ارغامهن على مغادرة دير معلولا. نطلب، إذا تبيّن ذلك، الافراج عنهن فوراً».
انتحاري في دمشق
من جهة أخرى، استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 17 أمس، إثر هجوم انتحاري على مكتب لوزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق يقصده أهالي شهداء الجيش لتسوية اوضاع عائلاتهم المالية. وفي حمص، أحكم الجيش سيطرته الكاملة على جبال الشومرية وتلول الهوى والجبال المحيطة بقرية أم صهريج في المخرم في ريف حمص الشرقي، بعد القضاء على آخر تجمعات المسلحين فيها.
اخفاق «غزوة الفتح»
وفي حلب (باسل ديوب)، تراجعت حدة المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في المدينة وريفها، بعدما فشلت «غزوة الفتح» في إحراز تقدم يذكر على جبهة الشيخ سعيد. وتبادلت المجموعات المعارضة الاتهامات حول مسؤولية الاخفاق في الغزوة التي أطلقتها «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وشاركتها فيها «حركة أحرار الشام الإسلامية» وعدة مجموعات أخرى، أبرزها «صقور العز». وحمّل قادة في «الدولة» حركة «أحرار الشام» مسوؤلية الاخفاق ومقتل عشرة من مقاتليها ومقاتلي «صقور العز» نتيجة عدم التزامها بتنفيذ الخطة المتفق عليها، في حين ردّ «أحرار الشام» التهمة بتأكيد أنّ مسلحي «الدولة» هم أول من انسحب من المعركة فتبعهم الآخرون، حسب بيان لهم.
إيران تدعو السعودية إلى "العمل معاً" من أجل السلام والإستقرار في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يكشف إنه بصدد زيارة السعودية وأن "الزيارة مرتبطة فقط بترتيب موعد مناسب للطرفين" مشدداً خلال جولته الخليجية على "أهمية السعودية البالغة في المنطقة والعالم الإسلامي".
دعت إيران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف المملكة العربية السعودية إلى "العمل معا" من أجل إرساء السلام والإستقرار في المنطقة، مشددة على "الأهمية البالغة" للمملكة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريحات خاصة لوكالة الصحافة الفرنسية في مسقط الإثنين "نعتقد انه يتعين على إيران والسعودية العمل معاً من أجل السلام والإستقرار في المنطقة"، مؤكداً على رغبته في زيارة السعودية: "أنا مستعد لزيارة السعودية، وأعتقد أن علاقاتنا مع السعودية يجب أن تتوسع".
وأشار الوزير الإيراني إلى "ان السعودية بلد يتمتع بأهمية بالغة في المنطقة وفي العالم الإسلامي".
وكشف أن زيارته للسعودية مرتبطة فقط "بترتيب موعد مناسب للطرفين، وسأزورها قريباً إن شاء الله".
وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة العمانية مسقط، أعلن ظريف أنه سيزور الإمارات "قريباً"، بعد الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الخميس الماضي إلى طهران. وقال في هذا السياق "اعتقد اننا سنستمر في التقدم بالاتجاه الصحيح"، مضيفاً "أن تمتين العلاقات بين ايران وبلدان المنطقة يحظي بأهمية بالغة ولا توجد هناك أي عقبات لتطويرها".
وافادت وكالة الانباء العمانية ان وزير الخارجية الإيراني وصف محادثاته مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، بأنها "باكورة أعمالنا وانطلاقة لنشاطاتنا".
وأضاف ان وتيرة الأعمال والنشاطات هذه يمكن أن تتطور وتتسع رقعتها مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي أهميةً خاصة لتوثيق علاقتها مع البلدان الجارة.
وأكد الوزير الإيراني أن علاقات بلدان المنطقة يجب أن تبنى على أساس من الثقة المتبادلة وتعزيز أواصر الصداقة فيما بينها، وعلى التعاون والقواسم المشتركة في مختلف المجالات العقائدية والثقافية والجغرافية والإقتصادية والسياسية.
واشار ظريف الى الزيارة التي قام بها كبار المسؤولين في سلطنة عمان لإيران، معرباً في هذا السياق عن أمله في ديمومة التواصل بين السلطنة والجمهورية الاسلامية الايرانية.
وحول برنامج ايران النووي قال وزير الخارجية الإيراني إن استخدام وإنتاج الأسلحة الذرية هو أمر غير شرعي وغير أخلاقي وغير إنساني، مضيفاً "اننا نعتبر السلاح النووي يضر بأمننا الوطني ونحن لسنا بحاجة الي أي سلاح نووي وعلى أي مستوى من المستويات".
وأوضح ظريف أن الطاقة النووية إذا ما استخدمت للأغراض السلمية، فهو أمر غير قابل للتفاوض مطلقاً وشدد أن الجمهورية الاسلاميه الايرانية ستواصل نشاطها النووي للأغراض السلمية والمدنية.
ورأى الوزير الإيراني أن كل ما تتخذه طهران من إجراءات في هذا الإطار هو للأغراض السلمية البحتة، وأن كل ما تقوم به من أنشطة يتم تحت المظلة الدولية من دون إيجاد قلق أو هواجس للآخرين.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال ظريف إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم التوصل الى تسوية سلمية لهذه الأزمة، قائلاً "إننا نؤكد بأن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتم من خلال الخيار العسكري، ونؤكد كذلك أن مستقبل سورية يجب أن يحدد حصراً من قبل أبناء الشعب السوري وصناديق الاقتراع".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل الأحد إلى مسقط بعد زياره قام بها إلى دولة الكويت، وغادر عمان الاثنين، متوجهاً إلى قطر.
جعفري: أي خطأ من أميركا وأتباعها ستكون نتيجته إبادة إسرائيل

قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه يتوجب على المسؤولين الإيرانيين التعاطي مع الإتفاق النووي كأنه لم يكن في حال لمسوا أي نقض للعهد من قبل الغرب والأميركيين، معتبراً ان المواجهة بين ايران وأميركا تشبه الحرب الوجودية.
دعا قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري إلى الإستمرار في دعم الفريق الإيراني المفاوض في الملف النووي بما يضمن نجاحهم في مواجهة المطالب غير المقبولة من الطرف المقابل.
وجدد جعفري تأكيده على الخطوط الإيرانية الحمراء وضرورة الإعتراف بها بشكل صريح ورسمي وعلى رأسها الحق الايراني في تخصيب اليورانيوم وامتلاك التقنية الكاملة لإنتاج الوقود النووي ورفع كافة العقوبات المفروضة على طهران.
وأكد جعفري أنه يتوجب على المسؤولين الإيرانيين أن يتعاطوا مع الإتفاق النووي وكأنه لم يكن في حال لمسوا أي نقض للعهد من قبل الغرب وأميركا أو بدر من الغرب وواشنطن أي تصريحات توحي بعدم الإلتزام بما تعهدوا به.
وشدد قائد الحرس الثوري على أن يعتمد المسؤولون الإيرانيون على الطاقات الداخلية والوطنية في تطوير البلاد إلى جانب إستمرارهم في الحراك الدبلوماسي المقتدر على الساحة الدولية.
وعن العلاقة مع الولايات المتحدة أكد جعفري أن المواجهة بين ايران وأميركا تشبه الحرب الوجودية، وتجاه أي خطأ من قبل أميركا أوأتباعها في المنطقة سيكون الرد الإيراني المطروح على الطاولة هو إبادة الكيان الصهيوني.