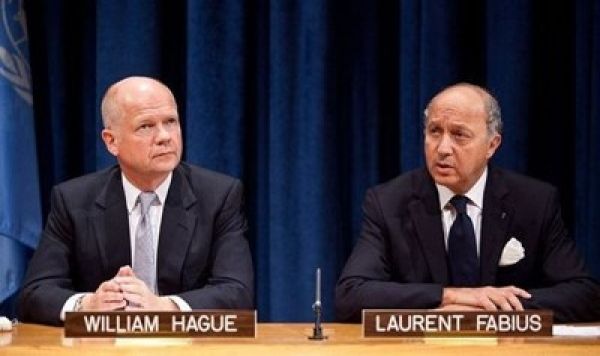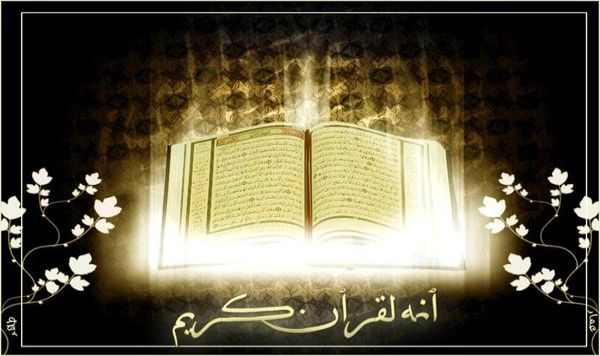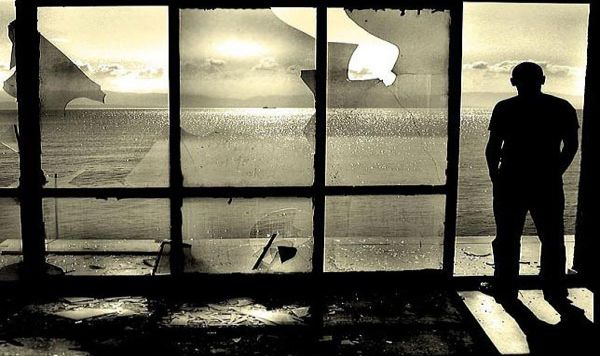Super User
استشهاد عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب تل أبيب

ليست المرة الأولى التي يقتل فيها عمال فلسطينيون على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي...
استشهد العامل الفلسطيني عنتر شبلي محمود الأقرع ( 24 عاماً) شمال تل أبيب برصاص جندي إسرائيلي من حرس الحدود خلال مطاردة الجيش لعمال من الضفة الغربية دخلوا للبحث عن لقمة عيش داخل مقبرة قرب تل أبيب، وهرب الجندي دون الابلاغ عن الجريمة لحين العثور على جثمانه.
واعترفت اسرائيل بالحادثة لكن كعادتها ادّعت "أن الفلسطيني حاول طعن الجندي".
وكان الشهيد عنتر وهو من قرية قبلان جنوب مدينة نابلس قرر العمل ليل نهار من أجل أن يجمع التكاليف الأخيره لاقامة حفل زفافه الذي كان مقرراً اقامته في القرية، وقد حجز الصالة، واتفق مع المصورين قبل أن يستشهد.
وفي هذا الإطار، قال رئيس نقابات فلسطين شاهر سعد للميادين "إن ما تفعله إسرائيل ضد العمال هو إعدام وملاحقة بشكل بربري وإرهابي"، مطالباً "بتحرك جدي لوقف الجرائم ضد عمال فلسطين".
أوروبا تعود إلى دمشق ...

مصادر دبلوماسية أوروبية تكشف عن بدء سلوك مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين أوروبيين طريق دمشق ولقاءات لهؤلاء مع المقداد والمملوك.
كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن "سفراء ومسؤولين في أجهزة استخبارات أوروبية عادوا إلى سلوك طريق دمشق بخفر لإحياء الاتصالات مع المسؤولين السوريين". ونقلت "أ ف ب" عن سفير أوروبي معتمد في دمشق، ويتخذ من بيروت مقراً له منذ كانون الأول/ ديسمبر 2012 قوله "منذ شهر أيار، بدأنا بالعودة على نحو تدريجي. في البداية على نحو سري ليوم، ثم يومين، ثم ثلاثة أيام، والآن، نذهب إلى دمشق مرة أو مرتين في الشهر".
وبحسب الوكالة فإن "ممثلي النمسا ورومانيا واسبانيا والسويد والدنمارك، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي يحضرون إلى العاصمة السورية على نحو منتظم، وبعضهم شارك قبل يومين في لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لكن حكومات هؤلاء الدبلوماسيين تحظر عليهم لقاء أي من الشخصيات الـ179 المدرجة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين ممن تصفهم بأنهم "مشاركين في القمع العنيف ضد الشعب، والذين يدعمون النظام أو يستفيدون منه".
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي آخر قوله "لا يمكننا الإتصال بهؤلاء الأشخاص، لكن إذا دعينا إلى مكان ما وكان أحدهم موجوداً، لا ندير ظهرنا، وإذا توجه إلينا بالكلام، نردّ عليه" موضحاً أن "الاتحاد الأوروبي لم يطلب من الدول الأعضاء اغلاق سفاراتها. إنما جاء اقفال السفارات كمبادرة دعم للمعارضة قامت بها مجموعة اصدقاء سورية" معرباً عن اعتقاده "أنّه خلال الأشهر الأولى من عام 2014، سيسلك العديد من زملائي مجدداً طريق دمشق".
كذلك زار دمشق، خلال الفترة الأخيرة، وعلى نحو بعيد عن الأضواء مسؤولون في أجهزة استخبارات غربية اجروا اتصالات مع نظرائهم السوريين، والتقى بعضهم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، وبحثوا معه في كيفية استئناف التعاون مع بلاده.
وتبدو العودة الأوروبية مدفوعة بالمخاوف الأمنية المتنامية من تدفق المقاتلين التكفيريين إلى سورية. وفي هذا الإطار قال دبلوماسي أوروبي إن "وجود أكثر من ألف جهادي قدموا من أوروبا للقتال في سورية يقلق الدول التي أتوا منها. لذلك تريد هذه الدول استئناف تعاونها مع السلطات السورية، التي توقفت منذ أكثر من سنتين" مضيفاً أنه "حتى فرنسا التي هي رأس حربة ضد النظام السوري، أرسلت أخيراً اثنين من عملائها للقاء مملوك، ليسألاه ما إذا كان في الإمكان استئناف العلاقات القديمة بين أجهزة استخبارات البلدين". وبحسب المصدر فإن مملوك أجاب "هل هذا ممكن؟ نعم، لكن هل نريد ذلك؟ الجواب هو لا، ما دامت سفارتكم لا تزال مغلقة". وأشار الدبلوماسي إلى أن بريطانيا قامت بمبادرة مماثلة.
معارك عنيفة في النبك في القلمون.. وإسرائيل تتدخل في معارك الغوطة!!

على وقع المعارك العنيفة في منطقة القلمون معلومات جديدة عن هجوم المسلحين في الغوطة الشرقية تشير إلى دور إسرائيلي ما في الهجوم!!
تستمر المعارك في منطقة القلمون بين مسلحي المعارضة والجيش السوري الذي كان قد سيطر على دير عطية، وتمكن من الدخول إلى بلدة النبك المجاورة لقارة التي استعادها الجيش أيضاً. وقالت المعارضة "إن معارك عنيفة دارت أمس الجمعة على محور النبك".
وجاءت هذه المعارك بعد أيام قليلة على هجوم آلاف المسلحين على الغوطة الشرقية، وسط معلومات كشفتها صحيفة "السفير" تحدثت عن دور إسرائيلي في هذا الهجوم. وأشارت المعلومات إلى "أن الإسرائيليين قدّموا خرائط وصوراً استطلاعية لمواقع الجيش السوري إلى نواة القوة المهاجمة التي انطلقت من الأردن وقاموا وقبل انطلاق الموجة الأولى من الهجوم بتعطيل منظومة الإتصالات للجيش السوري".
وفي ريف دمشق، بث ناشطون معارضون صوراً مشيرين إلى أنها "قصف من الجيش السوري لمنطقة داريا وبلدة الرقة".
وكان أربعة أشخاص قد قتلوا في دمشق وأصيب 26 معظمهم من النساء والأطفال في سقوط قذيفة هاون أمام الجامع الأموي في العاصمة. هذا القصف جاء ضمن عمليات تستهدف الأحياء السكنية من مواقع مسلّحي المعارضة بشكل شبه يوميّ. وأوضح مصدر أمني أن "القذيفة سقطت أمام المدخل الغربي للجامع".
من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن مقاتلي المعارضة السورية تمكنوا من دخول بلدة معلولا شمال دمشق مجددا السبت، وتدور اشتباكات عنيفة على اطرافها بينهم وبين الجيش السوري.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن: "اشتباكات عنيفة تدور بين كتائب مقاتلة وبينها جبهة النصرة من جهة والجيش السوري من جهة اخرى في معلولا التي دخلتها الكتائب وتحاول السيطرة عليها".
وشهدت بلدة معلولا جولة معارك في ايلول/سبتمبر نزح خلالها معظم سكان البلدة، التي دخلها مقاتلو المعارضة قبل ان يخرجوا منها مجددا وتعود اليها قوات النظام.
قتلى وجرحى في اشتباكات في شمال لبنان

مقتل 6 أشخاص وجرح قرابة 40 آخرين بينهم عناصر في الجيش اللبناني في إشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن، وميقاتي يرأس إجتماعاً أمنياً لمعالجة التدهور الأمني في المدينة.
ليل طويل من الاشتباكات العنيفة شهدته مدينة طرابلس شمال لبنان. وأسفرت الاشتباكات التي بدأت فجر السبت في جولة جديدة من المعارك بين جبل محسن وباب التبانة عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة قرابة أربعين جريحاً بينهم 9 عسكريين.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً امنياً مع وزير الداخلية والقادة الامنيين، لتدارك الوضع في المدينة.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد جولة من العنف بين الطرفين وقعت في الاسبوعين الاخيرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، وكانت الثامنة عشرة في اطار مسلسل المواجهات في المدينة منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف آذار/مارس 2011، حيث ينظر إلى المواجهات على أنها انعكاس للصراع الدائر هناك.
واشار الجيش اللبناني الذي ينفذ خطة أمنية في المدينة للفصل بين المقاتلين، إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح في تبادل اطلاق النار. وقال في بيان له إن "عناصر مسلّحة في حي المنكوبين أقدمت على إطلاق النار باتجاه أحد مواطني محلة جبل محسن وإصابته بجروح، وعلى الأثر، "شهدت منطقة جبل محسن ـ التبانة عمليات قنص، كما تعرض عدد من مراكز الجيش لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح مختلفة. وقد ردّت وحدات الجيش على مصادر إطلاق النار، كما أوقفت أحد الأشخاص المشتبه فيهم بالاعتداء على المواطن المذكور".
وكان التوتر السائد بين المنطقتين ازداد في الايام الماضية بعد إطلاق الرصاص على أربعة عمال من سكان جبل محسن عند مستديرة أبو علي في طرابلس، بينما كانوا عائدين سيراً على الاقدام من مقر عملهم في بلدية طرابلس الى منازلهم في جبل محسن، ما اثار تنديداً واحتجاجات في اوساط أهالي الجبل.
دور القرآن في اسلام المهتدين حديثاً؟

أعتقد أن الغرب الحديث قد مرّ بتجربة كبرى من ضياع الثقة. فالثقة بالحكومة والقيم التقليدية والتربية والعلاقات الانسانية والكتب المقدسة والدين والله كله قد اضمحل وتلاشى بسبب الصراع من أجل التقدم المادي. وقد خلف هذا الضياع فراغاً كبيراً للمعنى والهدف، وأنجب العديد من الأفراد الذي لا يعترفون بأي نظام فكري، والذين أصبحوا فضوليين ومستعدين لأي وجهة نظر بديلة. فمن بين جميع الديانات والايديولوجيات التي يمكن لهم أن يختاروا إحداها يبدو أن الاسلام قد جذب منهم عدداً أكبر مما كانت تتوقع له إحصائيات الحصص. والسبب وربما يعود للاهتمام الكبير الذي توليه وسائل الإعلام الغربية للإسلام، وكذلك بسبب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من مجتمعات إسلامية إلى الغرب، وكذلك من خلال التفاعل الكبير والمتزايد بين الدول الغربية والشرق أوسطية هذه الأيام. ولا شك أن جميع هذه العوامل قد أسهمت في زيادة الاهتمام الغربي بالاسلام.
إن المعتنقين الجدد يقدمون أسباباً عديدة لاختيارهم الاسلام، ويصفون السبل المختلفة التي قادتهم إلى اعتناق هذا الدين. وبغض النظر عن السبب الذي أثار اهتمامهم أولاً أو دفع بهم لاتخاذ القرار النهائي كي يصبحوا مسلمين، فإن هؤلاء المهتدين الجدد إلى الاسلام غالباً ما يعبرون عن الإحباط الذي يشعرون به، والذي يحتملونه في صراعهم للتأقلم مع جاليتهم الدينية الجديدة. إن أهم سؤال يجب أن نتحقق منه بشأن هؤلاء لا يتعلق بالكيفية التي دخلوا بها الاسلام، بل بالسبب الذي يجعل العديد منهم متمسكاً بقوة بهذا الدين؟ وغالباً ما يكون جوابهم أن القرآن هو السبب. وعملياً نجد أن جميع المعتنقين الجدد الملتزمين بالاسلام يعزون إيمانهم لعقيدة راسخة، وهي أن القرآن بكامله ما هو إلا تنزيل منزه من لدن رب العالمين. وقد يشيرون إلى بعض ملامح القرآن لكي يؤكدوا هذا المعتقد، ولكن غالباً ما نجد أن هذه الملامح قد تعلموها بعد أن تطور هذا الإيمان بالقرآن لديهم. وليس من السهل تعريف أو تفسير أي عنصر في القرآن من شأن المعتنق الجديد أن يشير إليه بشكل نموذجي على أنه سبب إيمانه بهذا القرآن. فبعد بعض السبر لأغوار القرآن يكتشف المعتنق الجديد أن أساس هذا الإيمان لا ينجم عن مجرد قراءة موضوعية لكتاب المسلمين المقدس (القرآن)، بل هو خبرته الخاصة به أو لنقل نتيجة لتواصله مع هذا الكتاب الكريم. فالعديد من المعتنقين الجدد، وكذلك من المسلمين، يذكرون الإحساس الرائع الذي يشعرون به عندما يتواصلون مع التنزيل المحكم عند قراءتهم للقرآن، فهم يحكون عن مناسبات شعروا من خلالها وكأن القرآن يستجيب لحالاتهم العاطفية والنفسية، ويستجيب كذلك لردة فعل استجابتهم لبعض نصوصه و:أن القرآن يتنزل عليهم شخصياً، وفي كل لحظة يقرأونه فيها، صفحة بصفحة حيث يكشف كل نص تال كيف أثر بهم النص السابق. فقد وجدوا أنفسهم ينسابون وينهمكون في حوار حقيقي مع التنزيل، حوار ينبعث من أعمق وأصدق وأطهر أعماق الوجود، حيث تنكشف لهؤلاء، ومن خلال ذلك التواصل، خصال الرحمة والعطف والمعرفة والمحبة التي يشعر بها المخلوق من الخالق والانساني من المقدس والمحدود من اللامحدود والانسان من الله.
وكما يعلم العديد من المعتنقين الجدد، فليس بالضرورة أن يكون المرء مسلماً لكي يشعر بهذه الطاقة الداخلية للقرآن؛ ذلك أن العديد منهم يختار الاسلام ديناً بعد لحظات من هذا الشعور أو بسببه. ولقد عبّر العديد من الباحثين في الاسلام من غير المسلمين عن مثل هذا الشعور الذي كان ينتابهم لدى قراءتهم للقرآن. فباحث العربية المعروف البريطاني آرثر ج.آربيري يذكر كيف أنه وجد في القرآن عوناً له في بعض الأوقات الصعبة التي مرّ بها في حياته، حيث قال: إنه حينما يستمع إلى القرآن يتلى بالعربية فكأنما يستمع إلى نبضات قلبه. ويذكر فريدريك دينّي، وهو كاتب غير مسلم، تلك (التجربة العجيبة غير الطبيعية) التي يشعر بها المرء أحياناً لدى قراءته للقرآن، لحظات يشعر القارئ من خلالها (بحضور شيء ما غامض وأحياناً مرعب معه). وبدلاً من قراءة القرآن فإن القارئ يشعر وكأن القرآن (يقرؤه)!
ومع ذلك فليس كل قراءة للقرآن تقود لمثل هذه التجربة، فالمسلمون يعتقدون أن تجربة كهذه تحتاج حالة معينة من العقل والروح ومن التواضع وصدق النية ومن الإرادة والاستعداد. فهم يقولون: إذا كان القارئ مدركاً لحالة ضعفه وهوانه أمام الله، وإذا كان لديه الاستعداد كي يرى نفسه على حقيقتها، وإذا كانت لديه القدرة كي يطرح جانباً صور الزيف التي كونها لنفسه، وتلك التي تكونت لديه من الآخرين، وإذا ما توصل للحقيقة الواقعة وهي أن لا حول ولا قوة إلا بالله، عندئذ فقط يكون جاهزاً، بحول الله تعالى، كي يتحول ويتغير بفضل هذا القرآن الكريم. فكل جيل من المسلمين كان دوماً يشعر بأن القرآن يتناسب وعلى نحو نموذجي مع تطلعات زمانه، والكتب والمقالات التي كتبها مؤخراً بعض المعتنقين الجدد تظهر أن لديهم مثل تلك التطلعات. لا أستطيع تقديم شرح كاف عن سبب شعور المسلمين القدامى بمثل هذا الشعور، أو لماذا ينتاب هذا الشعور مسلمين آخرين في أجزاء أخرى من العالم، ولكنني سوف أحاول مشاطرة المعتنقين الجدد خبرتهم في مثل هذا الشعور.
عندما يفتح القارئ الغربي القرآن للمرة الأولى فإنه سرعان ما يواجهه، وبطريقة درامية، أحد أعظم الأسئلة التي دفعت بالعديد من البشر في العصر الحديث لإنكار وجود الله، وهو موضوع سؤال الملائكة لله في القرآن: (قالوا أتجعل فيها مَن يفسد فيها ويسفك الدماء) البقرة/ 30. ثم يبدأ القرآن بالشرح، ولكن في بداية القرآن نجد الشرح مقتضباً، وذلك ما يجذب انتباه واهتمام القارئ، وما على القارئ الذي يريد الحصول على مزيد من الأدلة إلا أن يستمر في قراءة القرآن.
وبعد أن يقرأ القارئ الغربي عن آدم (ع) والذي تختلف قصته في القرآن في تفاصيل رئيسة عما يوازيها في الكتاب المقدس، يتساءل في نفسه: أين يضع الاسلام نفسه بالضبط من التراث اليهودي-المسيحي؟ وكلن القرآن يضع هذا في المنظور، أولاً: في قصة بني إسرائيل (انظر الآيات 40-86 من سورة البقرة)؛ وثانياً: في مناقشة مواقف وعقائد أهل الكتاب (اليهود والنصارى). ثم يتبع ذلك قصة بناء إبراهيم وإسماعيل (ع) للكعبة، والتي تربط الاسلام بالأب الأكبر لكل من هذه الديانات الثلاث (إبراهيم الخليل (ع)، انظر الآيات 122-141 من سورة البقرة). ويخبرنا القرآن أن الاسلام هو تجديد للعقيدة الحنيفية الطاهرة للنبي إبراهيم (ع) (انظر الآيات 142-167 من سورة البقرة).
وطبيعي أن يحول القارئ الغربي بعد ذلك انتباهه إلى مسائل أكثر عملية مثل ممارسات المسلمين التي يسمع الكثير عنها مثل (قوانين الحمية) الصوم والجهاد والحد ووضع المرأة في الاسلام؟ ونجد نقاشاً لهذه المواضيع في آيات القرآن (انظر الآيات 168-283 من سورة البقرة). ويجد القارئ بين هذه الآيات وتلك تذكيراً بوجود الله وحدانيته، ودلائل حكمة الله ورحمته وقدرته وحاجة الانسان الماسة للتوجه إليه. ثم نجد أن القرآن يحاول غرس هذه الحقائق الأساسية في عقل القارئ على نحو مستمر ومتكرر ومركز، بحيث يحاول الوصول إلى أقصى أبعاد روحه الداخلية، ثم يبعث فيه من جديد الواقع الذي يعيش ويتنفس من خلاله.
وتختتم السورة الثانية (البقرة) بالدعاء الذي تعلّم القارئ من خلاله كيف يسأل الله العون على مصائب الدهر، ويرجه المغفرة التامة والرعاية. وأما السورة الثالثة (آل عمران) فتبدأ بهذا التوسل: إن رجاءنا الحقيقي وملاذنا هو في: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام) آل عمران/ 2-4.
فعندما ينتهي القارئ من سورة البقرة (السورة الثانية) تتكون لديه بعض المعرفة بالاسلام. ثم نجد في السور 12 الباقية من القرآن تطويراً ودعماً واستطراداً وشرحاً للمواضيع الرئيسة الواردة في هذه السورة. وكما في الفصل الأول من هذا الكتاب، فإن القارئ سوف يجد أن هذه المواضيع متداخلة عبر النص. فالقرآن لا يدع القارئ يفكر في أحدها بمعزل عن الآخر، بل يطلب منه أن يرى ويدرك ترابطها بعضها مع بعض. ومع ذلك، نرى أن كل سورة من السور التالية تركز في معظم الوقت على واحد أو اثنين من هذه المواضيع الرئيسة. وأما السورة الثالثة (آل عمران) فهي تضع الخطوط العريضة للتاريخ الديني لبني البشر مع الاشارة الخاصة إلى أهل الكتاب، كما أنها تذكر المسلمين بواجبهم لمحاربة الظلم والطغيان. وأما السورة الرابعة (النساء) فإنها تعود إلى موضوع حقوق المرأة وواجبات الأسرة. وأما السورة الخامسة (المائدة) فتتعلق بشكل رئيس باليهودية والمسيحية وتؤكد من جديد فساد هاتين الديانتين اللتين انبعثت تعاليمهما النقية الطاهرة، واكتملت من جديد في الاسلام.
وكلما تقدمنا في قراءتنا للقرآن نجد أن السور تقصر بالتدريج، كما أن توكيدها وأسلوبها يتغير أيضاً. وفي سور منتصف القرآن، تصادفنا بعض الأحكام والقواعد الأخرى الإضافية، ولكن التوكيد الرئيس يتحول إلى المزيد من القصص والأخبار التي تتعلق بأنبياء سابقين، وكذلك إلى المزيد من الإشارات الدرامية إلى دلائل الإعجاز الطبيعية التي تعبر عن قدرة الله وحكمته وجوده، وهنا أيضاً تجد المزيد من التركيز على علاقة الانسان بالله ورجوعه إليه. وكلما تقدمنا بالقراءة يصبح الأسلوب الأدبي في القرآني، والذي هو خير ما يمكن تذوقه بالعربية، أكثر عاطفية وأشد وقعاً في النفس.
وكلما اقتربنا من النهاية يتركز الخطاب بشكل كلي تقريباً على القارئ وعلاقته بالله، وكذلك على العلاقة العضوية بين أعمال المرء ومصيره في الآخرة، حيث تلج هذه المواضيع من السور أذن القارئ على شكل ومضات من النشوة والتفجر العاطفي. فالجنة والنار والساعة ويوم القيامة والدنيا والآخرة وفناء الكون، ورجوعنا إلى الله، جميعها تتجه لتلتقي عند مصير واحد وهو نقطة الذروة عند قيام الساعة.
وهكذا نجد أن القرآن يدفع بالقارئ وهواجسه العملية والآنية عبر عوالم الأنبياء وآباء الأنبياء والمعجزات والآيات إلى اللحظة القصوى، حيث يتبدى فيها للقارئ أنه يقف بمفرده أمام ربه وخالقه؛ ويشعر العديد من أولئك الذين يقومون بهذه الرحلة بشيء من رهبة ذلك اللقاء وهوله بينما يقتربون في قراءتهم من نهاية القرآن. وسرعان ما يساورهم الشك بأنفسهم وينتابهم الخوف، ويشعرون بالوطأة عندما يقتربون من الخيار الذي يضعه القرآن أمامهم لا محالة. فالعديد منهم يخشى المجتمع ويراجع نفسه ليرى إن كان قد اعتراه سوء في عقله، ثم إنهم يتشككون بمقدرتهم على تحويل وجهة حياتهم والاستسلام لأمر الله. ومنهم مَن يشعر أن الوقت قد فات وأنهم أبعد من أن تشملهم رحمة الله ومغفرته. ومع ذلك نجد أن الله يطمئن القارئ عبر آيات القرآن وعلى نحو مستمر ألا يركن إلى هذا النوع من الشك والقنوط من رحمة الله ومغفرته:
(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) البقرة/ 186.
(فاستجاب لهم ربهم ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب) آل عمران/ 195.
(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) الزمر/ 53.
(ما أنت بنعمة ربك بمجنون) القلم/ 2.
(والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ضالاً فهدى) الضحى/ 1-8.
(ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً) الشرح/ 1-6.
وفي الوقت الذي يطبق فيه الخيار المطلق على القارئ نرى كيف يضع القرآن أمامه الكلمات التي ما فتئت روحه تبحث عنها، فيأمره بقول:
(قل هو الله أحد) الإخلاص/ 1.
(قل أعوذ برب الفلق) الفلق/ 1.
(قل أعوذ برب الناس) الناس/ 1.
إذ يبدو من هذه الآيات وكأن الله يخاطب القارئ قائلاً له: قل هذه الكلمات وسوف آتيك، قلها ولسوف أحميك وأواسيك، توجه إليّ فلسوف أمنحك المودة، وسوف يعرف قلبك معنى السكينة والطمأنينة.
لقد وقف العديد منّا، بعد قراءته للقرآن، وقد سقط في يديه كمن أصابه الشلل وهو على حافة من اللاقرار، تمتد من بين الإيمان والإعراض، وما بين أحلامنا المادية ورجائنا بالآخرة، وما بين رغباتنا الدنيوية وحاجاتنا الروحية. ولقد مرت عليان ليال مؤرقة، وكنا كما بدا لنا نجري خلف السراب، وكانت تستحوذ علينا رؤى من ردود فعل الأهل والأصحاب، وكانت تخطر في بالنا بعض الآيات وكان ينتابنا القلق حول وظائفنا وأعمالنا، والأسوأ من ذلك كله فراغ الفراق عمن لامس تنزيله شغاف قلوبنا إذام ا أعرضنا عن اتباع الهدى. فمن بين أولئك الذين عرفوا هذا العذاب وخبروه أعرض بعضهم وولى إلى غير رجعة. ومع ذلك فقد كان هناك مَن تخلى عن المقاومة وأخذ يركض بأذرع مفتوحة ليعانق رحمة ربه، من أذعن واستسلم لنداء أعماقه ليغوص في محيط من العطف والمودة.
فأما أولئك الذين يختارون الاسلام فسرعان ما يكتشفون وللأبد أن عليهم أن يجيبوا على السؤال التالي: (كيف أصبحت مسلماً؟) وبالطبع سوف يقدمون شروحات جزئية مختلفة في أوقات مختلفة وذلك حسب السياق الذي تم فيه السؤال. وعلى كل حال، فإننا جميعاً الذين قمنا باتخاذ ذلك القرار لا نستطيع الإجابة بشكل كامل على هذا السؤال؛ ذلك أن حكمة الله وتدبيره أمر لا يمكن الإحاطة بهما. وقد تكون أصدق وأبسط إجابة نستطيع أن نقدمها هي الإجابة التالية: في لحظة من اللحظات الخاصة في حياتنا ـ لحظة لم نتنبأ من قبل أن نمر بها عندما نكبر ـ منّ الله بواسع علمه ورحمته وعطفه علينا، بعد أن وجد فينا من العذاب ما نكابد، ومن الألم ما نشعر به، ومن عظيم الحاجة إلى ملء الخواء الروحي الكبير في أنفسنا، وبعد أن وجد لدينا الاستعداد الكبير لقبول ذلك. وعلى كل حال فقد حقق الله ذلك لنا، فله الشكر والمنة إلى يوم الدين. حقاً سبحان الله والحمد لله.
د. جيفري لانغ
أستاذ الرياضيات في الجامعات الأميركية
هل تجوز الصلاة عند القبور؟
السؤال:
هل تجوز الصلاة عند القبور؟
الجواب:
قد جرت السيرة المطّردة من صدر الإسلام ـ منذ عصر الصحابة الأوّلين، والتابعين لهم بإحسان ـ على زيارة قبورٍ ضمنت في كنفها نبيّاً مرسلاً، أو إماماً طاهراً، أو وليّاً صالحاً، أو عظيماً من عظماء الدين، وفي مقدّمها قبر النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله).
وكانت الصلاة لديها، والدعاء عندها، والتقرّب إلى الله، وابتغاء الزلفة لديه بإتيان تلك المشاهد، من المتسالم عليه بين فرق المسلمين، من دون أيّ نكير من آحادهم، وأيّ غميزة من أحدٍ منهم على اختلاف مذاهبهم، حتّى ولد ابن تيمية الحرّاني، فأنكر تلكم السنّة الجارية، وخالف هاتيك السيرة المتبعة. فإذاً دليل جواز الصلاة عند القبور من سيرة المسلمين.
وأمّا حديث ابن عباس: «لعن رسولُ الله(صلى الله عليه وآله) زائرات القبور، والمتّخذين عليها المساجد والسُرُج»(1)، فالظاهر والمتبادر من اتّخاذ المسجد على القبر هو السجود على نفس القبر، وهذا غير الصلاة عند القبر، هذا لو حملنا المساجد على المعنى اللغوي.
وأمّا لو حملناها على المعنى الاصطلاحي، فالمذموم اتّخاذ المسجد عند القبور، لا مجرّد إيقاع الصلاة، كما هو المتعارف بين المسلمين، فإنّهم لا يتّخذون المساجد على المراقد، فإنّ اتّخاذ المسجد ينافي الغرض في إعداد ما حول القبر إعانة للزوّار على الجلوس لتلاوة القرآن وذِكر الله والدعاء والاستغفار، بل يُصلّون عندها، كما يأتون بسائر العبادات هنالك.
____________________
1ـ مسند أحمد 1/229، سنن أبي داود 2/87، الجامع الكبير 1/201، سنن النسائي 4/95.
الأدلّة على جواز الصلاة عند القبور
السؤال:
ما هو ردّكم على كلام ابن تيمية حيث قال: لم يقل أحد من أئمّة السلف أنّ الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبّة أو فيها فضيلة، ولا أنّ الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء، بل اتّفقوا كلّهم على أنّ الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور(1).
الجواب:
إنّ ما دلّ على جواز الصلاة والدعاء في كلّ مكان، يدلّ بإطلاقه على جواز الصلاة والدعاء عند قبر النبيّ(صلى الله عليه وآله) وقبور سائر الأنبياء والصالحين أيضاً، ولا يشكّ في الجواز مَن له أدنى إلمام بالكتاب والسنّة، وإنّما الكلام هو في رجحانها عند قبورهم.
فنقول في هذا المجال: إنّ إقامة الصلاة عند تلك القبور لأجل التبرّك بمَن دُفن فيها، وهذه الأمكنة مشرّفة بهم، وقد تحقّق شرف المكان بالمكين، وليست الصلاة ـ في الحقيقة ـ إلّا لله تعالى لا للقبر ولا لصاحبه، كما أنّ الصلاة في المسجد هي لله أيضاً، وإنّما تُكتسب الفضيلة بإقامتها هنا لشرف المكان، لا أنّها عبادة للمسجد.
فالمسلمون يصلّون عند قبور مَن تشرّفت بمَن دُفن فيها لتنالهم بركة أصحابها الذين جعلهم الله مباركين، كما يصلّون عند المقام الذي هو حجر شرف بملامسة قدمي إبراهيم الخليل(عليه السلام) لها.
قال الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى...﴾(2)، فليس لاتّخاذ المصلّى عند ذلك المقام الشريف سبب إلّا التبرّك بقيام إبراهيم(عليه السلام) عليه، وهم يدعون الله عند القبور لشرفها بمَن دُفن فيها، فيكون دعاؤهم عندها أرجى للإجابة وأقرب للاستجابة، كالدعاء في المسجد أو الكعبة أو أحد الأمكنة، أو الأزمنة التي شرّفها الله تعالى.
والحاصل: أنّه يكفي في جواز الصلاة الإطلاقات والعمومات الدالّة على أنّ الأرض جُعلت لأُمّة محمّد مسجداً وطهوراً.
وأمّا الرجحان فللتبرّك بالمكان المدفون فيه النبيّ أو الوليّ ذي الجاه عند الله، كالتبرّك بمقام إبراهيم، أفلا يكون المكان الذي بورك بضمّه لجسد النبيّ الطاهر مباركاً، مستحقّاً لأن تستحبّ عنده الصلاة وتندب عبادة الله فيه.
والعجب أنّ ابن القيّم جاء في كتابه «زاد المعاد» بما يخالف عقيدته، وعقيدة أُستاذه ابن تيمية، إذ قال: «وأنّ عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد، آلت إلى ما آلت إليه، من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين، ومتعبّدات لهم إلى يوم القيامة، وهذه سنّته تعالى فيمَن يريد رفعه من خلقه»(3).
فإذا كانت آثار إسماعيل وهاجر لأجل ما مسّها من الأذى مستحقّة لجعلهما مناسك ومتعبّدات، أفلا تكون آثار أفضل المرسلين الذي قال: «ما أُوذي نبيّ قطّ كما أُوذيت» تستحقّ أن يُعبد الله فيها؟ وتكون عبادة الله عندها والتبرّك بها شركاً وكفراً؟
____________________
1_ رسالة القبور 1/28.
2_ البقرة: 125.
3_ زاد المعاد 1/75.
ما هي الأسباب والحكم من غيبة الإمام المهدي (ع)؟
السؤال:
ما هي الأسباب والحكم من غيبة الإمام المهدي ( عليه السلام ) ؟
الجواب:
إنّ غيبة الإمام المنتظر ( عليه السلام ) كانت ضرورية لابدّ للإمام منها ، نذكر لك بعض الأسباب التي حتمت غيابه ( عليه السلام ) :
1ـ الخوف عليه من العباسيين :
لقد أمعن العباسيون منذ حكمهم ، وتولّيهم لزمام السلطة في ظلم العلويين وإرهاقهم ، فصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الأليم ، وقتلوهم تحت كُلّ حجرٍ ومدرٍ ، ولم يرعوا أيّة حرمة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عترته وبنيه ، ففرض الإقامة الجبرية على الإمام علي الهادي ، ونجله الإمام الحسن العسكري ( عليهما السلام ) في سامراء ، وإحاطتهما بقوى مكثّفة من الأمن ـ رجالاً ونساءً ـ هي لأجل التعرّف على ولادة الإمام المنتظر ( عليه السلام ) لإلقاء القبض عليه ، وتصفيته جسدياً ، فقد أرعبتهم وملأت قلوبهم فزعاً ما تواترت به الأخبار عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن أوصيائه الأئمّة الطاهرين : أنّ الإمام المنتظر هو آخر خلفاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّه هو الذي يقيم العدل ، وينشر الحقّ ، ويشيع الأمن والرخاء بين الناس ، وهو الذي يقضي على جميع أنواع الظلم ، ويزيل حكم الظالمين ، فلذا فرضوا الرقابة على أبيه وجدّه ، وبعد وفاة أبيه الحسن العسكري أحاطوا بدار الإمام ( عليه السلام ) ، وألقوا القبض على بعض نساء الإمام الذين يظنّ أو يشتبه في حملهن .
فهذا هو السبب الرئيسي في اختفاء الإمام ( عليه السلام ) ، وعدم ظهوره للناس ، فعن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إنّ للقائم غيبة قبل ظهوره » ، قلت : ولَمِ ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يخاف » ، وأومئ بيده إلى بطنه ، قال رزارة : يعني القتل (1) .
ويقول الشيخ الطوسي : « لا علّة تمنع من ظهوره ( عليه السلام ) إلاّ خوفه على نفسه من القتل ، لأنّه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار » (2) .
2ـ الامتحان والاختبار :
وثمّة سبب آخر علّل به غيبة الإمام ( عليه السلام ) ، وهو امتحان العباد واختبارهم ، وتمحيصهم ، فقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « أمّا والله ليغيبن إمامكم سنيناً من دهركم ، ولتمحصن حتّى يقال : مات أو هلك ، بأيّ وادٍ سلك ، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ، ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر ، فلا ينجو إلاّ من أخذ الله ميثاقه ، وكتب في قلبه الإيمان ، وأيّده بروح منه » (3) .
ولقد جرت سنّة الله تعالى في عباده امتحانهم ، وابتلاءهم ليجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون ، قال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) (4) ، وقال تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ) (5) .
وغيبة الإمام ( عليه السلام ) من موارد الامتحان ، فلا يؤمن بها إلاّ من خلص إيمانه ، وصفت نفسه ، وصدّق بما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة الهداة المهديين من حجبه عن الناس ، وغيبته مدّة غير محدّدة ، أو أنّ ظهوره بيد الله تعالى ، وليس لأحدٍ من الخلق رأي في ذلك ، وإن مثله كمثل الساعة فإنّها آتية لا ريب فيها .
3ـ الغيبة من أسرار الله تعالى :
وعُلّلت غيبة الإمام المنتظر ( عليه السلام ) بأنّها من أسرار الله تعالى ، التي لم يطّلع عليها أحد من الخلق ، فقد ورد عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « إنّما مثله كمثل الساعة ، ثقلت في السماوات والأرض ، لا تأتيكم إلاّ بغتة » (6) .
4ـ عدم بيعته لظالم :
ومن الأسباب التي ذكرت لاختفاء الإمام ( عليه السلام ) أن لا تكون في عنقه بيعة لظالم ، فعن علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أبيه ، عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « كأنّي بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه » ، قلت له : ولم ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال ( عليه السلام ) : « لأنّ إمامهم يغيب عنهم » ، فقلت : ولِمَ ؟ قال : « لئلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالسيف » (7) .
وأعلن الإمام المهدي ( عليه السلام ) ذلك بقوله : « إنّه لم يكن لأحد من آبائي ( عليهم السلام ) إلاّ وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وإنّي أخرج حين أخرج ، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي » (8) .
هذه بعض الأسباب التي علّلت بها غيبة الإمام المنتظر ( عليه السلام ) ، وأكبر الظنّ أنّ الله تعالى قد أخفى ظهور وليّه المصلح العظيم لأسباب أُخرى أيضاً لا نعلمها إلاّ بعد ظهوره ( عليه السلام ) .
ــــــــــــــ
(1) علل الشرائع 1 / 246 ، كمال الدين وتمام النعمة : 481 .
(2) الغيبة للشيخ الطوسي : 329 .
(3) الإمامة والتبصرة : 125 ، الكافي 1 / 336 ، الأمالي للشيخ الصدوق : 191 .
(4) الملك : 2 .
(5) العنكبوت : 2 .
(6) كفاية الأثر : 168 و 250 ، ينابيع المودّة 3 / 310 .
(7) علل الشرائع 1 / 245 ، عيون أخبار الرضا 2 / 247 .
(8) كمال الدين وتمام النعمة : 485 ، الغيبة للشيخ الطوسي : 292 .
الانتظار.. جهادا

كالعديد من المفاهيم، فقد غير الناس وبدلوا في مفهوم (الانتظار) الذي يتعلق بالامام الثاني عشر من ائمة اهل بيت النبوة والرسالة والوحي عليهم السلام، والمولود في الخامس عشر من شهر شعبان المعظم.
ولا اريد هنا ان ابحث في اصل قضية الظهور عند كل الامم والاقوام والاديان والمذاهب، خاصة عند المذهب الاثنا عشري، ولا في شروطه وعلاماته ووقته وغير ذلك، فلكل هذه الموضوعات ابحاثها الخاصة التي ملأ بها الباحثون بطون الكتب والمجلدات على مدى اكثر من ثلاثة عشر قرنا.
انما الذي اريد ان ابحثه هنا هو فلسفة الانتظار كمفهوم حضاري وتاثيره على شخصية الانسان ــ الفرد والانسان ــ المجتمع، ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين وفي خضم كل هذا التطور المدني والاجتماعي والسياسي والتكنلوجي وفي العلاقات العامة.
فماذا نعني بالانتظار؟ وكيف ينبغي علينا التعامل معه كمفهوم تاريخي وحضاري في آن؟ وهل من طريقة لتوظيفه في عملية التغيير التي يشهدها العالم في كل شئ؟.
لعل من ابرز ما ورد من احاديث شريفة عن رسول الله (ص) بشأن (الانتظار) هو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (جهاد امتي انتظار الفرج)
في الوهلة الاولى يتصور المرء ان هناك تناقضا بين مفهومي (الجهاد) و(الانتظار) فالجهاد لغة اصله، كما ورد في معاجم اللغة، المبالغة واستفراغ الوسع، اما الانتظار فهو اقرب الى التامل منه الى الحركة وبذل الوسع، فهل عنى الحديث الشريف ان يجمع بين المتناقضين؟ ام ان هناك معنى آخر اراد ان يصل اليه الحديث من خلال الجمع بين المفهومين؟.
بالتاكيد لم يشا الحديث الشريف المراد الاول، لانه ليس من البلاغة في شئ، كما انه بعيد عن الحقيقة المتوخاة من مفهوم الانتظار.
وبرأيي، فان الحديث الشريف سعى، بجمع مفهومي (الجهاد) و(الانتظار) في حديث واحد الى ان يصل الى لب مفهوم (الانتظار) والذي هو (استفراغ الجهد في زمن الغيبة والانتظار) بمعنى آخر فان الحديث يشير هنا الى (الانتظار الايجابي) وليس الى (الانتظار السلبي) الذي شاع كثيرا بين الناس، خاصة بعد كل فشل او هزيمة يمنى به المجتمع.
انه اراد ان يكون (الانتظار) جهادا، ولا يمكن تحقيق ذلك الا بالانتظار الايجابي، فاذا تمثلت الانتظار السلبي في حياتك وجلست في بيتك تتنظر اليوم الموعود من دون حركة او فعل ايجابي، فليس في كل ذلك اي جهاد او مشقة او تعب، اليس كذلك؟ فالانتظار بهذا المعنى هو جهد العاجزين الفاشلين، انما الجهاد يصدق عندما تنتظر ايجابيا، في قول او فعل او حركة تغييرية وتجديدية وتحديثية.
انه يصدق عندما تعاني وتتحدى وتبذل جهدك، واحيانا مالك ونفسك وروحك وما تملك، من اجل شئ ما.
ومن الواضح جدا فان هناك فرق شاسع بين النوعين، فبينما يعني (الانتظار الايجابي) الاستعداد والتهيؤ واعداد العدة والظروف اللازمة وادوات التمكين للموعود المنتظر، يعني (الانتظار السلبي) ان تضع يدا على يد، او يدا على خد، بانتظار اليوم الموعود، فلا تحرك ساكنا ولا تعد شيئا ولا تهيئ امرا، انما تجلس في دارك او على قارعة الطريق تنتظر الموعود ليغير ويبدل، وربما تنهى الاخرين اذا تحركوا او تعيق حركتهم او تحرض ضدهم او تشي عليهم عند السلطان الجائر، كما يفعل كثيرون ممن ينتظرون (سلبيا).
فهل في هذا النوع اي معنى من معاني الجهاد؟ بالتاكيد لا.
في الانتظار الاول يكون لك كل الدور، اما في الانتظار الثاني فليس لك اي دور، وفي الاول انت جزء لا ينفصل من مشروع التغيير اما في الثاني فانت على الهامش، وفي الاول انت فاعل وفي الثاني انت خامل، وفي الاول انت حركة وفي الثاني انت سكون.
ان الانتظار في جو الجهاد هو (الانتظار الايجابي) اما الانتظار في جو السكون والسكوت والخمول فهو (الانتظار السلبي) ومما لا شك فيه فان الحديث عنى الاول ولم يعن الثاني البتة، لانه ليس من المعقول ان يدعو رسول الله (ص) الناس الى يوم القيامة ان يجلسوا في بيوتهم بانتظار اليوم الموعود من دون ان يبذلوا اي جهد للمساهمة في الاعداد له، كيف يدعو الى مثل هذا المفهوم وهو (ص) القائل {كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته}؟ او قوله (ص) {من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان}؟.
والان، وبعد ان عرفنا ما عناه الحديث الشريف من قوله الانف الذكر، عندما جمع بين مفهومي الجهاد والانتظار، فان ذلك يفتح لنا افقا لوعي المعنى بشكل افضل.
فالمرء عندما يكون في حالة الانتظار، فهذا يعني عدة امور:
الاول: انه غير مقتنع بالواقع ولذلك فهو ينتظر من يبادر الى التغيير نحو الافضل ليكون معه مساهما ومساندا.
انه يعيش حالة الرفض الدائم للواقع مهما كان شكله ونوعه، متطلعا نحو مستقبل افضل واحسن، وهذا هو عين الايمان بالتقدم والكفر بالتاخر او حتى التوقف عند لحظة زمنية معينة، ولقد اشار الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام الى هذا المعنى بقوله (من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان امسه خيرا من يومه فهو ملعون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقيصة، ومن كان في نقيصة فالموت خير له).
لذلك يمكن القول ان من يؤمن بعصر الظهور هو من اكثر الناس تطلعا الى التغيير نحو الافضل، او على الاقل هكذا يجب ان يكون، والا لما انتظر شيئا او امرا ما، فالذي يقتنع بواقعه، مهما كان مرا او منحرفا، لا ينتظر احدا ليغير، اليس كذلك؟.
الثاني: انه يبذل اقصى جهده ليكون شخصيا بمستوى التصدي مع (المغير) نحو الافضل ليلتحق بمشروعه الحضاري، وهو يسعى بكل ما اوتي من طاقات ليتقمص شخصية من ينتظره ليكون في عداد اصحابه، فاذا كان التغيير في اليوم الموعود شاملا وجذريا كيف يمكن ان يكون المرء، اي امرئ، جزءا منه اذا لم يكن قد استعد لمثل هذه المهمة واخذ لها عدتها؟.
انه يستعد شخصيا على كل المستويات، ليكون الافضل والاحسن والاقدر والاكفأ، ان على الصعيد العلمي او التكنلوجي او الصحي او الجسدي او الاقتصادي او الاجتماعي او ما الى ذلك، فتراه يواكب التطور العالمي ولا يتأخر عنه، ويكتسب من المهارات ما يجعله في المقدمة، ويقرا ويطالع ويتعلم ويثقف نفسه بكل علم مشاع، كما انه يربي نفسه روحيا وايمانيا ليكون صالحا في مجتمعه، جاهزا ليكون جنديا في مشروع التغيير الحضاري المرتقب.
الثالث: انه يسعى دائما لان يعمل بروح الفريق، لان التغيير في اليوم الموعود لا يكون فرديا وانما جماعيا ليشمل العالم كله، فاليوم الموعود لا تحده الجغرافيا او الاثنية او اللغة او الخلفية او اي شئ آخر، وانما هو للناس كافة كما كانت رسالة الاسلام التي بعث بها رسول الله (ص) للناس كافة، فكيف يمكن لاحد ان يكون جزءا من الفريق الذي سيتصدى لعملية التغيير الشاملة اذا لم يكن مستعدا ومتعلما ومتدربا على العمل مع الاخرين كفريق واحد؟.
فالاناني لا يمكن ان يتصور نفسه مع مثل هذا الفريق ابدا، كما ان الذي يحب الخير لنفسه ولا يحبه لغيره، او انه مشبع بحب الظهور والاستعراض لا يمكن ان يكون جزءا من هذا الفريق الذي سيعتمد التعاون والتجانس والتناسق في الافكار والحركة، في المبدا والمنتهى.
انه يتسلح بكل شروط العمل كجماعة، ويتعلم فنون واخلاقيات هذا النوع من العمل، فيزرع الثقة اين ما حل وارتحل، ويشيع روح التعاون والايثار بين الناس، كما انه يشيع ثقافة العفو والتجاوز والصفح في المجتمع، ما امكنه الى ذلك سبيلا.
الرابع: انه يعيش الرقابة الذاتية على مدار الساعة، لانه يستشعر حضور الموعود في حياته، يراقب حركاته وسكناته، قوله وفعله، ما يدفعه لان يحسب لكل شئ حسابه، فلا يلفظ بقول قبل ان يزنه، ولا يقدم على فعل قبل ان يتثبت منه، ولا ينقل خبرا او يشيع معلومة قبل ان يتاكد من صحتها، انه يستحضر الرقيب الذاتي دائما، وشعاره قول الله عز وجل {ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد} ولذلك فهو مشروع (احسن) الذي كرره القران الكريم في العديد من الايات القرانية، كقوله عز وجل (ايكم احسن عملا).
ان الرقابة الذاتية تساهم بشكل فعال في تحسين اداء المرء، ما يجعله الاقرب الى النجاح، بغض النظر عن حال المجتمع الذي يتحجج به البعض لتبرير ذنوبهم ومشاكلهم الاخلاقية والسياسية وغير ذلك، فتراه يتحجج بانحراف المجتمع اذا انتقدته على خطا، قائلا (وهل بقيت علي انا والمجتمع كله على خطا؟) او قول بعض المسؤولين اذا عاتبته على فساد مالي او اداري (ان كل السياسيين يفعلون الامر ذاته، فلماذا علي ان اتطهر وغيري يفسد ويسرق؟) او كتمثل بعضهم بالقول المعروف (اذا لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب) اذا عاتبته على اخلاق الذئاب التي يتصف بها في علاقاته مع الاخرين بدءا باسرته وليس انتهاءا بالمجتمع.
ولقد اشار امير المؤمنين عليه السلام الى اهمية االرقابة الذاتية بقوله {من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف امن، ومن اعتبر ابصر، ومن ابصر فهم، ومن فهم علم} فهي اساس كل خير.

الخامس: انه يتمتع بقدرة فائقة على استيعاب الاخرين، يتعاون معهم اذا اتفقوا معه في الراي والهدف والوسائل ويتحاور معهم اذا اختلفوا معه في الرؤى والافكار، لا يعتدي على احد ولا يكفر احدا ولا يبيح دم احد اذا اختلف معه في راي او موقف او تشريع كما يفعل فقهاء التكفير الذين يحرضون على البغض والكراهية والحقد والاعتقاد بالحقيقة المطلقة من دون سائر الناس.
يسوق الباحثون فكرة ان واحدة من اسباب وفوائد ولادة الامام الثاني عشر ومن ثم غيبته عن الانظار وعدم بقائه في الارحام ليولد عندما يشاء الله، هو ان طول العمر سيمكن الامام من ان يعيش حياة الاجيال المتعاقبة ويشهد تجاربهم ولذلك فهو عندما يظهر في اليوم الموعود سيكون حاملا لتجارب كل الاجيال التي مرت على وجه البسيطة، ما يعني انه سيكون مستوعبا لتجارب الحياة كلها وكانه عاشها بتفاصيلها مع الاجيال المتعاقبة، فلم يظهر في محيط غريب عنه، كما يتصور البعض فيتساءل كيف له، عندما يظهر، ان يعيش الزمن الحالي وهو من الزمن والجيل (الحرس) القديم؟.
ان هذه الفكرة هي التي يجب ان تحكم علاقة من يؤمن بفكرة (الانتظار) مع الاخرين، اذ عليه ان يستوعب كل الاراء والافكار والتجارب ليكون بمستوى الحدث التاريخي عندما يقع، اما الذي يرفض الاخرين ولا يقبل الحوار وانما يلجا الى القتل وسفك الدماء لفرض آرائه ومعتقداته، كما هو حال (الوهابيون) مثلا، فان مثل هذا المنهج سيضيق عليه خناق المعرفة، لان اللاحوار يحبس صاحبه في صندوق مغلق ومظلم يحول بينه وبين ان يسمع الراي الاخر، وبالتالي المعرفة والوصول الى الحقيقة.
لقد تجاوز القران الكريم هذه المعضلة التي يعيشها كثيرون في كل العصور، ما يحول بينهم وبين الاطلاع على الحقيقة فضلا عن قبولها، بقوله (الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب).
السادس: هو ان (الانتظار) استعداد من جنس اليوم الموعود وهويته وماهيته، فانتظار الفلاح ليوم الحصاد يستعد اليه بالحرث والبذر والسقي، اما انتظار الطالب ليوم النجاح فيستعد له بالحضور اليومي والتحضير المستمر والقراءة والمطالعة والبحث وسهر الليالي على طلب العلم، فيما يستعد السياسي ليوم الانتخابات باعداد البرنامج الحكومي مثلا او اطلاق الوعود الى الناخب بما قد يقنعه بانه يحمل الحلول لمشاكله، ما يعني ان جنس الانتظار من جنس اليوم الموعود بالنسبة لكل انسان.
ولان (المنتظر) في اليوم الموعود سيكون من جنس التغيير الاجتماعي الشامل، بما فيه الابعاد السياسية والاقتصادية والاخلاقية وفي العلاقات العامة، وفي كل شئ، لذلك فان الاستعداد له يجب ان يكون من جنسه، يعمل (المنتظر) على تغيير شخصيته بما سينسجم مع (المنتظر) في اخلاقياته واهدافه وادوات التغيير التي سيستخدمها وغير ذلك.
ولذلك لا يمكن ان نتصور ان كذابا مثلا او لصا او سئ الخلق او فاشلا او حقودا او قاتلا او ظالما او كسولا، يمكن ان يدعي بانه (ينتظر) اليوم الموعود ليلتحق بركب (المنتظر) في عملية التغيير، فان مثل ادعائه هذا كمثل الفلاح الذي يدعي انه ينتظر يوم الحصاد من دون ان يحرث او يبذر او يسقي، فهل يمكن ان نصدق ما يدعي؟ بالتاكيد كلا.
السابع: هو ان (الانتظار) يتطلب ايمانا عميقا بالامل، والذي يدفع صاحبه الى التمسك بعملية التغيير مهما طال الزمن، ومهما كثرت التضحيات، ومهما استخدم الطاغوت من وسائل التدمير والتعذيب والقتل والتضليل للقضاء على اي بصيص امل للتغيير المرجو.
ان الياس لا يشجع على الانتظار كل هذه المدة الزمنية الطويلة، كما انه يدفع بصاحبه الى الاستسلام والقبول بالامر الواقع، ولذلك فان الياس ضد فلسفة (الانتظار) الذي يعني الاستعداد الدائم للتغيير في اجواء الجهاد.
يمكن القول، اذن، ان (الانتظار) يعتمد على مبدأين أساسيين، هما الرفض والتطلع، رفض الواقع المر بكل ما يحمل في طياته من تمييز وتخلف وقهر وظلم وسحق لحقوق الانسان واغتيال الفرص وسوء العلاقات الاجتماعية سواء في الاسرة الواحدة او بين ابناء المجتمع الواحد، وغياب العلم والمعرفة واعتماد الخرافة للحشد الديني والمذهبي والعنف والارهاب وغير ذلك من الامراض التي ابتليت بها مجتمعاتنا.
وبالتاكيد فان من يرفض هذا الواقع المر وبكل هذه التفاصيل واكثر، فانه سيكون في حالة حرب وجهاد، اذ ان المجتمع، خاصة السلطة الظالمة والجماعات المتطرفة والظلامية والمتخلفة التي تحن الى الماضي دائما او تلك التي تعتمد مبدا (السلفية) المتزمتة، سوف لن يتركوا المرء وشانه يسفه احلامهم ويعري مناهجهم المتخلفة، ولذلك نرى اليوم، مثلا، كيف ان النظام السياسي العربي الفاسد لجا الى مخازن اسلحته المملوءة بمختلف انواع السلاح الفتاكة ليواجه بها حركة الثورة الشاملة التي انطلقت بها الشعوب العربية من اجل التغيير الجذري الشامل، لتحقيق مبدا الحياة الحرة الكريمة.
أكثر من هذا فان بعضها، كما هو الحال بالنسبة الى نظام اسرة آل سعود الفاسدة، راحت تصرف المليارات من دولارات الفقراء والمعوزين لشراء احدث الاسلحة الفتاكة من عدد من دول الغرب، ليس من اجل الدفاع عن مصالح الشعب او عن عز الامة وكرامتها او لتحرير القدس وفلسطين التي طالما تاجر بها الحكام العرب، ابدا، وانما من اجل قمع شعب اعزل مسالم طيب كشعب البحرين الابي الذي تعرض الى واحدة من ابشع صور القمع الوحشي على يد الاسرتين الفاسدتين الحاكمتين في الجزيرة العربية والبحرين، واقصد بهما آل سعود وآل خليفة، وامام مرآى ومسمع العالم باسره.
أما المبدأ الثاني، مبدأ التطلع، فان (الانتظار) الذي يعني رفض الواقع لابد ان يتكامل مفهومه بمفهوم آخر هو (التطلع) فالرفض لوحده عبث ولا ينتج شيئا، اذ ماذا يمكن ان ينفع المجتمع اذا رفض الانسان الواقع المر من دون ان يقدم حلا للاصلاح والتغيير والتبديل، من اجل حياة افضل في ظل الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص والغاء التسلط والقمع ومصادرة حرية التعبير؟.
ان (الانتظار) يعني ان يكون لك مشروعا تغييريا حقيقيا وليس من اجل الوصول الى السلطة فقط بعد ازاحة الطاغوت، لتعود الكرة مرة اخرى، ولكن هذه المرة على يدك وليس على يد طاغوت مدحور او ظالم مخلوع، كما هو الحال مع الكثير من السياسيين في العراق الجديد من الذين طالما ناضلوا وجاهدوا ضد الطاغية الذليل صدام حسين حتى اذا قيض الله تعالى للعراقيين من يساعدهم على ازاحته واسقاطه عن عرشه وانهاء فترة حكمه المظلمة، ليتبوأوا مقعده، اذا بهم يمارسون نهجه ويلجأون الى عهده ناسين او متناسين ان الدنيا دول وهي تشبه دولاب الهواء تارة يكون المرء في اسفله واخرى في اعلاه، في القمة، واذا صادف انه في القمة فهذا لا يعني انه سيظل ابد الابدين فيها، ابدا، اذ لابد من ان يدور الفلك ليعود هو في القاع وغيره في القمة، وهكذا هي حال الحياة، فلماذا يسعى بعضهم الى ان يكرروا اخطاء الطاغية والكثير من جرائمه؟.
أن الذي (ينتظر) اليوم الموعود لا يمكن ان يستبدل طاغوت بآخر، ولا يزيح ظالم ليحل محله ثم يمارس نهجه، ابدا، لانه بهذه الحال سوف لن يكون ممن (يجاهد) منتظرا اليوم الموعود، وانما يمارس العبث بهذه الطريقة التي لا تنتج حلا ولا تقدم بديلا صالحا وسليما ابدا.
هذا على صعيد الانسان ــ المجتمع، اما على صعيد الانسان ــ الفرد، فينبغي لمن يؤمن بفلسفة (الانتظار) ان يكون في جهاد دائب من اجل تغيير الذات اولا، وهو الذي يسميه حديث رسول الله (ص) بالجهاد الاكبر، لانه اصعب بكثير من الجهاد الاصغر، جهاد العدو، لما يعتري هذا الجهاد من معوقات كثيرة كما وصفها الشاعر في قوله:
نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي
انها بالفعل تحد عظيم يواجهه المرء وهو يمارس الجهاد الاكبر، من اجل تغيير الذات، ولطالما سمعنا وقرانا عن قصص الذي سقطوا في اول امتحان تحدي بعد عمر مديد قضوه بالطاعات والعبادات، فقد نقل لي ثقاة انهم كانوا يتمنون ان يصلوا جماعة خلف احدهم لشدة تقواه وقوة ايمانه ايام كان يقيم في العاصمة البريطانية لندن، حتى اذا دار الفلك واستوزر في الحكومة التي خلفت نظام الطاغية الذليل، اذا به يتحول الى لص منحرف يسرق قوت الفقراء ويتجاوز على المال العام، وهو عادة لا ينسى ان يتوضأ قبل ان يسرق، ليحلل (لقمة الحرام).
ان مثله يشبه حال قول الشاعر:
صلى وصام لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر لا صلى ولا صاما
والتاريخ ملئ بمثل هذه النماذج التي اشبهها بابن آوى الذي قرر يوما ان يتوب الى الله تعالى فلا يعتدي على الدجاج ولا ياكلها ظلما وعدوانا، حتى اذا جاءته احداها سال لعابه فهجم عليها لياكلها وعندما سالته عن توبته واين حل بها الدهر، اجابها بالقول: ساتوب بعد ان اشبع معدتي، او لم يقل قائد جيش بني امية عمر بن سعد الذي خرج لقتال السبط الشهيد في كربلاء في عاشوراء عام 61 للهجرة عندما ذكره بعضهم بحقيقة سيد شباب اهل الجنة سبط رسول الله (ص) الامام الحسين بن علي بن ابي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله:
يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين
فان صدقوا مما يقولون انني اتوب الى الرحمن من سنتين
ان (الانتظار) بمفهوم الجهاد هو الذي يبعث كل هذه الروح الثورية التي يشهدها اليوم العالم العربي، بعد طول سبات وخضوع وخنوع للظالم والطاغوت.
انه هو الذي اسقط كل النظريات الزائفة مثل (عدم جواز الخروج على السلطان مهما انحرف او كان ظالما) ونظرية (عبادة الطاغوت الذي يمثل ظل الله في الارض) او طاعته لانه ولي الامر مهما فعل من منكرات ومظالم بحق الناس، او نظرية تاليه الحاكم، او ما اشبه من النظريات الزائفة التي شرعنتها فتاوى البلاط الاموي منذ قرون، ثم اصلتها، في العصر الحديث، فتاوى البلاط السعودي الفاسد، واشباهه.
اللهم عجل بظهور الامام (ع) واجعلنا من انصاره واعوانه، ومن المستعدين ليوم لقائه.
نزار حيدر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
حالتان متناقضتان (المذهبية والطائفية) مظاهرهما وعلل الانحراف

والصلاة على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين وبعد،
فإن الدارس لتاريخ العلاقة بين علماء المذاهب يلمح ظاهرتين متناقضتين إحداهما هي (التنوع المذهبي) وتستمد جذورها من روح الاسلام وعقلانيته ومنحه حرية الاجتهاد ووضعه قواعد الحوار وتاكيده على الأصول العامة للدخول في نطاق الأمة وكذلك تركيزه على روح الاخوة والوحدة،
والثانية هي (الطائفية) وهي تتنافى مع اصول الاسلام وقواعده.
امثلة من مظاهر التعامل المذهبي الإيجابي
ورغم احتدام الخلاف الفكري بين العلماء من اتباع المذاهب فاننا نلاحظ في كثير من الأحيان علاقات صفاء ومحبة وتمازج الى حد كبير بحيث يدرس بعضهم على بعض، ويدرّس البعض فقه المذاهب الأخرى، وينقل مناهجهم الى مذهبه ويطلب بعضهم الإجازة من البعض الآخر. وهناك مجموعة رائعة من كتب الفقه المقارن، ونقل رائع لآراء الآخرين.
ومما روي عن الشيخ الصدوق أنه كان يجوب البلدان ويجلس الى العلماء مهما كان مذهبهم ومنهم الحاكم ابو محمد بكر بن علي الحنفي الشاشي( [1])
وابو محمد محمد بن ابي عبدالله الشافعي الفرغاني( [2])
وكان التعامل يتم عبر مجالات عديدة كالتعليم والدراسة والحوار والاستفادة المتبادلة من المصادر والبحوث ونقد الآراء والتزاور والجلسات التي تتم في المناسبات.
ففي مجال التعلم نجد كتب الفريقين متبادلة في الجامعات العلمية والحوزات تستفيد منها دون ان تسأل عن مذهب الكاتب ويشمل هذا مختلف العلوم كالنحو والفقه واصول الفقه والحديث بطرقه المختلفة:
(السماح والقراءة او العرض، والإجازة والمناولة والمكاتبة والوصية والوجادة).
ولقد كان شيخ الشيعة ببغداد (الشيخ المفيد) يحاور العلماء من شتى المذاهب الاسلامية ويجالسهم( [3]) وكان يحرص على التعليم – حيث يقول الذهبي: وإن كان ليدور على المكاتب وحوانيت الحاكمة فيلمح الصبي الفطن فيذهب الى أبيه وأمه حتى يستأجره ثم يعلمه، وبذلك كثر تلامذته. ( [4])
ولقد جاء كتاب الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي «المتوفى سنة 460هـ» أروع مثال على ذلك وقد نقل بكل أمانة آراء المذاهب الأخرى وبالتفصيل ومنها آراء المذهب الشافعي الى الحد الذي ظن السبكي معه انه من علماء المذهب الشافعي وذكره في طبقاتهم رغم اعترافه بأنه فقيه الشيعة ومصنفهم ولكنه يقول عنه (كان ينتمي الى مذهب الشافعي). ( [5])
وكان الشيخ يعتمد على ما روي في مصنفات أهل السنة اذا لم يجد ما يعتمد عليه في مصنفات الشيعة تبعاً لرواية عن الصادق(ع) تقول: (اذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها في ما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن علي(ع) فاعملوا به). ( [6])
وهذه ظاهرة رائعة نلمحها في بعض العلماء فتعبر لنا عن امتزاج عجيب بين المذاهب، وقد عبروا عن ابن الفوطي (توفي 723) وهو صاحب (معجم الالقاب) وكان قيماً على أعظم مكتبة في عصره - عبروا عنه بأنه كان شيعياً حنبلياً. كما ذكر الشيخ وهبة الزحيلي( [7]) بان الطوفي المعروف بدفاعه الشديد عن أصل (المصالح المرسلة) هو من غلاة الشيعة متبعاً في ذلك ابن رجب الذي عده من علمائهم، في حين أن الطوفي كان من علماء الحنابلة في القرن الثامن. ( [8]) ودفاعه عن هذا (الاصل) الذي يرفضه الشيعة، وعدم ذكره في فهارس علماء الشيعة يؤيدان كونه حنبلياً.
وهذا محمد ابن أبي بكر السكاكيني العالم الشيعي المعروف كان كل مشايخه من أهل السنة. وقد خرّج له ابن الفخر علاء الدين ابن تيمية (المتوفي سنة 701) ما رواه عن شيوخه وناظره وشهد له بالتفوق وقال عنه : (هو من يتشيع به السني ويتسنن به الرافضي) وقد نسخ صحيح البخاري بيده، وهو صاحب القصيدة المعروفة ومطلعها:
أيا معشر الاسلام ذمي دينكم تحير دلّوه بأوضح حجة
وهو صاحب (الطرائف في معرفة الطوائف) الذي مزقه السبكي وأحرقه.
ولو رجعنا الى كتب طبقات الحنابلة لرأينا التقارب العجيب فهذا المحبي كبير السنة في دمشق يمدح البهاء العاملي عالم الشيعة المعروف فيقول عنه (كما في خلاصة الأثر): وهو أحق من كل حقيق بذكر أخباره ونشر مزاياه، واتحاف العالم بفضائله وبدائعه، وكان امة مستقلة في الأخذ بأطراف العلوم والتضلع بدقائق الفنون، وما أظن الزمان سمح بمثله ولا جاد بنده وبالجملة فلم تشنف الاسماع بأعجب من أخباره.
وقد ذكر الخطيب البغدادي أن سيرة سلف السنة هو الأخذ بروايات الثقات من الشيعة.( [9])
ومن العروف ان الشيخ الطوسي كان له مشايخ من أهل السنة ومنهم: ابو الحسن بن سوار المغربي، ومحمد بن سنان والقاضي ابو القاسم التنوخي( [10]) وعده صاحب (الرياض) من الشيعة.
وعندما ندرس اوضاع حوزة الحلة التي ازدهرت بعد القضاء على حوزة بغداد من قبل السلاجقة نجد مجالاً رحباً للتسامح.
فهذا الشيخ ابن ادريس يدرس على مجموعة من علماء اهل السنة( [11])، وهذا المحقق الحلي يؤلف كتاب (المعتبر) ويذكر فيه آراء المذاهب بل ويستخدم نفس اسلوبهم في الاستدلال، ثم نجد تلميذه العلامة الحلي المؤلف الكبير يستجيز الكثير من علمائهم ويعتبر عصره من أروع عصور التعامل الايجابي، وهو يقول في مقدمة كتابه (منتهى المطلب) أنه يذكر مذاهب المخالفين مع حججهم على وجه التحقيق. ( [12]) وله اساتذة من علماء اهل السنة ذكروا في مقدمة كتابه (ارشاد الأذهان).
هذا ويعتبر الشهيد الأول من خريجي هذه المدرسة.
ويعتبر الشهيد الاول وهو محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني، من علماء القرن الثامن، والشهيد الثاني وهو زين الدين بن علي العاملي الجبعي من علماء القرن العاشر، يعتبران مثلين رائعين من أمثلة الانفتاح والتمازج الفكري بين العلماء رغم أنهما كانا نموذجين بارزين من أمثلة ما يؤدي اليه التطرف المذهبي من نتائج فجيعة.
فهذا الشهيد الاول يعيش مع علماء عصره، وكان مجلسه لا«يخلو غالباً من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم»( [13])، وقد قال في بعض اجازاته (أنه يروي عن نحو أربعين شيخاً منهم)( [14]) وهي إجازته لابن الخازن حيث جاء فيها (فاني أروي عن نحو اربعين شيخاً من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس، ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة بسندهم الى البخاري، وكذا صحيح مسلم ومسند ابي داوود وجامع الترمذي... الى غير ذلك مما لو ذكرته لطال الخطب، وقرأت الشاطبية على جماعة منهم قاضي قضاة مصر.. بن جماعة».( [15]) والجميل أن نجد شمس الأئمة الكرماني الشافعي – وهو احد شيوخه يصفه بـ (المولى الأعظم الأعلم إمام الأئمة صاحب الفضلين مجمع المناقب..) ( [16])
وكان (ره) كما يقول المرحوم صاحب الرياض: «يشتغل بتدريس كتب المخالفين ويقرئهم».( [17])
وكان يرى أنه لو كانت هناك صلاتان للجماعة احداهما للشيعة والأخرى للسنة فان حضور الثانية افضل لأنه روي عنهم(ع)( [18]) من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فيه»، قال: ويتأكد مع المجاورة. ( [19])
وهذا الشهيد الثاني كان يذكر الصحابة بكل احترام فهو يقول: «ورجعت الى وطني الاول بعد قضاء الواجب من الحج والعمرة والتمتع بزيارة النبي وآله واصحابه صلوات الله عليهم...» ( [20]).
وقد اجتمع الى جملة من علماء السنة؛ ففي سفره الى مصر اجتمع مع «الشيخ الفاضل شمس الدين بن طولون الدمشقي وقرأ عليه جملة من الصحيحين في الصالحية بالمدرسة السليمية واجيز منه بروايتهما... ثم سافر الى بيت المقدس في ذي الحجة (948هـ) واجتمع بالشيخ شمس الدين بن ابي اللطيف المقدسي وقرأ عليه بعض صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم وأجازه إجازة عامة ثم رجع الى وطنه واشتغل بمطالعة العلوم ومذاكرته مستفرغا وسعه وفي سنة 952هـ سافر الى الروم ودخل القسطنطينية في 17 ربيع الاول ولم يجتمع مع احد من الأعيان الى ثمانية عشر يوماً وكتب في خلالها رسالة في عشرة مباحث من عشرة علوم وأوصلها الى قاضي العسكر محمد بن محمد بن قاضي زاده الرومي فوقعت منه موقعاً حسنا وكان رجلاً فاضلاً واتفق بينهما مباحثات في مسائل كثيرة... واجتمع فيها بالسيد عبدالرحيم العباسي صاحب معاهد التنصيص وأخذ منه شطراً ... وأقام ببعلبك يدرس في المذاهب الخمسة واشتهر أمره وصار مرجع الأنام ومفتي كل فرقة بما يوافق مذهبها...» ( [21]) ورحل الى مصر وقرأ بها على ستة عشر رجلاً من أكابر علمائهم وقد ذكرهم مفصلاً، ويبدو أنه استجازهم وروى كتبهم ويقول صاحب رياض العلماء «ويظهر منه ومن إجازة الشيخ حسن وإجازات والده أنه قرأ على جماعة كثيرين جداً من علماء العامة، وقرأ عندهم كثيراً من كتبهم في الفقه والحديث والاصول وغير ذلك، وروى جميع كتبهم وكذلك فعل الشهيد الأول والعلامة».( [22])
وذكر هو بعض هؤلاء:
من قبيل الشيخ زين الدين الجرمي المالكي
والشيخ ناصر الدين اللقاني
والشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي
والشيخ شمس الدين محمد بن ابي النحاس
وقال ابن العودي تلميذه: كثيراً ما كان ينعت هذا الشيخ يعني ابن ابي النحاس بالصلاح وحسن الأخلاق والتواضع. ( [23])
والحديث مفصل في هذا المجال.
وكأن هذا المسلك لم يرق لبعض العلماء وخصوصا للاخباريين منهم فابدوا عدم رضاهم به( [24]) وقد اتهمه البعض بالميل الى التسنن. ( [25])
وربما جاء الاتهام لأنه (رحمه الله) قام بعمل فريد اذ اعتمد منهج اهل السنة في علم الدراية وطبقه في المجال الشيعي؛ يقول صاحب الرياض: «ثم اعلم أن الشيخ زين الدين هذا هو أول من نقل علم الدراية من كتب العامة وطريقتهم الى كتب الخاصة، وألف فيه الرسالة المشهورة ثم شرحها كما صرح به جماعة ممن تأخر عنه، ويلوح من كتب الأصحاب ايضاً، ثم الف بعده تلميذه الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي وبعده ولده الشيخ البهائي وهكذا... ( [26])
وهنا يقول العلامة الامين: «والعلامة والشهيدان أجل قدراً من أن يقلدوا أحدا في مثل هذه المسائل او تقودهم قراءة كتب غيرهم الى اتباع ما فيها بدون برهان وهم رؤساء المذهب ومؤسسوا قواعده وبهم اقتدى فيه أهله ومنهم أخذوه، وإنما أخذوا اصطلاحات العامة ووضعوها لأحاديثهم غيرة على المذهب لما لم يروا مانعاً من ذلك، وكذلك فعلوا في أصول الفقه وفي الإجماع وغيره كما بين في محله وكذلك في فن الدراية وغيره «وكيف يكون عدم رضا الشيخ حسن بما فعلوا لهذه العلة وهو قد تبعهم وزاد عليهم».( [27])
وهكذا نجد التعامل الايجابي البناء بين القادة:
- احترام يصل إلى حد التكريم الرفيع.
- وعبارات المودة والمحبة سائدة رغم النقد العلمي احياناً،
- وانبهار واحترام يفوق الوصف،
- وعلماء الفريقين يشرح بعضهم كتاب الآخر
- وإرجاع من امام إلى امام،
- وتدريس البعض وافتاؤه الناس بالمذهب الآخر،
- واعتراف بالفضل والعلم بأروع التعابير،
- وإلحاح على التعلم رغم الوضع السياسي الحرج،
- واستجازة البعض من البعض الآخر ورواية كتبه،
- واخيراً عدم إلاصرار على الراي، ورد للمنقول عنهم اذا لم يوافق الكتاب والسنة.
- وامتزاج الى حد عدم تبين المذهب لدى البعض،
- وحرية في الاجتهاد وقبول بالتعددية وانفتاح على الآخر،
- ونقل المنهج العلمي لدى الآخر الى علوم المذهب،
فهل يا ترى تقتضي العقلانية غير ذلك؟ وهل احتفظ اتباع الأئمة بمثل هذه الروح بعد ذلك؟!
وصايا إلى الاتباع
وازاء هذا التعامل الجميل بين الأئمة نلاحظ الوصايا التي تترى منهم لاتباعهم، كي يتعاملوا بنفس الروح التسامحية، ويتجاوزوا الخلافات الفرعية في العقيدة والتقييم التاريخي والفقه إلى الموقف المبدئي والتحاب ووحدة الموقف، والتعالي إلى المستويات المصلحية العليا. فلنلاحظ بعض النصوص كما يلي:
1- ذكر التاريخ ان عبدالله بن احمد بن حنبل روى ان قوماً من الكرخيين ذكروا خلافة الخلفاء الراشدين (وربما تنازعوا فيما بينهم) فقال: الامام احمد ناهياً اياهم عن هذه النـزاعات الجانبية العقيمة:
«يا هؤلاء أكثرتم القول في علي والخلافة، والخلافة وعلي؛ إن الخلافة لم تزين علياً، بل علي زينها»( [28]).
2- وقد طرد الشيخ الحسين بن روح - أحد النواب الاربعة للامام الثاني عشر المهدي(ع) - خادماً له لأنه سمعه يهين معاوية( [29]).
3- واوصى الامام الصادق اصحابه فقال لهم: صلوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وادوا حقوقهم، فان الرجل منكم اذا ورع في دينه، وصدق الحديث وادى الامانة، وحسن خلقه مع الناس وقيل هذا جعفري، يسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر»( [30]).
4- روى ابن ابي يعفور قال: سمعت الصادق يقول: «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع»( [31]).
5- تذكر لنا الروايات أنه جرى ذكر قوم عند الامام الصادق فقال بعض شيعته: انا لنبرأ منهم، انهم لا يقولون ما نقول، فقال الامام: «يتولونا ولا يقولون ما تقولون، تبرأون منهم»؟ فاجاب الراوي: نعم، قال: «هو ذا عندنا ماليس عندكم، فينبغي لنا ان نبرأ منكم»( [32]).
6- وعن الصادق: «من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه»( [33]).
7- وعن الباقر(ع) في قوله تعالى: (أو يلبسكم شيعاً)، قال: «وهو اختلاف في الدين وطعن بعضكم على بعض»( [34]).
8- وقال الصادق: «عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، واقامة الشهادة، وحضور الجنائز، انه لابد لكم من الناس، ان احداً لا يستغني عن الناس في حياته، والناس لابد لبعضهم من بعض»( [35]).
9- معاوية بن وهب قال: قلت له (اي الصادق) كيف ينبغي ان نصنع فيما بيننا وبين قومنا، وبين خلطائنا من الناس، ومن ليسوا على أمرنا؟ فقال: «تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون الامانة اليهم»( [36]).
10- وقال الصادق(ع): «رحم الله عبداً اجترّ مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون، وترك ما ينكرون»( [37]).
11- وقال زين العابدين(ع): «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن العصبية ان يعين قومه على الظلم»( [38]).
وهكذا نجد الأئمة يؤكدون على العلاقات الحسنة، والتعامل الايجابي، وعدم الغرق في نزاعات غير عملية، وعدم الاساءة والاهانة، والدخول في قلب العمل الاجتماعي، وعدم الاعتزال نتيجة الايمان برأي يخالف الأكثرية من الناس، والسعي للتأدب بأدب الأئمة، وعدم الغرور العلمي، وعدم جعل الاختلاف في الراي سبيلاً للتدابر، والدخول في جماعة المسلمين، واجتناب العصبية واجترار حب الناس وامثال ذلك.
من مظاهر الحالة الطائفية اللاعقلانية
نعم لم تستمر تلك الحالة النيرة كثيراً، فسرعان ما ساد التعصب والانغلاق، وتقليد المجتهدين لغيرهم «حتى آل بهم التعصب إلى ان أحدهم إذا ورد عليه شيء من الكتاب والسنة على خلاف مذهبه يجتهد في دفعه بكل وسيلة من التأويلات البعيدة، نصرة لمذهبه ولقوله»( [39]).
ونقل الفخر الرازي عن اكبر شيوخه انه قال: قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في بعض مسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوها، ولم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون الي كالمتعجب – يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها- ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من اهل الدنيا»( [40]).
وقد ذكر الشيخ أسد حيدر اقوالاً اخرى من هذا القبيل( [41]).وربما كان اغلاق الاجتهاد وحصر المذاهب نتيجة وعاملاً على المزيد من ذلك.
ولم يقتصر الامر على هذا الحد، وانما انتقل إلى مرحلة نقل الصراع من مرحلة (الخطأ والصواب) إلى مستوى (الكفر والايمان)، الأمر الذي نقل الخلاف إلى الجماهير العريضة، وتسبب في كوارث يشيب لها الوليد.
واشتد الهجوم على العلوم العقلية والمتعاطين بها سواء بين الشيعة( [42]). او السنة( [43]).
وراحت التهم تطال المذاهب والآراء فتصفها بالهالكة، وانها مجوس الامة وامثال ذلك، وزاد الخلاف على الفرعيات والانشغال بها وهكذا( [44]).
وزاد تدخل الحكام (وكانت البلاد قد تحولت إلى اقطاعيات كبيرة) الطين بلة (ومع كل جائحة من عداوة وغضب، اسرفت تهم النبذ والتحريم والتكفير والرمي بالباطل ضد الآخر مقدمة للقتل واحراق الممتلكات واتلاف كتب أصحاب المذاهب ومؤلفات فقهائها ونشر الرعب والكراهية.
وفي تاريخ الجائحات تكررت همجية البطش مع كل سلطة جديدة مرة ضد الشيعة، ومرة ضد السنة... ( [45]).
وراح الفرد يحاسب على مذهبه؛ فعندما بنى السلاجقة المدرسة النظامية في قبال بناء الازهر من قبل الفاطميين اشترطوا ان يكون المدرسون والتلامذة شافعيين ولذا منعوا الفصيحي الاسترآبادي وهو تلميذ عبدالقاهر الجرجاني من التدريس رغم علمه الجم بالعربية( [46]) وأصدر شهاب الاسلام عبدالرزاق رئيس المدرسة النظامية بنيسابور أمراً بقتل الفتال النيسابوري صاحب (روضة الواعظين).
وعند استعراض عوامل جرأة التتار على مهاجمة المسلمين نجد أن النزاع بين الدولة الخوارزمية والدولة العباسية يشكل عاملاً مهماً بالاضافة لدور الصراع المذهبي الرهيب؛ يقول المؤرخ ابن ابي الحديد: «فانهم (اي التتار نزلوا عليها (اي على اصفهان) مراراً في سنة سبع وعشرين وستماءة وحاربهم اهلها وقتل من الفريقين مقتلة ولم يبلغوا منها غرضاً.
حتى اختلف اهل إصفهان في سنة ثلاث وثلاثين وستماءة وهم طائفتان حنفية وشافعية وبينهم حروب متصلة وعصبية ظاهرة.
فخرج قوم من اصحاب الشافعي الى من يجاورهم ويتاخمهم من ممالك التتار فقالوا لهم: اقصدوا هذا البلد حتى نسلّمه اليكم.. فنزلوا على اصفهان في سنة ثلاث وثلاثين (وستماءة) المذكورة وحصروها.
فاختلف سيفا الشافعية والحنفية في المدينة حتى قتل كثير منهم وفتحت المدينة؛ فتحها الشافعية على عهد بينهم وبين التتار أن يقتلوا الحنفية ويعفوا عن الشافعية، فلما دخلوا البلد بدأوا بالشافعية فقتلوهم قتلاً ذريعاً، ولم يقفوا مع العهد الذي عهدوه لهم ثم قتلوا الحنفية، ثم قتلوا سائر الناس وسبوا النساء وشقوا بطون الحبالى ونهبوا الأموال وصادروا الأغنياء ثم أضرموا النار فاحرقوا اصبهان حتى صارت تلولاً من الرماد( [47]) وهكذا دامت هذه النزاعات حتى ادت الى سقوط بغداد بعد زمن قصير.
وهذه النزاعات تقودنا الى تذكر نزاعات طائفية أخرى ادت الى تدخل الصليبين الذين صنعوا العجائب والفواجع في العالم الاسلامي.
يقول احد المؤرخين الغربيين لهذه الحروب: «على ان الضعف لم يلحق سوريا فحسب بسبب ما حدث من انفصالها عن جسم الامبراطورية السلجوقية، بل أيضاً بسبب ما انتابها من انقسامات في الداخل، وما تعرضت له من هجمات الخليفة الفاطمي بمصر من الخارج. ففي سنة 1095، تولى الاخوان، رضوان ودقاق، حكم حلب ودمشق على الترتيب، غير ان الحرب لم تلبث ان شبت بينهما، واشترك ياغي سيان امير انطاكية فيما وقع بينهما من المنازعات، ولم يتوقف رضوان وياغي سيان عن مهاجمة دقاق، الا حين بلغتهما الانباء باقتراب الصليبيين، فاسرع ياغي سيان إلى انطاكية، في خريف سنة 1097.
وفي تلك الاثناء لم يتوان الفاطميون في الافادة من هذه المنازعات. إذ ان انشقاقاً دينياً كبيراً، كان يفصل الخليفة الفاطمي في القاهرة، وزعيم المذهب الشيعي، عن الخليفة العباسي ببغداد، وزعيم المذهب السني. وهذا الاختلاف يجوز مقارنته، بما كان بين الكنيستين اليونانية واللاتينية من نزاع. بل انه يفوقه بما غلب عليه من طابع الاختلاف السياسي. وكيفما كان الأمر، فان هذا الاختلاف ادى إلى عرقلة حركة المسلمين مثلما ادى ما بين الكسيوس واللاتين من الحسد والحقد، إلى عرقلة حركة الحرب الصليبية. وادرك الامراء الصليبيون تمام الادراك، الفجوة التي تفصل بين خليفة القاهرة عن الامراء السنيين في سوريا، وسعوا عن طريق مبعوثيهم إلى ان يتصلوا بخليفة القاهرة، املا في ان يظفروا، بفضل مساعدته، ببيت المقدس، التي حكمها وقتذاك نيابة عن الترك سقمان ابن الامير ارتق( [48]). غير ان الخليفة (الفاطمي) رأى ان ينفرد بالعمل لنفسه، واستغل ما وقع بين امراء سوريا من حروب، وما اثاره زحف الصليبيين من الخوف والرعب، فاستولى على بيت المقدس (اغسطس سنة 1098) على الرغم من ان زعماء الحملة الصليبية لم يحرزوا شيئا من النجاح في استغلال ما وقع من منازعات بين المسلمين على النحو الذي يبتغونه، فالواقع ان ما اصابوه من النجاح، انما يرجع إلى حد كبير إلى هذه المنازعات»( [49]).
وكذلك لنا أن نقرأ قول ابن خلدون عن عهد المستعصم بالله «وكانت الفتنة ببغداد لاتزال متصلة بين الشيعة واهل السنة، وبين الحنابلة وسائر أهل المذاهب، وبين العيارين والدعار والمفسدين»( [50])
كما لنا ان نتذكر ان الصراع بين الصفويين والعثمانيين - وكل منهما يتمترس خلف خلفية مذهبية – دام اربعة قرون واورث الأمة خراباً ودماراً، واضعفها امام عدوها الغربي.
هناك نص للشيخ الطوفي من أئمة الحنابلة ذكره للاستدلال على مبدأ (المصالح المرسلة) مقدماً اياه على النصوص والاجماع، لأنه راى ان النصوص متعارضة، والاجتهادات متضاربة، والاحاديث الموضوعة كثيرة. وفي هذا السياق يذكر بعض انماط الصراع في تلك العصور فيقول:
«ان المالكية استقلت في المغرب، والحنفية بالمشرق، فلا يقار احد المذهبين احداً من غيره في بلاده الاعلى وجه ما. وحتى بلغنا أن اهل جيلان من الحنابلة اذا دخل اليهم حنفي قتلوه، وجعلوا ماله فيئاً، حكمهم في الكفار، وحتى بلغنا أن بعض بلاد ماوراء النهر من بلاد الحنفية كان فيه مسجد واحد للشافعية، وكان والي البلد يخرج كل يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق؟ فلم يزل كذلك، حتى اصبح يوماً وقد سد باب ذلك المسجد بالطين واللبن فاعجب الوالي ذلك»( [51]).
والتاريخ يحدثنا عن صور اخرى معبرة عن الحالة المزرية من التعامل الطائفي؛
من قبيل:
- هجوم الغوغاء على بيت الشيخ الطوسي واحراق مكتبته عام 449. ( [52])
- والهجوم على مساجد الشيعة عام 483 واتلاف الكتب فيها. ( [53])
- وحادثة منع دفن ابن جرير الطبري واتهامه بالالحاد مشهورة
- والاتهامات وانماط التكفير تزخر بها كتب التاريخ
والروايات الموضوعة التي تسفه المذاهب كثيرة.
عوامل الانحراف:
وبنظرة عامة نستطيع القول ان اهم العوامل التي نقلت الحالة المذهبية الى الحالة الطائفية هي:
أولاً: تآمر أعداء الأمة لخلق الظروف الملائمة لتمزيقها بشتى الأساليب من الدس والوضع والتحريك وخلق الفتن وهو تآمر مستمر على مر العصور ومنذ صدر الاسلام وحتى اليوم إذ نلاحظ الاستعمار الغربي يعمل خلال فترات الاحتلال وخصوصاً في الفترة التي احتل فيها العالم الاسلامي كله تقريباً، وقضى على آخر دولة اسلامية شمولية في الربع الاول من القرن الميلادي العشرين، لاحظنا انه اعتمد سياسة ثلاثية تستهدف:
1 ـ ابقاء الامة على تخلفها العلمي والاقتصادي والثقافي والتعليمي وغير ذلك.
2 ـ اشاعة الحالة العلمانية الغربية على الروح الاسلامية في العالم الاسلامي الى جانب تحريك النزعات القومية والعنصرية ولكن سرعان ما فشل مشروعه مما دعى بعض الكتاب المعاصرين لتسميته بـ«النصر سريع الزوال للعلمانية (1920 ـ 1970) »
3 ـ تمزيق العالم الاسلامي الى دول وشعوب متفرقة، وتحريك العنعنات المذهبية الجغرافية والقومية والعنصرية حتى التاريخية كل ذلك خوفا من هاجس الوحدة الاسلامية الذي يجري الحديث عنه والتخوف منه باستمرار من قبل القادة والمفكرين والكتاب الغربيين ويتم التنظير لصراع دائم مع العالم الاسلامي على اساسه تقول الكاتبة هانتر في مقدمة كتابها:
«قامت الرواية التي ألفها جون بوشان، وكان لايزال رائداً في إستخبارات الجيش البريطاني عام 1916، على فرضية قيام ثورة إسلامية، من شأنها، إذا ما اندلعت، أن تقلب مجرى الحرب العالمية الأولى في غير مصلحة القوات الحليفة.
كتب بوشان في روايته، العباءة الخضراء The Green Mantle: «الاسلام عقيدة قتالية، إذ لا يزال ذلك الشيخ يقف في المحراب حاملاً القرآن باليد والسيف المشهور في اليد الأخرى. فإذا افترضنا أن هناك أملاً بالخلاص يعيد الروح حتى إلى الفلاحين في المناطق النائية ويدغدغ أحلامهم بالجنة فماذا سيحدث يا صديقي؟ ستفتح جهنم أبوابها في هذه الأرجاء عما قريب. لدي تقارير من العلماء في كل مكان؛ صغار التجار في جنوب روسيا، وتجار الأحصنة في افغانستان والتجار التركمان، والحجاج في الطريق إلى مكة، والأشراف في شمال أفريقيا، ولابسي جلود الغنم من المغول، والفقراء الهندوس والتجار اليونانيين في الخليج، فضلا عن القناصل المحترمين الذين يستخدمون الشيفرة. هؤلاء جميعاً يجمعون في رواياتهم التي يرسلونها إلي على الأمر نفسه، أن الشرق في إنتظار إشارة إلهية».
بعد ذلك بنحو ثلاثة أرباع القرن، عبر المعلق السياسي الأميركي، تشارلز كراوثمر، عن مخاوف مماثلة عندما قال إن الولايات المتحدة تواجه خطرين جيوسياسيين محتملين، يتأتى احدهما من المنطقة نفسها التي ذكرها جون بوشان في روايته، فهو يتخذ «شكل عالم إسلامي متحد تحت راية أصولية على النمط الايراني تخوض صراعاً وجودياً ضد الغرب الكافر».( [54])
وهي من اهم النقاط التي ركز عليها المرحوم السيد جمال الدين في خطته العامة لتحقيق نهضة اسلامية كبرى.
وها نحن نشهد دور اليد الاجنبية الممتدة لتحرك النزاعات الطائفية في باكستان والعراق وافغانستان ولبنان وسائر البلاد التي يتعايش فيها اتباع المذاهب. وربما استخدمت وسائل الاعلام والاقلام والالسنة الماجورة لتحقيق الهدف.
ثانياً: المصالح الشخصية لبعض الزعماء والحكام.
وهو امر شهدناه في عصور الظلام الماضية، ونشهده اليوم ايضاً حيث يستغل البعض نفوذه ليثير البسطاء بل ربما بعض المنتسبين لاهل العلم لتحريك الإحن والنزاعات الطائفية.
يقول احد الكتاب المؤرخين واصفاً بعض حروب الطوائف بتحريك من السلطات الحاكمة:
«وكانت لا تمر سنة دون عنف بين ما وصف بفرق السنة وفرق الشيعة في سائر ارجاء المنطقة العربية الاسلامية فقد تولى الترك بانفسهم عام 249هـ عمليات القمع الطائفي ضد الشيعة... وكان اكثر الضحايا من منطقة (الشاكرية) ببغداد وبنتيجتها هوجم السجن المركزي واحرق احد الجسرين الواصلين بين جانبي الكرخ والرصافة».
ويستمر في الحديث عن دور حكومات الطوائف في تحريك الفتن في مصر، وعن الاقتتال الطائفي بعد قيام حركة الزنج في سواد جنوب العراق، وامتداد النزاع الى المدينة المنورة والى طبرستان، وتواصلت الى شمال افريقيا وهكذا. ( [55])
وهناك كتب كثيرة تتحدث عن هذه الظاهرة كمقدمة ابن خلدون وغيرها.
ويكفي ان نذكر بدور النزاع العثماني الصفوي في خلق الفتن الطائفية الداخلية واضعاف الامة الاسلامية مما جر بالتالي الى ان تفقد شوكتها وعزتها امام التحديات.
فلقد سيطرت الدولة العثمانية (1280 ـ 1924م) على الشام وأجزاء من العراق اضافة الى مناطق في شمال أفريقيا، وسيطرت الدولة الصفوية (1506 ـ 1734م) على ايران. وراحتا تتنافسان وتؤكدان هويتهما المذهبية.
مما أفرز نزاعاً طائفياً مقيتاً سببه نزاع المصالح ونهم الغزاة والقبائل والمستبدين لاالمذاهب، وشهدنا استعار موجة التكفير والقتل وإهانة المقدسات في كلا الطرفين.
ونحن إذ نشير الى هذا النزاع لاننكر الخدمات التي قدمتاها للحضارة الاسلامية ولكننا ننعى عليهما استخدام النزعات المذهبية لأغراض سياسية.
واذا كنا ننكر أي اكراه أو عنف للاجبار على تغيير المذهب فاننا ننكره على الطرفين معا وبمستوى واحد.
ثالثاً: التكفير
وتعد هذه الظاهرة من اهم العقبات بوجه التقريب. ورغم ان الاسلام وضح تماماً الحدود الفاصلة بين الكفر والايمان، وحددها بدقة فان هذه الحالة الغريبة حدثت بقوة.
فعن عبادة بن الصامت قال رسول الله (ص):
من شهد ان لا إله الا الله وحده لاشريك له وان محمداً عبده ورسوله وان عيسى عبدالله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
وفي رواية ادخله الله من ابواب الجنة الثمانية أيها شاء وروى الشيخان والترمذي: من شهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله حرم الله عليه النار. ( [56])
وروى سماعة عن الامام الصادق (ع) قوله:
الاسلام شهادة ان لا إله الا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. ( [57])
وربى القرآن الكريم الرسول الكريم(ص) اتباعه على التعامل العقلاني والحوار المنطقي والقبول بالتعددية الاجتهادية اذا كانت على اسس شرعية منضبطة.
الا ان هذه الظاهرة حدثت في ظل ظروف عصبية في مطلع الأمر كما في قضية الخوارج.
واني اعتقد أن أهم ما قاد لهذه الظاهرة هو ما يمكن تسميته بمؤاخذة الاخر بلوازم كلامه رغم ان هذا الآخر لا يؤمن بهذه الملازمة مطلقا.
فقديماً كفر الخوارج علياً عليه السلام معتقدين ان لازم موقفه من التحكيم كفره والعياذ بالله.
فقد ذكروا انه شك في نفسه حين قال للحكمين:
«انظرا فان كان معاوية احق بها فأثبتاه،وان كنت اولى بها فاثبتاني» فاذا هو شك في نفسه ولم يدر أهو أحق ام معاوية فنحن فيه أشد شكا».
ورد الامام عليهم بقوله: «فان ذلك لم يكن شكاً مني، ولكن انصفت في القول، قال الله تعالى: «وانا أواياكم لعلى هدى او في ضلال مبين».
ولم يكن ذلك شكاً وقد علم الله أن نبيه على الحق»( [58])
وبعد عصر الأئمة دبت هذه الحالة بوتيرة اوسع وذلك كما لاحظناه في الاختلاف حول (زيادة الصفات على الذات الالهية) و(التحسين والتقبيح العقليين) حيث رأى الطرفان المتنازعان ان الطرف الآخر يقوده رايه الى الكفر وهكذا نجد هذه الظاهرة في قضايا كثيرة من قبيل (التوسل) و(الشفاعة) و(البداء) وحتى في مثل (الاستحسان) و(القياس) و(المصالح المرسلة) وغيرها. في حين لواحتكم الجميع الى الحوار المنطقي لاكتشفوا على الاقل لدى الطرف الآخر ما يبرر له الايمان بهذه القضية او تلك وربما اكتشفوا ان النزاع لفظي لاحقيقة له.
وزاد الجهل والتعصب الطين بلة حيث يدخل في عملية الفتوى من ليس أهلا لها فيفتي بغير ما انزل الله. وهذا ما شهدناه بكل وضوح في الحركات التكفيرية في عصرنا مما ادى الى سفك الدماء البريئة على نطاق واسع باسم الدفاع عن الدين والامة وهما من هذه الحالة براء.
رابعاً: التشكيك في نوايا الداخلين في الحوار فانه لا يحقق الجو الهادىء المطلوب، ويدفع لنوع من التهرب او المماطلة او تلمس العثرات مما يمنع من تحقق النتيجة المطلوبة. وهذا ما شهدنا نظيره في عمليات الحوار بين اتباع الاديان نتيجة ما يحمله كل طرف من تراكمات ذهنية عن الآخر فالطرف المسيحي مثلا يحمل احقاده الصليبية وايحاءات المستشرقين بما يسمونه بـ(الهرطقة الاسلامية) وما يدور في نفسه من هواجس الصحوة الاسلامية التي تنافس مشروعه في السيطرة، في حين يحمل الطرف الاسلامي سوابق ذهنية كبيرة عن خدمة التبشير المسيحي للاستعمار على مدى قرون.
ولكن العمل الجاد والتوجه للتعليمات الاسلامية الهادية والداعية لحسن الظن في الاخ المسلم يمنع من أن يلعب هذا العامل دوره في المنع من التقريب خصوصا اذا تم على مستوى العلماء العاملين الذين خبر بعضهم بعضا في مجالات العلم والاخلاص والعمل في سبيل الامة بمجموعها.
خامساً: التهويل والتضخيم واستحضار الماضي والتهجم على المقدسات وعدم احترام الآخر.
وكل واحد من هذه الامور يمكن ان يشكل بنفسه مانعاً من تحقق الحوار المطلوب وبالتالي الوصول الى التقريب، وقد وجدنا النصوص الاسلامية تتظافر في المنع من هذه الامور:
فقوله تعالى: «قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة»( [59]) يمنع من الحوار في الاجواء الانفعاليةالمصطنعة.
وقوله تعالى: «قل لا تسألون عما أجرمنا ولانسأل عما تعملون»( [60]) يمنع من الانشغال بالماضي ويفرض احترام الآخر وذلك ايضا واضح في الآية التي تنهى حتى عن سب آلهة المشركين.
سادساً: اضف الى كل ذلك ان اختلاف مناهج الاستدلال وطرق الاستنباط يمنع من التقارب في النتائج فينبغي السعي الى ما يأتي:
1 ـ الفراغ من المفروضات المسبقة قبل بدء عملية الحوار
2 ـ الاتفاق على منهج واحد للاستنباط وليس هذا الاتفاق امراً صعباً.
3 ـ تحقيق محل الحوار بدقة لئلا ينظر كل طرف الى قضية ومفهوم لاينظر اليه الطرف الآخر.
وهناك موانع أخرى من قبيل
1 ـ اعتبار القول الشاذ علامة على المذهب كله.
2 ـ اخذ تصورات المذهب من اقوال خصومه.
3 ـ دخول من ليس اهلاً في عملية الحوار
4 ـ اتباع الاساليب الملتوية للظفر بالآخر
وغير ذلك مما لا يسعنا المجال للتعرض له ولكن يجب حذفه حتى نصل الى التقريب المطلوب بل الضرورة في عالمنا الملتهب.
محمد علي التسخيري
الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
________________________________________
الهوامش
[1] - معاني الأخبار للصدوق ص 43.
[2] - معاني الأخبار للصدوق ص 59.
[3] - التهذيب ج 17.
[4] - تاريخ الاسلام للذهبي ج9 ص 228.
[5] - طبقات الشافعية الكبرى للشيخ تاج الدين تقي الدين السبكي ج3 ص 51.
[6] - راجع عدة الأصول ج 1 ص 139 وقاموس الرجال ج1 ص 20.
[7] - في بحثه المقدم الى ندوة الفقه الاسلامي بمسقط (شعبان 1408هـ).
[8] - مصادر التشريع ص 80.
[9] - الكفاية في علم الرواية ص 125.
[10] - راجع (الاجازة الكبيرة) للعلامة الحلي.
[11] - موسوعة ابن ادريس تحقيق السيد الخرسان ج1 ص 53.
[12] - منتهي المطلب: المقدمة ص 4 طبعة مشهد.
[13] - اعيان الشيعة للسيد محسن العاملي ج 10 ص 62.
[14] - ن.م،وذكر ذلك في أمل الأمل ج 1 ص 103.
[15] - بحار الأنوار ج 107 ص 191.
[16] - ن.م ص 183.
[17] - رياض العلماء ج 5 ص 185.
[18] - الوسائل ج 5 ص 381.
[19] - الدروس الشرعية طبعة مجمع البحوث الاسلامية – مشهد ج 1 ص 163.
[20] - اعيان الشيعة ج 7 ص 150.
[21] - الكنى والالقاب ج 2 ص 382 - 383.
[22] - رياض العلماء ج، ص 365.
[23] - اعيان الشيعة ج 7 ص 149.
[24] - راجع مثلاً، أمل الأمل ج1 ص 90 ورياض العلماء ج 2 ص 365 ومعجم رجال الحديث ج 7 ص 378.
[25] - كما ذكر ذلك المحدث الجزائري في كتابه (الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللآلي) نقلاً عن بعض اولاد الشهيد الثاني «راجع مقال المحققين لكتاب (منية المريد)ص43».
[26] - رياض العلماء ج 2 ص 365.
[27] - اعيان الشيعة ج 7 ص 157.
[28] - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج 1 ص 109.
[29] - بحار الانوار، ج 51، ص 357.
[30] - عوالم الامام الصادق للبحراني، ج 2، ص 635.
[31] - الكافي ، ج 2، ص 105.
[32] - وسائل الشيعة، ج 16، ص 160.
[33] - بحار الانوار، ج 85، ص 13.
[34] - تفسير الميزان، ج 7، ص 149.
[35] - وسائل الشيعة، ج 12، ص 6.
[36] - وسائل الشيعة، ج 12، ص 6.
[37] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 471.
[38] - الكافي، ج 2، ص 308.
[39] - مختصر المؤمل لشهاب الدين ابي شامة، ص 14.
[40] - التفسير الكبير، ج 16، ص 31 في تفسير الآية 31، من سورة التوبة .
[41] - الامام الصادق والمذاهب الاربعة طبعة مجمع اهل البيت، ج 3، ص 192 .
[42] - راجع كتاب (المعالم الجديدة لعلم الاصول) للامام السيد محمد باقر الصدر .
[43] - راجع مقال الاستاذ الطويل في كتاب قضية الفلسفة، ص 211.
[44] - راجع كتاب (قصة الطوائف) للدكتور الانصاري، فصل الحقبة الطائفية، ص 185.
[45] - ن.م. ص 219.
[46] -معجم الادباء للحموي ج15 ص 67.
[47] - شرح نهج البلاعة لابي الحديد ج8 ص 237 طبعة بيروت.
[48] - حدث في وقت واحد المفاوضات والقتال اثناء الحرب الصليبية الأولى. وجرى ذلك أيضاً في الحرب الثالثة والحرب السادسة. ونلحظ ما قام به العلمانيون من نشاط في توجيه سير الحرب الصليبية. فعلى الرغم من ان هذه الحرب قامت على أساس ديني، فانها اتخذت في سيرها صفة دنيوية. ومن الأمور المتناقضة ان حملة دينية اسهمت في نمو الحافز الدنيوي، وهيأت للعلمانيين ان يفلتوا من ذلك الميل نحو التيوقراطية البابوية، وكان ذلك واضحاً في زمن بابوية جريجوري السابع.
أنظر حبشي: الحرب الصليبية الأولى. القاهرة 1958 ص 126- 127.
William of Tyre Trans. Krey. 1943. Vo.l.pp.223-224 .
[49] - المؤرخ إرنست بارگر في كتابه (الحروب الصليبية) الفصل الثالث ترجمة الدكتور الباز العريني وقد قدم له بمقدمة جيدة.
[50] - العبر وديوان المبتدأ والخبر ج32 ص 536.
[51] - رسالة الطوفي، ص 116.
[52] - المنتظم لابن الجوزي ج16 ص 16 سنة 449.
[53] - تاريخ الاسلام للذهبي ج10 ص 471.
[54] ـ مستقبل الاسلام والغرب. شيرين هنتر تعريب زينب شوربا ص 111.
[55] ـ قصة الطوائف للدكتور فاضل الانصاري ص 233.
[56] ـ ذكرتها الصحاح في اول ما ذكرته من روايات وجمعها صاحب جمع الفوائد في مطلع كتابه.
[57] ـ الكافي، ج2 ص 25.
[58] ـ الاحتجاج للعلامة الطبرسي ج1 ص444.
[59] ـ سبأ 46.
[60] ـ سبأ 25.