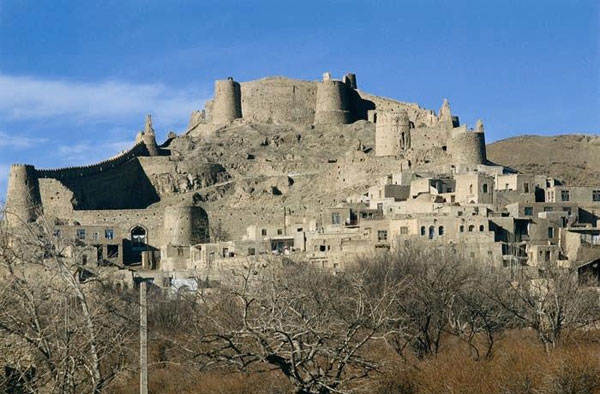Super User
الأبعاد السياسية لثورة الإمام الحسين(ع)
كان أول شيء اهتم به يزيد بن معاوية بعد أن تولى الخلافة من بعد أبيه هو فرض البيعة على الحرمين الشريفين، وكان الحرمان الشريفان يعتبران نقطتي الثقل السياسي في إعطاء الشرعية أو سلب الشرعية من مركز الخلافة في الشام، وأكثر ما كان يهم يزيد من أمر البيعة ثلاثة أشخاص: الإمام الحسين(ع) وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير.
رفض خيار البيعة:
فكتب إلى عامله على المدينة (الوليد بن عتبة) ليأخذ البيعة من الإمام(ع) فامتنع الحسين(ع) امتناعاً شديداً في قصة طويلة، يذكرها الطبري وابن الأعثم، وغيرهما من المؤرخين. فقد قال الحسين(ع) لمروان بن الحكم الذي كان حاضراً ذلك المجلس، وكان يحث الوليد ألا يترك الحسين حتى يأخذ البيعة في ذلك المجلس، وإلاّ فيضرب عنقه. فقال له الإمام الحسين(ع): (الويل لك يابن الزرقاء أتأمر بضرب عنقي، كذبت والله، والله لو رام ذلك أحد من الناس لسقيت الأرض من دمه قبل ذلك. فرم ضرب عنقي إن كنت صادقاً)([1]).
ثم أقبل الحسين(ع) على الوليد بن عتبة فقال: (أيها الأمير إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومحل الرحمة، بنا فتح الله، وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله)([2]).
وعندما خرج الحسين(ع) من عند الوليد، لامه مروان على ذلك لوماً شديداً فقال له عامل يزيد: (ويحك أتشير عليّ أن أقتل الحسين(ع)، والله ما يسرني أن لي الدنيا وما فيها، وما أحسب أن قاتله يلقى الله بدمه إلاّ خفيف الميزان يوم القيامة).
فقال له مروان مستهزئاً: (إن كنت إنما تركت ذلك لذلك فقد أصبت).
وقد كان موقف الإمام(ع) في الامتناع من البيعة ليزيد موقفاً واضحاً لا يشك فيه أحد، وكلمات الإمام في مواقف متعددة في مسيره من المدينة إلى كربلاء توضح هذه الحقيقة، يقول الإمام(ع) لمحمد بن الحنيفة (أخيه):
(يا أخي، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية أبداً)([3]).
وخطب الإمام(ع) يوم عاشوراء في جيش بني أمية فقال:
(إلا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت. من أن نؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام)([4]).
فلم يكن الإمام(ع) إذن ليبايع يزيد مهما يكن من أمر، ومن طرف آخر لم يكن يزيد ليترك الإمام(ع) من دون بيعة مهما تكن النتيجة.
وقد كان الإمام الحسين(ع) مؤمناً بهاتين القضيتين معاً، فلا سبيل إلى بيعة يزيد مهما يكن من أمر، ولا يمكن أن يتركه من دون بيعة أيضاً، وكانت النتيجة المترتبة على هذين الأمرين واضحة للإمام(ع) كل الوضوح لا يشك فيها لحظة واحدة.
وقال الإمام(ع) لأصحابه حينما أرادوا الخروج من الحجاز إلى العراق: (وأيم الله لو كُنتُ في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني)([5]).
ولما علم عبد الله بن جعفر أن الحسين(ع) يريد الخروج إلى العراق كتب إليه يدعوه إلى البقاء، فكتب إليه الحسين(ع): (والله يا بن عمي لو كنتُ في جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني حتى يقتلوني، والله يا بن عمي ليعتدنَّ عليَّ كما عدت اليهود في يوم السبت)([6]).
خيار الشهادة:
إذاً فلم يكن للإمام الحسين(ع) غير طريق واحد هو الشهادة... يزيد لا يقبل من الإمام إلاّ البيعة، وما دام الحسين(ع) لا يعطي البيعة ليزيد، مهما تكن الأسباب، فلا طريق للحسين(ع) إلاّ الشهادة، ولابد أن يكون الحسين(ع) مقدماً على الشهادة، حين خرج من الحجاز إلى العراق.
خيار العزلة:
وكان هناك طريق آخر ثالث، اقترحه عليه بعض الناصحين له، رفضه الإمام(ع) رفضاً قاطعاً، وهو أن يبتعد عن ساحة المعركة، ويعتزل الناس، ويذهب بعيداً إلى اليمن، أو إلى بعض شُعب الجبال، ويحتجب الناس فيكون قد حقق الغاية، وهو الامتناع عن البيعة ليزيد، دون أن يعرض نفسه وأهل بيته وأصحابه للأذى والهلاك من قبل يزيد وولاته وعمّاله، يقول ابن الأثير: «لما عزم الحسين(ع) على الخروج من الحجاز إلى العراق جاءه ابن عباس فقال:
(يا بن العم أني أتصبّر، ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال، إن أهل العراق قوم غدّر، فلا تقربنهم).
أقم في هذا البلد (مكة المكرمة) فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا، فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم ثم أقدم عليهم، فإن أبيت إلاّ أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بها حصوناً وشعوباً وهي أرض عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة»([7]).
وكان ممن يحمل هذا الرأي أخوه محمد بن الحنفية إذ جاء إلى الحسين(ع) لما عزم على مغادرة المدينة بأهل بيته، فقال له كما يروي ابن الأثير:
(يا أخي أنت أحب الناس إلي وأعزّهم عليّ، ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحقُ بها منك، تنح ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، وابعث رسلك إلى الناس... فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك وأن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك.. قال الحسين(ع): فأين أذهب؟ قال: أنزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فبسبيل ذلك، وإن نأت لحقت بالرمال وشعب الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنتظر إلى ما يصير أمر الناس)([8]).
وفي العراق اقترح الطرّماح بن عدي على الإمام(ع) أن يمتنع عن جيش يزيد بن معاوية بمعاقل طي المنيعة، فقال للإمام: (فإن أردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به، حتى ترى من رأيك وتستبين لك ما أنت صانع، فسر حتى أنزلك مناع جبلنا، الذي يدعى (أجا) امتنعنا والله به عن ملوك غسان، وحمير ومن النعمان بن المنذر، ومن الأسود والأحمر، والله إن دخل علينا ذل قط، فأسير معك حتى أنزل القرية).
إلاّ أن الإمام(ع) ردّ هؤلاء جميعاً من دون تردد، لا لأنه كان يشك في صدقهم ونصحهم له، ولا لأنهم كانوا موضع ارتياب وشك عند الإمام(ع)، ولكن لأن هؤلاء لم يكونوا يفهمون الإمام(ع) ورأيه وموقفه بالشكل الصحيح، فلم يكن همّ الإمام(ع) فقط أنه لا يبايع يزيداً، وألاّ يضع يده في يد ابن معاوية، ولو كان الإمام(ع) يكتفي بهذا الحد ما كلّفه ذلك كثيراً، فما كان أيسر على الإمام(ع) أن يعتزل الناس ويغادر الحجاز إلى بلد ناء من هذه البلاد النائية التي نصحه بها أخوه محمد وابن عمه عبد الله بن عباس، أو نصحه بها الطرماح بن عدي، إلاّ أن الإمام(ع) لم يكن يكتفي بهذا الموقف السلبي في أمر خلافة يزيد بن معاوية، ولم يكن هذا الموقف السلبي في رفض البيعة إلاّ وجهاً واحداً من وجهي الموقف.
أما الوجه الآخر وهو الأهم، والذي كلّف الإمام(ع) نفسه، وأهل بيته(ع) وأصحابه وشيعته، فهو إعلان هذا الرفض على الملأ من المسلمين.
وهذا الإعلان هو الذي أغضب بني أمية وأثارهم، فقد اعتبروه تحدياً صارخاً لسلطانهم، وحكمهم وشقاً لصفهم، وخروجاً على حكمهم وسلطانهم، ولم يكن بنو أمية يتحملون شيئاً من ذلك في أيام سطوتهم وسلطانهم وزهوهم.
وكان الإمام الحسين(ع) يتوخى من هذا الإعلان مطلباً سياسياً لم يكن يتحقق لولا إعلان الرفض، وهو إسقاط شرعية خلافة بني أمية في نظر العامة من المسلمين. فقد كانت الخلافة رغم كل السلبيات التي أحاطت بها إلى هذا الحين تتمتع بالشريعة في نظر الأكثرية من المسلمين، وتشل عمل ودور المعارضة، وتعطي للنظام الأموي قوة ومقاومة كبيرة.
وأخطر من هذا كله، إن هذه الشريعة كانت تمكن بني أمية من إدخال الانحرافات الجاهلية التي جاء بها بنو أمية معهم إلى الحكم إلى الإسلام، فيمس الخطر عند ذلك الإسلام وتكون مصيبة المسلمين مصيبتين:
مصيبة في حياتهم ونظام أمورهم، ومصيبة أخرى أكبر وأخطر في دينهم، وكانت هذه النقطة الثانية تشغل بال سيد الشهداء(ع) أكثر من أي شيء أخر، فقد بدأ هذا الانحراف يتسرب إلى الإسلام نفسه من داخل قصور بني أمية، مما يقترفون من لهو وفساد وظلم، وإلى هذه النقطة بالذات يشير الإمام(ع) في كلامه مع مروان بن الحكم صبيحة الليلة التي خرج فيها الإمام(ع) من بيت الوليد، رافضاً البيعة، حيث التقى مروان بالإمام في الطريق فنصح الإمام بالبيعة ليزيد، فقال الإمام(ع) لمروان: (على الإسلام السلام، إذ بليت الأمة، براع مثل يزيد ولقد سمعت جدي رسول الله(ص) يقول: (الخلافة محرمة على آل أبي سفيان)([9]).
إذن كان الإمام(ع) يخشى أكثر ما يخشى على الإسلام بالذات من أن يدخل عليه ما جاء به بنو أمية إلى الحكم من انحراف وفساد، وإذا كان لا يمكن إسقاط الخليفة وانتزاع السلطان منه، فإن من الممكن انتزاع الشيعة من الخلافة، وتجريد الحكم الأموي من الشرعية التي كان يحرص عليها حكام بني أمية.
ومثل هذا الأمر يتطلب موقفاً صريحاً معلناً في رفض البيعة، والامتناع عن قبول خلافة يزيد من جانب الإمام(ع) في وسط الرأي العام الإسلامي حينذاك، وهذا ما عمد إليه الحسين(ع) عندما رفض البيعة ورفض أن يخفي موقفه السلبي هذا، ويعتزل الوسط السياسي إلى بعض الشعاب والوديان والجبال، ليسلم بنفسه وأهل بيته وأصحابه من ملاحقة حكام بني أمية.
لقد كان الإمام(ع) يخطط ليجعل من موقفه هذا موقفاً سياسياً صارخاً، واحتجاجاً في وجه حكام بني أمية وإعلاناً لسحب الثقة والشرعية من حكام بني أمية وإعلام الأمة كلها بذلك.
وهذه بعض النماذج من كلمات الإمام(ع) ومواقفه الصريحة في هذا الصدد:
أولاً: غادر الإمام(ع) المدينة إلى مكة ليلاً بجميع أهله وسار على الجادة التي يسلكها الناس، فقال له ابن عمه مسلم بن عقيل: (لو عدلنا عن الطريق وسلكنا غير الجادة، كما فعل عبد الله بن الزبير كان عندي الرأي، فإنّا نخاف أن يلحقنا الطلب) فقال له الحسين(ع):
(لا والله يابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبداً أو أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى).
ثانياً: دخل الإمام(ع) مكة بصورة علنية متحدياً سلطان بني أمية، ويصف الخوارزمي نزول الحسين(ع) بمكة فيقول: (وكان قد نزل بأعلى مكة، وضرب هناك فسطاطاً ضخماً، ثم تحول الحسين(ع) إلى دار العباس، حوّله إليها عبدالله ابن عباس... فأقام الحسين(ع) مؤذناً يؤذن، رافعاً صوته، فيصلي بالناس) وتجمع الناس حول ابن بنت رسول الله(ص) في مكة اجتماعاً كبيراً، يقول ابن الأعثم: (دخل الحسين(ع) إلى مكة ففرح به أهلها، فرحاً شديداً، وجعلوا يختلفون إليه بكرة وعشيّاً، واشتد ذلك على عبد الله بن الزبير لأنه قد كان طمع أن يبايعه أهل مكة، فلما قدم الحسين(ع) شقّ ذلك عليه... لكنه كان يختلف إليه (إلى الحسين(ع)) ويصلّي بصلاته، ويقعد عنده ويسمع من حديثه، وهو مع ذلك يعلم أنه لا يبايعه أحد من أهل مكة، والحسين بن علي(ع) بها، لأن الحسين(ع) لأنه أعظم في أنفسهم من ابن الزبير)، وكان عمرو بن سعيد الأشدق يومئذٍ عامل يزيد على مكة، فهاب الحسين(ع)، وهرب إلى المدينة، وكتب إلى يزيد بأمر الحسين(ع): يقول الخوارزمي: (وهاب ابن سعيد أن يميل الحجاج مع الحسين(ع)، لما يرى من كثرة اختلاف الناس إليه من الآفاق، فانحدر إلى المدينة وكتب بذلك إلى يزيد).
ثالثاً: تتفق المصادر التاريخية: إن الحسين(ع) خرج من مكة إلى العراق يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، عندما كان الحجاج يتوجهون إلى عرفات استعداداً ليوم عرفة، وقد أثار خروج ابن بنت رسول الله(ص) يوم التروية من بين الحجاج إلى العراق انتباه عامة الحجاج الذين كانوا قد أمّوا البيت الحرام من مختلف الآفاق.
فهذا ابن بنت رسول الله(ص) يحل من العمرة ويغادر مكة في وقت يتوجه فيه الحجاج إلى عرفات لأداء الحج.
يقول سبط ابن الجوزي في التذكرة: ولم يبق بمكة إلا من حزن لمسيره، ولما كثروا عليه أنشد أبيات أخي الأوس:
سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهدً مسلما
وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبوراً وخالف مجرما
فإن عشت لم أندم، وإن مت لم أُلم كفى بك ذلاً أن تعيش فترغما([10]).
ثم قرأ «وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً». لا نحتاج إلى تأمل طويل لنكشف إن طريقة الحسين(ع) في الخروج من المدينة إلى المكة ثم مقامه في المكة، ثم مغادرته لها إلى العراق، كان بهدف التعبير والإعلان عن رفضه للبيعة، ولو كان الإمام(ع) يريد أن يتجنب البيعة فقط، دون تنبيه وإلفات الرأي العام الإسلامي لهذا الموقف السياسي لما احتاج إلى كل هذه الخطوات التي كلّفته وكلّفت أهل بيته وأصحابه كثيراً، وأثارت عليه سخط بني أمية وغضبهم.
ولقد كان بنو أمية يكتفون من الحسين(ع) في أغلب الظن أن يحتجب ويبتعد عن الرأي العام، ويخرج إلى ثغر بعيد من ثغور المسلمين، بعيداً عن الأجواء السياسية، لكن الحسين(ع) أبى أن يبايع إباءً قاطعاً، وأبى أن يخرج إلى ثغر من ثغور المسلمين، ويترك الساحة السياسية والاجتماعية ومسؤوليته الشرعية تجاه هذه الساحة.
وهناك نص يرويه الطبري عن عقبة بن سمعان بهذا الشأن، وعقبة هذا كان قد رافق الحسين(ع) من المدينة إلى كربلاء ولم يفته شيء من كلمات الإمام(ع) وإشاراته ومواقفه، يقول ابن سمعان: (صحبتُ حسيناً فخرجتُ معه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، ولم أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق، ولا بالعراق ولا في عسكر، إلى يوم مقتله، إلاّ وقد سمعتها)([11]).
لا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس، وما يزعمون، من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: (دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس)([12]).
ومن كلمات الإمام في كربلاء، أمام جيش ابن سعد: (لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد)([13]). فلا يعطيهم يده للبيعة، إعطاء الذليل، وهو الخيار الأول الذي تحدثنا عنه ولا فرار العبيد، وهو الخيار الثاني الذي اقترحه عليه بنو أمية، لإلغاء دوره، وتعطيل موقفه عن خبث ومكر، واقترحه عليه بعض الناصحين له عن عدم وعي.
الهوامش:
[1] ـ كلمات الإمام الحسين(ع) ص282.
[2] ـ بحار الأنوار 44: 324.
[3] ـ بحار الأنوار 44: 328.
[4] ـ تحف العقول ص58.
[5] ـ بحار الأنوار 45: 99.
[6] ـ مدينة المعاجز ج3 ص485.
[7] ـ تاريخ الطبري ج4 ص288.
[8] ـ بحار الأنوار 44: 326.
[9] ـ مجمع المسائل (فارسي) ج1 ص434.
[10] ـ بحار الأنوار 44: 192.
[11] ـ تاريخ الطبري ج4 ص313.
[12] ـ بحار الأنوار ج44 ص327.
[13] ـ البداية والنهاية ص194.
عاشوراء الحسين في فكر الإمام الـخميني (رحمه الله) والإمام الخامنئي (دام ظله الوارف)
الف - عاشوراء الحسين في فكر الإمام الـخميني (رحمه الله)
لقد قرأ الإمام الخميني (رحمه الله) ثورة عاشوراء بعين حسينية وهي قراءة تختلف نتائجها ومعطياتها عن بعض القراءات الثورية، ذلك لأنّ الإمام الخميني (رحمه الله) قد استخدم قراءته هذه في برمجة تحركاته الثورية وبما يناسب متطلبات الأمة لمواجهة كل المستجدات، حيث أدرك أن انطلاقته لا تتم إلا في إطار حسيني ودون ذلك لم تستطع الأمة من إعادة ذاتها وبرمجة إصلاحاتها.
ولقد فهم الإمام الخميني (رحمه الله) أنه من خلال معطيات ثورة الإمام الحسين(ع) تتبلور جميع الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكل العصور، ومن خلالها تنفتح آفاق الجهاد والكفاح لمواجهة أشرس هجمات الأعداء، فكان يقرأها قراءة تطبيقية، وكان يعي أن الأمة متى ما ذابت في ثورة الحسين(ع)، كانت حسينية، في فكرها، في تحركها، وفي نظراتها المستقبلية. ثم انتهج نهجاً آخر في تسليط الأضواء على ثورة عاشوراء ليترشّح من خلالها على الأمة عطاءات فكر الحسين(ع).
لقد كانت مفاهيم عاشوراء تفتح على الإمام الخميني (رحمه الله) بصيرة إسلامية خالصة، ليعرف الإسلام بصيغته المحمدية الأصيلة وأيضاً لقد أدرك الإمام الخميني(رحمه الله) الباطن السياسي العميق للظاهر الديني الذي دفع الحسين(ع) إلى كربلاء، كما أدرك أن عظم التضحيات يدفع الأمور إلى الذروة وأن الهدف المنشود لا يقاس بحجم الدماء أو الشهداء، ما دامت النهضة وجوباً في سبيل الإسلام وشهادة في فضح السلطة السياسية والدينية التي أوشكت القضاء على الدين بسبب الفساد الشخصي والاجتماعي الذي مارسه هؤلاء.
ولا يمكن أن نفهم هذا الـتأكيد على عاشوراء واستلهام دروسها من جانب الإمام الخميني(رحمه الله) إلا من خلال إدراكه لهذا الترابط العميق بين ظاهرها الديني وباطنها السياسي، بين النهضة في سبيل الإسلام، والنهضة في سبيل فضح السلطة وكشف زيفها، وهو لهذا يقول: (سيد الشهداء هو سر بقاء الإسلام)، ويقول أيضاً: (ولولا نهضة سيد الشهداء(ع) لما استطعنا تحقيق النصر في ثورتنا هذه)، ويشدد الإمام الخميني(رحمه الله) في معظم المناسبات التي التقى فيها العلماء والمبلّغين والمفكرين والأساتذة من داخل إيران وخارجها على أهمية عاشوراء والمجالس الحسينية ودورها في تحقيق الثورة ضدّ الشاه وفي ثبات الشباب الإيراني أثناء الحرب واندفاعه للتضحية والدفاع عن الإسلام.
ومن منطلق الفكر السياسي للإمام الخميني (رحمه الله) بالنسبة إلى نهضة عاشوراء وأخذ الإمام يحث العلماء والمبلغين أن يقوموا بدورهم الرّسالي في موسم محرم وصفر وكان يقول: (محرم وصفر هما اللذان حفظا الإسلام)، وينبغي لنا إحياء محرّم وصفر بذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام فبذكر مصائبهم بقي هذا الدين حياً حتى الآن، وكان يقول: (كل ما عندنا هو من محرم وصفر).
وفي إحدى جلساته ومحاضراته خاطب المبلغين والخطباء بقوله: (إن على المبلغين الأعزاء والعلماء الخطباء أن يبيّنوا للناس – خلال الاجتماعات والمجالس التي تعقد في شهري محرم وصفر – القضايا المعاصرة، أن يبيّنوا لهم القضايا السياسية والاجتماعية ويبيّنوا لهم تكليفهم في مثل هذا الوقت الذي نعاني فيه من كل هؤلاء الأعداء، وعليهم أن يفهّموا الناس أننا ما زلنا في منتصف الطريق وأن علينا الاستمرار في المسيرة حتى النهاية إن شاء الله).
ب- عاشوراء الإمام الحسين من وجهة نظر الإمام الخامنئي (دام ظله الوارف)
لقد تحدث وخطب سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله الوارف) في مناسبات مختلفة بالأخص محرم الحرام وصفر، حول نهضة الإمام الحسين(ع) وثورته وعللها وأهدافها ونتائجها، وهكذا تكلم حول أهمية إقامة مجالس عاشوراء ودورها التبليغي والتعليمي والتربوي في توعية الناس دينياً وسياسياً، فكان يحث الخطباء أن يركّزوا في خطاباتهم في مجالس عاشوراء على ثلاثة أمور:
الأولى: محبة أهل البيت(ع) وفضلهم ومقامهم ودورهم العلمي والجهادي.
الثانية: تبيين أسس وجذور ثورة الإمام الحسين(ع) وأهدافها الأصيلة والعبر المستوحاة منها.
الثالثة: التركيز على أمور تزيد من المعرفة الدينية والإيمانية للناس، والتأكيد على المواعظ والإرشادات.
وقد جاء الحث والتأكيد على هذه الأمور الثلاثة في خطبه التي ألقاها في محرم الحرام وسنختار مقتطفات من تلك الخطب.
يقول سماحته في الخطبة التي ألقاها في محرم الحرام سنة 1415هـ:
«أعتقد أنه من الضروري أن يتم التركيز في هذه المجالس على ثلاثة أمور مهمة هي:
أولاً: ينبغي التركيز في هذه المجالس على محبة أهل البيت(ع) وتعميق الرابطة العاطفية بين الناس وهذه العترة الطاهرة، لأنها ذات أهمية كبيرة لبناء الشخصية المسلمة الملتزمة.
ثانياً: لابدّ أن تتوضح الكثير من الأمور المرتبطة بهذه الواقعة للناس ويتم التركيز في هذه المجالس على أسس وجذور الثورة الحسينية وأهدافها الأصيلة وظروف وقوعها والعبر المستوحاة منها والدعوة إلى التأمل فيها وفي مراسمها المختلفة.
ثالثاً: ينبغي التركيز في هذه المجالس على أمور تزيد من المعرفة الدينية والإيمانية للناس، والتأكيد على المواعظ والإشارات المستوحاة من القرآن الكريم والسنة الشريفة وسيرة أهل البيت عليهم السلام لاسيما الإمام الحسين(ع)، والتركيز على الأحاديث والأخبار الصحيحة والحذر من الأحاديث والأخبار والروايات غير الصحيحة أو المشكوك بصحتها».
أما فيما يخص مجالس العزاء والمراسم التي تقام في هذه المناسبة الأليمة فإن لها فلسفة حقيقية أكّد عليها أئمتنا وعلماؤنا عبر التاريخ ودعوا المسلمين والموالين لأهل البيت(ع) إلى إقامتها بشكل مناسب وعدم الإفراط والتفريط في جوانب منها، وقد كان الإمام الراحل (رحمه الله) يؤكد دوماً على ضرورة إقامة المراسم الحسينية بالأساليب التقليدية الأصيلة التي تقرب الناس إلى الله جل وعلا وتبعدهم عن موارد الشبهة والإفراط في بعضها.
ويقول سماحته أيضاً: «إذن يجب رواية الأحاديث وقراءة الرثاء والمديح ولطم الصدور وبيان حادثة عاشوراء وأهداف الإمام الحسين(ع) عن طريق المحاضرات الغنية من خلال الإشارة إلى الكلمات الواردة عنه(ع) من قبيل: (إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر) أو قوله(ع): أيها الناس إن رسول(ص) قال: (من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخله)([1]) وقوله(ع): (فمن كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا) »([2]).
وفي إحدى الزيارات التي يزار بها الإمام الحسين(ع) في يوم الأربعين، هنالك عبارة غاية في المعنى وهي: (وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة) ولقد انطوت فلسفة التضحية التي قام بها الحسين بن علي(ع) في هذه العبارة، بما تحتويه من معنى ومفهوم راقٍ ومتقدم.
ويقول سماحته: (وهنا تبرز لنا مسألة هامة جداً ألا وهي مسألة التبليغ، ويا حبذا لو أنّ هؤلاء الطلبة الشباب وفضلاء الحوزات العلمية والمبلغين والوعّاظ وذاكري مناقب آل البيت(ع) استطاعوا يوماً أن يجعلوا من واقعة عاشوراء حربة ضد الظلمات المهيمنة على حياة البشرية ويزيلوا بهذا السيف الإلهي هذه الحجب ويكشفوا النقاب عن شمس الحقيقة المتجسدة بحكومة الإسلام وهي الحقيقة التي بانت في هذا الزمان ووقف الجميع على عظم مكنوناتها الإعجازية، هل هناك ما يمنع من الاعتقاد بأن بإمكان المبلغين والخطباء وعلماء الدين في كل عصر حمل سيف الحق ذي الفقار النبوي المولوي ضد الباطل).
الهوامش:
[1] ـ تحف العقول ص 505.
[2] ـ مثير الأحزان ص29.
إلى كل الشباب في البلدان الغربية
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى كل الشباب في البلدان الغربية
الأحداث المريرة التي ارتكبها الإرهاب الأعمى في فرنسا دفعتني مرة أخرى لمخاطبتكم. ويؤسفني أن توفر مثل هذه الأحداث أرضية الحوار، بيد أن الواقع هو أن القضايا المؤلمة إذا لم توفر الأرضية للتفكير بالحلول ولم تعط الفرصة لتبادل الأفكار، فستكون الخسارة مضاعفة. فمعاناة الإنسان، في أيّ مكان من العالم، محزنة بحد ذاتها لبني البشر. مشهد طفل في حالة نزع الروح أمام أحبائه، وأمّ تبدلت فرحة عائلتها إلى مأتم، وزوج يحمل جسد زوجته مسرعاً إلى ناحية ما، أو متفرّج لا يدري أنه سيشاهد بعد لحظات المقطع الأخير من مسرحية حياته، هذه ليست مشاهد لا تثير العواطف والمشاعر الإنسانية. كل من له نصيب من المحبة والإنسانية يتأثر ويتألم لمشاهدة هذه المناظر، سواء وقعت في فرنسا، أو في فلسطين والعراق ولبنان وسورية. ولا شك أن ملياراً ونصف المليار من المسلمين لهم نفس الشعور، وهم براء ومبغضون لمرتكبي هذه الفجائع ومسببيها. غير أن القضية هي أن آلام اليوم إذا لم تؤد إلى بناء غد أفضل وأكثر أمناً، فسوف تختزل لتكون مجرد ذكريات مُرّة عديمة الفائدة. إنني أؤمن أنكم أنتم الشباب وحدكم قادرون، باستلهام الدروس من محن اليوم، على أن تجدوا السبل الجديدة لبناء المستقبل، وتسدوا الطرق الخاطئة التي أوصلت الغرب إلى ما هو عليه الآن.
صحيح أن الإرهاب أصبح اليوم الهم والألم المشترك بيننا وبينكم، لكن من الضروري أن تعرفوا أن القلق وانعدام الأمن الذي جرّبتموه في الأحداث الأخيرة يختلف اختلافين أساسيين عن الآلآم التي تحملتها شعوب العراق واليمن وسورية وأفغانستان طوال سنين متتالية: أولاً إن العالم الإسلامي كان ضحية الإرهاب والعنف بأبعاد أوسع بكثير، وبحجم أضخم، ولفترة أطول بكثير. وثانياً إن هذا العنف كان للأسف مدعوماً على الدوام من قبل بعض القوى الكبرى بشكل مؤثر وبأساليب متنوعة. قلّ ما يوجد اليوم من لا علم له بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين وتقوية وتسليح القاعدة، وطالبان، وامتداداتهما المشؤومة. وإلى جانب هذا الدعم المباشر، نری حماة الإرهاب التكفيري العلنيون المعروفون كانوا دائماً في عداد حلفاء الغرب بالرغم من أن أنظمتهم أكثر الأنظمة السياسية تخلفاً، بينما تتعرض أكثر وأنصع الأفكار النابعة من الديمقراطيات الفاعلة في المنطقة إلى القمع بكل قسوة. والإزدواجية في تعامل الغرب مع حركة الصحوة في العالم الإسلامي هي نموذج بليغ للتناقض في السياسات الغربية.
الوجه الآخر لهذا التناقض يلاحظ في دعم إرهاب الدولة الذي ترتكبه إسرائيل. الشعب الفلسطيني المظلوم يعاني منذ أكثر من ستين عاماً من أسوء أنواع الإرهاب. إذا كانت الشعوب الأوربية اليوم تلوذ ببيوتها لعدة أيام وتتجنب التواجد في التجمعات والأماكن المزدحمة، فإن العائلة الفلسطينية لا تشعر بالأمن من آلة القتل والهدم الصهيونية منذ عشرات الأعوام، حتى وهي في بيتها. أيّ نوع من العنف يمكن مقارنته اليوم من حيث شدة القسوة ببناء الكيان الصهيوني للمستوطنات؟ إن هذا الكيان يدمر كل يوم بيوت الفلسطينيين ومزارعهم وبساتينهم من دون أن يتعرض أبداً لمؤاخذة جادة مؤثرة من قبل حلفائه المتنفذين، أو على الأقل من المنظمات الدولية التي تدعي استقلاليتها، من دون أن تتاح للفلسطينيين حتى فرصة نقل أثاثهم أو حصاد محاصيلهم الزراعية، ويحصل كل هذا في الغالب أمام الأعين المذعورة الدامعة للنساء والأطفال الذين يشهدون ضرب وإصابة أفراد عوائلهم، أو نقلهم في بعض الأحيان إلى مراكز التعذيب المرعبة. تری هل تعرفون في عالم اليوم قسوة بهذا الحجم والأبعاد وبهذا الاستمرار عبر الزمن؟ إمطار سيدة بالرصاص في وسط الشارع لمجرد الاعتراض على جندي مدجّج بالسلاح، إنْ لم يكن إرهاباً فما هو إذن؟ وهل من الصحيح أن لا تعدّ هذه البربرية تطرفاً لأنها ترتكب من قبل قوات شرطة حكومة محتلة؟ أو بما أن هذه الصور تكررت على شاشات التلفزة منذ ستين سنة، فإنها يجب أن لا تستفز ضمائرنا؟
الحملات العسكرية التي تعرض لها العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة، والتي تسببت في الكثير من الضحايا، هي نموذج آخر لمنطق الغرب المتناقض. البلدان التي تعرضت للهجمات ، فقدت بناها التحتية الاقتصادية والصناعية، وتعرضت مسيرتها نحو الرقي والتنمية إما للتوقف أو التباطؤ، وفي بعض الأحيان تراجعت لعشرات الأعوام فضلاً عن ما تحملته من خسائر إنسانية. ورغم كل هذا يطلب منهم بوقاحة أن لا يعتبروا أنفسهم مظلومين. كيف يمكن تحويل بلد إلى أنقاض وإحراق مدنه وقراه وتحويلها إلى رماد، ثم يقال لأهاليه لا تعتبروا أنفسكم مظلومين رجاء! أليس الأفضل الاعتذار بصدق بدل الدعوة إلى تعطيل الفهم أو نسيان الفجائع؟ إن الألم الذي تحمله العالم الإسلامي خلال هذه الأعوام من نفاق المهاجمين وسعيهم لتنزيه ساحتهم ليس بأقل من الخسائر المادية.
أيها الشباب الأعزاء، إنني آمل أن تغيروا أنتم في الحاضر أو المستقبل هذه العقلية الملوثة بالتزييف والخداع، العقلية التي تمتاز بإخفاء الأهداف البعيدة وتجميل الأغراض الخبيثة. أعتقد أن الخطوة الأولى في توفير الأمن والاستقرار هي إصلاح هذه الأفكار المنتجة للعنف. وطالما تسود المعايير المزدوجة على السياسة الغربية، وطالما يقسّم الإرهاب في أنظار حماته الأقوياء إلى أنواع حسنة وأخرى سيئة، وطالما يتم ترجيح مصالح الحكومات على القيم الإنسانية والأخلاقية، ينبغي عدم البحث عن جذور العنف في أماكن أخرى.
لقد ترسّخت للأسف هذه الجذور تدريجياً على مدى سنين طويلة في أعماق السياسات الثقافية للغرب أيضاً، وراحت تعِدّ لغزو ناعم صامت. الكثير من بلدان العالم تعتز بثقافاتها المحلية الوطنية، تلك الثقافات التي غذّت المجتمعات البشرية على نحو جيد طوال مئات الأعوام محافظه علی إزدهارها وإنجابها. والعالم الإسلامي ليس استثناء لهذه الحالة. ولكن العالم الغربي استخدم في الحقبة المعاصرة، أدوات متطورة مصرّاً على الاستنساخ والتطبيع الثقافي في العالم. إنني أعتبر فرض الثقافة الغربية على سائر الشعوب، واستصغار الثقافات المستقلة، عنفاً صامتاً وعظيم الضرر. ويتم إذلال الثقافات الغنية والإسائة لأكثر جوانبها حرمة، رغم أن الثقافة البديلة لا تستوعب أن تكون البديل لها على الإطلاق. وعلى سبيل المثال، إن عنصري «الصخب» و«التحلل الأخلاقي» اللذين تحوّلا للأسف إلى مكوّنين أصليين في الثقافة الغربية، هبطا بمكانتها ومدی قبولها حتى في موطن ظهورها. والسؤال الآن هو: هل هو ذنبنا نحن أننا نرفض ثقافة عدوانية متحللة بعيدة عن القيم؟ هل نحن مقصّرين إذا منعنا سيلاً مدمراً ينهال على شبابنا على شكل نتاجات شبه فنية مختلفة؟
إنني لا أنكر أهمية الأواصر الثقافية وقيمتها. وهذه الأواصر متى ما حصلت في ظروف طبيعية وشهدت احترام المجتمع المتلقي لها ستنتج التطور والإزدهار والإثراء. وفي المقابل فإن الأواصر غير المتناغمة والمفروضة ستعود فاشلة جالبة للخسائر. يجب أن أقول بمنتهى الأسف أن جماعات دنيئة مثل "داعش" هي ثمرة مثل هذه الصلات الفاشلة مع الثقافات الوافدة. فإذا كانت المشكلة عقيدية حقاً لوجب مشاهدة نظير هذه الظواهر في العالم الإسلامي قبل عصر الاستعمار أيضاً، في حين أن التاريخ يشهد بخلاف ذلك. التوثيقات التاريخية الأكيدة تدلّ بوضوح كيف أن التقاء الاستعمار بفكر متطرف منبوذ نشأ في كبد قبيلة بدوية، زرع بذور التطرف في هذه المنطقة. وإلّا كيف يمكن أن يخرج من واحدة من أكثر المدارس الدينية أخلاقاً وإنسانية في العالم ، والتي تعتبر وفق نسختها الأصلية أن قتل إنسان واحد يعدّ بمثابة قتل الإنسانية كلها، كيف يمكن أن يخرج منها زبلٌ مثل "داعش"؟
ومن جانب آخر ينبغي السؤال: لماذا ينجذب من وُلِد في أوربا وتربّى في تلك البيئة الفكرية والروحية إلى هذا النوع من الجماعات؟ هل يمكن التصديق بأن الأفراد ينقلبون فجأة بسفرة أو سفرتين إلى المناطق الحربية إلى متطرفين يمطرون أبناء وطنهم بالرصاص؟ وبالتأكيد علينا أن لاننسی تاثيرات التغذية الثقافية غير السليمة في بيئة ملوثة ومنتجة للعنف طوال سنوات عمر هولاء. ينبغي الوصول الی تحليل شامل في هذا الخصوص، تحليل يكشف النقاب عن الأدران الظاهرة والخفية في المجتمع. وربما كانت الكراهية العميقة التي زرعت في قلوب شرائح من المجتمعات الغربية طوال سنوات الازدهار الصناعي والاقتصادي، ونتيجة حالات عدم المساواة، وربما حالات التمييز القانونية والبنيوية، قد أوجدت عقداً تتفجّر بين الحين والآخر بهذه الأشكال المريضة.
على كل حال، أنتم الذين يجب أن تتجاوزوا الصور الظاهرية لمجتمعاتكم، وتجدوا مكامن العقد والأحقاد وتكافحوها. ينبغي ترميم الهوّات بدل تعميقها. الخطأ الكبير في محاربة الإرهاب هو القيام بردود الأفعال المتسرّعة التي تزيد من حالات القطيعة الموجودة. أية خطوة هياجية متسرعة تدفع المجتمع المسلم في أوربا وأمريكا، والمكوّن من ملايين الأفراد الناشطين المتحمّلين لمسؤولياتهم، نحو العزلة أو الخوف والاضطراب، وتحرمهم أكثر من السابق من حقوقهم الأساسية، وتقصيهم عن ساحة المجتمع، لن تعجز فقط عن حل المشكلة بل ستزيد المسافات الفاصلة وتكرّس الحزازات. التدابير السطحية والانفعالية، خصوصاً إذا شرعنت وأضفي عليها الطابع القانوني، لن تثمر سوى تكريس الاستقطابات القائمة وفتح الطريق أمام أزمات مستقبلية.
وفقاً لما وصل من أنباء، فقد سنّت في بعض البلدان الأوربية مقررات تدفع المواطنين للتجسس على المسلمين. هذه السلوكيات ظالمة، وكلنا يعلم أن الظلم يعود عكسيا شئنا أم أبينا. ثم إن المسلمين لا يستحقون هذا الجحود. العالم الغربي يعرف المسلمين جيداً منذ قرون. إذ يوم كان الغربيون ضيوفاً في دارالإسلام وامتدت أعينهم إلى ثروات أصحاب الدار، أو يوم كانوا مضيّفين وانتفعوا من أعمال المسلمين وأفكارهم، لم يلاقوا منهم في الغالب سوى المحبة والصبر. وعليه، فإنني أطلب منكم أيها الشباب أن ترسوا أسس تعامل صحيح وشريف مع العالم الإسلامي، قائم على ركائز معرفة صحيحة عميقة، ومن منطلق الاستفادة من التجارب المريرة. في هذه الحالة ستجدون في مستقبل غير بعيد أن البناء الذي شيّدتموه على هذه الأسس يمدّ ظلال الثقة والاعتماد على رؤوس بُناته، ويهديهم الأمن والطمأنينة، ويشرق بأنوار الأمل بمستقبل زاهر على أرض المعمورة.
السيد علي الخامنئي
29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015
الدرس الثامن: عقيدة الشيعة الإمامية في النبوة
إذا كانت بعض الإفتراءات على الشيعة قيلت ثم ماتت واندثرت، وبعضها قيلت ولكنّها لم تشتهر، فإنّ اُکذوبة أن الشيعة تشک بنبوة محمد(ص) أو ما يطلق عليها بمسألة (خان الأمين) تعيش فعلاً في بعض الأذهان ولم تمسح إلی يومنا هذا، ونحن في هذا الدرس حول عقيدة الشيعة في النبوة نبحث أولاً مسألة عصمة الأنبياء ثمَّ نبحث عقيدة الشيعة بنبوَّة محمَّد(ص) بصورة خاصَّة، ونجيب علی شبهة «خان الأمين».
الأنبياء معصومون
قد أجمع علماء المسلمين على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذب في تبليغ الرسالة عن الله تعالى واختلفوا بعد ذلك في صدور ما ينافي العصمة فذهب بعض علماء السنة إلى جواز وقوع كل ذنب منهم صغيراً كان أو كبيراً حتى الكفر قبل النبوة و صدورالسهو و النسيان منهم حتَّی بعد النبوَّة بينما البعض الآخر فصَّل في ذلك ولم يصل إلى هذا الحد، وبوسع القارئ الرجوع إلى آراء الفخر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء، والباقلاني والغزالي مفصلاً في کتاب نظرية الإِمامة([1]). أما الشيعة الإمامية فقد ذهبوا إلى عصمة الأنبياء مطلقاً عن الذنوب الکبيرة والصغيرة، قبل البعثة وبعدها، علی سبيل العمد أوالنسيان وقد ساقوا لذلك أدلة كثيرة، والذي يهمنا في المقام هو البحث حول نبوَّة محمد وعقيدة الشيعة الإمامية في ذلک([2]).
عقيدة الشيعة في نبوَّة محمد(ص)
يقول آية الله کاشف الغطاء: يعتقد الشيعة الإمامية: أن جميع الأنبياء الذين نص عليهم القرآن الكريم رسل من الله، وعباد مكرمون، بعثوا لدعوة الخلق الى الحق، وأن محمداً(ص) خاتم الأنبياء، وسيد الرسل، وأنه معصوم من الخطأ والخطيئة، وأنه ما ارتكب المعصية مدة عمره، وما فعل إلا ما يوافق رضا الله سبحانه حتى قبضه الله إليه. وأن الله سبحانه أسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، ثم عرج من هناك بجسده الشريف الى ما فوق العرش والكرسي وما وراء الحجب والسرادقات، حتى صار من ربه قاب قوسين أو أدنى.... ويعتقد الإمامية أن كل من اعتقد أو ادعى نبوة بعد محمد(ص)، أو نزول وحي أو كتاب فهو كافر يجب قتله ([3]).
نبوة محمد(ص) و شبهة «خان الأمين»
ملخَّص هذه الإکذوبة المنسوبة للشيعة أنّ الشيعة يعتقدون أنّ الوحي أراده الله تعالى لعليِّ بن أبي طالب ولكن جبرئيل خان أو أخطأ فذهب بالوحي إلى محمّد(ص)، ولقد وضعت هذه الفرية على لسان الشعبي عامر بن شراحيل فقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة أنَّ الشعبي قال: «احذرِّكُم أهل هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، ... إلى أن قال: واليهود تبغض جبرئيل ويقولون هو عدوُّنا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون غلط جبرئيل بالوحي على محمد ...الخ»([4]). إنّ هذه الصورة التي وضعت على لسان الشعبي: أخذها ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل فنسبها لفرقة من الغلاة سمَّاهم الغرابية: لأنّهم قالوا إنّ علياً أشبه بمحمد من الغراب بالغراب، ولذلك غلط جبرئيل بالوحي فذهب به لمحمد وهو مبعوث لعليٍّ ولا لوم عليه لأنّه اشتبه، وبعضهم شتمه وقال بل تعمد ذلك ([5]). في حين ذهب الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين إلى أنّهم قالوا غلط ولم يتعمد([6]). وفي المعاصرين من أهل القلم وهو مـحمد ثابت المصري يـضـرب على هذا الوترنفسه في كتابه ( جولة في ربوع الشرق الادنى ) حيث يقول : «ومن الشيعة قسم اوجب النبوة بعد النبي فقالوا بانَّ الشبه بين محمد وعلي كان قريباً لـدرجـة انَّ جـبـرائيـل أخـطأ، وتلك فئة الغالية او الغُلاة، ومنهم من قال بأنَّ جبرائيل تعمَّد ذلك ».
بطلان شبهة «خان الأمين»
قد عرفت أنّ منشأ مسألة خان الأمين هي رواية الشعبي ونظراً لأهمية الموضوع سنثبت ضعف هذه الرواية بل کذبها ليتبيَّن بطلان هذه الشبهة:
1 ـ إنّ رجال سند هذه الرواية بين متهم مثل عبدالرحمن بن مالك بن مغول فقد قالت عنه كتب التراجم بأنّه ضعيف، وكذَّاب، ووضَّاع، ويقول عنه النسائي ليس بثقة([7]).
2-إنَّ أوَّل ما يقال في هذه الرواية أنّ الشعبي عندما كان يقارن بين اليهود والشيعة يسمى الشيعة بالرافضة، وهذا اللقب الذي نبز به الشيعه قد ذكر مؤرخوا السنة أنّه عرف في آخر أيام زيد بن عليٍّ عندما طلب منه أفراد جيشه البراءة من الخليفتين فأبى فرفضه قوم منهم سموا بالرافضة هذه هي رواية هذا اللقب وهذه الواقعة كانت سنة مقتل زيد أي: سنة 123 هجرية في حين أنّ الشعبي ولد عام عشرين أو ثلاثين على رواية اُخرى من الهجرة فالفرق بين وجوده والرواية سبعة عشر سنة لأنّه مات سنة مائة وخمس من الهجرة، فإمَّا أن يكون لفظ الرافضة ورد قبل هذا وهو ما لا تقول به رواياتهم أو أنّ القصة مخترعة وهو الأصح،ومن جهة اُخری أنّ الشعبي يرمى بالتشيع وقد نص على تشيعه كل من ابن سعد والشهرستاني ولا يعقل أن يقول شيعي هذا القول ([8]).
3- أوليس القرآن الكريم يقول عن جبرئيل: “ مُطاعٍ ثَمَّ أَمين” ([9]). ويقول عن النبي (ص): “ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ ...” ([10]). والشيعة يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار فكيف لا يفهمون ذلك، وأيضاً ألا تكفي آلاف المنائر والمساجد عند الشيعة والتي تصرخ ليل نهار أشهد أنّ محمداً رسول الله للتدليل على أنّ هذه القصة فرية مفتعلة كأخواتها.
4ـ إنّ كتب مصادر الشيعة الإمامية في العقائد متوفرة، فهل يوجد في كتاب واحد منها ما يشير إلى هذه الفرية، وأين القائلون بهذه المسألة، ومن هم هؤلاء «الغرابية» وكم عددهم وأين مكانهم، والظاهر أنَّهم خرجوا من المقلع الذي خرج منه عبدالله بن سبأ، وخلقتهم الأهداف التي خلقته نفسها، وهي تشويه سمعة الشيعة والتشيع، وتفريق المسلمين وتمزيق وحدتهم.
والحق أنَّ هؤلاء لهم مصالح في بقاء هذه الشبهات والأکاذيب، کما کانت لأسلافهم في قضية مقتل عثمان واُکذوبة اشتراک علي بن أبي طالب (ع) في دمه، وقد سئل مروان عن موقف الإِمام عليٍّ(ع) من عثمان بالثورة فقال: ما كان أحد أدفع عن عثمان من عليٍّ فقيل له: ما لكم تسبُّونه على المنابر؟ فقال: لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك([11]).
هذا وقد عرضنا عقيدة الشيعة حول الأنبياء ونبوَّة محمد(ص) في الدرس السابق، وفي ختام هذا البحث نأتي بعبارات اُخری ممَّا كتبه علماء الشيعة عن نبوة النبي محمد(ص)، فهذا السيد محسن الأمين العاملي وهو من المعاصرين يقول: «إنّ من شك في نبوة النبي وجعل له شريكاً في النبوة فهو خارج عن دين الإِسلام »([12]). ويقول محمدرضا المظفر في کتابه عقائد الإِمامية:« نعتقد أنّ صاحب الرسالة الإِسلامية هو محمد بن عبدالله وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين، وأفضلهم على الإِطلاق كما أنّه سيد البشر جميعاً لا يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه أحد في مكرمة، وإنّه لعلى خلق عظيم »([13]).
الهوامش:
([1]) راجع نظرية الإِمامة :111.
([2]) راجع دلائل الصدق1: 368.و معالم الفلسفة لمغنية :193.
([3]) أصل الشيعة واصولها :143.
([4]) منهاج السنة1: 16.
([5]) الفصل بين الملل والنحل4: 183.
([6]) اعتقادات فرق المسلمين :59.
([7]) لسان الميزان :427.
([8]) راجع ترجمة الشعبي في کتاب وفيات الأعيان 1 :266 .
([9])التكوير:21
([10])الأحزاب:40.
([11]) الصواعق المحرقة:53.
([12]) أعيان الشيعة 1: 92 .
([13]) عقائد الإمامية :64. ولمزيد الإطَّلاع علی هذه المسألة راجع کتاب شرح العقائد للصدوق ، وأوائل المقالات للمفيد، وتنزيه الأنبياء للشريف المرتضى وغيرها من الکتب.
الدرس السابع: الشيعة الإمامية الإثنا عشرية وعقائدهم
من أهمِّ وأکبرالفرق الثلاثة الشيعية المشهورة هي الفرقة الإمامية الاثنا عشرية،وهم القائلون بعصمة الائمة الاثني عشر(ع ) وإمامتهم بالنص بعد رسول الله (ص) وقـد اسـتند الامامية في اعتقادهم هذا على مجموعة من الـنـصوص من الکتاب والسنة والتي سنتطرق إليها فيما يأتي. و اسم الشيعة ينصرف في الفترات المتأخرة إلى هذه الفرقة باعتبارها تمثل روح التشيع وجوهره، وحان الوقت لکي نبحثها بالتفصيل ليتبين مکانتها بين الفرق الإسلامية:
مکانة الإمامية بين الفرق الإسلامية
إنّ المناهج الكلامية التي قسَّمت المسلمين إلى فرق و مذاهب حدثت في أواخر القرن الأوّل الهجري، کاخوارج والمرجئة، والجهمية، والمعتزلة، والحشوية، والأشعرية، والكرّامية بفرقهم المتشعّبة، لا تجد لها تاريخاً متّصلًا بزمن النبيّ الأكرم(ص)، فالخوارج كانوا فرقة سياسية نشأت في عام 37هـ أثناء حرب صفّين ثمّ تبدّلت إلى فرقة دينيّة في أواخر القرن الأوّل، والمرجئة ظهرت عند اختلاف الناس في الخليفة عثمان والإمام علي(ع)، ثمّ تطورت إلى معنى آخر و هو تقديم الإيمان وتأخير العمل، والجهمية نتيجة أفكار «جهم بن صفوان» المتوفّى سنة 128.ق، والمعتزلة تستمد من واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري المتوفّىعام130هـ، وهكذا القدريّة والكرّاميّة والظاهريّة والأشعريّة فجميعها فرق نتجت عن البحث الكلامي عبر القرون، فلا تجد لهذه الفرق سنداً متّصلًا بالنبيّ الأكرم(ص). وأمّا الشيعة الإمامية فلا صلة في نشأتها بينها وبين تلك الفرق، لأنّها أُخذت أساساً من مصادر التشريع الحقيقي للإسلام وهو: الذكر الحكيم، والسنّة النبويّة، وتبيانهما من قبل الأئمة المعصومين(ع) فلأجل ذلك يحدّد تاريخ عقائدهم بتاريخ حياة النبي وأئمّتهم الطاهرين(ع)، وکان من البداية المرتكز الأساسي لبناء العقيدة الخاصة بالشيعة الإمامية هو الاعتقاد بعصمة الأئمة الإثني عشر و بإمامتهم بالنَّص من رسول الله(ص) وبأمرٍ من الله تعالی، وأنّ رسول الله وأهل بيته(ع) هم المرجع الأعلى بعد الذكر الحكيم. وهذا هو العنصر المقوّم للتشيّع، وأمّا سائر الأُصول فإنّها عقائد إسلامية لا تختص بالشيعة الإمامية وحدها، وإنّ الشيعة الذين نذكر عقائدهم و آراءهم أو ندافع عنهم هم الإِمامية الإِثنا عشرية الذين يؤلفون الجمهور الشيعي اليوم والذين تملأ كتبهم مكتبات العالم ولسنا نتكلم عمَّن يسمى شيعياً لغة لأنّه ذهب إلى تفضيل عليٍّ(ع) على غيره فعرف بالتشيع من أجل ذلك، وليس الفرق التي قد تکون منقرضة لا يوجد لها أثر إلا في مخيلة البعض أو في وريقات من كتب مهجورة.
وبما أنَّه لا تؤخذ عقيدة فئة من کتب الأدب أو القصص كما رأينا البعض يفعله فإنّ لكلِّ فرقة كتباً تختص بها فينبغي الرجوع إليها إذا كنا نتوخى الدقة فيما نقول أو نكتب.ولذا من أراد التَّعرف علی الشيعة الإمامية فلابُدَّ من مراجعة کتبهم الأصلية المعتمد عليها وأقوال أئمتهم وکبار علمائهم، وسنذكر هنا جملاً قصيرة عمَّا جاء من أئمة الشيعة و ماكتبه علماؤهم الأقدمون والمتأخرون بأقلامهم عن عقائدهم من مصادرهم حتى يقف الطالب للمعرفة على جذور تلك العقائد وتتوضح له الصورة الحقيقية عن ركائز معتقدات الإمامية وأنَّها محض الإسلام المحمدي الأصيل.
عقائد الإمامية هي محض الإسلام
روى الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا(ع) أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار فكتب (ع) له: «إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً، فرداً صمداً، قيّوماً، سميعاً، بصيراً، قديراً، قديماً، قائماً، باقياً، عالماً لا يجهل، قادراً لا يعجز، غنيّاً لا يحتاج، عدلًا لا يجور، وأنّه خالق كلّ شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضدّ له ولا ندّ له ولا كفو له، وانّه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة.وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأمينه وصفيّه وصفوته من خلقه، وسيّد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبيّ بعده ولا تبديل لملّته ولا تغيير لشريعته، وانّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد اللَّه هو الحقّ المبين، والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رسل اللَّه، وأنبيائه، وحججه، والتصديق بكتابه، الصادق العزيز الذي: “لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميد” ([1])، وانّه المهيمن على الكتب كلّها، وانّه حقّ من فاتحته إلى خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتشابهه، وخاصّه وعامّه، ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه واخباره، لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله. وأنّ الدليل بعده والحجّة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين، والناطق عن القرآن، والعالم بأحكامه: أخوه وخليفته ووصيّه ووليّه، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى: علي بن أبي طالب- عليه السّلام أميرالمؤمنين، وإمام المتّقين، وقائد الغرِّ المحجّلين، وأفضل الوصيّين، ووارث علم النبيّين، والمرسلين، وبعده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة، ثمّ علي بن الحسين زين العابدين، ثمّ محمّد بن علي باقر علم النبيّين، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق وارث علم الوصيّين، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ علي بن موسى الرضا، ثمّ محمّد بن علي، ثمّ علي بن محمّد، ثمّ الحسن بن علي، ثمّ الحجّة القائم المنتظر- صلوات اللَّه عليهم أجمعين- أشهد لهم بالوصية والإمامة، وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة للَّه تعالى على خلقه في كلّ عصر وأوان، وأنّهم العروة الوثقى، وأئمّة الهدى والحجّة على أهل الدنيا، إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها، وأنّ كل من خالفهم ضال مضل باطل، تارك للحقّ والهدى، وأنّهم المعبّرون عن القرآن، والناطقون عن الرسول صلَّى اللَّه عليه و آله بالبيان، ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية، وأنّ من دينهم الورع والفقه والصدق والصلاة والاستقامة والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، وطول السجود، وصيام النهار وقيام الليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن العزاء وكرم الصحبة ([2]). ثمّ ذكر الإمام فروعاً شتّى من مختلف أبواب الفقه وأشار إلى بعض الفوارق بين مذهب أهل البيت وغيرهم لا يهمّنا في المقام ذكرها ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى المصدر.
عقائد الإمامية هو دين الله الخالص
روى الصدوق عن عبد العظيم الحسني([3]) قال: دخلت على سيدي علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) فلمّا بَصُرَ بي، قال لي: «مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقّا» قال: فقلت له: يا ابن رسول اللَّه إنّي أُريد أن أعرض عليك ديني، فإنّ كان مرضيّاً أثبت عليه حتى ألقى اللَّه عزّ وجلّ. فقال: «هاتها أبا القاسم». فقلت: إنّي أقول: إنّ اللَّه تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج من الحدّين: حدّ الابطال، وحدّ التشبيه، وأنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسِّم الأجسام ومصوِّر الصور، وخالق الأعراض والجواهر، وربَّ كلّ شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، خاتم النبيّيين فلا نبيّ بعده إلى يوم القيامة، وأقول: إنّ الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ علي بن الحسين، ثمّ محمّد بن علي، ثمّ جعفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ علي بن موسى، ثمّ محمّد بن علي، ثمّ أنت يا مولاي. فقال (ع): «ومن بعدي الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده» قال: فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟ قال: «لأنّه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً».
قال: فقلت: أقررت وأقول: إنّ وليّهم وليّ اللَّه، وعدوّهم عدوّ اللَّه، وطاعتهم طاعة اللَّه ومعصيتهم معصية اللَّه، وأقول: إنّ المعراج حقّ والمساءلة في القبر حقّ، وإنّ الجنّة حقّ، والنار حقّ، والميزان حقّ، وانّ الساعة آتية لا ريب فيها وانّ اللَّه يبعث من في القبور، وأقول: إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمّد (ع): يا أبا القاسم: «هذا واللَّه دين اللَّه الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه ثبّتك اللَّه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ([4]).
وقد اكتفينا بهذين النصّين من الإمامين الطاهرين، أحدهما قوليّ، والآخر إمضائيّ.
عقيدة الإمامية في التوحيد و القرآن
صنّف الشيخ الصدوق (306- 381 هـ) رسالة موجزة في عقائد الإمامية، قال: اعلم انّ اعتقادنا في التوحيد: أنّ اللَّه تعالى واحد أحد، ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، سميعاً بصيراً، عليماً حكيماً، حيّاً قيّوماً، عزيزاً قدّوساً، عالماً قادراً، غنيّاً، ...إلى أن قال: وأنّه تعالى شيء لا كالأشياء، أحد صمد لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كفواً أحد، ولا ند ولا ضد، ولا شبه ولا صاحبة، ولا مثل ولا نظير، ولا شريك له، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا الأوهام وهو يدركها، لا تأخذه سنة ولا نوم وهو اللطيف الخبير، خالق كلّ شيء لا إله إلّا هو، له الخلق والأمر تبارك اللَّه ربّ العالمين. ومن قال بالتشبيه فهو مشرك، ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب، وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع، وكل حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو باطل، وإن وجد في كتب علمائنا فهو مدلس ... ثمّ إنّه قدّس اللَّه سرّه ذكر معتقد الإماميّة في أفعال العباد، وأنّه بين الجبر والتفويض، كما ذكر عقائدهم في القضاء والقدر،... إلى أن قال: اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللَّه تعالى على نبيّه محمّد هو ما بينالدفّتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس 114 سورة، وعندنا أنّ الضحى والانشراح سورة واحدة، كما أنّ الإيلاف والفيل سورة واحدة. ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب ... إلى آخر الرسالة ([5]).
ثمّ إنّ الشيخ المفيد (336- 413 هـ) قد شرح تلك الرسالة بكتاب أسماه شرح عقائد الصدوق، أو تصحيح الاعتقاد ناقش فيها استاذه الصدوق في بعض المواضع التي استند فيها الصدوق على روايات غير جامعة للشرائط في باب العقائد. و تحدّث الشيخ المفيد عن القرآن وأشار إلى قول من يدعي أنّ القرآن حذف منه شيء فأوّل هذا القول بأنّ المحذوف هو الشروح والتفسيرات ولا شيء من أصل القرآن محذوف وذكر أنّه من الذاهبين إلى هذا الرأي فقال في ذلك: «وقال جماعة من أهل الإِمامة إنّه لم ينقص من آية ولا من كلمة ولا من سورة ولكن حذف ما كان في مصحف عليٍّ من تأويله، وتفسير معانيه على حقيقة تنزله، وذلك كان ثابتاً وإن لم يكن من كلام الله تعالى وقد يسمى تأويل القرآن قرآناً، قال الله تعالى: “فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْني عِلْماً “ ([6]). فقد سمى تأويل القرآن قرآناً، وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم نفس القرآن([7]).
عقيدة الشيعة الإمامية في النبوة و القرآن
يقول آية الله کاشف الغطاء: يعتقد الشيعة الإمامية : أن جميع الأنبياء الذين نص عليهم القرآن الكريم رسل من الله، وعباد مكرمون، بعثوا لدعوة الخلق الى الحق، وأن محمداً(ص) خاتم الأنبياء، وسيد الرسل، وأنه معصوم من الخطأ والخطيئة، وأنه ما ارتكب المعصية مدة عمره، وما فعل إلا ما يوافق رضا الله سبحانه حتى قبضه الله إليه وأن الله سبحانه أسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، ثم عرج من هناك بجسده الشريف الى ما فوق العرش والكرسي وما وراء الحجب والسرادقات، حتى صار من ربه قاب قوسين أو أدنى. وأن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه للإعجاز والتحدي، ولتعليم الأحكام، وتمييز الحلال من الحرام، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وعلى هذا إجماعهم، ومن ذهب منهم ـ أو من غيرهم من فرق المسلمين ـ الى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطىء يرده نص الكتاب العظيم “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون”([8]). والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة، وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، فإما أن تُأول بنحو من الاعتبار، أو يضرب بها الجدار. ويعتقد الإمامية أن كل من اعتقد أو ادعى نبوة بعد محمد (ص)، أو نزول وحي أو كتاب فهو كافر يجب قتله ([9]).
عقيدة الشيعة الإمامية في الإمامة
يقول آية الله کاشف الغطاء: هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين، وهو فرق جوهري أصلي، وما عداه من الفروق فرعية عرضية كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي والشافعي وغيرهما. وعرفت أن مرادهم بالإمامة: كونها منصبا إلهياً يختاره الله بسابق علمه بعباده، كما يختار النبي، ويأمر النبي بان يدل الأمة عليه، ويأمرهم باتباعه.
ويعتقدون: أن الله سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي (ع) وينصبه علماً للناس من بعده، وكان النبي يعلم أن ذلك سوف يثقل على الناس، وقد يحملونه على المحاباة والمحبة لابن عمه وصهره، ومن المعلوم أن الناس ذلك اليوم، وإلى اليوم، ليسوا في مستوى واحد من الإيمان واليقين بنزاهة النبي وعصمته عن الهوى والغرض، ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فاوحى اليه : “ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ ہرِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ “ ([10]).، فلم يجد بدَّاً من الإمتثال بعد هذا الإنذار الشديد، فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غدير خم، فنادى ـ وجلهم يسمعون ـ : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؟. فقالوا: اللهم نعم . فقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» الى آخر ما قال([11]). ثم أكد ذلك في مواطن اخرى تلويحاً وتصريحاً، إشارة ونصاً، حتى أدى الوظيفة، وبلغ عند الله المعذرة. ولكن كبار المسلمين بعد النبي (ص) تأولوا تلك النصوص، نظراً منهم لصالح الإسلام ـ حسب اجتهادهم ـ فقدموا وأخروا، وقالوا : الامر يحدث بعده الأمر. وامتنع علي(ع) وجماعة من عظماء الصحابة عن البيعة أولاً، ثم رأى [ أن ] امتناعه من الموافقة والمسالمة ضرر كبير على الإسلام، بل ربما ينهار عن أساسه، وهو بعد في أول نشوئه وترعرعه، ...، فمن ذلك كله تابع وبايع ([12]) ، حيث رأى أن بذلك مصلحة الإسلام، وهو على منصبه الإلهي من الإمامة، وان سلم لغيره التصرف والرئاسة العامة، فإن ذلك المقام مما يمتنع التنازل عنه بحال من الأحوال . أما حين انتهى الأمر إلى معاوية، وعلم أن موافقته ومسالمته وإبقائه والياً ـ فضلاً عن الإمرة ـ ضرر كبير، وفتق واسع على الاسلام ـ لا يمكن بعد ذلك رتقه ـ لم يجد بُداً من حربه ومنابذته ... وإن الإمامية تعتقد أن الله سبحانه لا يخلي الأرض من حجة على العباد، من نبي أو وصي، ظاهر مشهور، أو غائب مستور، وقد نص النبي (ص) وأوصى إلى علي، وأوصى علي ولده الحسن، وأوصى الحسن أخاه الحسين، وهكذا إلى الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر(ع) وهذه سنة الله سبحانه في جميع الأنبياء، من آدمهم إلى خاتمهم ([13]).
عقيدة الشيعة في المهدي الموعود
إنّ فكرة الإِمام المهدي في نطاق العقيدة الدينية، هي من البحوث الإسلامية التي قد نالت الإهتمام الكثير من قبل علماء الإسلام وقد بُحث من جميع جوانبه على ضوء الكتاب والسنّة والعقل، لأنَّ الإيمان والاعتقاد بظهور المصلح العالمي المنتظر كما هو موجود عند الفرق الشيعية موجود في سائر المذاهب الاُخری أيضاً ولکن بصورة ناقصة و غيرواضحة ولا وجود له في الخارج فعلاً. ولکن حينما يتحدث أهل البيت(ع) وشيعتهم عن هذه الفكرة فإنما يقدِّمون البيان الأكمل في هذا الموضوع، ويشخِّصون مصداقه ويذکرون رائد هذا الإصلاح و النهضة العالمية، وقائد عملية الإنقاذ والتغيير الشامل، وفي ذلک يقول الشيخ محمد رضا المظفَّر: «أنَّ هذا المصلح المهدي هو شخص معين ولد في سنة 255 هـ (في سامراء) ولايزال حيَّاً، وهو بن الحسن العسكري واسمه (محمد). وذلک بما ثبت عن النبي(ص) وآل البيت من الوعد به و ماتواتر عندنا من ولادته و احتجابه ...» ([14]). هذا وسيأتي الکلام بالتفصيل حول قضية الإمام المهدي الموعود.
خلاصة الکلام
ما ذکرناه هو مقتطفات من اُمَّهات عقائد الشيعة الإمامية أوردناها من أعلام أئمتهم وعلمائهم بتلخيص لتكون مؤشراً لعقائد هذه الفرقة، وهذه الکلمات ممتدة على أبعاد التاريخ الشيعي فإنّ کلمات اثنين ممن ذكرناهم هما من أئمة الشيعة الأول علي بن موسى الرضا(ع) والثاني هو الإمام الهادي علي بن محمّد(ع) وقد عاشا في القرن الثاني والثالث، والشيخ الصدوق والمفيد من کبار علماء الإمامية وقد عاشا في القرن الرابع، وأما الأخيران المعاصران هما المرحوم آية الله کاشف الغطاء صاحب کتاب (أصل الشيعة واصولها)، والمرحوم المجدد الشيخ محمد رضا المظفر صاحب کتاب (عقائد الإمامية).
وبعد هذه الجولة القصيرة في عقائد الإمامية سنفرد لبعضها بحثاً مستقلاً لأهميتها أوجوهريتها في العقيدة الشيعية ونجيب علی بعض التساؤلات والشُّبهات المطروحة حولها، ومن تلک العقائد: عقيدة الإمامية في النبوة والإمامة، والعصمة والإمام المهدي الموعود، وأهل البيت(ع) و مسألة الغلو ومايرتبط بها، ونبدأ بالبحث حول عقيدة الشيعة الإمامية بالأنبياء وبنبوَّة محمد(ص) في الدرس الآتي ونتابع البحث والبيان والتوضيح لبقية العقائد والمسائل المرتبطة بها في الدروس الآتية إن شاءالله تعالی ([15]).
الهوامش:
([1]) فصلت: 42.
([2]) عيون أخبار الرضا 2: 121.
([3])ينتهي نسب عبد العظيم الحسني بوسائط أربع إلى الإمام الحسن المجتبى(ع) فهو عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن المجتبى(ره)، ولد في الرابع من ربيع الثاني عام 173هـ في المدينة ، وتوفي عبد العظيم الحسني في النصف من شوال عام 252 للهجرة،ودفن في ري في بستان عبدالجبَّار بن عبد الوهَّاب عند شجرة التِّفاح. وعلوّ مقام عبد العظيم وجلالة شأنه أظهر من الشمس فهو من أكابر المحدثين وأعاظم العلماء والزهّاد والعباد ومن أصحاب الإمامين الجواد والهادي(ع)، وقد روى عنهما أحاديث كثيرة، وقدعرض دينه على الإمام الهادي(ع)، فأقرّه وصدَّقه، وهو المؤلف لكتاب خطب أمير المؤمنين(ع)، و يروي ابن بابويه وابن قولويه في فضل زيارة عبد العظيم الحسني أنَّ رجلاً من أهل الرَّي قدم إلی الإمام علي الهادي(ع) فسأله: من أين قدمتَ؟ فقال:کنتُ في زيارة الحسين،فقالA(ع)« أما لوأنَّك زرتَ قبرَ عبد العظيم عندَكم لكنتَ كمن زارَ الحسينَ بن علي(ع)» ([3]).
([4]) التوحيد للشيخ، الصدوق:81 ،باب التوحيد والتشبيه ، ح37.
([5]) الأمالي، للشيخ الصدوق: کتاب المقنع والهداية.
([6]) طه آية 114.
([7]) أوائل المقالات للشيخ المفيد:53 .
([8]) الحجر: 9.
([9]) المائدة : 67.
([10]) المائدة 5 : 67 .
([11]) روت معظم المصادر الحديثية وغيرها واقعة الغدير باسانيد متعددة منها : مسند أحمد 1 : 84 ، 88 و 4: 368 ، 372 و5 : 366 ،419 ، تاريخ بغداد 7 : 377 و 8 : 290 و 12 : 343 ، اسد الغابة 2 : 233 و 3 : 3 9 ، الإصابة 1 : 304 ، مستدرك الحاكم 3 : 109 ، 110 ، 116 64 ، ترجمة الامام علي(ع) من تاريخ دمشق2 :50 1 ـ 531 ، وغيرها من المصادر.
([12]) وکانت البيعة بعد تفاقم حرکات الرِدات وفي حياة فاطمة الزهراء(ع)، ولايصحُّ القول بأنَّ ذلک کان بعد ستة أشهر وبعد وفاتها(ع) ، وهورواية الزُهري الاُموي عن عروة بن زبير عن خالته عائشة ، لتقول أنَّ الناس إنَّما احترموا علياً لحياة الزهراء(ع) وهو کان ممتنعاً عن البيعة بها وإلاَّ فلا حرمة لعلي(ع)! ( راجع المجلد الرابع من موسوعة التاريخ الإسلامي ، للشيخ هادي اليوسفي الغروي ) .
([13]) أصل الشيعة واصولها :143.
([14] عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفَّر:178.
([15]) هذا و من أراد التوسع في معرفة عقائد الشيعة الإمامية فليراجع الکتب والموسوعات المؤلَّفة قديماً وحديثاً في هذا الموضوع.
الدرس السادس: الفرقة الإسماعيلية وعقائدها
من الفرق الثلاثة الشيعية المشهورة هي الفرقة الإسماعيلية التي لازال لها أتباع خاصة في الحجاز وسورية ولبنان وأفغانستان والهند وغيرها من البلدان، وجاء الدور لکي نتعرف علی هذه الفرقة و تاريخها وعقائدها وإنشعاباتها.
تاريخ الفرقة الإسماعيلية وعقائدها
إنَّ الدعوة الإسماعيلية، ليست سوى استمراراً لتلك الحركة الباطنية التي تزعّمها أبو زينب محمد بن مقلاص المعروف بأبي الخطاب الأسدي وزملاؤه، نظير: المغيرة بن سعيد، وبشار الشُعيري وغيرهم، وقد اشتهروا بالخطَّابية، وکان ذلک في زمن الإمام الصادق(ع) وقد تبرّأ منهم الإمام(ع) على رؤوس الأشهاد،لأنَّهم قد أغروا جماعة من شيعة أئمّة أهل البيت(ع). وأتباع أبي الخطّاب كانوا يقولون: ينبغي أن يكون في كلّ وقت إمام ناطق وآخر صامت فكان النبي(ص) ناطقاً، ثمّ صار علي بعده ناطقاً. وهكذا يقولون في الأئمة، وكان أبو الخطّاب في وقته إماماً صامتاً وصار بعده ناطقاً، وكانت الخطّابية تؤوّل الآيات إلى مفاهيم غير مفهومة من ظواهر الآيات والروايات، حتى أنّه أوّل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنّها رجال([1]).
و الخطّابية بعد قتل زعيمهم أبي الخطّاب وحَرقه علی يد عيسى بن موسى العباسي على شاطئ الفرات، توجهوا إلى محمد بن إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق(ع) فقالوا بإمامته وأقاموا عليها، وقد استغلوا إمامة محمد بن إسماعيل لبثِّ آرائهم، فتحولت الخطّابية إلى الإسماعيلية، واستمروا بالتأويل والغلوا في أئمتهم حتَّی أصبح التأويل من أرکان عقيدتهم ولذا اشتهروا بالباطنية، وقد لُقِّبوا بالملاحدة، واُطلق عليهم إسم السبعية أيضاً: قال المحقّق الطوسي: إنّما سُمُّوا بالإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، والباطنية لقولهم: كلّ ظاهر فله باطن، يكون ذلك الباطن مصدراً وذلك الظاهر مظهراً له، ولا يكون ظاهر لا باطن له إلّاما هو مثل السراب، ولا باطن لا ظاهر له إلّا خيال لا أصل له، ولقّبوا بالملاحدة لعدولهم من ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال ([2]). وأمّا تسميتهم بالسبعية، لأنّهم قالوا: إنّما الأئمّة تدور على سبعة سبعة، كأيام الأُسبوع، والسماوات السبع، والكواكب السبع([3]).
فِرَق الإسماعيلية وأئمتهم ([4]).
إنَّ الإسماعيلية في بداية نشأتها كانت فرقة واحدة، فانشقَّت إلى أربعة فِرَق: قرامطة، ودروز، ومستعلية المعروفون بالبُهرة بقسميها (الداودية وسليمانية)، ونزارية بقسميها (المؤمنية والقاسمية المعروفة بالآغاخانية) وسيوافيك تفصيلها:
1- فرقة القرامطة:
فرقة القرامطة قائلة بإمامة محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق و غيبته، ثمّ دخلت الإمامة في كهف الاستتارعندهم ،وهؤلاء کانوا يعيشون ويحکمون في جنوب العراق والبحرين والقطيف والأحساء، وکانت نشأتهم في بداية القرن الثالث ونهايتهم في نهاية القرن الخامس. ويقول مؤلّف «البحرين عِبر التاريخ»: إنّ حمدان قرمط ابن الأشعث، هو مؤسّس حركة القرمطيين في واسط بين الكوفة والبصرة- حيث أنشأ داراً للهجرة، وجعلها مركزاً لبث الدّعوة، ثمّ كلّف دعاته بإنشاء فروع للحركة، أهمّها على الإطلاق فرعُ البحرين الذي أقامه أبو سعيد الجنابي.
و قال النوبختي: إنّما سُمّيت بهذا لرئيس لهم من أهل السواد (العراق) من أهل الأنباط كان يلقب «قرمطويه» وكانوا في الأصل على مقالة المباركيّة، ثمّ خالفوهم، فقالوا لا يكون بعد محمد النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم إلّا سبعة أئمّة، علي بن أبي طالب وهو إمامٌ رسولٌ، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، ومحمد بن إسماعيل بن جعفر، وهو الإمام القائم المهدي، وهو رسولٌ ([5]).
2- فرقة الدَروز:
الدَروز هي جمع الدَرزي، والعامة تتكلّم بضم الدال، والصحيح هو فتحها. والظاهر انّ الكلمة فارسية بمعنى الخياط، وهؤلاء يسوقون الإمامة إلى الإمام الحادي عشر الحاكم بأمر اللَّه، ثمّ يقولون بغيبته وينتظرون ظهوره، ويبالغون فيه حيث يعتقدون بتجلي الله فيه، وهم فرقة من الباطنية لهم عقائد سرية متفرقون بين جبال لبنان وحوران والجبل الأعلى من أعمال حلب. ولم يكتب عن الدروز شيء يصح الاعتماد عليه ولا هم من الطوائف التي تنشر عقائدها حتى يجد الباحث ما يعتمد عليه من الوثائق، وبحسب ماجاء في دائرة المعارف لبطرس البستاني فهم ينقسمون باعتبار الطريقة المذهبية إلى قسمين:
القسم الأول: الطائعون ويعرفون بالعُقَّال، وهم السالكون بمقتضى الطريقة المذهبية، كالامتناع عن التدخين وسائر المشروبات الروحية والابتعاد عن التأنّق في المأكولات والملبوسات وسائر اللذات الدنيوية والاقتصار على التقشف في المعيشة.
القسم الثاني: الشرَّاحون ويعرفون بالجُهَّال، وهم المخالفون للعُقَّال في الامتناع عن التدخين والمشروبات الروحية وعن الترفّه في المعيشة والتنعّم باللذات الدنيوية، ولذلك لا يسوغ لهم مطالعة القرآن الشريف، ولا متون الحكمة خلافاً للعقال، لأنّ عندهم كتباً مقدسة لا يمسّها إلّا الطاهرون. والطهارة عندهم الامتناع عن سائر المحرمات والممنوعات، وإنّما يسوغ لهم تلاوة بعض شروح كتب دينية، ولهذا يقال لهم شراحون. و يمتاز العقال عن الجهلاء بكونهم يتعمّمون بعمامة بيضاء ويلبسون الملابس البسيطة كالقباء والعباءة، ونسبة هؤلاء العقال إلى الجهال عدداً أكثر من ثلاثة أرباع([6]).
ويکتب محمد فريد وجدي عن عقائدهم: وقد قام مذهب الدروز على فكرة أنّ اللَّه قد تجسد في الإنسان في جميع الأزمان. فالخليفة الحاكم وفقاً لهذه العقيدة يمثل اللَّه في وحدانيته وهذا هو السبب في أنّ حمزة بن علي(375- 433 ه) قد أطلق على مذهبه اسم مذهب «التوحيد» وهم يعبدون الحاكم ويسمّونه «ربنا» ويفسرون متناقضاته وقسوته تفسيراً رمزياً، فهو آخر من تجسد فيهم اللَّه. وهم ينكرون وفاته ويقولون إنّه إنّما استتر وسيظهر في يوم ما وفقاً للعقيدة المهدوية([7]).
وأمّا عقيدة الدروز في الفروع فالصلاة عندهم ساقطة، والمقصود بها هي الصلة للقلوب مع مولاهم الحاكم.وأمّا الزكاة فتعني توحيد المولى الحاكم وتزكية القلوب وتطهيرها. وأمّا الصوم فباطنه الصمت لقوله لمريم: «فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً» ([8])، والصوم الحقيقي هو صيانة القلوب بتوحيد المولى الحاكم. أمّا الحج فهو معرفة المولى الحاكم والبيت هو توحيد المولى. كما أنّهم من القائلين بجواز الزواج من المحارم كالأُخت وبتعدّد الزوجات وحلية الخمر([9]).
3- فرقة المستعلية:
الفرقة المستعلية من الإسماعيلية يسوقون الإمامة إلى الإمام الثالث عشر المستنصر باللَّه الإمام الثالث عشر من أئمة الإسماعيلين، ويقولون بإمامة ابنه المستعلى باللَّه بعده، وهم المعروفون بالبُهرة، وقد انقسمت المستعلية سنة 999 هـ إلى فرقتين: داودية وسليمانية، والظاهر من التتبّع في كتب الإسماعيلية انّ الفرقة المستعلية القاطنين في اليمن والهند أقرب إلى الحقّوعقائد جمهور المسلمين من الدرزية و النزارية، فالفرقة المستعلية متعبّدون بالظواهر وتطبيق العمل على الشريعة بخلاف أغلب النزارية خصوصاً الدعاة المتأخرين منهم، وهم الآغاخانية فإنّهم يواجهون الأحداث الطارئة والمستجدة بالتدخل في الشريعة وتغييرها أو عدم الإلتزام بأحکامها ([10]).
4- فرقة النزارية:
وهؤلاء يسوقون الإمامة إلى المستنصر باللَّه، ثمّ يقولون بإمامة ابنه الآخر نزار بن معد، وقد انقسمت النزارية إلى: مؤمنية وقاسمية المعروفة بالآغاخانية.
الأئمّة المتّفق عليهم بين الفرق الإسماعيلية
کما تقدَّم يرجع نشوء الإسماعيلية وتكوّنهم، إلى القول بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق (ع) واستمرارها في عقبه، فکانوا ثلاثة عشر أئمّة آخرهم المستنصربالله، وهؤلاء هم الأئمّة المتّفق عليهم بين الفرق الإسماعيلية الثلاث: المستعلية، والنزارية المؤمنية، والنزارية القاسمية (الآغاخانية)، وأسماؤهم کمايلي:
1- إسماعيل بن الإمام جعفرالصادق.
2- محمد بن إسماعيل الملقّب بالحبيب (إمام مستور والقرامطة توقفوا عليه).
3- عبد اللَّه بن محمد الملقب بالرضي(إمام مستور).
4- أحمد بن عبد اللَّه الملقب بالوفي(إمام مستور).
5- الحسين بن أحمد الملقب بالتقي(إمام مستور).
6- عبيد اللَّه المهدي بن الحسين (مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب).
7- محمد القائم(المهدي الموعود)
8- إسماعيل بن محمد المنصور.
9- معد بن إسماعيل «المعز».
10- نزار بن معد «العزيز».
11- الحسن بن نزار «الحاكم بأمر اللَّه »(والدَروز توقَّفوا عليه).
12- علي بن الحسن «الظاهر».
13- معد بن علي المستنصربالله.
الأئمة المستورون عند الإسماعيلية
کان إسماعيل هو الإمام الأوّل وهو أكبر الإخوة من أبناء الإمام الصادق(ع)، مات في حياة أبيه (ع) «بالعُريض»، سنة ثلاث وثلاثين و مئة(133هـ ) ودفن بالبقيع ولمّا توفي إسماعيل حزن الإمام الصادق(ع) عليه وتقدّم سريرَه بغير حذاء ولا رداء، وأمر بوضع سريره على الأرض قبلَ دفنه مراراً، وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه، ليشهد الناس علی موته حيث كان الإمام الصادق(ع) حريصاً على إفهام الشيعة بأنّ الإمامة لم تُكْتب لإسماعيل، ولکن مع هذا روَّج بعض الشيعة بأنَّ الإمامة انتقلت من الإمام الصادق(ع) إلى ولده إسماعيل ومنه إلی ابنه محمَّد وهو أوَّل الأئمة المستورين وهکذا استمروا إلی أربعة أئمة، فالأئمّة المستورون عند الإسماعيلية هم الأئمّة الأربعة الأوائل الذين جاءوا بعد إسماعيل، ونشروا الدعوة سرا ًوكتماناً، وهم:
1- محمد بن إسماعيل الملقّب ب «الحبيب»: ولد سنة 132 هـ في المدينة المنورة، وتسلّم شؤون الإمامة واستتر عن الأنظار خشية وقوعه بيد الأعداء، ولقّب بالإمام المكتوم، لأنّه لم يعلن دعوته وأخذ في بسطها خفية، وتوفي عام 193 هـ.
2- عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل الملقّب ب «الوفي»: ولد عام 179هـ في مدينة محمودآباد، وتولّى الإمامة عام 193 ه بعد وفاة أبيه، وسكن السلْمية عام 194 هـ مصطحباً عدداً من أتباعه، وهو الذي نظم الدعوة تنظيماً دقيقاً، توفي عام 212 هـ.
3- أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل الملقب ب «التقي»: ولد عام 198، وتولّى الإمامة عام 212 هـ سكن السلمية سراً حيث أصبحت مركزاً لنشر الدعوة، توفي فيها عام 265 هـ.
4- الحسين بن أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل المقلب ب «الرضي»: ولد عام 212 هـ، وتولّى الإمامة عام 265 هـ، توفي عام 289 هـ.([11]).
الأئمة الظاهرون عند الإسماعيلية
المعروف بين الإسماعيلية انّ عبيد اللَّه المهدي- الذي هاجر إلى المغرب وأسّس هناك الدولة الفاطمية- كان ابتداءً لعهد الأئمّة الظاهرين الذين جهروا بالدعوة وأخرجوها عن الاستتار. واختلف الإسماعيلية بعد المستنصربالله إلى فرقتين، فذهبت المستعلية إلى أنّ الإمام القائم بالأمر عبارة عن كلّ من: أحمد المستعلي، الآمر بأحكام اللَّه، الطيّب بن الآمر، ثمّ جاء دور الستر فلا إمام ظاهر. لكن النزارية بكلا الفرقتين( المؤمنية والقاسمية المعروفة بالآغاخانية) قالوا باستمرار الإمامة بعد المستنصر، وکان أولهم المصطفى باللَّه نزار بن معد المستنصر (توفي عام 490 هـ ) حيث استقر بقلعة «ألموت» ،وعمل مع الحسن بن الصباح(المتوفي سنة 518 هـ )، وهکذا استمرت الإمامة فيهم حتی وصلت إلی شمس الدين. ثمّ افترقت النزارية المؤمنية والنزارية القاسمية (الآغاخانية)،فكلّ ساقوا الإمامة بعد (شمس الدين)، بشكل خاص لا يلتقيان أبداً إلى العصر الحاضر. فعدد الأئمّة عند النزارية المؤمنية بعد المستنصر يبلغ 22 إماماً،ثمَّ توقفوا، وعند الآغاخانية يبلغ 31 إماماً ، واستمروا بالإمامة إلی يومنا هذا وقد وصل عددهم إلی 41 إماماً.
إنّ الفرقة الإسماعيلية النزارية المؤمنية تقطن في عهدنا الحاضر في سورية في بلدتي «القدموس» و «مصياف» وفي مدينة سلمية و بعض قُراها، وأمّا الفرقة القاسمية النزارية الآغاخانية فتقطن في سلمية، وما يتبعها من القرى، وفي نهر الخوابي قرب طرطوس، كما تقطن في الهند، وباكستان، وبورما، والصين، وإفريقية الشرقية، و الكونغو ومدغشقر و زنجبار وغيرها([12]).
وإمام الآغاخانية اليوم هو: كريم خان، الإمام التاسع والأربعين وهو من الأغنياء ولديه أموال شرعية يتصرف بها مايشاء ووالد کريم خان هو الأميرعلي خان الذي أُقصي عن مركز الإمامة، وأُمّه هي الأميرة البريطانية (جون بربارايولد) ابنة اللورد تشارستون، تلقّى علومه الأوّلية في مدارس سويسرا، فأتقن الإنگليزية والفرنسية والإسبانية، كما درس اللغة العربية، وبعد أن أكمل تحصيله في سويسرا انتسب إلى جامعة (هارفرد الأميركية)، وكان كثير الأسفار، ويهتم بالشؤون الاقتصادية، ويتجنّب الخوض في السياسة، كما ويقوم بزيارة لإفريقية وسوريا ولبنان وإيران في العام، لتفقد شؤون أتباعه([13]).
مرجع الإسماعيلية في الأصول والفروع
المذهب الإسماعيلي كغيره من المذاهب الإسلاميّة له أُصول، وفروع، أمّا الفروع فلا يختلف أتباع هذا المذهب مع المسلمين في أُمهاتها، وكفى في الوقوف عليها ما كتبه القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي باسم «دعائم الإسلام». نعم، انفردوا في الاعتقاد بأنّ لكلِّ حكم فرعي ظاهر وباطن.
إنّما الكلام في عقائدهم وأُصولهم التي بنوا مذهبهم عليها، والعثور عليها ودراستها وبحثها على أنّها عقائد ثابتة لفرقة موحّدة، أمر مشكل لتطورها حسب البيئات والأزمان، وحسب أذواقهم في مجال التأويل. و للتستر علي مصادرعقائدهم وإخفائها وعدم جعلها تحت متناول أيدي الآخرين من قبل دعاتهم وعلمائهم.
وممَّا ظهر من کتب العقائد الإسماعيلية کتابان يمکن الإعتماد عليهما في فهم عقيدتهم ودراستها وهما: «راحة العقل»: تأليف حميد الدين أحمد بن عبد اللَّه الكرماني، الملقّب بحجة العراقين، وكبير دعاة الإسماعيليّة في جزيرة العراق، ألّفه عام (411 هـ )، وقد عاصر الفيلسوف الإسلامي الكبير ابن سينا (373- 427 هـ )، والکتاب الثاني هو: «تاج العقائد و معدن الفوائد»، تأليف الداعي الإسماعيلي اليمني المطلق علي بن محمد الوليد (522- 612 هـ ) حقّقه عارف تامر، ونشرته دار المشرق بيروت، وهذا الكتاب أسهل فهماً وأحسن تعبيراً في بيان عقائد الإسماعيلية.
وبما أنَّه لا يسع المجال ولايمکن الخوض في البحث عن جزئيات عقيدة الإسماعيلية نذکر الخطوط العريضة منها ثمَّ نرکِّز البحث حول اُمَّهاتها.
الخطوط العريضة للعقيدة الإسماعيلية
إنّ للفرقة الإسماعيلية آراءً وعقائد، سنوافيك تفاصيلها في البحوث الآتية ونذكر هنا الخطوط العريضة عندهم:
الأُولى: إنتماؤ الإسماعيلية إلى أهل البيت(ع)
من العوامل التي کان لها رصيد شعبي كبير للإسماعيلين هو ادّعاء انتماء أئمّتهم إلى بيت الوحي والرسالة، وكونهم من ذرية الرسول وأبناء بنته الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السّلام، وكان المسلمون منذُ عهدِ الرسول يتعاطفون مع أهل بيت النبيّ، وقد كانت محبتهم وموالاتهم شعار كلّ مسلم. ومن هذا المنطلق صارت الإسماعيلية تفتخر بانتماء أئمتهم إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله حتى إذا تسلّموا مقاليد الحكم وقامت دولتهم، اشتهروا بالفاطميين.
الثانية: الإسماعيلية وتأويل ظواهرالآيات والأحکام الشريعة
إنّ تأويل الظواهر والتلاعب بآيات الذكر الحكيم وتفسيرها بالأهواء والميول جعل المذهب الإسماعيلي يتطور مع تطور الزمان، ويتكيّف بمكيفاته، ولا ترى الدعوة أمامها أيمانع من مماشاة المستجدات وإن كانت على خلاف الشرع أو الضرورة الدينية.
إنّ نظرية المثل والممثول تُعدُّ الحجر الأساس لِعامّة عقائد الإسماعيليّة، التي جعلت لكلِّ ظاهر باطناً، وسمّوا الأوّل مثلًا، والثاني ممثولًا. وعليه تبتني نظرية التأويل الدينيّة الفلسفية، فتذهب إلى أنّ اللَّه تعالى جعل كلَّ معاني الدّين في الموجودات، لذا يجب أن يُستدل بما في الطبيعة على إدراك حقيقةَ الدين، فما ظهر من أُمور الدين من العبادة العمليّة، التي بيّنها القرآن معاني يفهمها العامّة، ولكن لكلّ فريضة من فرائض الدين تأويل باطني، لا يعلمه إلّا الأئمّة، وكبار حججهم وأبوابهم ودعاتهم([14]).
الثالثة: التنظيم والتخطيط للدعوة الإسماعيلية
يقول المؤرخ الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب: وبالحقيقة لم توجه أية دولة من الدول، أو فرقة من الفرق، اهتماماً خاصاً بالدعاية وتنظيمها، كما اهتمّت بها الإسماعيلية، فجعلت منها الوسيلة الرئيسية لتحقيق نجاح الحركة في دور الستر والتخفّي، ودور الظهور والبناء معاً. ولقد أحدث التخطيط الدعاوي المنظم تنظيماًعجيباً لم يسبقهم إليه أحد في العالم...، ولقد برعوا براعة لا توصف في تنظيم أجهزة الدعاية- على قِلّة الوسائل في ذلك العصر- واستطاعوا أن يشرفوا بسرعة فائقة على أقاصي بقاع البلدان الإسلامية، ويتنسموا أخبار أتباعهم في الأبعاد المتناهية. وذلك بما نظموا من أساليب وأحدثوا من وسائل. وقد كان للحمام الزاجل- الذي برع في استخدامه دعاة الإسماعيلية- أثره الفعّال في تنظيم نقل الأخبار والمراسلات السرية المهمَّة([15]).
الرابعة: الإسماعيلية و إضفاء طابع القداسة على أئمّتهم
شعرت الدعوة الإسماعيلية أيام نشوئها بأنّه لا بقاء لها إلّا إذا أضفتْ طابع القداسة على أئمّتهم ودعاتهم بحيث توجب مخالفتهم مروقاً عن الدين وخروجاً عن طاعة الإمام، لأنّ الإمامة عندهم تحتل مركزاً مرموقاً ولها درجات ومقامات مختلفة حتى أضحت من أبرز سمات المذهب الإسماعيلي کما سيأتي البحث حولها.
الخامسة: الإسماعيلية وتربية الفدائيين للدفاع عن مذهبهم
إنّ الأقلية المعارضة من أجل الحفاظ على كيانها لا مناص لها من تربية فدائيين مضحِّين بأنفسهم في سبيل الدعوة لصيانة أئمّتهم ودعاتهم من تعرض الأعداء، فينتقون من العناصر المخلصة المعروفة بالتضحية والإقدام، والشجاعة النادرة، والجرأة الخارقة، ويكلَّفون بالتضحيات الجسدية، وتنفيذ أوامر الإمام أو نائبه، وإليك أحد النماذج المذكورة في التاريخ:
في سنة 500 هجرية فكر فخر الملك ابن نظام الملك الطُّوسي وزير السلطان سنجر، أن يثأر لأبيه وهاجم قلاع الإسماعيلية، فأوفد إليه الحسن بن الصباح أحد فدائييه فقتله بطعنة خنجر. وفي سنة 501 هـ حوصرت قلعة «ألموت» من قبل السلطان السلجوقي واشتد الحصار عليها، فأرسل السلطان رسولاً إلى الحسن بن الصباح يطلب منه الإستسلام، ويدعوه لطاعته، فنادى الحسن أحد فدائييه وقال له: ألقي بنفسك من هذا البرج ففعل، وقال للثاني: اطعن نفسك بهذا الخنجر ففعل، فقال للرسول: اذهب وقل لمولاك إنّه لدي سبعونَ ألفاً من الرجال الأُمناء المخلَصين أمثال هؤلاء الذين يبذلون دماءهم في سبيل عقيدتهم المُثلى([16]).
السادسة: الإسماعيلية وكتمان الوثائق
كانت الدعوة الإسماعيلية محفوفة بالغموض و انّ الإسماعيلية كتموا وثائقهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم وكلّ شيء يعود لهم ولم يبذلوها لأحد سواهم، فصار البحث عن الإسماعيلية بطوائفها أمراً صعباً إلى أن جاء دور بعض المستشرقين فوقفوا على بعض تلك الوثائق ونشروها، وأوّل من طرق هذا الباب المستشرق الروسي الكبير البروفسور «ايفانوف» عضو جمعية الدراسات الإسلامية في «بومبايي» وبعده البروفسور «لويس ماسينيون» المستشرق الفرنسي الشهير، ثمّ الدكتور «شتروطمان» الألماني عميد معهد الدراسات الشرقية بجامعة هامبورغ، و «مسيو هانري كوربن» أُستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة طهران، والمستشرق الانكليزي «برنارد لويس».وحتى سنة 1922 ميلادية كانت المكتبات في جميع أنحاء العالم فقيرة بالكتب الإسماعيلية إلى أن قام المستشرق الألماني «ادوارد براون» بإنشاء مكتبة إسماعيلية ضخمة([17]).
نظام الإمامة عند الإسماعيلية
إنّ الإسماعيلية أعطت للإمامة أهمِّية خاصَّة، وجعلو لها رتباً ودرجات، کالإمام المقيم، والأساس و المتم والمستقر والمستودع، و ربما يضاف إليها رتبتان الإمام القائم بالقوة، و الإمام القائم بالفعل. وزوّدوا الإمامة بصلاحيات واختصاصات واسعة، وصنّفوا الأئمة إلی الأئمة المستورين الداخلين في كهف الاستتار، والأئمة الظاهرين ويملكون جاهاً وسلطاناً في المجتمع کما مرَّ. والعجب انّهم عندما بحثوا موضوع الإمامة لم يجعلوا تسلسلها من إسماعيل ابن جعفر الصادق(ع) فحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وحجتهم انّ الإمامة إذا كانت قد بدأت من هذا العهد المبكر فتكون محدثة ولا يقوم وجودها على أساس، فذهبوا إلى بدء الإمامة من عهد آدم إلى يومنا هذا، ثمّ أضافوا إلى ذلك قولهم بالأدوار، فقد جعلوا كل دور يتألف من إمام مقيم ورسول ناطق أو أساس له، ومن سبعة أئمة يكون سابعهم متم الدور. فالإسماعيلية يعتقدون بالنطقاء الستة، وانّ كلّ ناطق رسول يتلوه أئمة سبعة:
1- فآدم رسول ناطق تلته أئمة سبعة بعده.
2- فنوح رسول ناطق تلته أئمة سبعة.
3- فإبراهيم رسول ناطق جاءت بعده أئمة سبعة.
4- فموسى رسول ناطق تلته أئمة سبعة.
5- فعيسى رسول ناطق تلته أئمة سبعة.
6- فمحمّد رسول ناطق تلته أئمة سبعة، وهم: علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي الباقر، جعفر بن محمد الصادق، إسماعيل بن جعفر، وهو متم الدور، وانّ ابنه محمد بادئ للدور الآخر كالتالي:
1- محمد بن إسماعيل(إمام مستور).
2- عبد اللَّه بن محمد الملقب بالرضي(إمام مستور).
3- أحمد بن عبد اللَّه الملقب بالوفي(إمام مستور).
4- الحسين بن أحمد الملقب بالتقي(إمام مستور).
5- عبيد اللَّه المهدي بن الحسين (إمام ظاهرومؤسس الدولة الفاطمية في المغرب).
6- محمد القائم( المدَّعی بأنَّه المهدي الموعود)
7- المنصور، وبه يتم الدور.
ويرد عليهم أنّ ما ذكروه من الأدوار السبعة للإمامة و انّ كلَّ رسول ناطق تتلوه أئمّة سبعة، على النحو السابق،أمر مبنيٌّ على الظن والأساطير لا على القطع واليقين، بل الثابت في النصوص الدينيية أنَّ عدد أوصياء الأنبياء کان في الغالب إثني عشر وصياً، ومنهم الأئمة الإثنا عشرأوصياء نبيّنا محمَّد (ص)، وثانياً أنَّ هذه الدرجات والرُتب لاتزال مجهولة لدى الباحثين، ومقصورة على الإسماعيلين، وهي ممّا تخالف عقائد جمهور المسلمين([18]).
ملامح الإمامة عند الإسماعيلية
قد تعرفت على نظام الإمامة في مذهب الإسماعيلية ولكن المهم هو الوقوف على ملامح الإمامة عندهم بصورة عامة، وقد تصدّى لذكرها الداعي اليمني علي بن محمد الوليد في كتابه «تاج العقائد» ونحن ننقل منه بعض ما يبيّن عقيدتهم في الاُمور التالية:
الأمر الأول- أنّ الإمامة في آل بيت رسول اللَّه(ص):
أنّ الإمامة في آل بيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله من نسل علي وفاطمة فرض من اللَّه سبحانه أكمل به الدين فلا يتم الدين إلّا به، ولا يصحّ الإيمان باللَّه والرسول إلّا بالإيمان بالإمام والحجّة، ويدل على فرض الإمامة إجماع الأُمّة على أنّ الدين والشريعة لا يقومان ولا يصانان إلّا بالإمام، وهذا حقّ لأنّه سبحانه لا يترك الخلق سدى. ولا يمنعهم هذه الفريضة التي لا تسوغ الهداية إلّا بها. وأنّ رسول الله(ص) نص على ذلك نصاً تشهد به الأُمة كافة بقوله: «الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، وأبوهما خير منهما»، ولم يحوج الأُمّة إلى اختيارها في تنصيب الإمام، بل نص عليها بهذا لأنّ بالإمامة كمال الدين.فلو أنّ الرسول تركها حتى تكون الأُمة هي التي تفعلها ويتم بما فعلوه (في) دين اللَّه بقولهم انّ الرسول لم ينص على الوصية ولا استخلف أحداً لخرجت الإمامة عن أن تكون فرضاً على الأُمة، وكان سبيلها سبيل الولاة في كلّ زمان، القائمين بأُمور الناس...إلى أن قال: وقد اعترف المخالفون بأنّ إمامة الثلاثة ليست بنص، لأنّهم قد جحدوا النص والوصية وفيما جرى في السقيفة من الأُصول ما يجب للعاقل أن يفكر فيه وغير معيوب على المتخلّف عن بيعتهم والخلاف لهم فيها إذ كان الحال فيما تقرّر مشهوراً غير مستور، والعودة إلى الحقائق أولى لمن يعتمد عليها إذا كان طالباً للهداية مع ترك التعصب([19]).
الأمرالثاني- أنَّ الوصية من بعد النبي(ص) إلى علي بن أبي طالب(ع):
لقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله: «لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلّا و وصيته مكتوبة عند رأسه».وإجماعنا على أنّ الرسول(ص) استخلف علياً في المدينة في غزوة تبوك مقتدياً باستخلاف موسى لأخيه هارون عند مضيه لميقات ربه، وفي هذا الاستخلاف قال له: «يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي». ولحديث الدار والإنذار وقد ذكره المفسرون في تفسير قوله سبحانه: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»([20]). ويعتقد انّ كلّ من دفع الإمام عن مقامه ومنزلته وعانده بعد وصية النبي له في كلّ عصر وزمان، إنّما هو المشار إليه باسم الطاغوت، وهو رئيس الجائرين الحائدين عن أمر الرسول، المعنيّ بالظالم([21]).
الأمر الثالث- أنّ الأرض لا تخلو من حجّة للَّه:
وهذا الحجَّة إمَّا نبيّ، أو وصي، أو إمام يقوم المسائل، ويقيم الحدود، ويحفظ المراسيم، ويمنع الفساد في الشرع، ويقبل الأعمال،...محفوظ النسب، معروف الولادة، متَّبِع دينَ آبائه، لا يرجع عن أقوالهم، ولا يقدم غيرهم، ... متبوع لا تابع، مقصود لا قاصد، مرغوب في حكمه، وصحّة أفعاله، وتعاليمه، وهدايته، لأنّ الرسول جعله دليلًا للمتعلم، ونجاة للحائر([22]).
ويلاحظ علی کلام صاحب تاج العقائد من أنّ الأرض لا تخلو من حجة للَّه ليس لضرورة إقامة الحدود، وحفظ المراسم، ومنع الفساد؛ فإنّ ذلك يقوم به سائر الولاة أيضاً، وإنّما الوجه انّه الإنسان الكامل وهو الغاية القصوى في الخلقة ويترتب على وجود ذلك الإنسان الكامل بقاء العالم بإذن اللَّه سبحانه وإلى ذلك يشير الحديث النبوي: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»([23]). وقوله(ص): «إنّي و أحد عشر من ولدي وأنت يا علي زرّ الأرض، بنا أوتد اللَّه الأرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا»([24]). وقال(ص): «أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون»([25]). وقال الإمام أميرالمؤمنين(ع): «اللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم للَّه بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً»([26]).
الهوامش:
([1]) راجع فرق الشيعة للنوبختي: 69. وتاريخ الطبري 6: 147.
([2]) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد: 301.
([3]) الملل والنحل: الشهرستاني 1: 200.
([4]) إقتباس من موسوعة «الملل والنحل» لآية الله السبحاني مع تصرف في العبارات وتلخيص وإضافات.
([5]) فرق الشيعة للنوبختي: 72.
([6]) دائرة المعارف لبطرس البستاني 7 : 675.
([7]) دائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي 9: 217.
([8]) مريم: 26.
([9]) راجع خطط الشام، لمحمد كرد علي: 265.
([10]) راجع أعيان الشيعة 10: 202.
([11]) راجع موسوعة «الملل والنحل» ، لآية الله السبحاني.
([12]) راجع الإمامة في الإسلام لعارف تامر: 178-170. وموسوعة «الملل والنحل» ، لآية الله السبحاني.
([13]) راجع الإمامة في الإسلام: 237؛ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية: 403.
([14]) مصطفى غالب: في مقدمة الينابيع:.13
([15]) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب: 37.
([16]) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب: 263.
([17]) تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب: 22.
([18]) راجع الإمامة في الإسلام: 141، تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب: 37. و كشف الفوائد: 303.
([19]) تاج العقائد: 65.
([20]) الشعراء: 214.
([21]) تاج العقائد: 64. والعجب انّه لم يذكر حديث الغدير الذي اتفقت الأُمّة على نقله!
([22]) تاج العقائد: 70.
([23]) الصواعق المحرقة: 233.
([24]) الغيبة: 99، وعنه في بحارالأنوار 36 : 259 ح 79.و زرّ الأرض أي: أوتادها وجبالها.
([25]) الصواعق المحرقة: 150.
([26]) نهج البلاغه:الحكمة رقم 147.
من صفات شيعة اهل البيت(ع)
قال تعالی:] وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لَإِبْراهيمَ [([1])
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍالباقر(ع): يَا جَابِرُ أَيَكْتَفِي مَنِ انْتَحَلَ التَّشَيُّعَ أَنْ يَقُولَ بِحُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ، وَ مَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جَابِرُ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التَّخَشُّعِ وَ الْأَمَانَةِ وَ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ وَ التَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْغَارِمِينَ وَ الْأَيْتَامِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ كَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ،....([2])
إنَّ أئمة أهل البيت(ع) قدتحدَّثوا كثيراً عن صفات شيعتهم، وكان العلماء السابقون(قدس سرهم)يهتمون بتأليف الكتب حول موضوع صفات الشيعة، وذلك من أجل أن يشخّصوا معالم شخصية الشيعي، ليكون المثال الذي يقتدى به، حيث وردت نصوص عديدة عن أهل البيت(ع) تتحدث عن صفات هؤلاء الشيعة و يبدو من النصوص التي وردت عن النبي(ص) وأهل البيت(ع) التاكيد علی توفر خصوصية التقوى والورع في هؤلاء الشيعة، و من تلك النصوص المهة هو حديث جابر عن الامام الباقر (ع)حيث يعطي المعالم الاساسية لاتباع اهل البيت(ع)سنتعرف علی بعض مفرداته بعد ما نعرف معني التشيع لغةً و اصطلاحاً.
التَّشيع في اللغة، هو المشايعة أي: المتابعة والمناصرة والموالاة فالشيعة بالمعنى اللغوي هم الأتباع والأنصار([3]) وبهذا المعنى اللغوي استعمل القرآن الكريم لفظة الشيعة كما في قوله تعالى : ]وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لَإِبْراهيمَ[ ([4]) اي: كان النبي ابراهيم الخليل(ع)علی سنة النبي نوح(ع) قولاً و عملاً و كان بينهما( 2640 سنة) و كان بينهما هود و صالح، و كقوله تعالى : ]وَ دَخَلَ الْمَدينَةَ عَلى حينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى الَّذي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ ...[.([5])
وكلمة (شيعة) في حد ذاتها و بمعناها اللغوي ليس لها قداسة خاصة، و كماتطلق علی اهل الحق، تطلق علي اتباع الباطل ايضاً ،كما في قول الامام الحسين (ع) لجيش يزيد بن معاوية :«يا شيعةَ آل ابي سفيان إن لم يكن لكم دين وکنتم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم».
التشيع في الإصطلاح: هو إسم لمذهب أتباع الامام علي(ع) الذين يعتقدون بولايته و امامته بلافصل من بعد النبي(ص)، قال الشهيد الثاني في كتابه شرح اللمعة: «و الشيعة من شايع علياً - أي اتبعه وقدمه على غيره في الإمامة و إن لم يوافق على إمامة باقي الأئمة، فيدخل فيهم الإمامية و الجارودية من الزيدية و الإسماعيلية غير الملاحدة منهم و الواقفية والفطحية».([6])
إذن جوهر التشيع هو الالتزام بإمامة علي و ولده، وتقديمه على غيره لوجود نصوص في ذلك، و ينتج من ذلك أن الإمامة امتداد للنبوة يترتب عليها ما يترتب على النبوة من لوازم عدى الوحي فإنَّ نزوله مختص بالأنبياء، و أنَّ الإمامة لاتتم بالانتخاب و الاختيار و إنَّما بالتعيين من الله تعالى فهو الذي ينص على الإمام عن طريق النبي، و إنما يختاره لتوفر مؤهلات عنده لاتوجد عند غيره.
وبعد ماعرفنا معنی الشيعة والتشيُّع لغة و إصطلاحاً، السؤال الذي يطرح دائماً، من هم الشيعة الحقيقيون الناجون يوم القيامة؟
الإمام الصادق(ع) والخراساني
حدّث إبراهيم عن أبي حمزة عن مأمون الرقي قال: كنت عند سيدي الصادق(عليه السلام) إذ دخل سهل بن حسن الخراساني فسلّم عليه ثم جلس فقال له: يا ابن رسول الله لكم الرأفة و الرحمة و أنتم أهل بيت الإمام، ما الذي يمنعك أن يكون لك حقّ تقعد عنه و أنت تجد مِن شيعتك مئة الف يضربون بين يديك بالسيف؟ فقال(ع) له:«اجلس يا خراساني رعى الله حقك»، ثم قال(ع): «يا حنيفة اسجري التنّور»، فسجرته حتى صار كالجمرة وابيضّ علوه، ثم قال(عليه السلام): «يا خراساني قم فاجلس في التنّور»، فقال الخراساني: يا ابن رسول الله لاتعذبني بالنّار، أقلني أقالك الله، قال(ع):« قد أقلتك». فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في سبابته، فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، فقال له الصادق(ع) :« القِ النّعل من يدك واجلس في التنور»، قال: فألقى النعل من سبابته، وأقبل الإمام يحدّث الخراساني حديث خراسان حتّى كأنّه شاهد لها، ثمّ قال(ع):« قم يا خراساني وانظر ما في التنّور»، قال: فقمت إليه فرأيته متربّعاً فخرج إلينا وسلّم علينا، فقال له الإمام(ع):« كم تجد بخراسان مثل هذا»؟ فقلت: والله ولا واحد. فقال(ع):« لا والله ولا واحد، أما إنّا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت»([7]).
هل يكفي حب أهل البيت(ع)؟
يا تري أَيَكْتَفِي مَنِ انْتَحَلَ التَّشَيُّعَ أَنْ يَقُولَ بِحُبِّ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ هذه شبهة في سياق سؤال، كانت و لاتزال موجودة عند بعض منتحلي مذهب التشيع، و هي أنَّهم قد يكتفون بمجرد الإدعاء لحبِّ أهل البيت(ع)، و أنَّ ذلك الحب أو إدعاءُه يكفيهم في تحصيل النجاة، مع أنَّهم –في سيرتهم غالباً– مخالفون لأهل البيت(ع)، و منشأ هذه الشبهة عندهم هو ما تواتر عن النبي الصادق الأمين(ص) وأهل بيته(ع)، في ما رواه الخاصة و العامة من البشائر العديدة لشيعة أهل البيت (ع) و محبيهم و انَّهم هم الناجون لا غير، و الواقع أنَّ تلك البشائر هي حقيقة ثابتة لاينكرها إلا جاهل أو معاند، و لكن السئوال الذي يُطرح دائماً من هم شيعتهم الحقيقيون؟([8])
ويجيب الإمام الباقر(ع) عن هذا الاستفهام فيقول مقسماً بالله العظيم لتأكيد واقعية جوابه: فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ وَ... و هذه الصفات كلها –في الحقيقة و الواقع– قلَّ من اجتمعت فيه من شيعة أهل البيت(ع) و من هنا قال جابر الجعفي الراوي عن الإمام الباقر(ع)حديثه هذا قال: قلت له: يابن رسول الله ما نعرف أحداً بهذه الصفة؟ (الصفات) فأجاب الإمام(ع): يَا جَابِرُ لَا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ أُحِبُّ عَلِيّاً وَ أَتَوَلَّاهُ ثُمَّ لَا يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَالًا فَلَوْ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ فَرَسُولُ اللَّهِ(ص) خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ(ع) ثُمَّ لَا يَتَّبِعُ سِيرَتَهُ وَ لَا يَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ مَا نَفَعَهُ حُبُّهُ إِيَّاهُ شَيْئاً فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَ اعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ، أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ أَتْقَاهُمْ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ، يَا جَابِرُ وَ اللَّهِ مَا يُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا بِالطَّاعَةِ، وَ مَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ لَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ، وَ مَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، وَ مَا تُنَالُ وَلَايَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعِ([9]).
ومن المسلَّم انَّه لا تنال ولاية أهل البيت(ع) إلاَّ بالعمل الصالح و الورع عن المحرَّمات، و يؤيد ذلك ما ورد عن الإمام الرضا(ع) أنه قال: «لاتدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتِّكالاً على حبِّ آل محمد(ص) و لاتدعوا حبّ آل محمد و التسليم لأمرهم اتكالاً على العبادة فإنَّه لا يقبل أحدهما دون الآخر... الخ»([10]).
وإذا جمع العبد المؤمن بين حبِّ آل محمد(ص) و بين العمل الصالح فهو الناجي، بل هو الذي تكون له الدرجات العالية و المقامات السامية عندالله و رسوله و أهل بيته، و يكون محبوباً عند أئمته فحينئذٍ يغتمّون لغمّه و يفرحون لفرحه كما في قول إمامنا أبی الحسن الرضا(ع) في حديث له: «من عادی شيعتنا فقد عادانا، و من والاهم فقد والانا، لأنَّهم منَّا، خلقوا من طينتنا، و مَن أحبَّهم فهو منَّا، و مَن أبغضهم فليس منَّا، شيعتنا ينظرون بنورالله، ...، ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، و لا اغتمَّ إلا اغتممنا لغمه، و لايفرح إلا فرحنا، ...»([11]).
اذن لابدَّ من توفر خصوصية التقوى و الورع فيمن يدَّعي التشيُّع حتی يصدق عليه هذا الإسم والعنوان، فينبغي ان نركز البحث علي هذه المفردة من الحديث ثمَّ الكلام حول المفردات الأخری.
شِيعَتُنَا أهل التقوی
التقوى لغةً، مأخوذة من الوقاية، و الوقاية تعني الحذر و الاحتراز و البعد و الاجتناب، و لها مراتب بحيث كلما كان الحذر و الاجتناب أكثر كانت التقوى أكمل، و لكن مجرد الحذر و الاجتناب عن شيء ليس معناه التقوى المطلوبة في الإسلام، و إنّما التقوى التي دعا إليها الإسلام و أكد عليها القرآن الكريم عبارة عن قوة روحية نفسية تتولد في الإنسان بسبب التمرين على العمل الذي يحصل منه الحذر و الاجتناب من الذنوب([12]).
وأما التقوى في الإصطلاح الإسلامي فهو اجتناب ما حرّم الله وإتيان ما أوجبه على العبد، كما جاء هذا المعنى في كثير من الروايات، و إذا ترك الإنسان المحرمات و المكروهات و حتى المشتبهات و عمل بالمستحبات فهذا هو الورع.
و إنَّ للتقوى آثاراً عظيمةً جدَّاً تعود فوائدها إلى الفرد المتقي، و المجتمع ، نذكر بعضها:
آثار التقوى في الدُّنيا والآخرة
أولاًـ بالتَّقوى خروج من الضيق: الإنسان في هذه الدنيا غالباً ما يتطوق بالمصائب و الابتلاءات، و هذه الابتلاءات على نوعين، فمنها ما يتمكن الإنسان من حلِّها، و رفع مشاكلها، و منها ما لايتمكن من حلِّها، و يقف عاجزاً أمام هذا النمط منها، و ليس لـه أدنى حول، إلاَّ أن يغيثه الله تبارك وتعالى، و يخرجه من هذا الضيق، و بالتقوى يخرج المتقون من هذا الضيق، و تحلّ مشاكلهم، يقول تعالى: ]وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لـه مَخْرَجاً[([13])، أي من الضيق، ويقول تعالى: …]وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لـه مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً[،([14]) و عن أمير المؤمنين(ع) لأبي ذر: «... ولو أنَّ السَّماوات والأرض كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى الله لجعل الله لـه منهما مخرجاً... »([15]).
ثانياًـ بالتقوى تُدَّر الأرزاق: إنَّ من أكثر ما يشغل بال الفرد في المجتمع الرزق، و كم يسعى لتحصيله، و كم ينفق من عمره في سبيل تحصيل قوته و قوت عياله، و يمكننا القول بأنَّ حركة المجتمعات البشرية في معظم الأوقات تفرغ في سبيل تحصيل الرزق و القوت، و لاريب أنَّ من أهمِّ العوامل التي تحقق للإنسان رزقه و ما يكفيه، هو التقوى، قال تعالى: ]وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لـه مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ[([16]).
ثالثاًـ بالتقوى تقبل الأعمال: لا شكَّ أنَّ أهم ما يهتم به المؤمن أن يقبل الله أعماله التي يقوم بها من الطَّاعات کالصلاة و الصيام و الزكاة و الحج، و کثير من الأعمال الحسنة و الخيرات.
ودائماً يخاف الإنسان من أن لا تكون هذه الجهود من عباداته موضع قبول الله تعالى، و الطريق الذي رسمه الله تعالى لقبول الأعمال هو التقوى، قال تعالى: ]إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ[([17])، فالتقوى سبب من أسباب القبول، بل هي السبب الوحيد بدلالة إفادة (إنَّما) على الحصر، و قد وردت هذه الآية في قصة هابيل و قابيل ابني آدم حيث اختلفا في أمر فحكّما فيه أباهما آدم، فأشار عليهما أن يقدِّما قرباناً إلى الله فمن يتقبل الله قربانه يكون هو الصائب، فقدم قابيل عنزاً، و قدم هابيل كبشاً عظيماً و سنابل قمح، و كانت علامة القبول، أن يضعا القربانين على جبل فإذا نزلت النار و أكلت قربان أحدهما دل ذلك على قبول الله له، و فعلاً نزلت النار على قربان هابيل وترکت سنابل القمح، فتعجب قابيل، و استغرب من قبول الله السنابل و الكبش، فقال لـه أخوه هابيل: ]إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ[ ([18])، فعظمة العمل و كثرته لا تعدوا شيئاً عند الله إلاّ بالتقوى، و من هنا قال علي(ع): «لا يقِّل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل»([19])، و مما أوصى به رسول الله(ص) أباذر، قال: يا أباذر كن للعمل بالتقوى أشدّ اهتماماً منك بالعمل»([20]).
رابعاًـ بالتقوى تنال كرامة الله تعالى: لقد خلق الله تعالى الإنسان كريماً، قال تعالى: ]وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ[ و إنّما يذِّل و يهان بالمعاصي والذنوب، و هذه الكرامة أعطاها و وهبها لجميع البشر على نمط واحد، و بحد متساوٍ، غير أنَّه بامكان كل فرد من البشر أن يصبح أكرم من سائر الأفراد و ذلك بالتقوى، قال تعالى: ]يا أيّها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ[([21]).
خامساًـ بالتقوى ينال الإنسان الجنة: قال تعالى: ]إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ[([22])، وقال تعالی: ]جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ[([23]).
ولعل أعظم الآثار للتقوى، تعكسها خطبة المتقين لأمير المؤمنين(ع)في نهج البلاغة، و لايسع المجال لذكرها وشرحها،([24]) و هناك آثار أخرى عزفنا عن ذكرها مراعاة للاختصار.
صدق الحديث وأداء الأمانة
و من أهمِّ صفات شيعة أهل البيت(ع) صدق الحديث و أداء الأمانة و قد وردت احاديث أهل البيت(ع) لتؤكِّد هذتين الصفتين كثيراً فقد روى عن الصادق(ع) أنَّه قال: « إنَّ اللّه عزوجل لم يبعث نبياً إلاّ بصدق الحديث وأداء الامانة إلى البرِّ والفاجِر» ([25])، و عنه(ع): «لاتغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم; فإن الرجل ربما لهج بالصلاة و الصوم حتى لو تركه استوحش، و لكن اختبروهم عند صدق الحديث و أداء الامانة»([26]). عن أبي عبد اللّه(ع) قال : « كونوا دعاة للناس بالخير بغير السنتكم; ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع »([27]).
و الصدق هو زينة الحديث كما جاء عن النبي(ص) قوله: «زينة الحديث الصدق» ([28]) و قد عرف عن رسول اللّه(ص) أنه كان يوصف قبل البعثة بالصادق الامين و كان لهذه الصفة دور مهم في التأثير على مسيرة الدعوة الاسلامية.
و الأمانة: شيء يودع عند شخص ليحتفظ به ثم يردّه إلى مَن أودعه عنده، أو ليقضي به مآربه ثم يرجعه إليه، فهناك أناس يؤدون الأمانة إلى أهلها، و هناك أناس يخونونها، فمن صفات شيعة أهل البيت(ع) الإلتزام بأداء الأمانة طاعة لله و تبعاً لأئمتهم(ع).
وقد أكَّد القرآن الكريم هذه الصفة فأمر بها و وصف عباده المؤمنين بها في آيات عديدة، كما وصف بها بعض أنبيائه في مقام التأكيد لأهميتها ، و منه قوله تعالى: ]والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون[ ([29]) و نهى عن الخيانة في الامانة في قوله تعالى: ]يا أَيُّها الذين آمَنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون[([30])
ونشير بهذه المناسبة إلى ما ورد من أن أحد العلماء كتب إلى السيد المرتضى يسأله –فيما معناه- أن أحداً إذا اعتدى على أحدٍ و قطع يده فعليه الدية، و قدرها خمسمائة دينار ذهباً، في حين لو سرق أحد أحداً ربع دينار يحكم عليه الشرع بقطع يده و يجب أن تقطع يده.
و وجه السؤال أن اليد هل قيمتها خمسمائة دينار، و نظم له هذا المعنى شعراً فقال:
يد بخمس مئين عسجداً وُديت ما بالها قُطعت في ربع دينار
فأجابه السيد المرتضى: اليد إذا كانت أمينة كانت ثمينة، و إذا خانت هانت، و نظم هذا المعنى شعراً فقال:
عِزُّ الأمانة أغلاها، وأرخصَها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري
الشيعةوكثرة ذكر الله تعالى
ومن صفات الشيعة في حديث جابر هو كثرة ذكر الله وقد جاء في حديث الامام الصادق(ع):«شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا اللّه كثيراً»([31]).
والذكر مجموع الكلمات التي يذكر بها اللّه تعالى بالثناء و التمجيد أو الاستعانة، من قبيل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه اكبر و الخ...، و أيضاً الاستغفار و الدعاء بالصلاة على النبي محمد و آله([32]).
والذكر بهذا المعنى الواسع عبادة من العبادات الاسلامية التي حث عليها القرآن الكريم في كثير من آياته، قال تعالى: ]واذكر اسم ربك بكرة واصيلاً [ ([33])و قال تعالى: ]يا أَيُّهَا الذينَ آمَنوا اذكُروا اللهَ ذِكراً كَثيراً وَسَبِّحُوهُ بُكرَةً وَ أَصيلاً[([34])
ومن أهمِّ مواضع الذكر عند تظافر النعم على الانسان، و في الحاح الفقر، قال رسول اللّه(ص):« من تظاهرت عليه النعم فليقل الحمد للّه رب العالمين، و من ألحَّ عليه الفقر فليكثر من قول لا حول و لا قوة إلاّ باللّه العلي العظيم; فإنه كنز من كنوز الجنة و فيه الشفاء من اثنين و سبعين داء أدناها الهم»([35])
و ذكر الله على قسمين، ذكر في اللسان كالأدعية و الاستغفار و ما شابه ذلك من التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير، و القسم الثاني هو ذكرالله تعالى في ما أحلَّ و حرَّم، أي يذكر الإنسان ربَّه فيما أباحه له و أمره به فيأتي به، و ما حرَّمه عليه و نهاه عنه فيتركه، و القسم الأول هو المقصود من قول الإمام الباقر(ع) في وصف الشيعة بكثرة ذكر الله، و هذا الذكر هو الدواء الناجع النافع للإنسان الذي يريد صلاح نفسه و رضا ربّه، و قد يكون إلى هذا القسم من الذكر يشير الشاعر بقوله:
وإذا سقمت من الذنوب فدواها بالذكر إنَّ الذكر خير دواء
الشيعة و موالاة أهل البيت(ع)
ومن أظهر صفات شيعة أهل البيت(ع) و أهمها التي توجب لهم النجاة، و يمتازون و يعرفون بها، هي موالاة أهل البيت(ع) و البراءة من أعدائهم، و الفرح لفرحهم، و الحزن لحزنهم، قال إمامنا أميرالمؤمنين(ع) في حديث له:« إنَّ الله تبارك و تعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منا وإلينا»([36]).
وقال(ع) في حديث آخر:« رحم الله شيعتنا والله هم المؤمنون، فقد والله شاركونا في المصيبة بطول الحزن والحسرة »([37]).
شيعتنا يحزنون لحزننا
قدتعرض أهل بيت النبي(ص) لأنواع الأذى و الظلم و الاضطهاد في سبيل حفظ الإسلام من الانحراف، بوقوفهم ضد الظالمين، من الحكّام الأمويين و العباسيين، و قد حدّثنا التاريخ و روايات أهل البيت (ع) عن بعض ما وقع عليهم من الظلم و الاضطهاد، بحيث يقول الإمام الحسن(ع) في حديثه بعد قتل أبيه أميرالمؤمنين(ع): حدثني جدي رسول اللّه (ص) «أنَّ الأمر يملكه إثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ما منّا إلاّ مقتول أو مسموم»([38]).
إنَّ شيعة أهل البيت(ع) قد شاركوا أهل البيت(ع) في مصائبهم بطول الحزن و الأسی خصوصاً على مصاب الإمام الحسين(ع) و من هنا تراهم في أيام عشرة المحرم بالخصوص في غاية الحزن و البكاء حيث أن أئمتهم كانوا كذلك، إذا هل هلال المحرم تراكمت عليهم الهموم و الغموم و اجتمعت عليهم الأحزان و الكروب و كانوا يعقدون مجالس العزاء، و يأمرون من يدخل عليهم من الشعراء بالرثاء و الإنشاد، فكان الإمام الصادق(ع) إذا هل هلال عاشوراء اشتد حزنه و عظم بكاؤه على مصاب جده الحسين(ع) و كان الناس يأتون إليه من كل جانب و مكان يعزونه بالحسين(ع) و يبكون معه على مصابه.
و في خبر عن الإمام الرضا(ع): «كان أبي إذا هلَّ المحرم لا يرى ضاحكاً وك انت الكآبة تغلب عليه حتي تمضي منه عشرة أيام، فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول(ع): هواليوم الذي قتل فيه جدي الحسين»([39]).
الإمام الرضا(ع)و أيام محرَّم
دخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا(ع)، و لعلَّه کان في أيام المحرم فرآه و قد عقد مجلس العزاء، و هو جالس جلسة الحزين الكئيب و أصحابه من حوله كذلك، قال دعبل: فلما رآني مقبلاً قال لي:« مرحباً بك يا دعبل، مرحباً بناصرنا بيده و لسانه»، ثم إنه وسَّع لي في مجلسه و أجلسني إلى جنبه، ثم قال لي: «يا دعبل أحب أن تنشدني في الحسين شعراً، فإنَّ هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، و أيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني أمية، يا دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا، و بكی لما أصابنا من أعدائنا، حشره الله تعالي معنا في زمرتنا، يا دعبل من بكی علی مصاب جدي الحسين(ع)غفرالله ذنوبه»، ثم إنه نهض وضرب ستراً بيننا و بين حرمه، و أجلس أهل بيته من وراء الستر ليبكوا علی مصاب جدهم الحسين(ع)، ثم التفت إلیَّ و قال: «يا دعبل ارثِ الحسين(ع)، فأنت ناصرنا و مادحنا فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت ما دمت حيا»، قال دعبل فاستعبرت و سالت عبرتي و أنشأت أقول:
أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً وقد مات عطشاناً بشط فرات
إذاً للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضِ فلاة
قبور بجنب النهر في أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرات[40]
توفوا عطاشی بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي
الهوامش:
[1]- الصافات: 83
[2]- الكافى: 2 : 74 ، صفات الشيعه : 11.
[3]- القاموس المحيط وكتاب المنجدفي اللغة: مادة شاع.
[4]- الصافات: 83.
[5]- القصص:15.
[6]- شرح اللمعة 2 : 228
[7]- مناقب آل ابي طالب4: 237، بحار الأنوار 47: 127،ب5.
[8]- راجع ما روى من البشائر لشيعة أهل البيت(ع) كتاب فضائل الشيعة، للصدوق وبحار الانوار ج 68 باب فضائل الشيعة.
[9]- الكافى: 2 : 74 ، صفات الشيعه : 11.
[10]- راجع بحار الأنوار 78 : 347.
[11]- صفات الشيعة للصدوق: 4، ونقله عنه المجلسي في بحار الأنوار68 : 167.
[12]- هذا التعريف للتقوى هو المشهور بين علمائنا لا سيما عند الإستاذ الشهيد مطهري.
[13]- الطلاق: 2.
[14]- الطلاق: 4.
[15]- بحار الأنوار 22: 411، ح30.
[16]- الطلاق: 2،3.
[17]- المائدة: 27.
[18]- المائدة: 27.
[19]- بحار الأنوار 6: 38 ح62.
[20]- كنز العمال: 851.
[21]- الحجرات: 13.
[22]- الحجر: 45.
[23]- النحل: 31.
[24]- لقد ذکرنا بعض فقراتها في الجزء الأول من الموسوعة فراجع.
[25]- الكافي 2 : 104 ، ح 1 .
[26]- الكافي 2 : 104 ، ح 2 .
[27]- الكافي 2 : 105 ، ح 10 .
[28]- الأمالي للصدوق : 292، بحار الانوار71:9.
[29]- المؤمنون : 8 .
[30]- الأنفال: 28.
[31]- جامع احاديث الشيعة 15: 367 ،الباب 5 ، ح 2
[32]- الظاهر أن الاستغفار و الصلاة على النبي محمد(ص) و آله من الدعاء و ليس من الذكر، و لكنَّها تذكر لمشابهتها الذِّكر في البناء اللفظي في جمل قصيرة، و أيضاً لانه ورد في استحبابها تكرارها في بعض المواضع مرات عديدة، شأنها في ذلك شأن الذكر، و لذا يتم الحديث عنها في هذا الباب، كما أنه ورد في بعض الروايات أن الصلاة على النبي(ص) تعوض عن ذكر اللّه و تسبيحه (الشهيد السعيد سيدباقر الحكيم).
[33]- الانسان : 25 .
[34]- الأحزاب: 42-43.
[35]- جامع احاديث الشيعة 15: 385 ، ح 1 .
[36]- الخصال للصدوق: 635، بحار الأنوار 44: 278.
[37]- اللهوف :137، بحار الأنوار43: 221ب8.
[38]- كفاية الأثر: 160.
[39]- الأمالي للصدوق 128، المجلس 27، بحار الأنوار44: 383ب34.
[40]- المعرس : بفتح الراء و تشديدها هو المكان.
المولوي سلامي يؤكد ضرورة تعزيز الوحدة الاسلامية في المجتمع
أکّد ممثل أبناء محافظة سیستان وبلوشستان(جنوب شرق إیران ذات الغالبیة السنیة) فی مجلس خبراء القیادة فی ایران أنه یجب علی المجتمع الدیني السعي إلی الحد من التفرقة، والحرکة نحو تعزیز الوحدة، والتقارب والتآزر.
وصرح المولوی نذیر أحمد سلامي أنه یتفق العقلاء جمیعاً علی أن السعادة الدنیویة تتوقف علی التعایش السلمي بین جمیع الشعوب، واحلال السلام، والوحدة فی العالم، مضیفاً أن موضوع الوحدة، والتقارب یعتبر إستراتیجیة عامة ومستمرة، حسب الرؤیة الشرعیة.
وشدد علی أن الوصول إلی الکمال لایمکن إلا بأداة الوحدة، والتعایش السلمي، لافتاً إلی أن مصالح المجتمع البشری تتحقق فی ظل الوحدة، وأن الصراع لایزال یلعب دوراً هداماً، ویعد أکبر عائق أمام تحقیق الأهداف.
واشار الى أن السذاجة لدی المسلمین تسهم فی ظهور الأعداء الداخلیین والأجانب، مؤکداً أن القضاء علی الأمة الإسلامیة هو غایة الأعداء، فینبغي علی المسلمین مواجهة هذا المخطط بأداة الوحدة، والتضامن، ومعرفة المؤامرات.
وأکّد ممثل أبناء محافظة سیستان وبلوشستان فی مجلس خبراء القیادة فی ایران علی ضرورة معرفة الأعداء، لافتاً إلی أنه لایمکن التخلص من مخططات ومخادع الأعداء مادام لم یتم التعرف علیهم.
واعتبر سلامي أن الأحداث الأخیرة التی تشهدها المنطقة، وتزاید محاولات الأعداء الرامیة إلی النیل من الإسلام تنبهنا إلی ضرورة الحفاظ علی الحدود الدینیة والجغرافیة، مؤکداً أنه یسعی الأعداء إلی تجزئة الدول الإسلامیة وإضعافها.
وأکّد العالم السني علی ضرورة حفظ الوحدة بین الشیعة والسنة، مصرحاً أن الصراع بین الحق والباطل هو صراع قدیم شهدته مختلف العصور، إلا أن الإنتصار قدکان دوماً للحق، وأن الباطل محکوم علیه بالفشل، حسب ما جاء فی القرآن الکریم.
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾
نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام لعام 1436 هـ ق
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد الخلق أجمعين محمد و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين، و على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
و السلام على الكعبة الشريفة، مقرّ التوحيد و مطاف المؤمنين و مهبط الملائكة، و السلام على المسجد الحرام و عرفات و المشعر و منى، و السلام على القلوب الخاشعة، و الألسنة الذاكرة، و الأعين المفتحة بالبصيرة، و الأفكار المستلهِمة للعبرة، و السلام عليكم أيها الحجاج السعداء الذين توفقتم لتلبية الدعوة الإلهية، و تحلقتم حول هذه المائدة المليئة بالنعم.
الواجب الأول هو التأمّل في هذه التلبية العالمية التاريخية الدائمة: إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك. كل الحمد و الثناء له، و كل النعم منه، و كل الملك و القدرة له.. هذه هي النظرة التي تُمنَحُ للحاجّ في الخطوة الأولى من هذه الفريضة الطافحة بالمعاني و المغزى، و التي تستمر هذه المناسك بما يتناغم معها، من ثم توضعُ نصبَ عينيه كتعليمة باقية و درس لا ينسى، و يطلب منه تنظيم برامج حياته على أساسها. تعلمُ هذا الدرس الكبير و العمل به هما الينبوع المبارك الذي يمكنه إضفاء النضارة و الحيوية و التوثب على حياة المسلمين، و تحريرهم مما يعانون منه من معضلات في زمانهم هذا و في كل زمان. صنم النزعات النفسية و الكبر و الشهوة، و صنم طلب الهيمنة و الخضوع للهيمنة، و صنم الاستكبار العالمي، و صنم الكسل و اللامسؤولية، و كل الأصنام المُهينة للنفس الإنسانية الكريمة، ستتحطم بهذه الصرخة الإبراهيمية عندما تخرج من أعماق الفؤاد و تغدو برامج حياة، و ستحلّ الحرية و العزة و السلامة محلّ التبعية و الشدة و المحنة.
ليفكّر الإخوة و الأخوات الحجاج، من أيّ شعب و بلد كانوا، في هذه الكلمة الإلهية الحكيمة، و لتكن لهم نظرتهم الدقيقة لمعضلات العالم الإسلامي، خصوصاً في غرب آسيا و شمال أفريقيا، النظرة التي يهتدون بها في ضوء الإمكانات و الطاقات الشخصية و المحيطة، إلى تعيين واجبات و مسؤوليات لأنفسهم، و السعي لأدائها.
السياسات الشريرة لأمريكا في هذه المنطقة اليوم، و الباعثة على الحروب و سفك الدماء و الدمار و التشرد، و كذلك الفقر و التخلف و الخلافات القومية و الطائفية، من ناحية، و جرائم الكيان الصهيوني الذي أوصل سلوكه الغاصب في بلد فلسطين إلى ذروة الشقوة و الخبث، و إهاناته المتكررة لحريم المسجد الأقصى المقدس، و سحقه أرواح الفلسطينيين المظلومين و أموالهم من ناحية أخرى، هي قضيتكم الأولى جميعاً أيها المسلمون، و التي يجب أن تفكروا فيها و تعرفوا واجبكم الإسلامي حيالها. و على علماء الدين و النخب السياسية و الثقافية واجبات أثقل بكثير، يغفلون عنها غالباً للأسف. ليتعرف العلماء بدل تأجيج نيران الخلافات الطائفية، و السياسيون بدل الانفعال مقابل الأعداء، و النخب الثقافية بدل الانشغال بالأمور الهامشية، ليتعرفوا على الوجع الكبير الذي يعاني منه العالم الإسلامي، و ليتقبلوا رسالتهم التي هم مسؤولون عن أدائها أمام محضر العدل الإلهي، و ليتحمّلوا أعباءها بكفاءة. الأحداث المُبكية في المنطقة، في العراق و الشام و اليمن و البحرين، و في الضفة الغربية و غزة، و في بعض البلدان الآسيوية و الأفريقية الأخرى، هي المعضلات الكبرى للأمة الإسلامية التي ينبغي مشاهدة بصمات مؤامرة الاستكبار العالمي فيها، و التفكير في علاجها. على الشعوب أن تطالب ذلك من حكوماتها، و على الحكومات أن تفي لمسؤولياتها الجسيمة.
و الحج و تجمّعاته العظيمة أرقى مكان لظهور و تبادل هذا الواجب التاريخي.
و فرصت البراءة - التي ينبغي اغتنامها بمشاركة كل الحجاج من كل مكان - من أبلغ المناسك السياسية في هذه الفريضة الجامعة للأطراف.
الحادثة المريرة الفادحة الخسارة التي وقعت في المسجد الحرام هذه السنة، أصابت الحجاج و شعوبهم بالمرارة. صحيح أن المتوفّين في هذا الحادث، و الذين كانوا يؤدون الصلاة و الطواف و العبادة، سارعوا للقاء الله و نالوا سعادة كبرى و ثووا - إن شاء الله - في حريم أمن الله و رعايته و رحمته، و هذا عزاء كبير لذويهم، بيد أن هذا لا يمكنه التقليل من ثقل مسؤولية الذين تعهدوا بتوفير أمن ضيوف الرحمن. العمل بهذا التعهد و أداء هذه المسؤولية مطلبنا الحاسم.
و السلام على عباد الله الصالحين
السيد علي الخامنئي
4 ذي الحجة 1436
و 27 شهريور 1394 هجرية