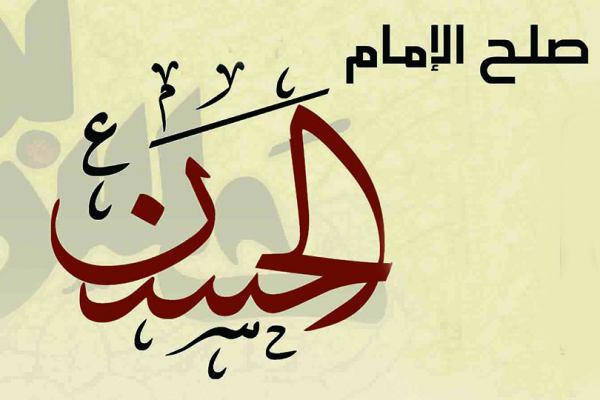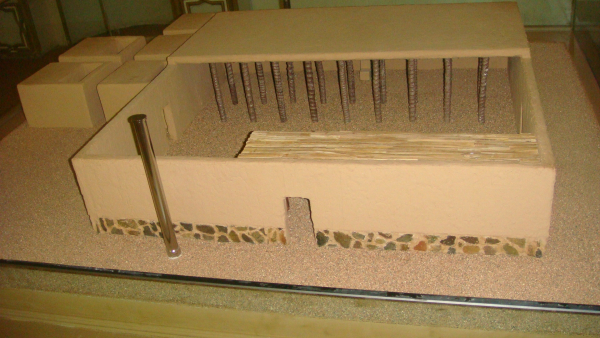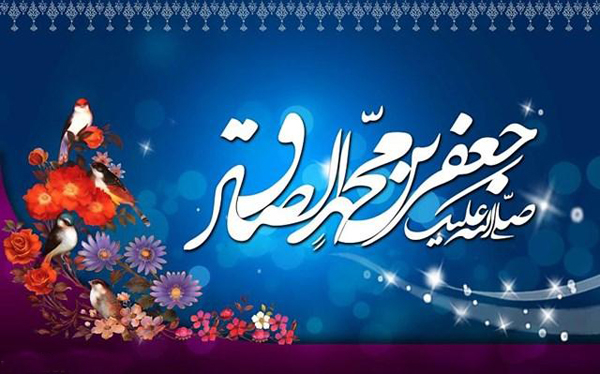Super User
سقوط دولة بني أمية (13/ ربيع الثاني/ السنة 132 هـ)
في رواية يؤكّدها الطبري، أصلها أن العباس بن عبد المطلب رأى أن دبابير تخرج من ظهره وتلدغ ظهر النبي(ص) ، فأوّلها النبي(ص) أنّ ذرية العباس تقتل ذريته (ص) ، وإنها تملك.
«وكان بدء ذلك فيما ذكر عن رسول الله(ص) أنه أعلم العباس بن عبد المطلب أنه تؤول الخلافة إلى ولده، فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويحدثون به بينهم..»([1]).
واتخذوا لذلك وسيلة الدعوة إلى آل محمد، واستفادوا كثيراً من هذه الوسيلة بل ربحوا قادة كبار جنّدوهم في سبيل الوصول إلى غايتهم، من ذلك أبو سلمة الذي كانوا يسمّونه وزير آل محمد والذي قتلوه حين استنفذوا غايتهم.
اعتبرت ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر عام (132هـ)([2]) حيث بويع أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بالخلافة هو يوم قيام الدولة العباسية..
أسباب سقوط الدولة الأموية
يذكر المؤرّخون عدة أسباب لسقوط الدولة الأموية، منها المنطقي المعقول، ومنها غير ذلك مما توحي به النفوس المريضة والأبصار الزائغة عن الحق. والسبب الرئيسي والأساسي لسقوط الأمويين، هو فسادهم وانحرافهم عن الدين وطعن الدين باسم الدين، فقتلوا عترة رسول الله(ص) ، فبدؤوا بسبطي النبي(ص) وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين(ع) وسبوا حريمهم، ومن قبل قتلوا عمار بن ياسر قتيل الفئة الباغية، وقتلوا حجراً، وأمَّروا أولاد الزنا، وعاثوا في الأرض فساداً على أيد العتاة المردة من جلاوزتهم أمثال بسر بن أرطاة، وعبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد، وشمر، والحجاج بن يوسف الثقفي، وغيرهم من المجرمين.
فمنذ مقتل الحسين(ع) بدأت الثورات ضد الحكم الأموي تتوالى، وكأنّ دم الحسين(ع) استصرخهم، واشتعلت الثورة ابتداءً من خطبة زينب (س)، إلى استنكار عام لهذا العمل الفظيع الذي تبلور فيما بعد في واقعة الحرة وانتفاضة المدينة، وثورة التوابين، وثورة المختار الثقفي، وثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث التي انضم إليها الشيعة والعباد والقرّاء وحتى الخوارج والمسيحيون([3])، وثورة يزيد بن المهلب، وثورة المطرف بن المغيرة([4])، ثم ثورة زيد بن علي بن الحسين(ع)([5])، ثم انتفاضة يحيى بن زيد، حتى ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، وأبي مسلم الخراساني([6]).
وكان كل المناهضين للحكم الأموي ومهما اختلفوا يتخذون آل بيت النبي(ص) رمزاً وشعاراً لحركاتهم وتحركاتهم. والتي نهضت بها سواعد الشيعة، وأبو مسلم الخراساني كان مثالاً لهذه الحركات. فقد استطاع أن يتغلب على بلاد خراسان، وأن يهزم نصر بن يسار عامل مروان الحمار على خراسان، واستقر الأمر لأبي مسلم الذي كان يتخذ من الثأر للحسين(ع) شعاراً، ثم اتجه إلى العراق واحتلها، ولكنه يخفي تحت هذا الشعار الدعوة إلى العباسيين.
أما أبو سلمة الخلال فكان هو الآخر يدعو لآل محمد(ص) ولكنه كان مخلصاً في دعوته لهم (عليهم السلام).
إلا أن التباين والدهشة ثم التخاذل ظهر حين بايع أبو مسلم الخراساني بالخلافة لأبي العباس السفاح في الكوفة يوم العاشر من محرم سنة (132هـ).
وكانت معركة الزاب هي نهاية الحكم الأموي إلى الأبد، فقد جاء في (مروج الذهب) و(تاريخ اليعقوبي) وغيرهما من المؤرخين؛ أنّ مروان بن محمد قد انهزم في معركة نهر الزاب بعد أن قتل أكثر من معه من الجيش وغرق في نهر الزاب خلق كثير ممن كانوا معه، وكان فيمن غرق من بني أمية ثلاثمائة غير من غرق من سائر الناس، واتجه مروان فيمن بقي معه نحو الموصل فمنعه أهلها من دخولها فاتجه إلى حران وكانت داره بها وعياله يقيمون فيها، ثم هرب بهم إلى فطرس في بلاد فلسطين، وعبد الله بن علي في إثره، وفي طريقه حاصر دمشق وفيها الوليد بن معاوية بن عبد الملك في خمسين ألف مقاتل ففتحها وأسر جماعة من أحفاد عبد الملك بن مروان وأرسلهم إلى أبي العباس في الحيرة، فقتلهم وصلبهم فيها. كما قتل من بني أمية وغيرهم خلقاً كثيراً، ومضى في طريقه إلى نهر أبي فطرس فقتل جماعة ممن كانوا مع مروان الحمار وأسر من بني أمية بضعاً وثمانين رجلاً، وقد كان جمعهم في مكان خاص وأمرهم بالدخول عليه، وأعدّ لكل رجل منهم رجلين يحملان العمد، وحينما دخلوا عليه أطرق ملياً..
فقام أحد الشعراء وأنشد أبياتاً جاء فيها:
|
أما الدعاة إلى الجنان فهاشم |
|
وبنو أمية من كلاب النار |
وكان النعمان بن يزيد بن عبد الملك جالساً إلى جانب عبد الله بن علي، فالتفت إلى الشاعر وقال: كذبت يا ابن اللخناء، فرد عبد الله بن علي قائلاً: بل صدقت يا أبا محمد امض لقولك.
ثم التفت إلى الأمويين، وأخذ يذكّرهم بمقتل الحسين(ع) وبنيه وإخوته وأنصاره وما جرى لأهل بيته من الإهانة والسبي والإذلال، ثم صفّق بيديه، فضرب القوم رؤوس الأمويين بالعمد التي أعدّوها فماتوا عن آخرهم، فناداه رجل من أقصى القوم:
|
عبد شمس أبوك وهو أبونا |
|
لا نناديك من مكان بعيد |
فقال له عبد الله: هيهات هيهات.. لقد كان ذلك ولكن قطعه قتل الحسين بن علي(ع) وسبي نسائه وأطفاله.
ثم أمر بهم فسحبوا وطرحت عليهم البسط وجلس بمن معه عليها ودعا بالطعام فأكلوا، وقال: يوم كيوم الحسين ولا سواء.
ثم دعا بذلك الرجل الذي أنشد البيتين وقال:
|
ومدخل رأسه لم يدنه أحد |
|
بين الفريقين حتى لزّه القرن |
وأمر بضرب عنقه.
وجاء في (البداية والنهاية) لابن كثير([7]): أن عبد الله بن علي عندما احتلّ دمشق أباح القتل فيها ثلاث ساعات وأنه قتل جمعاً كبيراً من الأمويين قُدّر بعشرات الآلاف.. ونبش قبور حكام آل أمية وأظهر العظام وحرقها إلا أنه لم يجد في قبر يزيد شيئاً إلا خط أسود على مساحة القبر كأنه خط بالرماد. ووجد جسد هشام بن الحكم على حاله وكان طلي بمعدن خاص يحفظه من الاهتراء فجلده ثمانين جلدة ثم أحرقه، ويعلل بعض المؤرخين جلده بأنه فعل ذلك به لأنه كان قذف أم زيد بن علي بالزنا حينما وقف بين يديه، وقال له: أخرج يا ابن الزانية، وقيل: إنما فعل ذلك انتقاماً لأبيه علي بن عبد الله، لأن هشاماً كان قد جلده ثمانين سوطاً..([8])
ويرى بعض الرواة أنّ الآية من سورة القدر (ليلةٌ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألفِ شَهْر)([9]) تشير إلى الزمان الذي تعيشه تلك الدولة التي لم تترك حرمة من حرمات الإسلام إلا وداستها ووطأتها بأقدامها، ولا لوناً من ألوان التعذيب والتنكيل بالعلويين والأبرياء من صلحاء المسلمين إلا ومارسته، وحققت لأبي سفيان وحزبه جميع ما كان يحلم به ويعمل من أجله، ولكن الله يمهل ولا يهمل..
لقد سقطت الدولة الأموية بعد تسعين عاماً على إنشاءها لتقوم دولة أخرى بدماء العلويين كما قامت دولة الأمويين على دمائهم.
([3]) الأخبار الطوال: للدينوري.
([5]) تاريخ ابن كثير، ومقاتل الطالبيين.
([7]) البداية والنهاية لابن كثير 10: 45.
([8]) تاريخ اليعقوبي: 92- 93، وكذا المجلد الثاني من مروج الذهب للمسعودي.
استقرار فرض الصلاة حضراً وسفراً (12/ ربيع الثاني/ السنة 1 هـ)
قال الله تعالى: )إِنّ الصّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مّوْقُوتاً)([1]).
ورد في بعض الروايات المعتبرة: أن الصلاة كانت في أول الأمر ركعتين ركعتين، فرضها الله تعالى على العباد مباشرة، وفوّض لرسوله زيادة معينة يزيدها عليها في الوقت المناسب، من دون حاجة إلى وحي جديد، فزاد (ص) في المغرب ركعة واحدة، وفي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين.
وقيل إن هذه الزيادة كانت في السنة الأولى من الهجرة، وقيل بعد ولادة الحسنين(عليهما السلام).
وفي قبال ذلك هناك قول آخر يثبت أن الصلاة قد فرضت من أول الأمر تامة كاملة، فعن نافع بن جبير وغيره، أنه لما أصبح رسول الله(ص) ليلة أسري به فيها، لم يرعه جبرئيل يتدلى حين زاغت الشمس، ثم تذكر الرواية: أنه صلى بهم الظهر أربعاً، والعصر كذلك ومعنى ذلك أن الصلاة أول ما فرضت فرضت تامة([2]).
وعن الحسن البصري: إن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعاً([3]).
ولكننا لا نستطع قبول ذلك، لوجود الروايات الثابتة والصحيحة عند الشيعة، وعند غيرهم، الدالة على أن صلاة الحضر قد فرضت أولاً ركعتين، ثم زيد فيها، ففي موثق فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول في حديث إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، عشر ركعات، فأضاف رسول الله(ص) إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة([4]).
ولعل المراد أن الصلاة أبلغت إلى النبي(ص) أولاً كاملة، ولكن المصلحة كانت تلزم أولاً بركعتين، ثم صارت تلزم بالكل، وفُوّض إلى النبي(ص) أمر تبليغ ذلك في الوقت المناسب، ولذلك فقد اعتبرت الركعتان الأوليان فريضة، أي ما فرض من الله مباشرة على العبد، والباقي سُنّة، وهو ما أبلغ حكمه للنبي(ص) ليبلغه في صورة تحقق موضوعه، وهو المصلحة المقتضية له([5]).
وهكذا فإن الله تعالى أول ما كلم موسى بن عمران في الوادي المقدس أمره بإقامة الصلاة، قال تعالى: (...وَأَقِمِ الصّلاَةَ لِذِكْرِيَ)([6])، وهكذا عيسى الذي جعله الله تعالى نبياً وهو في المهد صبياً، فعندما كلّم الناس أخبرهم بأنّ الله تعالى أوصاه بالصلاة، قال تعالى: (وَأَوْصَانِي بِالصّلاَةِ وَالزّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً)([7])، وكذلك لقمان الحكيم عندما كان يوصي ابنه، جعل من كبريات وصاياه التذكير بإقامة الصلاة: (يَبُنَيّ أَقِمِ الصّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ)([8])، وكل هذا يكشف عن أن الصلاة من التشريعات التي اهتمت بها الأديان اهتماماً بليغاً.
وكذلك الإسلام فقد اهتم بها اهتماماً عظيماً، ودعا إليها بما لم يدع إلى غيرها، وقد ظهر اهتمامه بها في عدة نقاط.
النقطة الأولى: النداء إليها، فإننا لا نجد عبادة ينادى إليها في كل يوم خمس مرات إلا الصلاة، فالأذان هو الذي يذكّر الإنسان بالصلاة، كما أننا لو تأملنا فصول الأذان وجدنا أن الصلاة قد وصفت فيه بصفات عظيمة وجليلة، كقوله: حيّ على الفلاح، وقوله: حيّ على خير العمل، فالصلاة هي الفلاح، وهي خير عمل يتقرب به الإنسان الى ربه.
النقطة الثانية: أنّ الله تعالى قد فرضها على الإنسان في كل يوم، وفي خمسة أوقات، وهذا يكشف عن شدة اهتمامه بها، بينما لم يفرض الزكاة الا في زمن خاص، وكذا الصيام والخمس، ولم يفرض الحج إلا مرة واحدة في العمر، فجميع العبادات فرضت في أوقات خاصة، ولم يفرضها في كل وقت كالصلاة وهذا يعني أن الإسلام يريد من الإنسان حصول التذكر من الصلاة في كل مجريات حياته، ويستشعر بها في كل أوقات يومه، ليعيش الصلة الوثيقة مع الله تعالى، ولتكون المذّكرة للطاعة، ولترك المعصية.
النقطة الثالثة: أنّ الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، حتى وإن كان مريضاً أو خائفاً أو غريقاً، بل يجب عليه أداؤها بكيفية خاصة تتلاءم مع حاله، بينما نجد أن الصيام يسقط عن المريض والمسافر، كما أن الحج لا يجب على غير المستطيع، والخمس والزكاة لا يجبان على غير المالك لأزيد من قوته، وكل هذا دليل واضح على عظيم اهتمام الإسلام بأمر الصلاة.
النقطة الرابعة: أنه جعل قبول الأعمال رهين قبولها، فعن النبي الأكرم(ص) أنه قال: «الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها»([9]).
النقطة الخامسة: أن الصلاة مكفّرة للذنوب، ففي تفسير قوله تعالى: (إِنّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّـيّئَاتِ) قال علي(ع): «إنّ الصلوات هي الحسنات التي تذهب السيئات الحاصلة بينهن»([10]).
آثار الاستخفاف بالصلاة
بعد ما ذكرنا من اهتمام الإسلام بأمر الصلاة، فلابد وأن يعلم أن التهاون والاستخفاف بها يوجب تضيعها، وتضيع آثارها الخيّرة التي تعود إلى كمال الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، وقد رتب على التهاون والاستخفاف بها آثار وخيمة نذكر بعضها:
1- إن الله لا ينظر إلى المستخف بصلاته: فقد تظافرت الأخبار على أن المستخف بصلاته لا يقبل الله منه عملاً، ولا ينظر إليه، فعن أبي عبد الله الصادق(ع) أنه قال: «والله إنه ليأتِ على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا، والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به»([11]).
2- أن المستخف بصلاته لا تشمله شفاعة النبي(ص) وآله(عليهم السلام) يوم القيامة، فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) أنه قال لما حضرته الوفاة: «لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة»، وقال الإمام جعفر الصادق(ع): «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة»([12]).
3- أن المستخف بصلاته يخرج عن ملة رسول الله(ص) ، ولا يرد عليه الحوض عندما يسقي المؤمنين، بيده الشريفة، فعن أبي جعفر الباقر(ع) قال: «لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي(ص) قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ولا يرد عليّ الحوض لا والله»([13])، إلى غير ذلك من آثار الاستخفاف والتهاون.
بماذا يتحقق التهاون في الصلاة
إن الاستخفاف والتهاون بالصلاة عنوان ينطبق على حالات نذكر بعضها:
أولاً: ما لو ترك الإنسان أداءها في أوقاتها المحدّدة لغير ضرورة، حيث أنّ المكلف مأمور بتأديتها في أوقاتها المحددة شرعاً، ويحاول جاهداً أن لا يقدّم عليها أي عمل مهما كان مهماً، لأن الصلاة أهم من سائر الأعمال، بل ينبغي المبادرة إلى الصلاة وأدائها في أول وقتها، لأن ذلك من علامة الإيمان، فقد كان نبي الرحمة(ص) يجلس في محرابه قبل دخول وقت الصلاة، وينتظر حلول الوقت بفارغ الصبر منادياً: يا بلال أرحنا؛ تعبيراً منه عن عشقه وحبه وتعلقه الشديد بالصلاة، وهذا في الحقيقة درس لنا أراد النبي(ص) أن يعلمنا، ويريد أن يقول لنا: أن على المؤمن أن ينتظر قدوم الصلاة، وأن يتجهّز لها قبل حلول وقتها، وأن ينادي للصلاة بنفسه، لا أن ينتظر إلى أن تناديه، وأن عليه أن تنبسط أسارير نفسه وينشرح صدره لدخول وقت الصلاة، لا أن يرتاح وينبسط عند فراغه منها، وكأنها الجبل أثقلت ظهره، فعن الإمام الصادق(ع) أنه قال: «لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظام»([14]).
وهذا معنى دقيق ينبغي التأمل فيه، إذ أنّ الحفاظ على الصلاة بأدائها في أوقاتها المحدّدة شرعاً يقيّد إبليس ويحجّمه، ويمنعه عن أن يخترق المملكة الإيمانية للإنسان، فالصلاة هي الحصن المنيع الذي يحفظ كيان المؤمن، ولا يسمح للشيطان أن يتوغّل فيه، فإذا ضيّعها، ولم يؤدها في أوائل أوقاتها انهدم هذا الحصن، وفسح المجال أمام الشيطان للسيطرة على المؤمن، فيدخله في الذنوب العظام.
وجاء عن محمد بن الفضيل، قال: سألت الإمام موسى بن جعفر الكاظم(ع) عن قول الله (عز وجل): (الّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ)([15])، قال: «هو التضييع»([16]).
ثانياً: يتحقق التهاون والاستخفاف بعدم إتمام أفعالها وأقوالها على الوجه
المطلوب شرعاً، فالعجلة في أدائها بحيث لا تتأدى على وفق الأوامر الإلهية الواصلة إلينا
هو في الحقيقة استخفاف بها وتهاون فيها، فعن الإمام الباقر(ع) أنه قال: «بينما كان رسول الله جالساً في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال (ص): نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته، ليموتنّ على غير ديني»([17]).
ثالثاً: مما يصدق عليه التهاون عدم التوجه القلبي إلى مضامين الصلاة، ومعانيها السامية التي من شأنها تربية المصلي على الفضائل، والأخلاق الحميدة، فقد قال الإمام الصادق(ع): «ليس لك من صلاتك إلا ما أقبل عليها قلبك»([18]).
([2]) مصنف الحافظ عبد الرزاق 1: 455.
([3]) البداية والنهاية 3: 331.
([4]) الوسائل: باب عدد الفرائض اليومية من أبواب أعداد الفرائض.
وفاة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) (10 / ربيع الثاني / السنة 201 هـ)
قال الإمام الصادق(ع): «إنّ لله حرماً وهو مكة، ولرسوله حرماً وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة، ولنا حرماً وهو قم، وستدفن امرأة من ولدي سميت فاطمة من زارها وجبت له الجنة».
لشدة تعلق السيدة فاطمة المعصومة بأخيها الإمام الرضا(ع)، حيث كانت تحبه
حباً جماً، وكان عزيزها الذي كانت تشعر بالأمن والراحة إلى جواره، قررت (عليها السلام) أن تلتحق به (ع) في خراسان، فتجهزت مع بعض إخوة الإمام وأبناء إخوته([1]).
خرج في قافلة السيدة المعصومة(عليها السلام) خمسة من إخوتها، وهم: فضل وجعفر وهارون وقاسم وزيد، ومعهم بعض أبناء إخوة السيدة المعصومة، وعدة من العبيد والجواري، وكان ذلك سنة (201هـ).
ولما وصلت القافلة إلى ساوة هجم عليهم أعوان بني العباس وقتلوا جمعاً من أفراد القافلة، وجرحوا البعض الآخر حتى قيل أنهم قتلوا (23 علوياً) من أفراد القافلة، وعلى أثر ذلك مرضت ونحلت وضعف بدنها، وقيل إن سبب ضعفها ومرضها السم الذي دسّ إليها في ساوة من قبل أعوان بني العباس([2])، ولذلك لم تستطع مواصلة السير وإكمال السفر، فسألت عن المسافة التي بينها وبين قم حيث مقر الكثير من وجوه الشيعة، وأتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) فقيل لها عشرة فراسخ، أي ما يقارب (55 كيلوا متراً)، فطلبت منهم أن يحملوها إلى قم، فحملت (عليها السلام) إليها ولما وصلت على مشارف الطريق مر بظعينتها راكب، فسأل: لمن هذه الظعينة؟ فقيل له: هي لفاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، وهي وافدة من الحجاز للقاء أخيها أبي الحسن الرضا(ع)، فأقبل ذلك الرجل إلى مجلس موسى بن الخزرج الأشعري - وكان من وجوه الشيعة في قم آنذاك وزعيم الأشعريين - وكان حاشداً بالناس، فقال الرجل وهو باك: يا موسى، لقد حلّ الشرف في بلدكم، ونزلت الخيرات والبركات بساحتكم. فقال موسى: لا زلت مبشراً بخير ما الذي جرى؟ قال ظعينة: أخت الرضا(عليها السلام) مقبلة على قم.
فخرج موسى مع أصحابه، وجمع كثير من الناس لاستقبالها، فلما وصل موسى إلى ظعينة السيدة فاطمة(عليها السلام) تناول يد القائد لناقتها فقبلها، وطلب منه أن يسلمه زمام الناقة ليقودها بيده وليتشرف بذلك، فسلم إليه زمام الناقة فقادها موسى بيده حتى أنزل السيدة فاطمة بيته، في (23 / ربيع الأول / سنة 201هـ).
بقيت في بيته (17 يوماً) وهي مريضة ناحلة حتى توفيت في العاشر من ربيع الثاني من نفس السنة، فدفنت في قم، ومقامها اليوم مشهور مشهود يؤمّه الناس، ويأتونه من كل فج عميق يتقرّبون إلى الله تعالى بزيارتها، وقد حصلت لهم كرامات كثيرة ومنيفة. فسلام على السيدة المعصومة يوم ولدت، ويوم أدّت رسالتها، ويوم توفيت، ويوم تبعث حية.
([2]) الحياة السياسية للإمام الرضاA للسيد جعفر مرتضى العاملي.
ولادة الإمام الحسن العسكري (ع)(8 / ربيع الثاني/ السنة 232 هـ)
الإمام العسكري(ع) في سطور
ولد الإمام الحسن العسكري(ع) في عام (232 هـ) على المشهور بين المحققين([1])، وأبوه الإمام الهادي علي بن محمد(ع)، وأمه حديثة([2])، وقيل: اسمها سوسن([3])، وكانت امرأة زاهدة مؤمنة، ومن العارفات الصالحات، ويكفي في فضلها أنها كانت مفزع الشيعة بعد وفاة أبي محمد، وفي تلك الظروف الحرجة([4]).
أشهر ألقابه:
النقي والزكي، والعسكري، ولقّب بالأخير؛ لأنه كان يقيم في سامراء مجبراً في حي يسمى بالعسكر، وكني بأبي محمد، وكان عمره (22) سنة عندما استشهد أبوه الهادي(ع)، وكانت إمامته ستة أعوام، حيث استشهد سنة (260هـ)([5])، ودفن في بيته إلى جوار قبر أبيه في سامراء، وتعتبر إمامته أقصر مدة للإمامة في تاريخ أهل البيت(ع).
النص على إمامته (ع):
ورد في النص على إمامته نصوصٌ كثيرة، ولعلّه لأجل أنّ الشيعة كانت تظن أنّ الإمامة بعد الإمام الهادي، لابنه محمد الذي كان أكبر سناً من أخيه الحسن العسكري، فقد روى أحمد بن عيسى العلوي من ولد علي بن جعفر، قال: دخلت على أبي الحسن بـ(صريا) فسلمنا عليه فإذا نحن بأبي جعفر وأبي محمد قد دخلا فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم عليه، فقال أبو الحسن(ع): «ليس هذا صاحبكم، عليكم بصاحبكم. وأشار إلى أبي محمد(ع)»([6]).
ولكن بعد وفاة محمد بن الإمام الهادي علمت الشيعة أن الإمام بعده ابنه الإمام العسكري(ع)، وروى الكليني بسنده عن يحيى بن يسار القنبري قال: أوصى أبو الحسن(ع) إلى ابنه الحسن قبل مضيه بأربعة أشهر، وأشهدني على ذلك، وجماعة من الموالي([7]).
([1]) الكافي 1: 503، والإرشاد: 335، ومناقب آل أبي طالب 4: 422، وإعلام الورى: 367.
([2]) الإرشاد: 335، وإعلام الورى: 366.
([3]) أصول الكافي 1: 503، وكشف الغمة 3: 192.
([5]) الإرشاد: 345، والإتحاف بحب الأشراف: 178 – 179.
شهادة السيدة فاطمة الزهراء (8 / ربيع الثاني/ السنة 11 هـ)
تمهيد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية نبينا محمد(ص)، وعلى الأقمار المضيئة الأئمة الطاهرين(عليهم السلام) .
«لا يقاس بآل محمد(ص) من هذه الأمة أحد، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة»([1]).
بهذه الكلمات البليغة المطرّزة بألوان الذهب الغالي، يقدّم لنا الإمام علي ابن أبي طالب(ع) وصفاً لمقام أهل بيت النبوة السامي، ويكشف لنا بعضاً من حقائق هذه الجواهر النفيسة والدرر الثمينة.
وشهر ربيع الثاني شهر عظيم، ولابد من تعظيمه بالمساعي الجميلة بما يناسب معرفته، وقد خصّ السيد ابن طاووس غرّة هذا الشهر بدعاء عن أهل بيت العصمة والطهارة.
وفي العاشر منه ولادة مولانا وإمامنا أبي محمد الحسن العسكري(ع)، وهو يوم شريف جداً، ويستحب فيه الصيام لله على هذه النعمة العظمى.
ولهذا اليوم خصوصية من جهة أنه (ع) والد إمامنا أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، فينبغي لرعيته (ع) تهنئته بما يليق به (ع)، وأن يزيد في حوائجه التي يعرضها لصاحب الولادة بالتضرّع والسؤال في أن يوصيه لصاحب العصر في أن يدخله في همّه، ونظر لطفه، ويخصّه من بين رعيته بمكارمه.
ونحن وإيماناً منّا بما صنعه أهل البيت(عليهم السلام) وما قدّموه من خدمات جليلة في سبيل تشييد أركان هذا الدين، وتأسيس دعائمه وإيصاله إلى الأمة صافياً نقياً، وبحسب تعبير الإمام الخميني: «الإسلام المحمدي الأصيل»، نقدّم للقرّاء الأعزّاء هذه الباقة من المواضيع في هذه السلسلة من المناسبات الإسلامية بدءاً من ولادة الإمام الحسن العسكري(ع)، ووفاة السيدة فاطمة المعصومة(عليها السلام)، ومروراً باستقرار فرض الصلاة، وانتهاءاً بثورة المختار الثقفي.
لعلّها تلامس بعض حقائق أهل البيت(عليهم السلام) وتكشفها لمن يريد الحقيقة، علّنا بذلك نحظى بشفاعتهم ورضوانهم.
سائلين المولى أن يمدّنا بالعون لنكون في خدمة من يحيون هذا الشهر العظيم.
والله من وراء القصد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شهادة السيدة فاطمة الزهراء (8 / ربيع الثاني/ السنة 11 هـ)
سيأتي الحديث عن السيدة الزهراء (عليها السلام) بمناسبة ولادتها وذكرى شهادتها على الروايتين المشهورتين وبمناسبة ذكرى شهادتها (عليها السلام) على الرواية الأولى التي تقرر أنها بقيت بعد أبيها رسول الله(ص) أربعين يوماً وهي ضعيفة لا يعمل بها، سنذكر أهم وأخطر جوانب شخصيتها، وهذه الجوانب هي كالتالي:
الجانب الأول: الزهراء (عليها السلام) مبلّغة لرسالة السماء:
كانت الزهراء(عليها السلام) مواكبة لأبيها رسول الله(ص)، وكانت تتصدى لتعليم النساء في المدينة أحكام دينهنّ، حتى أن النساء كنّ يأتين بيت فاطمة في كثير من الأحيان طلباً للعلم والمعرفة، فقد روي عن أبي محمد الحسن العسكري(ع) أنه قال: حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء(عليها السلام)، فقالت: إن لي والدة ضعيفة، وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليكِ أسألك، فأجابتها فاطمة(عليها السلام) عن ذلك، فثنّت فأجابت، ثم ثلّثت فأجابت.. إلى أن عشرت، فأجابت، ثم خجلت المرأة من الكثرة، فقالت لها: لا أشقّ عليك يا ابنة رسول الله، فقالت فاطمة(عليها السلام): هاتي وسلي عمّا بدا لك، أرأيت من اكترى يوماً يصعد إلى سطح بحمل ثقيل، وكِراه مائة ألف دينار يثقل عليه؟ فقالت: لا، قالت: اكتريت أنا بكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤاً فأحرى أن لا يثقل عليّ، سمعت أبي(ص) يقول: «إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم، وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلة من نور»([2]).
وقد كان النبي(ص) يعتمد عليها في تبليغ الإسلام، وتعليم القرآن لنساء أهل المدينة، والرواية السابقة توضح بشكل صريح أن نساء المدينة كنّ يأتينها لتعلّم أحكام الدين، وهذا يكشف عن أن الزهراء(عليها السلام) كانت محطاً للتعليم والتثقيف وتبليغ الرسالة.
وأيضاً بعد وفاة النبي الأعظم(ص) كانت الزهراء مبلّغةً للوصاية والإمامة لأمير المؤمنين(ع)، وكانت تواصل دفاعها عنه بشتى طرق الدفاع، وبمختلف أساليبه، فكانت تخرج مع علي(ع) إلى أبواب المهاجرين والأنصار؛ لتذكرهم حقوق الإمام (ع) على الأمة، وتدعوهم إلى نصرته بعد أن ابتزوا حقه وغصبوه.
يقول ابن قتيبة: وخرج علي (كرم الله وجهه) يحمل فاطمة بنت رسول الله(ص) على دابة ليلاً في مجالس الأنصار تسألهم النصرة، فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا ما عدلنا به، فيقول علي (كرم الله وجهه): أفكنت أدع رسول الله(ص)في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟! فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم([3]).
ولقد كان هذا الموقف منها دفاعاً واضحاً عن الإمامة، وتبليغاً عظيماً في سبيل هذا الحق الإلهي العظيم.
الجانب الثاني: جهاد الزهراء(عليها السلام)
كانت الزهراء(س) في دائرة الجهاد التي خطّها رسول الله(ص)، حيث أنها قد عاشت محن الجهاد بتمام تفصيلاته، فلقد قاست مرارة الحصار في شعب أبي طالب مع أبيها وأمها وسائر بني هاشم، ولم يمض من عمرها غير سنتين، كما أنها عاشت آلام أبيها والمحن التي عصفت به، والأذى الذي كان يلحقه القوم به، فقد روى عبد الله بن مسعود: أنه بينما كان رسول الله(ص) يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد نحرت بالأمس جزور، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا بني فلان فيأخذ منه ويضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي(ص) وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحك القوم، وجعل بعضهم يميل على بعض، فلما علمت الزهراء بذلك جاءت إليهم وهي طفلة صغيرة، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تلومهم وتعنّفهم بالقول([4]). كما أنها علمت ذات يوم بأن قريشاً تكيد لقتل النبي(ص) فأعلمته بذلك([5]).
واستمرت (عليها السلام) تواكب جهاد أبيها مع أمها، إلى أن اختار الله لخديجة دار المقامة عنده، ففقد النبي(ص) بفقدها الناصر والمعين، والشفيق الحنون، فلقد كانت نعم المواسيّ والمصبّر لرسول الله(ص)، وشكّل فقدها فراغاً كبيراً في حياته (ص) حتى أطلق على عام وفاتها الذي ارتحل فيه أيضاً عمه أبو طالب(ع) (عام الحزن)، كما أن الزهراء فقدت على صغر سنها الأم الحنون والحجر الدافئ، إلا أنها تناست أحزانها، ولم تدع المصيبة الجليلة تأخذ منها ومن عزيمتها، وتحطّ من قدرتها، فأخذت على عاتقها تسنّم مكانة أمها بفيض الحنان المتدفق على أبيها، فكانت بمجرد أن يدخل رسول الله(ص) إلى البيت تفرغ عليه حنانها، وتمارس دور أمها في تصبير النبي(ص) ومواساته، حتى فاقت بحنانها حنان أمها، فأسماها النبي(ص) «فاطمة أم أبيها»([6]).
وهذا الوسام يعكس بجلاء مدى الحنان الكبير، والمؤازرة العظيمة، والموقف الجليل الذي كانت تقوم به تجاه أبيها (ص).
كما أنها (عليها السلام) هاجرت في سبيل الله برفقة علي(ع) بركب الفواطم، وعايشت سائر غزوات النبي(ص)، حتى أنها خرجت في غزوة أحد إلى موقع المعركة، ورأت أباها بتلك الحالة المؤلمة، فأخذت تغسل عن وجهه الدماء المتخثّرة، وهي تقول: اشتدّ غضب الله على من أدمى وجه رسول الله، فكانت تغسل الدماء، وعلي يصب الماء من المجن، فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، عمدت إلى قطعة حصيرة فأحرقتها، وجعلت رمادها ضماداً على جبهته، وألزمته الجرح فاستمسك الدم.
وهكذا كانت تأتي أباها بكسيرات من الخبز في معركة الخندق، مما يكشف بوضوح
أنها (عليها السلام) كانت تعايش محن الرسالة، وهمّ الجهاد وتشارك بما يمكنها فيه المشاركة([7]).
الجانب الثالث: عبادة فاطمة(عليها السلام)
لقد عرفت الزهراء(عليها السلام) بعابدة البيت النبوي، حتى قال الحسن البصري: «ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة بنت رسول الله، وكانت تقوم بالأسحار حتى تورّمت قدماها»([8]).
وعن ابن عباس عن رسول الله(ص) قال: «... وأما ابنتي فاطمة، فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، إنها لتقوم في محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربين، وينادونها بما نادت به الملائكة مريم، فيقولون: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين»([9])..
وورد أن رسول الله(ص) قد بعث سلماناً إلى فاطمة(عليها السلام)، فوقف بالباب وقفة حتى سمع فاطمة تقرأ القرآن من جوا، وتدور الرحى من برا، ما عندها أنيس، فتبسم رسول الله(ص) وقال: «يا سلمان، ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها، وجوارحها إيماناً إلى مشاشها، تفرّغت لطاعة ربها، فبعث الله ملكاً اسمه زوقابيل، فأدار الرحى، وكفاها الله مؤونة الدنيا، مع مؤونة الآخرة»([10]).
وورد عنه (ص) أيضاً: «متى قامت في محرابها بين يدي ربها (جل جلاله) زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، ويقول الله (عز وجل) لملائكته: يا ملائكتي أنظروا إلى أمتي فاطمة، سيدة إمائي قائمة بين يدي، ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار..»([11]).
وجاء في كتاب (عدة الداعي): أن فاطمة كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله([12])، ومعنى النهج تتابع النفس من شدة الخوف والخشوع.
ولشدة ما تعلقت الزهراء(عليها السلام) بالعبادة والأذكار وقراءة القرآن تنازلت عن الخادم الذي هي بأمسّ الحاجة إليه لأجل مداومة ذكر الله تعالى وتسبيحه وتقديسه، حيث روي - بسند معتبر - أن فاطمة(عليها السلام) قد استقت بالقربة حتى أثّر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها([13])، وكسحت البيت حتى اغبرّت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد، وكان قد أهدي إلى رسول الله رقيق، فأتته فاطمة(عليها السلام) فسألته أن يعطيها خادماً يعينها في أعمالها، فقال لها رسول الله(ص): «يا فاطمة أعطيك ما هو خير لك من خادم، ومن الدنيا بما فيها: تكبّرين الله بعد كل صلاة أربعاً وثلاثين تكبيرة، وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة، وتسبحين الله ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، ثم تختمين ذلك بلا إله إلا الله، وذلك خير لك من الذي أردت ومن الدنيا وما فيها»([14]).
فقبلت فاطمة(عليها السلام) وتنازلت عن طلبها، على الرغم من أن الخادم في زمانها كان من ضروريات الحياة، وكان عند أغلب الناس خدم، فليس في طلب فاطمة هذا من النبي(ص) ما يدلّ على طلب الترف والترفع، بل ما هو ملائم لطبيعة الحياة آنذاك، والنبي(ص) لم يرفض طلبها، ولكنه خيّرها بين الخادم وهذا الذكر، فاختارت التسبيح إيثاراً لرضا ربها على رضا نفسها، ورغبة في الارتباط التام والعميق بالرب الرؤوف الرحيم، فكانت (صلوات الله عليها) ملازمة لهذا التسبيح طيلة حياتها، في أدبار الصلاة، وإذا أخذت مضجعها، وكانت قد عملت سبحتها من خيط صوف مفتّل، معقود عليه عدد التسحبيات، فكانت تديرها بيدها؟، وتكبّر وتسبّح، ولما قتل حمزة بن عبد المطلب(ع) في أحد، استعملت تربته، وعملت السبحة منه، فاستعملها الناس([15]).
وقد أصبح هذا التسبيح الذي عرف بــ(تسبيح الزهراء) من أفضل تعقيبات الصلاة، فقد ورد الحث البليغ والكثير عن الأئمة(عليهم السلام) بملازمته، والتعقيب به، فعن أبي عبد الله الصادق(ع) أنه قال لأبي هارون: «يا أبا هارون، إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة(عليها السلام) كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه، فإنه لم يلزمه عبد فشقى»([16]).
وهكذا غدا هذا التسبيح - وبفضل فاطمة(عليها السلام) - شعار كل مؤمن، وكل عابد وناسك، حتى صار سبحة هذا الذكر شعاراً يتزين بحمله المؤمنون.
فضل تسبيح الزهراء(عليها السلام) والتعقيب به:
قد ورد الكثير من الأخبار التي تعكس فضلاً كبيراً، وأجراً جزيلاً للتعقيب بتسبيح الزهراء(عليها السلام) ننقل بعضها تيمناً:
عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله(ع): «من سبح تسبيح فاطمة(عليها السلام) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له، ويبدأ بالتكبير».
وعن زرارة عن أبي عبد الله، قال: تسبيح الزهراء(عليها السلام) من الذكر الكثير الذي قال الله (عز وجل): (اذْكُرُواْ اللهَ ذِكْراً كَثِيراً)R([17]).
وعن محمد بن مسلم قال، قال أبو جعفر(ع): «من سبّح تسبيح فاطمة(عليها السلام) ثم استغفر غفر له، وهي مائة باللسان، وألف في الميزان، وتطرد الشيطان وترضي الرحمن».
وعن أبي جعفر(ع) قال: «ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة(عليها السلام)، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله(ص) فاطمة(عليها السلام) ».
وعن أبي خالد القماط، قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: «تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم»([18]).
([1]) نهج البلاغة: الخطبة 2، شرح صبحي الصالح.
([4]) سيرة ابن إسحاق: 192، ودلائل النبوة للبيهقي 2: 44. عن ابن إسحاق أيضاً.
([5]) مناقب آل أبي طالب 2: 71، والمستدرك على الصحيحين 2: 157.
([6]) بحار الأنوار 22: 152 ح4.
([7]) فاطمة الزهراء أم أبيها: 35.
([8]) المستطرف في كل فن مستظرف 1: 20، ومناقب آل أبي طالب 3: 341.
([9]) آمالي الصدوق: 437، وبحار الأنوار 43: 24.
([10]) مناقب آل أبي طالب 3: 338.
([12]) مسند فاطمة: 14، وبحار الأنوار 67: 40.
([14]) بحار الأنوار 585: 336 حديث: 25.
([15]) بحار الأنوار 85: 333 حديث: 16.
([16]) وسائل الشيعة 6: أبواب التعقيب: باب 7/1، وباب 8/1، وباب 9/1 - 2.
([17]) سورة الأحزاب: الآية 41.
([18]) وسائل الشيعة 6: أبواب التعقيب: باب 7/1، وباب 8/1، وباب 9/1 - 2.
إبرام معاهدة الصلح بين الإمام الحسن (ع) ومعاوية (26 / ربيع الأول / السنة 41 هـ)
بعد شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) خطب الحسن(ع) بجموع المسلمين في الكوفة بخطاب عرّفهم من فقدوا، ثم بكى وبكى الناس معه، فقال:
أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد رسول الله(ص) ، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، أنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، والذين افترض الله مودتهم في كتابه ([1]).
ثم قام عبد الله بن العباس بين يديه فدعا الناس إلى بيعته، فاستجابوا، وقالوا: ما أحبه إلينا وأحقّه بالخلافة، فبايعوه([2]).
وكان عدد المبايعين له أكثر من أربعين ألفاً، وكان يشترط عليهم بقوله: «أنكم مطيعون تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت»، فكانوا يبايعونه على ذلك([3]).
وأول عمل قام به (ع) بعد بيعة الناس له أن كتب إلى معاوية يدعوه إلى البيعة والطاعة والدخول فيما دخل فيه الناس، وفيما جاء في كتابه:
«... فاليوم فليعجب المتعجب من توثّبك يا معاوية على أمر لست من أهله، ولا بفضل في الدين معروف، ولا أثرٍ في الإسلام محمود، وأنت ابن حزب من الأحزاب، وإنّ علياً لمّا مضى لسبيله - رحمة الله عليه - ولابن المسلمون الأمر بعده.. فدع التمادي في الباطل، وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي، فإنّك تعلم أنّي أحقّ بهذا الأمر منك عند الله، وعند كل أوّاب حفيظ، ومن له قلب منيب.
واتق الله يا معاوية ودع البغي، واحقن دماء المسلمين.. فادخل في السلم والطاعة، ولا تنازع الأمر أهله، ومن هو أحقّ به منك، ليطفئ الله النائرة بذلك، وتجمع الكلمة، وتصلح ذات البين، وإن أنت أبيت إلاّ التمادي في غيّك نهدت إليك بالمسلمين، فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين»([4]).
فردّ عليه معاوية قائلاً له.. أنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني، فادخل في طاعتي، ولك الأمر من بعدي([5]).
فأمر الإمام الناس بالتحرك لقتال معاوية، كما أن معاوية حرّك جيش الشام باتجاه العراق، فخطب الإمام الحسن في الناس فقال لهم: إنه بلغني أن معاوية بلغه أنّا كنّا أزمعنا المسير إليه، فتحرك لذلك فاخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة([6]).
فسكتوا ولم يجيبوه، فقام عَدي بن حاتم الطائي، وقيس بن سعد بن عبادة، ومعقل بن قيس الرياحي، وزياد بن صعصعة التميمي يؤنبون الناس ويلومونهم على سكوتهم، ويحرّضونهم على الجهاد.
ولمّا تحرك الناس دعا (ع) عبيد الله بن العباس، وبعثه مع اثني عشر ألفاً من فرسان الكوفة، وأمره أن لا يقاتل معاوية حتى يبدأ بالقتال([7]).
حروب نفسية قبل القتال:
كثّف معاوية جهوده على ضرب جيش العراق دون قتال، وقد قام بعدة أساليب لإنزال الهزيمة به.
الأسلوب الأول - استقطاب القيادة: أرسل معاوية مع بعض جلاوزته كتاباً إلى قادة جيش الإمام الحسن(ع) يمنّيهم بالمناصب ويغريهم بالأموال، ويتبع معهم مغالطات ومراوغات يظهر من خلالها أنه سيصالح الحسن لا محالة.
فقد كتب إلى عبيد الله بن العباس فقال له: «قد راسلني الحسن في الصلح، وهو مسلّم الأمر إليّ فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً، وإلاّ دخلت وأنت تابع، ولك إن أجبتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم»([8]).
ولم يكن عبيد الله بن العباس ليتحمل مثل هذا الإغراء فانسل ليلاً ودخل معسكر معاوية ومعه ثمانية آلاف مقاتل([9]).
فاستلم قيادة الجيش قيس بن سعد بن عُبادة، فحثّ الناس على الجهاد فأجابوه بالطاعة، وحاول معاوية مع قيس واستجلبه بالمال، إلاّ أن قيس أجابه بجوابه الخالد: «لا والله لا تلقاني أبداً إلا وبيني وبينك الرمح»([10]).
وكثّف معاوية حملته على قادة جيش الإمام الحسن(ع) فكاتب أربعة من كبار الشخصيات في جيش الإمام كلٌ على انفراد: إن قتلت الحسن بن علي فلك مائتا ألف درهم، وجند من أجناد الشام، وبنت من بناتي، فأجابه بعضهم بالسمع والطاعة، وضمنوا له تسليم الإمام الحسن عند دنوهم من عسكره، أو الفتك به([11]).
وقد علم الحسن بمثل هذه المؤامرات فكان لا يخرج من خبائه إلاّ لابساً درعه([12]).
الأسلوب الثاني - اغتيالات في جيش الإمام الحسن(ع) : أرسل معاوية الكثير من جلاوزته لإجراء الاغتيالات السرية والليلية في جيش الإمام الحسن(ع) ، وقد شاعت كثيراً إلى درجة سلبت النوم من العسكر، فكانوا يبيتون طوال ليلهم دون نوم خوفاً من الفتك بهم، حتى ضاق المعسكر بهم ذرعاً فقرر الكثيرون اعتزال المعسكر قافلاً إلى بلاده.
الأسلوب الثالث - إشاعة الصلح: أرسل معاوية إلى الإمام الحسن، المغيرة بن شعبة وآخرون، والتقوا بالإمام ثم خرجوا من عنده وأشاعوا في أوساط الجيش أن الحسن قد قبل الصلح، يقول ابن الأعثم: «وتوالت الإشاعات مما أدى إلى خلخلة جيش الإمام وإضعاف معنوياته، وتشجيع أهل الأهواء والمنافع للالتحاق بمعاوية أو الفرار من معسكرات الجيش، فبدأت القبائل تلتحق به قبيلة بعد قبيلة حتى خفّ عسكره»([13]).
الأسلوب الرابع - القضاء على الإمام الحسن: قام معاوية بمحاولات عديدة لقتل الإمام والخلاص منه، وفعلاً تعرض الإمام الحسن(ع) وهو في قلب جيشه لعدة محاولات لاغتياله([14])، غير أنها باءت بالفشل.
هذه الأساليب التي قام بها معاوية لشلّ روحية جيش الإمام وإفقاده حيويته ومعنوياته، إضافة إلى استمالة الكثير منهم إلى صفّه، ومن جهة أخرى أن عقائد جيش الحسن(ع) وأهواءهم كانت مختلفة، إذ لم يكونوا جميعاً خارجين بوازع ديني ومبدأي، بل بعضهم كان بدافع الغنائم، وبعضهم بدافع الاستجابة لرئيس القبيلة، وهكذا استطاع معاوية افتراس جيش الإمام (ع) بمكره وخداعه، ولم يبق مع الإمام (ع) إلاّ القلّة.
في هذه الأثناء أرسل معاوية وفده يدعوا الحسن(ع) للصلح، ومعهم كتب رؤساء العشائر الذين ضمنوا لمعاوية فيها قتل الحسن أو تسليمه إليه([15])، وكان معهم أيضاً صحيفة بيضاء قد ختم معاوية أسفلها ليشترط الحسن ما يشاء([16]).
خرج الإمام الحسن(ع) وخطب في البقية من جيشه، وأخبرهم بدعوة معاوية إلى الصلح، ثم قال لهم: «.. فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بظبى السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا»، فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية([17]).
الإمام الحسن(ع) والصلح
تبين من خلال العرض السابق أن الإمام (ع) لم يكن يريد الصلح، وأن البقية المتبقية من جيشه لو قبلوا بالموت لحارب الحسن معاوية ولو أدى ذلك إلى تسجيل كربلاء حسنية قبل قيام كربلاء الحسين(ع) ، ولكن من تبقى كان ينادي بالبقاء والحياة، ولا يوجد عنده تنازل عنها ولا كان موطناً نفسه على لقاء الله، ولا باذلاً فيه مهجته، ولهذا فبقاء الإمام مصمماً على القتال لا طائل تحته، بل لعله يؤدي إلى تسليم الحسن أسيراً إلى معاوية، ويستلم معاوية زمام الأمور دون قيد أو شرط، ولهذا نزل الإمام عند رغبة أصحابه بالصلح - دون أن يكون راغباً فيه - ولكن حاول ترشيده، بما يخفف من وطأة الأزمة، ويعود على الأمة بالخير إلى حد ما، وحاله في ذلك حال أبيه أمير المؤمنين في قضية التحكيم في صفين فإنه لم يقبل التحكيم، لكن لما وجد جيشه مصمماً عليه حاول ترشيده باختيار مالك الأشتر حكماً عنه.
ولذا فقد حاول الحسن(ع) ترشيد الصلح فاشترط على معاوية شروطاً تعود بالنفع والخير للأمة والإسلام، ومنها ما يلي:
1- أنه لا يحق لمعاوية أن يعهد بالأمر بعده لأحد، بل يلي أمر الناس بعده الحسن، فإن قضى فللحسين.
2- إن للحسن(ع) خراج العراق بأكمله، أو ألف ألف دينار، يضعه حيث يشاء.
3- أن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله.
4- أن الناس آمنون حيثما كانوا في كوفتهم أو شامهم...
5- الأمان العام لشيعة عليّ وأصحابه.
6- عدم البغي على أهل البيت(عليهم السلام)،.
وعلى الرغم من قبول معاوية لهذه الشروط إلا أنه لم يفِ بواحد منها، حيث هو صرح بذلك بقوله: «إني قد أعطيت الحسن بن علي عهوداً وإني جعلتها تحت قدمي». وكان الإمام الحسن(ع) على علم ودراية بذلك، ولكن لكي تدرك الأمة خطورة ترك السلاح وأيضاً لتعيش تجربة في ظل جور بني أمية، حيث ضاق عليهم عدل علي، فلينعموا في سعة جور بني أمية.
([1]) الكامل في التاريخ 3: 170.
غزوة بني النضير (22 / ربيع الأول/ السنة 3 هـ)
قال تعالى: (هُوَ الّذِيَ أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأوّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنّوَاْ أَنّهُمْ مّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَا أُولِي الأبْصَار)
كانت غزوة بني النضير من أهم الأحداث التي تحمل في طياتها الكثير من الدروس والعبر، وقد تركت آثاراً بارزة على منحى وعمق الفكر الإنساني والرسالي، وعلى الفهم الدقيق للمسار العام في خط الرسالة، فهي حدث فريد ومتميز لا يقل في أهميته عن أي من الأحداث الكبرى في العهد النبوي، ومما يكشف عن ذلك أن سورة الحشر بتمامها قد نزلت في هذه المناسبة، وهذا يبرهن على الأهمية البالغة لهذه الواقعة، وعلى أنها تمثل تحولاً كبيراً وإيجابياً في مسيرة العمل والعاملين في سبيل الله سبحانه وتعالى من جهة، كما أنها تعتبر من الجهة الأخرى ضربة قاسية وقاصمة لأعداء الله وأعداء دينه من الكافرين.
فقد كان بنو النضير أقوى اليهود شوكة، وأشدّهم شكيمة، وأعزّهم عزةً، يعيشون في قلب الدولة الإسلامية وكان بإمكانهم الإطلاع على أدقّ دقائقها، وعلى كل الواقع الذي كان قائماً في داخل المجتمع الإسلامي، سواءً على مستوى العلاقات والارتباطات فيما بين فئات ذلك المجتمع، أو سائر المجالات ومختلف المواقع.
كما أنهم كانوا يملكون أذرعة ظاهرة وخفية، ممتدة هنا وهناك، وفي عمق المجتمع الإسلامي، حتى على مستوى بعض قيادات الدولة الإسلامية التي كانت تساهم بشكل فعّال في صنع القرار، أو في عرقلته وتعطيله([1]).
وكانوا يملكون قوة كبيرة من الثروات والأموال، ويكفي أنهم كانوا يملكون من الحلي الشيء الكثير، حتى قال بعضهم: إنهم كانوا يعيرونه للعرب من أهل مكة وغيرهم([2])، وكذلك كان لهم ديون على الناس كثيرة وإلى آجال مختلفة([3])، فكان وجود بني النضير واحداً من أهم مصادر القوة والتحدي لدى أعداء الإسلام والمسلمين، وبالأخص بالنسبة إلى المشركين، وكل من يتعاطف معهم من القبائل والطوائف في المنطقة العربية.
متى كانت غزوة بني النضير؟
اختلف المؤرخون في زمن غزوة بني النضير، فذهب جمع إلى أنها كانت قبل غزوة أحد، كما حكاه البخاري عن الزهري، وذهب آخرون كابن إسحاق إلى أنها بعد حرب أحد، ولعل الظاهر هو القول الثاني لما يأتي من سبب هذه الغزوة.
أسباب غزوة بني النضير:
لما رجع عمرو بن أمية من بئر معونة، والتي قتل فيها أربعون مبلغاً وداعياً من دعاة الإسلام كان النبي قد أرسلهم إلى أهل نجد لينشروا الإسلام ويعلّموا الناس الدين نزولاً عند طلب أبي براء العامري - الذي طلب من النبي ذلك وأجار المبلغين حفاظاً عليهم - لما قدم عليه المدينة، فلما بلغوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم، وهم يحملون من رسول الله كتاباً إلى عامر بن الطفيل، وقد كلّف المنذر بن عمرو - الذي كان زعيم البعثة - أحد المسلمين لإيصال الكتاب إلى عامر، فلما أتاه الكتاب لم ينظر فيه حتى عدا على حامل الكتاب فقتله، ثم استصرخ بني عامر على قتال المبلغين، فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم، وقالوا: لن ننقض عهد أبي براء، وقد عقد لهم عقداً وجواراً، فاستصرخ قبيلة أخرى من بني سليم فأجابوه فنزلوا عليهم، ودارت بينهم وبين مبلغي الإسلام حرب ضروس كان نهايتها أن قتل جميع المبلغين إلاّ كعب بن زيد الذي جرح وعاد إلى المدينة، وأخبر النبي(ص) بالأمر.
وكان عمرو بن أمية والحارث بن الصِّمَّة قد جعلهما جماعة المبلغين ليرعيا إبلهم ويحافظا عليها، وبينما كان الرجلان يقومان بواجبهما إذ أغار عليهما عامر بن الطفيل فقتل حارث بن الصمة، وأطلق سراح عمرو بن أمية، فعاد عمرو إلى المدينة، وفي أثناء طريقه التقى رجلين من العامريين فرافقهما وأمهلهما حتى إذا ناما وثب عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه انتقم لزملائه من المسلمين، ولكنه قد أخطأ في تصوره، لأن بني عامر لم تخفر جوار سيدها أبي براء، ولم تنقض أمانته كما بيّنا([4]).
فلما رجع المدينة أخبر النبي(ص) بالأمر فقال له: لقد قتلت رجلين لأدينَّهما،
فخرج (ص) إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين من بني عامر، وذلك طبقاً للعهد الذي كان (ص) أعطاهما، وكان بين بني عامر وبني النضير عهد وحلف، فلما أتاهم (ص) قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أجبت.
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذا، - وكان رسول الله(ص) إلى جنب جدار من بيوتهم قاعداً - فمَن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن حجاش بن كعب، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله في نفر من أصحابه، وفيهم علي وأبو بكر وعمر، فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة.
فلما استلبث النبي(ص) أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة، فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله(ص) حتى انتهوا إليه، فأخبرهم بما كانت اليهود أرادت من الغدر به.
فبعث رسول الله(ص) محمد بن مَسلمة يأمرهم بالجلاء عن جواره وبلده([5]).
أحداث غزوة بني النضير
بعد ما بلغهم أمر النبي(ص) بجلائهم عن جواره، بعث إليهم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول يحرضونهم على المقام في حصونهم ويعدونهم بالنصر فقويت عند ذلك نفوسهم، وحمي حيي بن أخطب، وبعثوا إلى رسول الله(ص) : «أنهم لا يخرجون، ونابذوه بنقض العهود».
عند ذلك أمر النبي(ص) الناس بالخروج إليهم، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، ثم سار إليهم بأصحابه حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال([6])، وقد تحصّنوا في حصونهم وأظهروا المقاومة والإصرار على الامتناع، فأمر رسول الله(ص) بقطع النخيل المحيطة بتلك الحصون، وإلقاء النار فيها لييأس اليهود من البقاء في تلك المنطقة ما دامت بساتينهم أعدمت وأفنيت، فتعالت نداءات اليهود تقول: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟!، فرد الله تعالى عليهم بقوله: (مَا قَطَعْتُمْ مّن لّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىَ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)([7])، ومن جهة أخرى خذلهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول فلم يأتوهم، كما اعتزلتهم يهود قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رجال، وقد ذكر الله تعالى خذلانهم إذ يقول: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَئِنْ أُخْرِجُواْ لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نّصَرُوهُمْ لَيُوَلّنّ الأدْبَارَ ثُمّ لاَ يُنصَرُونَ، لأنتُمْ أَشَدّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَفْقَهُونَ، لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاّ فِي قُرًى مّحَصّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتّىَ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَعْقِلُونَ)([8]).
وأخيراً رضخ اليهود لمطلب رسول الله، وسألوه أن يجليهم، ويكفّ عن دمائهم على أن يكون لهم ما حملت الإبل من أموالهم، إلا السلاح والدروع فرضي النبي(ص) بذلك، فاحتملوا من أموالهم أكبر قدر ممكن حتى أن الرجل منهم كان يخرب داره ويقلع بابه فيضعه على ظهر بعيره، فخرج منهم جماعة إلى خيبر، وجماعة أخرى إلى الشام، وقد خرجوا وهم يضربون بالدفوف، ويزمرون بالمزامير، وقد ألبسوا نساءهم الثياب الراقية، وحلي الذهب مظهرين بذلك تجلداً ليغطوا على هزيمتهم، ويروا المسلمين أنهم غير منزعجين من مغادرتهم تلك الديار([9]).
ويرى أكثر المؤرخين أنه لم يسفك في هذه الحادثة أيّ دم، ولكن الشيخ المفيد، يكتب في (الإرشاد): بأنه وقع ليلة فتح حصون بني النضير قتال محدود، قتل فيه عشرة من اليهود، وكان ذلك هو السبب في فتح تلكم الحصون([10]).
وقال المقريزي: وفُقد علي في بعض الليالي، فقال النبي(ص) : إنه في بعض شأنكم، فعن قليل جاء برأس (عزوك)، وقد كمن له حتى خرج في نفر من اليهود يطلب غرة من المسلمين، وكان شجاعاً رامياً، فشد عليه علي فقتله وفرّ اليهود([11]).
([1]) الصحيح من سيرة النبي الأعظم 8: 10.
([2]) الأموال: 242، وزاد المعاد 2: 136.
([4]) السيرة النبوية لابن هشام 2: 1168، وإن كان يرى أن المعتدل الذي كان مع عمرو بن أمية (المنذر بن محمد).
([5]) السيرة النبوية لابن كثير 3: 145 – 156، وتاريخ اليعقوبي 2: 49.
([6]) وقال الواقدي: فحاصرهم خمس عشرة ليلة.
([8]) سورة الحشر: الآيات 11 0- 14.
([9]) المغازي للواقدي 1: 365 – 383، والسيرة الحلبية 2: 263 – 270.
البدء ببناء مسجد النبي (ص) في المدينة المنورة (18 / ربيع الأول/ السنة الأولى للهجرة)
بعد وصول النبي(ص) بأيام إلى المدينة ابتاع الأرض التي بركت فيها ناقته يوم قدومه إلى المدينة، والتي كانت ليتيمين هما (سهل وسهيل) من الخزرج، وكانا عند أسعد بن زرارة، وقد اشتراها بعشرة دنانير، وذلك لإقامة مسجده فيها([1]).
وقد اشترك كافة المسلمين في تهيئة مواده وبنائه، كما أن رسول الله(ص) عمل بنفسه في تشييده فكان ينقل معهم اللبن والحجارة، وبينما هو (ص) ذات مرة ينقل حجراً على بطنه استقبله (أسيد بن حضير) فقال: يا رسول الله، أعطني أحمله عنك، فقال (ص) : لا، اذهب فاحمل غيره([2]).
وبهذا الأسلوب العملي كشف رسول الله(ص) عن جانب من خلقه وسلوكه القويم، إذ بيّن بعمله أنه رجل عمل، وليس رجل قول، وكان لهذا أثره الفعال في نفوس أتباعه، حتى أنشد بعضهم:
|
لئن قعدنا والنبي يعمل |
|
فذاك منا العمل المضلل([3]) |
وفعلاً بنى المسلمون مسجدهم وبنى المهاجرون منازلهم حول المسجد، وفتح كل واحد منهم بابه على المسجد شراعاً، فكانوا يخرجون من منازلهم فيدخلون المسجد من تلك الأبواب، ولكن فيما بعد أمر الله نبيه أن يأمر المسلمين بسد أبوابهم المشرعة على المسجد عدا بابه (ص) وباب علي(ع) .
فضل ومستحبات مسجد النبي (ص)
إن مسجد النبي (ص) في المدينة المنورة الذي بني على يد النبي(ص) وأصحابه الكرام يُعد ثانى المساجد في الفضل بعد مسجد الحرام في مكة المكرمة، وقد ورد في الحديث الشريف: «وصلاة في مسجدي تعدل (عشرة آلاف) صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»([4])، ولهذا المسجد مستحبات وآداب نذكرها بإختصار:
1- الغسل لدخول المسجد وزيارة قبر رسول الله (ص) .
2- الإستئذان بالدخول إلى المسجد والأفضل أن يكون الدخول من باب جبرئيل.
3- الصلوات على النبي (ص) عند الدخول وعند الخروج من المسجد وقراءة ذكر
(الله أكبر) مائة مرة.
4- صلاة ركعتين تحية المسجد النبوي الشريف.
5- زيارة قبر النبي (ص) وزيارة بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، التي يحتمل أن تكون مدفونة في بيتها أو في الروضة الشريفة بين قبر أبيها رسول الله (ص) ومنبره، ثم صلاة الزيارة.
6- الصلاة في الروضة الشريفة الواقعة بين قبر النبي (ص) ومنبره وقد جاء في الحديث النبوي الشريف «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»([5])، والصلاة عند اسطوانة التوبة والصلاة في مقام جبرئيل وإقامة الصلاة اليومية فيه ما أمكن.
7- الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف.
ولادة الإمام جعفر الصادق (ع) (17/ ربيع الأول/ السنة 83 هـ)
الإمام جعفر الصادق (ع) في سطور
هو الإمام الهمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، أبوه الإمام محمد الباقر(ع) سيد الناس وأعلمهم في عصره، ولم يظهر من أحد في ولد الإمامين الحسن والحسين(ع) من علم الدين والسنن، وعلم القرآن والسير، وفنون الأدب والبلاغة مثل ما ظهر منه([1]).
وأمه هي السيدة الفاضلة أم فروة بنت الفقيه القاسم بن محمد بن أبي بكر، وكانت من سيدات النساء عفة وشرفاً وفضلاً، فقد تربت في بيت أبيها، وهو من الفضلاء اللامعين في عصره، كما تلقّت الفقه والمعارف الإسلامية من زوجها الإمام محمد الباقر(ع) ، وكانت على جانب كبير من الفضل، فقد كانت مرجعاً لنساء عصرها في مهام أمورهنّ الدينية([2]).
لقّب(ع) بالصادق، ونصّ المؤرخون: أن النبي(ص) هو الذي سماه بجعفر ولقّبه بالصادق([3])، كما لقب بالصابر والفاضل والطاهر وعمود الشرف، والقائم والكافل والمنجي([4])، وكان يكنى بأبي عبد الله، وأبي إسماعيل، وأبي موسى([5]).
وقد اختلف المؤرخون في السنة التي ولد فيها، فمن قائل إنه ولد بالمدينة سنة 80 هـ([6])، وآخرون أنه ولد سنة 83 هـ يوم الجمعة، وقيل يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول([7])، وقيل سنة 86 هـ([8]).
رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز (65 سنة) في عام 148هـ، ودفن في البقيع إلى جوار أبيه الباقر(ع) ، وقد تزامنت إمامته مع نهاية الحكم الأموي في سنة 132هـ، وبدايات الحكم العباسي الذي بدأ من ذلك التاريخ، فقد عاصر من الخلفاء العباسيين، هشام بن عبد الملك، والوليد بن يزيد بن عبد الملك، ويزيد بن الوليد بن عبد الملك، وإبراهيم بن الوليد، ومروان بن محمد (المعروف بمروان الحمار)، ومن الخلفاء العباسيين، عبد الله بن محمد (المعروف بالسفاح)، وأبو جعفر (المعروف بالمنصور الدوانيقي).
المقام العلمي العظيم للإمام الصادق(ع)
اعترف أئمة المذاهب، وعلماء الأمة بالمقام العلمي الشامخ للإمام الصادق(ع) ، فقد قال أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) وهو إمام المذهب الحنفي الشهير: «ما رأيت أعلم من جعفر بن محمد»([9])، وقد استدل على أعلميته بأن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس([10]).
وقال مالك إمام المذهب المالكي: اختلفت إلى جعفر بن محمد زماناً، فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصلياً، وإما صائماً، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته قط يحدّث عن رسول الله(ص) إلاّ على طهارة([11])، ولا يتكلم بما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد والزهاد الذين يخشون الله، وما رأت عين ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً([12]).
وقال ابن حجر الهيثمي: جعفر الصادق نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في جميع البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه من العلوم([13]).
ويقول أبو بحر الجاحظ أحد علماء القرن الثالث: جعفر بن محمد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، ويقال إن أبا حنيفة من تلامذته، وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب([14]).
وكتب ابن خلكان المؤرخ الشهير: أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم أجمعين) أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية، وكان من سادات آل البيت، ولقّب بالصادق لصدقه، وفضله أشهر من أن يذكر، وكان أبو موسى جابر ابن حيان الكوفي تلميذاً عنده، وصنف جابر كتاباً في ألف ورقة يتضمن رسائل الإمام جعفر الصادق، وهي خمسمائة رسالة([15]).
الجامعة الجعفرية الكبرى
كان عصر الإمام الصادق(ع) عصراً فريداً، والظروف الاجتماعية والثقافية التي عاشها لم يعشها أيّ واحد من الأئمة(ع)، ذلك أن تلك الفترة كانت من الناحية السياسية فترة تزعزع الحكم الأموي، واشتداد شوكة العباسيين، وكان الطرفان في صراع مستمر، بدأ الصراع الإعلامي، والنضال السياسي للعباسيين منذ عهد هشام بن عبد الملك، وفي عام 129هـ دخل الصراع نطاق الكفاح المسلح، وفي نهاية المطاف انتصر العباسيون عام 132هـ.
ونظراً لانشغال الأمويين خلال هذه الفترة بالمشاكل السياسية الكثيرة لم تسنح لهم الفرصة لمضايقة الإمام الصادق وشيعته، كما أن العباسيين، ولأنهم كانوا يرفعون شعار الدفاع عن أهل البيت والثأر لهم قبل استلامهم مقاليد الحكم لم تكن هناك مضايقة من جانبهم أيضاً، ومن هنا كانت هذه الفترة فترة هدوء وحرية نسبية للإمام الصادق وشيعته، فكانت فرصة مناسبة جداً لتفعيل نشاطهم العلمي والثقافي.
ومن جهة أخرى كان عصره (ع) عصر تلاقح وتضارب الأفكار، وظهور الفرق والطوائف والتيارات المختلفة، وانبثقت شبهات وإشكاليات متعددة جراء تضارب عقائد المسلمين مع عقائد أهل الكتاب وفلاسفة اليونان.
وقد ظهرت تيارات وفرق، مثل المعتزلة والجبرية، والمرجئة، والغلاة، والزنادقة، والمشبهة، والمتصوفة، والمجسّمة، والتناسخية وغيرها، وكانت كل فرقة تروّج أفكارها وعقائدها، وفضلاً عن ذلك كله كان الخلاف يدب في العلم الواحد من العلوم الإسلامية بين علماء ذلك العلم، فمثلاً كانت تحدث مناقشات حادة في علوم القراءة والتفسير والحديث والفقه والكلام.
نظراً لذلك كله واصل الإمام الصادق(ع) الجهود التي ابتدأها أبوه الإمام الباقر، وأسس جامعة علمية كبيرة، علّم وربّى فيها تلامذة كباراً وبارزين، أمثال هشام بن الحكم، ومحمد بن مسلم، وأبان ابن تغلب، وهشام بن سالم، ومؤمن الطاق، والمفضل بن عمر، وجابر بن حيان، وغيرهم كثير في مختلف العلوم العقلية والنقلية، وقد ناهز عدد تلامذته الأربعة آلاف عالم([16])، وكان لبعضهم مؤلفات علمية وتلامذة كثيرون، فكان لهشام ابن الحكم واحد وثلاثون كتاباً([17])، ولجابر أكثر من مئتي كتاب([18]) وفي مواضيع مختلفة لا سيما في العلوم العقلية والطبيعية والكيمياوية، وقد أشتهر بأبي الكيمياء.
لقد زخرت هذه الجامعة بطلاب من مختلف المذاهب والفرق، وكان أئمة المذاهب السنية المشهورون بشكل مباشر وغير مباشر تلامذة لديه، وكان على رأسهم أبو حنيفة الذي لازم الإمام سنتين، وجعل هاتين السنتين مصدر علمه ومعرفته، وكان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان([19]).
ويكفي ما قاله الحسن بن علي بن زياد الوشاء في سعة هذه الجامعة فقال: أدركت في هذا المسجد - أي مسجد الكوفة - تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد([20]).
ويقول ابن حجر العسقلاني: فقد حدث عنه فقهاء ومحدثون، مثل: شعبة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عينية، ومالك، وابن جريح، وأبي حنيفة، وابنه موسى، ووهيب بن خالد، والقطان، وأبي عاصم، وجماعة كثيرة([21]).
([2]) قبسات من سيرة القادة الهداة 2: 50.
([3]) الدر النظيم في مناقب الأئمة: 185.
([4]) مرآة الزمان 5: 116، وسر السلسلة العلوية: 34، ومناقب آل أبي طالب 4: 281.
([5]) المناقب لابن شهر آشوب 4: 281.
([7]) أصول الكافي 1: 472، والمناقب 4: 280، وإعلام الورى: 271.
([10]) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 4: 335.
([14]) نقله عنه كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1: 55.
([18]) الفهرست لابن النديم: 512 – 517.
([19]) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1: 70.
ولادة النبي الأكرم (ص) (17 / ربيع الأول/ عام الفيل)
اتفق المسلمون - إلا من شذّ - على أن ولادته (ص) في عام الفيل في شهر ربيع الأول([1])، ولكنهم اختلفوا في يومه، فذهب المشهور من العلماء إلى أنه في اليوم السابع عشر منه، وقد نقله الأثبات من الأعلام كالمفيد، والطبرسي، وابن طاووس، والمجلسي الأول قال في (البحار): إعلم أنه اتفقت الإمامية - إلا من شذّ منهم - على أن ولادته (ص) كانت في السابع عشر من ربيع الأول عام الفيل، وذلك لأربع وثلاثين سنة مضت من ملك كسرى أنوشيروان([2]).
وذهب إخواننا السنة إلى أن ولادته كانت في الثاني عشر من ربيع الأول، وتابعهم عليه الكليني والشيخ المفيد.
وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية هذه الأيام بين تقدير التاريخين أسبوع الوحدة الإسلامية.
وقد ولد النبي(ص) في شِعب أبي طالب أو شِعب بني هاشم في الدار التي اشتراها محمد بن يوسف أخو الحجاج من ورثة عقيل بن أبي طالب، ثم صيرتها الخيزران أم هارون الرشيد مسجداً([3]).
قال المحدث القمي: «قالت آمنة بنت وهب: إن النبي - والله - سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء كل شيء، فسمعت في الضوء قائلاً يقول، إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمداً»([4])، وفي (الخرائج) كما عن (البحار): «أنه ولد (ص) مختوناً مقطوع السرة»([5]).
وترافق مع ولادته المباركة حوادث كانت غريبة وعجيبة على قريش والعالم بأسره، منها: انكباب الأصنام جميعاً على وجوهها حول الكعبة، واضطراب إيوان كسرى، وسقوط أربعة عشر شرفة منه، وانخماد نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة، ولم يبق سرير لملك من ملوك الأرض إلا نكس، وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة([6])، قال أمير المؤمنين(ع): «ولما حل الليل سمع هذا النداء من السماء: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، وأشرقت الدنيا كلها في هذه الليلة، وضحك الحجر والمدر، وسُبح الله في السماوات والأرضين، وبكى إبليس وقال: خير الأمة وأفضل الخلائق، وأكرم العباد وأعظم العالمين؛ محمد»([7]).
عناية الله بنبيه (ص)
فقد النبي(ص) أباه عبد الله بن عبد المطلب وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه، فكان اليتم ملازماً لحياته(ص) فجعل الله تعالى كفالته لجده عبد المطلب الذي كان يهتم به أكثر من سائر بني هاشم، وقد أوصى بكفالته من بعده إلى ابنه أبي طالب الذي كان نعم الناصر والمآزر والمحامي عن النبي(ص) ، فكان (ع) يباشر بنفسه حمايته، وبعد انطلاق النبي(ص) بالدعوة إلى الحق، كان أبو طالب قد جند بني هاشم لحمايته([8]) والذب عنه ونصرته، وهذه العناية الإلهية بالنبي(ص) كان قد بينها القرآن الكريم بقوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىَ)([9]).
من أوصاف النبي (ص)
أن النبي الأكرم(ص) كان قد كرّس جلّ حياته في سبيل دعوة الناس إلى الله تعالى وإلى تعاليمه، دون أن يستعين بأية وسيلة مادية كبيرة أو قوّة عسكرية هائلة.
فما الذي مكّن رسول الله(ص) من إحراز ذلك النجاح الباهر في مجتمع الجاهلية مغرق في القسوة والجفاء، وغلظة الطبع وشكاسة الخلق؟!
كيف طوى خاتم الأنبياء(ص) رحلة قرن ونصف من الزمان في ربع قرن؟ وكيف لم تحتج عملية الهداية المحمدية والتغيير الاجتماعي والفكري العميق إلى زمن طويل؟!
ويأتي الجواب القرآني واضحاً من خلال وصفه تعالى لرسوله الكريم بالخلق العظيم حيث وصف به نبيه تارة على نحو الإجمال، إذ قال عنه: (وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ)([10]).
وتارة بالتفصيل، نسبياً، إذ قال: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنْ حَوْلِكَ)([11]).
وقوله تعالى: (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ)([12]).
وفيما يلي باقة عطرة من خُلُق النبي(ص) وأدبه مع نفسه ومع ربه ومع مجتمعه كانت هي سرَّ نجاحه، ورمز خلوده، نقلاً عن ابن عمه الإمام علي بن أبي طالب (ع) يتحدث عن أخلاق رسول الله (ص) .
الإمام علي (ع) يصف النبي(ص)
قال الإمام الحسين بن علي(ع) سألتُ أبي عن رسول الله(ص) ، فقال (ع) :
* كان(ص) دخولُه في نفسه مأذوناً في ذلك.
* فإذا آوى إلى منزله جَزّأ دُخولَه ثلاثة أجزاءٍ جزءاً لله، وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه ثم جزّأ جزءه بينه وبين الناس فيردُّ ذلك بالخاصَّة على العامة، ولا يَدّخر عنهم منه شيئاً.
* وكان(ص) من سيرته في جزء الأمُّة، إيثار أهل الفضل بأدبه، وقسّمه على قَدَر فضلهم في الدين، فمنهم: ذو الحاجة ومنهم ذوالحاجتين، ومنهم ذوالحوائج، فيتشاغل بهم، ويشغَلهم فيما أصلَحَهم، والأُمّةَ، مِن مسألته عنهم، وبإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول: ليبلّغِ الشاهدُ منكم الغائبَ وأبلغوني حاجةَ من لا يقدرُ على إبلاغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجةَ من لا يقدرُ على إبلاغها ثبّت الله قدمَيْه يوم القيامة، لا يُذكر عنده إلاّ ذلك، ولا يقبل من أحدٍ غيرَه، يدخلون رُوّاداً، ولا يفترقونَ إلاّ عن ذواق ويخرجون أدلّةً.
* كان رسول الله(ص) يخزن لسانه إلاّ عمّا كان يعنيه.
* ويؤلّفهُّم ولا ينفّرهم.
* ويُكرمُ كريمَ كلِّ قوم ويولَّيه عليهم.
* ويحذَرُ الناس ويحترسُ منهم من غيرِ أن يطوي عن أحدٍ بِشره ولا خُلُقه.
* ويتفقَّد أصحابَه.
* ويسأل الناسَ عمّا في الناس.
* ويحسّنُ الحسنَ ويقوّيه.
* ويقبّحُ القبيحَ ويوهنُه.
* معتدلَ الأمر غير مختلف فيه.
* لا يغفَل مخافةَ أن يغفلوا ويميلوا.
* ولا يقصّرُ عن الحقِ ولا يجوِّزُهُ.
* الذين يَلُونه من الناسِ خيارُهم.
* أفضلُهم عنده أعمّهم نصيحةً للمسلمين.
* وأعظمهُم عنده منزلةً أحسنُهم مواساة وموازرة.
* كان(ص) لا يجلس ولا يقومُ إلاّ على ذكرٍ.
* وإذا انتهى إلى قوم، جَلَسَ حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك.
* ويعطي كلَّ جلسائه نصيبَه، ولا يحسب أحدٌ من جلسائه أنَّ أحداً أكرمُ عليه منه.
* مَن جالسَهُ صابره حتى يكونَ هو المنصرف.
* مَن سأله حاجة لم يرجع إلاّ بها، أو ميسورٍ مِنَ القول.
* قد وسع الناسَ منه خُلُقُهُ فصارَ لهم أباً، وصاروا عنده في الخَلق سواء.
* مجلسُه مجلسُ حلمٍ وحياءٍ وصدقٍ وأمانةٍ، لاتُرفَعُ عليه الأصوات، ولا تؤبَنُ فيه الحُرَم، ولا تُثَنى فلتاتُه، مُتعادلين، متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون الكبيرَ، ويَرحمون الصَّغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.
* كان(ص) دائمَ البشْر.
* سَهْلَ الخُلُقِ.
* لَيّنَ الجانب.
* ليس بفِظِّ ولا غليظٍ، ولا ضَحّاكٍ، ولا فحّاشٍ، ولا عَيّابٍ، ولا مَدّاحٍ.
* يتغافلُ عما لا يشتهي، فلا يؤيَس منه، ولا يُخيّبُ فيه مؤمليه.
* قد ترك نفسَه من ثلاث: المراء، والإكثار، ومالايعنيه.
* وترك الناس من ثلاث: كان(ص) لا يذمُّ أحداً ولا يعيّره، ولا يطلب عثراتِه ولا عورته.
* ولا يتكلم إلاّ فيما رُجِي ثوابَه.
* إذا تكلم أطرقَ جُلساؤه كأنَّ(ص) على رؤوسهم الطير، فإذا سكت سكَتوا.
* ولا يتَنازعون عنده الحديث.
* من تكلم أنصَتوا له حتى يفرَغ، حديثهم عنده حديث أوّلهم.
* يضحكُ ممّا يضحكون منه.
* ويتعجبُ ممّا يتعجَّبون منه.
* ويصبرُ للغريب على الجفوة في مسألته ومنطِقِه، حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالبَ الحاجة يطلبُها فأرْفِدُوهُ.
* ولا يقبل الثناء إلاّ مِن مكافىء.
* ولا يقطعُ على أحدٍ كلامَهُ حتى يجوز فيقطعُه بنهيٍ أو قيامٍ.
* كان(ص) سكوته على أربع: على الحلمِ، والحذرِ، والتقدير، والتفكير.
فأمّا التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس.
وأمّا تفكّرهُ ففيما يبقى ويفنى.
وجمع له الحلم والصبرَ فكان(ص) لا يغضبهُ شيء ولا يستفزُّه.
وجمع له الحذرَ في أربع: أخذُه بالحَسَن ليقتدى به، وتركُه القبيح ليُنتهى عنه، واجتهادُه الرأيَ في صلاح اُمَّتِه، والقيام فيما جمع له خير الدنيا والآخرة.
(وقال عنه علي بن أبي طالب(ع) أيضاً)
* كان رسول الله(ص) يأكل على الأرض،
* ويجلس جِلسَة العبد،
* ويخصفُ بيدِهِ نَعله،
* ويرقّع ثوبَه،
* ويركبُ الحمارَ العاري،
* ويردفُ خلفه،
* ويكون الستر على بابه فيكون عليه التصاويرُ فيقول: يا فلانة – لإحدى زوجاته – غيِّبيه عنّي، فإنيّ إذا نَظَرْتُ إليه ذكرتُ الدنيا وزخارفها.
فأعرضَ عن الدنيا بقَلبه، وأمات ذكرَها عن نفسه، وأحبَّ أن تغيب زينتها عن عينيه لكيلا يتخذ منها ريشاً، ولا يعتقدها قراراً، ولا يرجو فيها مقاماً، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيّبها عن البصر([13]).
([3]) الكافي 1: 439، ومروج الذهب 2: 174.
([4]) منتهى الآمال 1: 58، وتاريخ الطبري 2: 156.
([5]) بحار الأنوار 15: 369، والمنتظم 2: 227 – 249.
([7]) بحار الأنوار 15: 574، ومنتهى الآمال 1: 59.
([8]) سيرة ابن هشام 1: 118 – 119.
([11]) سورة آل عمران: الآية 159.
([12]) سورة التوبة: الآية 138.
([13]) ذكر هذا الحديث في الكتب التالية: معاني الاخبار للصدوق، مكارم الأخلاق للطبرسي، إحياء علوم الدين للغزالي، دلائل النبوة لأبي نعيم.