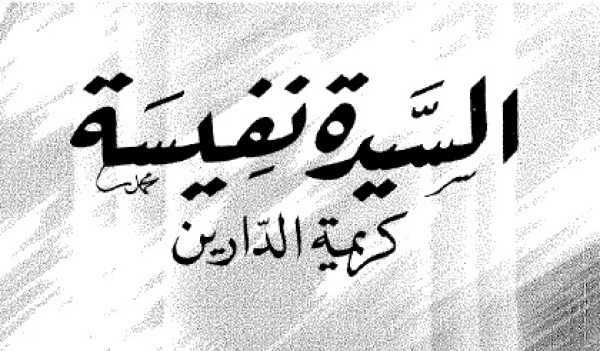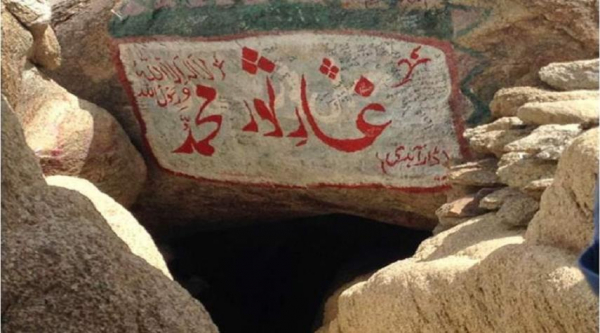Super User
ولادة النبي الأكرم (ص) (17 / ربيع الأول/ عام الفيل)
اتفق المسلمون - إلا من شذّ - على أن ولادته (ص) في عام الفيل في شهر ربيع الأول([1])، ولكنهم اختلفوا في يومه، فذهب المشهور من العلماء إلى أنه في اليوم السابع عشر منه، وقد نقله الأثبات من الأعلام كالمفيد، والطبرسي، وابن طاووس، والمجلسي الأول قال في (البحار): إعلم أنه اتفقت الإمامية - إلا من شذّ منهم - على أن ولادته (ص) كانت في السابع عشر من ربيع الأول عام الفيل، وذلك لأربع وثلاثين سنة مضت من ملك كسرى أنوشيروان([2]).
وذهب إخواننا السنة إلى أن ولادته كانت في الثاني عشر من ربيع الأول، وتابعهم عليه الكليني والشيخ المفيد.
وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية هذه الأيام بين تقدير التاريخين أسبوع الوحدة الإسلامية.
وقد ولد النبي(ص) في شِعب أبي طالب أو شِعب بني هاشم في الدار التي اشتراها محمد بن يوسف أخو الحجاج من ورثة عقيل بن أبي طالب، ثم صيرتها الخيزران أم هارون الرشيد مسجداً([3]).
قال المحدث القمي: «قالت آمنة بنت وهب: إن النبي - والله - سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء كل شيء، فسمعت في الضوء قائلاً يقول، إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمداً»([4])، وفي (الخرائج) كما عن (البحار): «أنه ولد (ص) مختوناً مقطوع السرة»([5]).
وترافق مع ولادته المباركة حوادث كانت غريبة وعجيبة على قريش والعالم بأسره، منها: انكباب الأصنام جميعاً على وجوهها حول الكعبة، واضطراب إيوان كسرى، وسقوط أربعة عشر شرفة منه، وانخماد نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة، ولم يبق سرير لملك من ملوك الأرض إلا نكس، وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة([6])، قال أمير المؤمنين(ع): «ولما حل الليل سمع هذا النداء من السماء: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، وأشرقت الدنيا كلها في هذه الليلة، وضحك الحجر والمدر، وسُبح الله في السماوات والأرضين، وبكى إبليس وقال: خير الأمة وأفضل الخلائق، وأكرم العباد وأعظم العالمين؛ محمد»([7]).
عناية الله بنبيه (ص)
فقد النبي(ص) أباه عبد الله بن عبد المطلب وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه، فكان اليتم ملازماً لحياته(ص) فجعل الله تعالى كفالته لجده عبد المطلب الذي كان يهتم به أكثر من سائر بني هاشم، وقد أوصى بكفالته من بعده إلى ابنه أبي طالب الذي كان نعم الناصر والمآزر والمحامي عن النبي(ص) ، فكان (ع) يباشر بنفسه حمايته، وبعد انطلاق النبي(ص) بالدعوة إلى الحق، كان أبو طالب قد جند بني هاشم لحمايته([8]) والذب عنه ونصرته، وهذه العناية الإلهية بالنبي(ص) كان قد بينها القرآن الكريم بقوله تعالى: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىَ)([9]).
من أوصاف النبي (ص)
أن النبي الأكرم(ص) كان قد كرّس جلّ حياته في سبيل دعوة الناس إلى الله تعالى وإلى تعاليمه، دون أن يستعين بأية وسيلة مادية كبيرة أو قوّة عسكرية هائلة.
فما الذي مكّن رسول الله(ص) من إحراز ذلك النجاح الباهر في مجتمع الجاهلية مغرق في القسوة والجفاء، وغلظة الطبع وشكاسة الخلق؟!
كيف طوى خاتم الأنبياء(ص) رحلة قرن ونصف من الزمان في ربع قرن؟ وكيف لم تحتج عملية الهداية المحمدية والتغيير الاجتماعي والفكري العميق إلى زمن طويل؟!
ويأتي الجواب القرآني واضحاً من خلال وصفه تعالى لرسوله الكريم بالخلق العظيم حيث وصف به نبيه تارة على نحو الإجمال، إذ قال عنه: (وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ)([10]).
وتارة بالتفصيل، نسبياً، إذ قال: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنْ حَوْلِكَ)([11]).
وقوله تعالى: (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ)([12]).
وفيما يلي باقة عطرة من خُلُق النبي(ص) وأدبه مع نفسه ومع ربه ومع مجتمعه كانت هي سرَّ نجاحه، ورمز خلوده، نقلاً عن ابن عمه الإمام علي بن أبي طالب (ع) يتحدث عن أخلاق رسول الله (ص) .
الإمام علي (ع) يصف النبي(ص)
قال الإمام الحسين بن علي(ع) سألتُ أبي عن رسول الله(ص) ، فقال (ع) :
* كان(ص) دخولُه في نفسه مأذوناً في ذلك.
* فإذا آوى إلى منزله جَزّأ دُخولَه ثلاثة أجزاءٍ جزءاً لله، وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه ثم جزّأ جزءه بينه وبين الناس فيردُّ ذلك بالخاصَّة على العامة، ولا يَدّخر عنهم منه شيئاً.
* وكان(ص) من سيرته في جزء الأمُّة، إيثار أهل الفضل بأدبه، وقسّمه على قَدَر فضلهم في الدين، فمنهم: ذو الحاجة ومنهم ذوالحاجتين، ومنهم ذوالحوائج، فيتشاغل بهم، ويشغَلهم فيما أصلَحَهم، والأُمّةَ، مِن مسألته عنهم، وبإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول: ليبلّغِ الشاهدُ منكم الغائبَ وأبلغوني حاجةَ من لا يقدرُ على إبلاغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجةَ من لا يقدرُ على إبلاغها ثبّت الله قدمَيْه يوم القيامة، لا يُذكر عنده إلاّ ذلك، ولا يقبل من أحدٍ غيرَه، يدخلون رُوّاداً، ولا يفترقونَ إلاّ عن ذواق ويخرجون أدلّةً.
* كان رسول الله(ص) يخزن لسانه إلاّ عمّا كان يعنيه.
* ويؤلّفهُّم ولا ينفّرهم.
* ويُكرمُ كريمَ كلِّ قوم ويولَّيه عليهم.
* ويحذَرُ الناس ويحترسُ منهم من غيرِ أن يطوي عن أحدٍ بِشره ولا خُلُقه.
* ويتفقَّد أصحابَه.
* ويسأل الناسَ عمّا في الناس.
* ويحسّنُ الحسنَ ويقوّيه.
* ويقبّحُ القبيحَ ويوهنُه.
* معتدلَ الأمر غير مختلف فيه.
* لا يغفَل مخافةَ أن يغفلوا ويميلوا.
* ولا يقصّرُ عن الحقِ ولا يجوِّزُهُ.
* الذين يَلُونه من الناسِ خيارُهم.
* أفضلُهم عنده أعمّهم نصيحةً للمسلمين.
* وأعظمهُم عنده منزلةً أحسنُهم مواساة وموازرة.
* كان(ص) لا يجلس ولا يقومُ إلاّ على ذكرٍ.
* وإذا انتهى إلى قوم، جَلَسَ حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك.
* ويعطي كلَّ جلسائه نصيبَه، ولا يحسب أحدٌ من جلسائه أنَّ أحداً أكرمُ عليه منه.
* مَن جالسَهُ صابره حتى يكونَ هو المنصرف.
* مَن سأله حاجة لم يرجع إلاّ بها، أو ميسورٍ مِنَ القول.
* قد وسع الناسَ منه خُلُقُهُ فصارَ لهم أباً، وصاروا عنده في الخَلق سواء.
* مجلسُه مجلسُ حلمٍ وحياءٍ وصدقٍ وأمانةٍ، لاتُرفَعُ عليه الأصوات، ولا تؤبَنُ فيه الحُرَم، ولا تُثَنى فلتاتُه، مُتعادلين، متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون الكبيرَ، ويَرحمون الصَّغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.
* كان(ص) دائمَ البشْر.
* سَهْلَ الخُلُقِ.
* لَيّنَ الجانب.
* ليس بفِظِّ ولا غليظٍ، ولا ضَحّاكٍ، ولا فحّاشٍ، ولا عَيّابٍ، ولا مَدّاحٍ.
* يتغافلُ عما لا يشتهي، فلا يؤيَس منه، ولا يُخيّبُ فيه مؤمليه.
* قد ترك نفسَه من ثلاث: المراء، والإكثار، ومالايعنيه.
* وترك الناس من ثلاث: كان(ص) لا يذمُّ أحداً ولا يعيّره، ولا يطلب عثراتِه ولا عورته.
* ولا يتكلم إلاّ فيما رُجِي ثوابَه.
* إذا تكلم أطرقَ جُلساؤه كأنَّ(ص) على رؤوسهم الطير، فإذا سكت سكَتوا.
* ولا يتَنازعون عنده الحديث.
* من تكلم أنصَتوا له حتى يفرَغ، حديثهم عنده حديث أوّلهم.
* يضحكُ ممّا يضحكون منه.
* ويتعجبُ ممّا يتعجَّبون منه.
* ويصبرُ للغريب على الجفوة في مسألته ومنطِقِه، حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالبَ الحاجة يطلبُها فأرْفِدُوهُ.
* ولا يقبل الثناء إلاّ مِن مكافىء.
* ولا يقطعُ على أحدٍ كلامَهُ حتى يجوز فيقطعُه بنهيٍ أو قيامٍ.
* كان(ص) سكوته على أربع: على الحلمِ، والحذرِ، والتقدير، والتفكير.
فأمّا التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس.
وأمّا تفكّرهُ ففيما يبقى ويفنى.
وجمع له الحلم والصبرَ فكان(ص) لا يغضبهُ شيء ولا يستفزُّه.
وجمع له الحذرَ في أربع: أخذُه بالحَسَن ليقتدى به، وتركُه القبيح ليُنتهى عنه، واجتهادُه الرأيَ في صلاح اُمَّتِه، والقيام فيما جمع له خير الدنيا والآخرة.
(وقال عنه علي بن أبي طالب(ع) أيضاً)
* كان رسول الله(ص) يأكل على الأرض،
* ويجلس جِلسَة العبد،
* ويخصفُ بيدِهِ نَعله،
* ويرقّع ثوبَه،
* ويركبُ الحمارَ العاري،
* ويردفُ خلفه،
* ويكون الستر على بابه فيكون عليه التصاويرُ فيقول: يا فلانة – لإحدى زوجاته – غيِّبيه عنّي، فإنيّ إذا نَظَرْتُ إليه ذكرتُ الدنيا وزخارفها.
فأعرضَ عن الدنيا بقَلبه، وأمات ذكرَها عن نفسه، وأحبَّ أن تغيب زينتها عن عينيه لكيلا يتخذ منها ريشاً، ولا يعتقدها قراراً، ولا يرجو فيها مقاماً، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيّبها عن البصر([13]).
([3]) الكافي 1: 439، ومروج الذهب 2: 174.
([4]) منتهى الآمال 1: 58، وتاريخ الطبري 2: 156.
([5]) بحار الأنوار 15: 369، والمنتظم 2: 227 – 249.
([7]) بحار الأنوار 15: 574، ومنتهى الآمال 1: 59.
([8]) سيرة ابن هشام 1: 118 – 119.
([11]) سورة آل عمران: الآية 159.
([12]) سورة التوبة: الآية 138.
([13]) ذكر هذا الحديث في الكتب التالية: معاني الاخبار للصدوق، مكارم الأخلاق للطبرسي، إحياء علوم الدين للغزالي، دلائل النبوة لأبي نعيم.
دخول النبي (ص) المدينة المنورة (15 / ربيع الأول / السنة 13 للبعثة)
المدينة تهبّ لقدوم النبي(ص)
لقد خرج النبي (ص) مهاجراً من مكة المكرمة في الأول من ربيع الأول السنة 13 للبعثة وقد وصل إلى منطقه قباء من ضواحي يثرب في 12 من ربيع الأول من تلك السنة وانتظر ابن عمه والذين معه من الفواطم والأصحاب ولم يدخل المدينة، إلى أن التحقوا به (ص) في 15 من ربيع الأول ودخلوا معه إلى مدينة يثرب التي سميت بعد ذلك بمدنية الرسول(ص) ، واشتهرت بالمدينة المنورة إلى يومنا هذا.
وكان اليوم الذي دخل فيه رسول الله(ص) يوماً عظيماً مشهوداً، فكم ترى ستكون عظيمة فرحة الذين آمنوا برسول الله(ص) منذ ثلاث سنين، وظلوا طوال هذه الأعوام يبعثون برسلهم ووكلائهم إليه، ويذكرون اسمه المقدّس، ويصلّون عليه في صلواتهم كل يوم، إذا سمعوا أن قائدهم ذلك الذي طال انتظارهم له، واشتد تشوقهم إليه قد حان لقاؤهم به، وقدومه عليهم.
حطّ قدمه على تراب يثرب استقبله الناس رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، استقبالاً عظيماً مهيباً، ورحّبوا به أعظم ترحيب. وكان في مقدمة المستقبلين أصحاب بيعة العقبة الثانية، وهم سبعون رجلاً وكذلك المهاجرون وفي مقدمتهم مصعب بن عمير.
وكانت بنو عمرو بن عوف قد اجتمعت عنده، وأصرّت عليه بأن ينزل في قباء، وقالوا له: أقم عندنا يا رسول الله، فإنا أهل الجد والجلد والحلقة (أي السلاح) والمنعة، ولكن رسول الله(ص) لم يقبل.
وبلغ الأوس والخزرج خروج رسول الله(ص) ، وقرب نزوله المدينة قلبوا السلاح وأقبلوا يعدون حول ناقته لا يمرّ بحيّ من أحياء الأنصار إلاّ وثبوا في وجهه، وأخذوا بزمام ناقته، وأصروا عليه أن ينزل عليهم، ورسول الله(ص) يقول: خلّوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
وأخيراً لما انتهت ناقته إلى أرض واسعة كانت ليتيمين من الخزرج يقال لهما: سهل وسهيل، وكانا في حجر أسعد بن زرارة، فبركت على باب أبي أيوب (خالد بن زيد الأنصاري) الذي كان على مقربة من تلك الأرض، فاغتنمت زوجة أبي أيوب الفرصة فبادرت إلى رحل رسول الله(ص) فحلّته وأدخلته منزلها، بينما اجتمع عليه الناس يسألونه أن ينزل عليهم، فلما أكثروا عليه، وتنازعوا في أخذه، قال (ص) : «أين الرحل؟» فقالوا: أم أيوب قد أدخلته في بيتها([1])، فقال (ص) : «المرء مع رحله»، وكان أبو أيوب أفقر أهل المدينة، وبقي النبي(ص) عنده حتى بُني مسجده.
دخول الإمام علي بن أبي طالب (ع) إلى المدينة المنورة (15 / ربيع الأول / السنة 13 للبعثة)
لما وصل النبي(ص) في هجرته من مكة إلى قرية قباء من ضواحي يثرب وكان ذلك في 12 من ربيع الأول أقام فيها عدة أيام منتظراً قدوم ابن عمه وأخيه علي بن أبي طالب(ع) بركب الفواطم، وكان قد ألحّ أبو بكر عليه لكي يدخل المدينة في ليلته إلاّ أن النبي(ص) قال له: «ما أنا بداخلها حتى يقدم ابن عمي وأخي وابنتي»، يعني علياً وفاطمة(عليهما السلام)، ([1]). فلما أمسى فارقه أبو بكر، ودخل المدينة، ونزل على بعض الأنصار، وبقي النبي(ص) في قباء نازلاً على كلثوم ابن الهدم([2])، ينتظر قدوم ابن عمه من مكة المكرمة ليدخلوا مدينة يثرب معاً.
وقد خرج الإمام علي بن أبي طالب (ع) من مكة المكرمة، بعد خروج النبي بثلاثة أيام بعدما نفَّذ وصايا النبي (ص) وكان معه من ضعفاء المؤمنين، وأمرهم أن يتسللوا ويتخفّوا تحت جنح الليل إلى ذي طوى، وخرج (ع) بالفواطم، وتبعهم أيمن ابن أم أيمن مولى رسول الله(ص) وأبو واقد، فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم، فأمره (ع) بالرفق فاعتذر بخوفه من الطلب، فقال أمير المؤمنين(ع) : «أربع عليك، فإن رسول الله(ص) قال لي: يا علي أما إنهم لن يصلوا من الآن إليك بأمر تكرهه»([3]).
وأدركه الطلب قرب ضجنان، وهم سبع فوارس متلثمون، وثامنهم مولى للحارث بن أمية يدعى جناحاً، فأنزل علي(ع) النسوة، وأقبل على القوم منتضياً السيف، فأمروه بالرجوع، فقال: فإن لم أفعل؟ قالوا: لترجعن راغماً، أو لنرجعن بأكثرك شعراً، وأهون بك من هالك.
ودنا الفوارس من المطايا ليثوّروها، فحال علي(ع) بينهم وبينها فأهوى جناح بسيفه، فراغ علي(ع) عن ضربته، وتختله علي(ع) فضربه على عاتقه فأسرع السيف مضياً فيه، حتى مس كاثبة فرسه، ثم شد عليهم بسيفه فتصدع القوم عنه، وقالوا: أغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب، قال (ع) : فإني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه، وأهريق دمه فليتبعني، أو فليدن مني، ثم أقبل على صاحبيه، فقال لهما: أطلقا مطاياكما.
ثم سار فنزل ضجنان، فتلوم بها قدر يومه وليلته، ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين، فعبدوا الله تلك الليلة قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر، فصلى بهم علي(ع) صلاة الفجر، ثم سار بهم، فجعلوا يصنعون ذلك في كل منزل حتى قدم قباء.
ولما بلغ النبي(ص) قدوم علي، قال: ادعوا لي علياً، قيل: يا رسول الله، لا يقدر أن يمشي، فأتاه النبي(ص) ، فلما رآه اعتنقه، وبكى رحمة لما بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دماً، فقال (ص) : «يا علي، أنت أول هذه الأمة إيماناً بالله ورسوله، وأولهم هجرة إلى الله ورسوله، وآخرهم عهداً برسوله، لا يحبك والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان ولا يبغضك إلا منافق أو كافر»([4]).
ثم بعد ذلك دخل النبي(ص) والإمام علي(ع) ومن معه إلى المدينة.
يقول المقريزي: قدم رسول الله(ص) قباء في الثاني عشر من ربيع الأول، والتحق به علي(ع) في منتصف ذلك الشهر نفسه([5])، ويؤيد هذا القول ما ذكره الطبري في (تاريخه) إذ كتب يقول: أقام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله(ص) الودائع التي كانت عنده إلى الناس([6]).
([1]) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) : 4: 88 – 89.
([3]) هذه الكلمة قالها النبي له بعد خروجه من الغار لا عند مبيته في الفراش كما توهمه ابن تيمية.
([4]) راجع تفاصيل هذه القصة: أمالي الطوسي 2: 83 – 86، وبحار الأنوار 19: 64 – 67، وتفسير البرهان 1: 332 – 333، نقلاً عن الشيباني في نهج البيان، وعن الشيخ المفيد في الاختصاص، ورواها ابن شهر آشوب في المناقب 1: 183 – 184، وإعلام الورى: 190، وإمتاع الإسماع للمقريزي 1: 48، وذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ 2: 106.
([6]) تاريخ الطبري 2: 382، نقلاً عن كتاب سيد المرسلين 1: 619.
بناء مسجد قباء أول مسجد في الإسلام (12 / ربيع الأول / السنة 13 للبعثة)
(لّمَسْجِدٌ أُسّسَ عَلَى التّقْوَىَ مِنْ أَوّلِ يَوْمٍ أَحَقّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُواْ وَاللهُ يُحِبّ الْمُطّهّرِينَ)([1])، وقد ورد في الأحاديث أن الصلاة فيه تعدل عمرة مفردة.
وصل النبي(ص) بعد خروجه من الغار إلى قرية قباء([2]) الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول، ونزل وصاحبه على كلثوم بن الهدم، وهو شيخ من بني عمرو، وقد خط رسول الله(ص) مسجداً لقبيلته بني عمرو بن عوف، ونصب لهم قبلته([3])، وكان أول مسجد بني في الإسلام، وقد عبّر عنه القرآن بأنه المسجد الذي أسس على التقوى.
مكانة المسجد في الإسلام
إن للمساجد مكانة عالية ومرموقة في الإسلام، وقد جعلها الله تعالى بيوته في الأرض، فعن رسول الله(ص) أنه قال: «مكتوب في التوراة، أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة»([4]).
وعن الإمام جعفر الصادق(ع) أنه قال: «عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهراً طهره الله من ذنوبه، وكتب من زواره، فاكثروا فيها من الصلاة والدعاء»([5]).
وقد اعتبر الإسلام المساجد مراكز للمسلمين، فمنها يستفيدون علوم دينهم، ويحيون نفوسهم، ويتأدبون بآداب نبيهم، فعن علي(ع) قال: «من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: أخاً مستفاداً في الله، أو علماً مستظرفاً، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنباً خشية أو حياء»([6]).
وعن رسول الله(ص) أنه قال: «لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به ليصرف الله به عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله عز وجل»([7]).
الآداب المعنوية للمساجد:
قد جعل الإسلام لبيوت الله في الأرض آداباً قلبية وروحية ونفيسة، ينبغي على زائرها الالتفات إليها، وفيما يلي حديث للإمام الصادق(ع) قد جمع فيه جملة من هذه الآداب فقال (ع): «إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب بيت ملك عظيم، لا يطأ بساطته إلا المطهّرون، ولا يؤذن بمجالسة مجلسه إلاّ الصدّيقون، وَهَبَ القدوم إلى بساط خدمة الملك، فإنك على خطر عظيم، إن غفلت هيبة الملك، واعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبك.
واعترف بعجزك وتقصيرك وفقرك بين يديه، فإنك قد توجهت للعبادة له، والمؤانسة واعرض أسرارك عليه، ولتعلم أنه لا تخفي عليه أسرار الخلائق أجمعين وعلانيتهم، وكن كأفقر عباده بين يديه، وأخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك، فإنه لا يقبل إلاّ الأطهر والأخلص»([8]).
الآداب السلوكية للمساجد
كما جعل الإسلام آداباً معنوية للمساجد، جعل لها أيضاً آداباً عملية سلوكية، وهي كما يلي:
الأول: أن يتطهر زائرها في بيته ثم يأتيها، فعن النبي(ص) أنه مكتوب في التوراة: «أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي»([9]).
الثاني: صلاة ركعتين تحية المسجد، فقد ورد عن النبي الأكرم (ص) أنه قال: «لا تجعلوا المساجد طرقاً حتى تصلّوا فيها ركعتين»([10]).
الثالث: التطيّب والتنظّف لدخولها، قال تعالى: (خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ)([11]).
الرابع: أن لا يصلي جار المسجد إلا في المسجد، فعن علي بن أبي طالب(ع) أنه قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا أن يكون له عذر أو به علة»، فقيل: ومن جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال (ع) : «من سمع النداء»([12]).
الخامس: إعمارها بالصلاة والذكر والدعاء، قال تعالى: (إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَأَقَامَ الصّلاَةَ وَآتَىَ الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاّ اللهَ فَعَسَىَ أُوْلَـَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ)([13]).
السادس: ترك ما لا ينفع من الأفعال والأقوال، والتحدث بحديث الدنيا والبيع والشراء ورفع الأصوات، فقد سأل أبو ذر رسول الله(ص) عن كيفية عمارة المساجد،
فقال (ص) : «لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يشترى فيها ولا يُباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلا نفسك»([14]).
وعنه (ص) أنه قال: «كل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذكر الله، أو سائل عن علم»([15]).
([2]) تقع قرية قباء على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة، وكانت مساكن بني عمرو بن عوف.
([3]) تاريخ الخميس 1: 333، بل نقل قوياً: أن المسجد بناه عمار قبل وصول الرسول (ص) (موسوعة التاريخ الإسلامي: ج3).
([6]) أمالي الصدوق: 1/31 ح 16.
([8]) مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق (ع) .
([9]) بحار الأنوار 83: 373 ح37.
([11]) سورة الأعراف: الآية 31.
([12]) بحار الأنوار 83: 354 ح7.
زواج النبي (ص) بالسيدة خديجة (10 / ربيع الأول / السنة 15 قبل البعثة)
لما تاجر رسول الله(ص) مضاربة في أموال خديجة، وخرج بقوافلها إلى الشام رجع وفير الربح سريع القدوم، فأخذ - ميسرة - خادمها يخبرها عما رآه بعينه من كرامة محمد ونبله وخلقه وسموه، ولأجل ما كانت تعرفه عنه وما شاع في الأوساط من أخلاقه في قومه رغبت في الزواج منه. قال ابن هشام في (سيرته): «فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول الله(ص) فقالت له: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك (عراقتك) في قومك، وأمانتك وحسن خلقك، وصدق حديثك، ثم عرضت نفسها عليه»([1]).
رجع النبي(ص) إلى أعمامه وأخبرهم بذلك، وطلب منهم أن يخطبوها له، فخرج جمع من بني هاشم يرأسهم أبو طالب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقيل: إلى عمها عمرو ابن أسد ليخطبوا خديجة لمحمد(ص) ، فلما استقرّ بهم المقام قام أبو طالب وقال: «الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرماً آمناً، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه..
ثم إن ابن أخي هذا من لا يوزن برجل من قريش إلاّ رجح به، ولا يقاس به رجل إلاّ عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلاً في المال؛ فإن المال رفد جار وظل زائل، وله في خديجة رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليه برضاها وأمرها، والمهر عليّ في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله، وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل»([2]).
قال القمي: «فلم يسعف عمها الرد فغالبت خديجة حياءها وقالت بلسان فصيح: أي عم، إنك وإن كنت الأولى بالكلام في هذا المقام غير أني بما أختاره الأولى، فقد زوجت نفسي منك يا محمد، وأما مهري فهو من مالي»([3]).
فقال أبو طالب: أيها الناس اشهدوا أن خديجة زوجت نفسها من محمد(ص) ، وأنها ضمنت مهرها، فقال بعضهم: عجباً أن تضمن النساء مهورهنّ للرجال!
فانتفض أبو طالب غاضباً وقال: لو كان الأزواج مثل ابن أخي لطلبتهم النساء بأغلى القيم، وأغلى المهور، ولو كان مثلكم لطلبن منهم مهراً غالياً([4]).
ثم إن أبا طالب(ع) نحر جزوراً لوليمة الزواج، وتم زفاف درة الأنبياء على جوهرة النساء، وأنشد عبد الله بن غنم، فقال:
|
هنيئاً مريئاً يا خديجة قد جرت |
|
لك الـطير فما كـان منك بأسعد |
إضاءة من سيرة السيدة خديجة(عليها السلام)
كان عمر خديجة عند زواجها بالرسول(ص) على القول المشهور أربعين سنة([5]).
وكان عمر النبي(ص) عندما بنى بخديجة خمساً وعشرين سنة. وكانت خديجة آنذاك عذراء لم تتزوج كما يذكر ذلك السيد جعفر مرتضى العاملي المؤرخ المعاصر في كتابه (الصحيح من السيرة) استناداً ما روى عن أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما والسيد المرتضى في كتابه الشافي.
فقال السيد جعفر مرتضى: Sخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، كانت تعرف في قومها بـ(سيدة قريش) و(الطاهرة)، فقد كانت ذات حسب وشرف ومال وحزم، وكان رجال قومها حريصين على الزواج بها لو يقدرون، وقد خطبها عظماء قريش، وبذلوا لها الأموال ولم ترض.
وقد كانت جميلة الخلقة، وكريمة الصفات، يعرف الكل سجاياها وكرم خلقها، ومنزلتها في قومها، وكان لها قوافل تجارية تجوب ما حول مكة من البلاد، وكان الكل يرغب في الاتجار معها.
نعم هكذا كانت خديجة، ولما لم تجد من أوصاف النبي السامية في غيره عرضت عليه الزواج بها، فيا للعجب، خديجة ترفض العظماء - بلحاظ الحكم الجاهلي - رغم ما يقدمون من المهور الغالية، وتقبل بالنبي(ص) وتضمن له مهرها من مالها، بل تهبه كل ما تملك وتضعه تحت تصرفه، كل ذلك لما وجدته فيه من صفات كانت غريبة جداً في مجتمع متردي الأطراف، وكذلك قبل النبي بها لا لشيء سوى سموها وحسن خلقها وطهارتها في قومها، وما كان المال يهمه، ولذا أنفقه بعد البعثة في نشر الإسلام.
وفاة عبد المطلب جد النبي (ص) (12/ ربيع الأول/ السنة 8 من ولادته)([1])
إضاءة من حياة عبد المطلب
هو عبد المطلب بن هاشم سيد مكة وزعيمها، وإليه ترجع الوفادة والسقاية، وكان القوم يرجعون إليه في الحل والعقد، وكان يوحّد الله، ويرفض عبادة الأصنام([2])، وكان يوصي ولده بصلة الأرحام وإطعام الطعام، ويرغّبهم ويرهّبهم فعل من يرقب معاداً وبعثاً ونشوراً([3])، وكان يأمرهم بترك الظلم والبغي، ويحثهم على مكارم الأخلاق، وينهاهم عن دنيّات الأمور، وكان يقول في وصاياه: إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى يُنتقم منه، وتصيبه عقوبة، وقد هلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة، فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكر، فقال: والله إن وراء هذه الدار داراً يُجزى فيها المحسن بإحسانه، ويعاقب فيها المسيء بإساءته([4]).
وقد بلغ من العظمة مبلغاً حتى كانت تأتيه الهدايا والتحف من أقصى البلاد والأمصار، وكان كلما أصيب العرب بداهية أخذوه إلى جبل ثبير، ودعوا الله بجاهه وشرفه كي يكشف عنهم البلاء، وكانوا يذبحون القرابين لأجله([5]).
ولم يكن يُعدل به أحد في شرافته وعظيم خطره، وكان لا يقرب من المقامرة، ولم يعبد صنماً، ولم يأكل لحم ذبيحة قدمت لصنم، وكان يقول: إني على دين أبي إبراهيم([6]). وكان إذا أهّل رمضان دخل حراء فبقي فيه طول الشهر، وكان يطعم المساكين، ويعظّم الظلم، ويكثر الطواف بالبيت([7]).
وقد سنّ سنناً سنّها رسول الله(ص) بعد ذلك في الإسلام ونزل بها القرآن الكريم، وهي الوفاء بالنذور، وجعل مئة من الإبل في دية القتل، وأن لا تُنكح المحارم، ولا تؤتى البيوت من ظهورها، وقطع يد السارق، والنهي عن قتل الموؤدة، والمباهلة، وتحريم الخمر، وتحريم الزنا والحد عليه، والقرعة، وأن لا يطوف أحد بالبيت عرياناً، وإقراء الضيف، وأن لا ينفقوا إذا حجوا إلاّ من طيب أموالهم، وتعظيم الأشهر الحرم، ونفي ذوات الرايات، فكانت قريش تقول عبد المطلب هو إبراهيم الثاني([8]).
وأضافت بعض الأخبار إلى ما سنّه: تحديد الطواف بسبعة أشواط بعد أن كان يطوف الزائر ما بدا له، وإخراج خمس الغنائم، وتسمية زمزم (سقاية الحاج)([9]).
وكان عبد المطلب يبحث وينقب عن بئر زمزم مدة من الزمن، حتى عثر عليها، فأخرج الحجر الأسود، والغزالين الذهبيين، وأسيافاً وأدرعاً([10])، وقد نازعه قومه فيها قائلين: إنها كانت لأجدادنا. فقال عبد المطلب: الأفضل أن نقرعها بيننا. فقسم الأشياء قسمين، وضرب عليها السهام بينه وبين البيت وبين قريش، فكانت الغزالتان الذهبيتان للبيت، والسيوف والدروع لعبد المطلب، ثم باع عبد المطلب السيوف والأدرع، واشترى بثمنها باباً للبيت([11]).
وأيضاً حسده قومه على ماء زمزم، وقالوا: إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقاً فأشركنا معك فيها، قال: ما أنا بفاعل، إنّ هذا الأمر قد خُصّصت به دونكم وأُعطيته من بينكم، فقالوا له: فأنصفنا فإنّا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، فأظهر الله تعالى حق عبد المطلب في ذلك الخصام([12]).
فلما رأى من العنت الذي أصابه من قريش في حفر بئر زمزم، نذر لله إن ولد له عشرة ذكور أن يذبح واحداً منهم قرباناً لله تعالى، فلما أراد الوفاء به أخبر أولاده العشرة بالأمر فانصاع الجميع لإرادته، وكل واحد يقدم نفسه على أخيه تلبية لوالده، غير أنّ عبد المطلب أوكل أمر تشخيص الذبيح إلى القرعة، فخرجت على عبد الله، فأخذ بولده والشفرة أمام البيت وتلّه ليذبحه، إلا أن القوم حالوا دون تحقق ذلك، وألحّوا على عبد المطلب أن يعذر فيه أمام ربه، فاقترحوا أن يخرجوا إلى العرّافة ليعرفوهم كيف العذر، فسألتهم العرّافة: كم دية الرجل الحر عندكم؟ فأجابوا: عشرة من الإبل، فقالت: اقرعوا بينه وبين العشرة، فإذا خرجت على صاحبكم فزيدوا في الإبل عشرة حتى يرضى ربكم. ففعلوا حتى إذا بلغت الإبل المئة خرجت القرعة عليها دونه، فتصايح القوم فرحين: قد انتهى رضى ربك يا عبد المطلب، فقال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاثاً، فتثبت بعدها من صواب ما فعل. ثم أمر بالإبل فنحرت، ونجى عبد الله، ولذلك كان يقول النبي(ص) : Sأنا ابن الذبيحينR، ويعني إسماعيل(ع) وعبد الله([13]).
ولما توفي عبد المطلب أعظمت قريش موته، وغسّلوه بالماء والسدر، ولفوّه في حلّة من حلل اليمن، وطرح عليه المسك، وحمل على أيدي الرجال، إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغييبه في التراب([14]).
ودفن في مقبرة الحجون، وقد خرج في حقه عن النبي(ص) والأئمة(ع) ثناءً بليغاً، فعن النبي(ص) أنه قال: «إن الله يبعث جدي عبد المطلب أمّةً وحده، في هيئة الأنبياء وزيّ الملوك»([15]).
قصة النذر ومشروعيتها:
قد يقال: إنه لا يحق لأحد التصرف في حياة الآخرين، فكيف بمن نذر أن يذبح إنساناً، ويصّر على الوفاء به؟!، وهل أن ديانات السماء شرّعت مثل هذا النذر، وأوجبت الوفاء به؟!، وهل فعلاً نقل لنا التاريخ حادثة أخرى من هذا القبيل؟
هذه التساؤلات وغيرها قد تأخذ بالبعض إلى أن عبد المطلب لم يكن موحّداً، ولا مؤمناً، وإلا فكيف ينذر ما يخالف الإيمان والتوحيد.
وقد تقدم ما يدلّ على إيمانه وتوحيده، مما نقله كبار المؤرخين، من دون مدافع من أحد، بل ما نقلناه يكشف عن أن إيمان عبد المطلب كان واعياً، حركياً حيث كان يأمر الآخرين بما يعتقد به.
وأما قضية نذر وذبح أحد أولاده لله لعل الأقرب أن مثل هذه التضحية كان معروفاً ومشروعاً، وذلك:
أولاً: لأنه قد تعلق به الوحي في قصة إبراهيم وابنه إسماعيل(عليهما السلام)، ([16]).
ثانياً: لقد نذرت امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت الله، وهذا أيضاً تصرف في حياة الولد([17])، وهي أيضاص إمرأة طاهرة مطهرة وموحدة.
ثالثاً: أنه إن كانت العرّافة مؤمنة بالله، فلما لم تعترض على عبد المطلب في نذره وتقول له: هذا النذر غير مشروع ولا يجب الوفاء به، بل على العكس نجدها أقرت نذره وقدمت له طريقة الإعذار مع ربه. وإن لم تكن مؤمنة، فلا يمكن لعبد المطلب المؤمن بالله أن يطلب العذر لربه من كافر أو مشرك، بل قام بهذا العذر من تفكيره وعقله، فقد روي أنه لم يقدر أن يذبحه ورسول الله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل ساهم عليها وعلى عبد الله...([18]).
وفي بعضها أن ابنته عاتكة من أشارت عليه بذلك([19]).
فعلى كل حال ليس ببعيد مشروعية مثل هذا النذر في الشرايع السابقة، وإن كانت محرّمة في شريعتنا، كما كانت التوبة في شريعة موسى - لفترة من الزمان - القتل([20])، وهو محرم في شريعتنا، وكان إذا أصاب أحداً من بني إسرائيل البول، طهره بقرضه بالمقاريض، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل الماء طهوراً([21]).
وأما قضية الأسماء فلا تعدو أن تكون تسمية لا يروم من ورائها بشيء، فلقد تعارف كثيراً تسمية عبد العزى وعبد مناف فعبد مناف مثلاً كان اسماً لأحد أجداد عبد المطلب، كما كان اسماً لجد آمنة أم النبي(ص) وهكذا..
([1]) منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل 1: 109.
([2]) تاريخ اليعقوبي 2: 10 – 11.
([3]) مروج الذهب 2: 103 و108، والسيرة الحلبية 1: 4، وتاريخ الخميس 1: 237.
([4]) الملل والنحل للشهرستاني 2: 75.
([6]) الكامل في التاريخ 1: 616.
([7]) السيرة النبوية لابن هشام 1: 142، وتاريخ الطبري 2: 251، والمنتظم 2: 207.
([8]) تاريخ اليعقوبي 2: 10 – 11، والخصال للصدوق: 312.
([9]) تاريخ اليعقوبي 2: 10 – 11.
([10]) كان سبب دفن هذه في البئر، أن عمرو بن الحارث الجرهمي سيد الجراهمة كان في مكة منذ عهد قصي، فحاربه حليل بن حبسية وغلبه وأمره بالخروج من مكة، فغضب عمرو لذلك، وصمم على = = الخروج، ولكنه قبل خروجه نزع الحجر الأسود من الركن وأخذ الغزالين اللذين وهبهما اسفنديار بن جشتاسب إلى البيت وأسيافاً قلعية وأدرعاً، فقذفها في بئر زمزم، ثم ملأه بالتراب، وهرب مع قبيلته إلى اليمن. منتهى الآمال 1: 52.
([11]) منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل 1: 52 – 53.
([12]) شرح النهج لابن أبي الحديد 15: 224.
([13]) تاريخ الطبري 2: 240 – 243، والكامل في التاريخ 1: 608 – 611.
([14]) موسوعة التاريخ الإسلامي 1: 288، نقلاً عن اليعقوبي 2: 13.
([15]) أصول الكافي 1: 446 – 447، وتاريخ اليعقوبي 2: 13.
([16]) سورة الصافات: الآية 102.
ولادة السيدة نفيسة (11/ ربيع الأول/ السنة 145هـ)
ولدت السيدة نفيسة بمكة المكرمة في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين ومائة من الهجرة النبوية (145هـ) وسماها أبوها نفيسه على اسم عمتها وبعد خمسة سنوات هاجرت مع أبيها إلى مدينة جدها رسول الله(ص) .
أبوها هو الحسن الأنور([1]) ابن زيد الأبلج ابن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب ، كان عالماً جليلاً يعد من التابعين وهو مجاب الدعوة، ويقال: مرّت به امرأة وهو في الأبطح ومعها ولدها فاختطفه عقاب فسألت الحسن أن يدعو الله لها برده، فرفع يديه إلى السماء ودعا ربه، فإذا بالعقاب قد ألقى الصغير من غير أن يضره بشيء فأخذته أمه([2])، وأمّا أم السيدة نفيسة فهي أم ولد.
تزوجت نفيسة بإسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق(ع) في سنة (161هـ) وبزواجها هذا اجتمع في بيتها نوران: نور الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فالسيدة نفيسة جدها الإمام الحسن والسيد إسحاق جده الإمام الحسين(ع) ، وكان إسحاق من أهل العلم والفضل والورع والصلاح وروى عنه بعض الأحاديث والأخبار، وقد ولدت نفيسة من إسحاق ولدين هما القاسم وأم كلثوم، وعاشت السيدة نفيسة في المدينة مع أبيها وزوجها إلى أن هاجرت إلى مصر ودخلتها في يوم السبت الموافق (26 من شهر رمضان/ سنة 193هـ) وقيل وفي طريقها إلى مصر زارت المسجد الأقصى والأنبياء والأولياء المدفونين في فلسطين، ثم زارت بغوطة دمشق السيدة زينب(عليها السلام)، ومن ثم زارت قبر عمتها فاطمة بنت الإمام الحسن(ع) ، وفضة جارية جدتها فاطمة الزهراء(عليها السلام)، وغير أولئك المدفونين في مقبرة باب الصغير.
نفيسة العلم والتقوى
بدأت السيدة نفيسة في سن مبكرة في تلاوة القرآن وحفظه، حتى تم لها حفظ القرآن خلال سنة واحدة، وكانت تؤدي الصلوات الخمسة بانتظام مع والديها في المسجد الحرام، وحتى في السادسة من عمرها([3])، وقد شغفت بحديث جدها المصطفى (ص) ، وروت من الحديث والآثار الكثير من أبيها وآل بيتها وعلماء عصرها بحيث عدت من المحدّثات، ومن بين من التقت بهم في المدينة الإمام مالك بن أنس، الذي كان حديث الفقهاء وقرأت كتابه (الموطأ) وناقشته، وفي مصر التقت السيدة نفيسة بالإمام الشافعي الذي نزل مصر بعدها بخمس سنوات، ومع جلالة قدر الإمام الشافعي كان يزورها في بيتها ويسمع عنها الحديث ويسألها الدعاء فتدعو له فيستجاب، ولما مرض مرضه الذي مات فيه أرسل لها على جاري العادة يلتمس منها الدعاء فقالت للقاصد: متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم، فعلم الإمام الشافعي أنه ميت وأوصى أن تصلي عليه فلما توفى سنة أربع ومائتين مرّوا به على بيتها فصلت عليه، مأمومة وكان الذي صلى بها للإمام أبو يعقوب البويصلي([4]).
وفاتها:
استقرت السيدة نفيسة(عليها السلام)، في الدار التي وهبها لها أمير مصر السرى بن الحكم في خلافة المأمون العباسي، وانتقلت إليها سنة إحدى ومائتين، وقد حضرت السيدة نفيسة جدها في دارها، وكانت تنزل فيه للتعبد والتذكر بالآخرة وكانت تصلي فيه النوافل العديدة.
كما قالت زينب بنت أخيها: تألمت عمتي في أول من رجب وكتبت إلى زوجها إسحاق المؤتمن كتاباً، وكان غائباً بالمدينة تطلب إليه المجيء إليها لدنو أجلها وفراقها لدنياها وإقبالها على أخراها، وكانت صائمة فأشاروا الأطباء عليها بالإفطار لحفظ قوتها ولتتغلب على مرضها وضعفها، فقالت: واعجباه إن لي ثلاثين سنة وأنا أسأل الله عز وجل أن يتوفاني وأنا صائمة أفأفطر؟! معاذ الله تعالى، ثم أنشدت تقول:
|
أصرفوا عني طبيبي |
|
ودعوني وحبيبي |
وقالت زينب: ثم إنها بقيت كذلك إلى العشر الأواسط من شهر رمضان، فاشتد بها المرض واحتضرت، فاستفتحت بقراءة سورة الأنعام، فلا زالت تقرأ إلى أن وصلت إلى قوله تعالى (فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبّكُمْ عَلَىَ نَفْسِهِ الرّحْمَةَ)([5]) ففاضت روحها الكريمة، وقيل إنها قرأت (لَهُمْ دَارُ السّلاَمِ عِندَ رَبّهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)([6]) فغشي عليها وقبضت واختارها الله لجواره ونقلها إلى دار كرامته وكان ذلك في سنة ثمان ومائتين (208هـ)([7]) وذلك بعد موت الإمام الشافعي بأربع سنين رحمهم الله جميعاً.
ولما توفيت اجتمع الناس ووصل زوجها في ذلك اليوم وأراد حملها إلى المدينة لدفنها بالبقيع فاجتمع أهل مصر إلى أمير البلد واستجاروا به إلى زوجها ليدفنها عندهم فقبل ذلك بعد الإصرار الكثير، فدفنها في مصر (القاهرة) ولذلك كان المصريون يسمونها بنفيسة المصرية.
فسلام عليها يوم، ولدت ويوم ماتت، ويوم أدّت رسالتها، ويوم تبعث حيّة شافعة لزوارها إن شاء الله.
كراماتها:
لا شك إن السيدة نفيسة تعد من أولياء الله المقربين لعلمها ومعرفتها بالله، وكثرة عبادتها ولشدة زهدها وتقواها ولذا صدرت منها كرامات في حياتها وبعد مماتها بحيث عدّ لها ابن حجر العسقلاني نحواً من مائة وخمسين كرامة، وقد ذكرها ابن حجر على سبيل المثال لا الحصر، وهذا دفع الناس قديماً وحديثاً للتوسل بها إلى الله لقضاء حوائجهم وقد اشتهرت بسرعة استجابة، دعاء من توسل بها، وإنّا لنذكر بعضاً منها لنكشف قبساً من ساطع نورها.
1- عن سعيد بن الحسن قال: توقف النيل بمصر في زمن السيد ة نفيسةIفجاء الناس إليها وسألوها الدعاء فأعطتهم قناعها، فجاءوا به إلى النهر وطرحوه فيه، فما رجعوا حتى زخر النيل بمائه وزاد زيادة عظيمة([8]).
2- قال أبو موسى دخلت إلى ضريحها فوضعت يدي على الضريح فسمعت قائلاً: أهكذا تدخل على أهل البيت النبوة؟!.
([1]) المدني الهاشمي، وهو والد جدّ عبد العظيم الحسني المدفون بطهران.
([2]) حكاه الشبلنجي في كتابه نور الأبصار: 137.
([3]) مجموعة آل البيت النبي(ص): ط مصر 79.
([4]) تحفة الأحباب وبغية الطلاب، 157.
([6]) سورة الأنعام: الآية 127.
([7]) وقيل توفيت في الثالث من شهر صفر سنة (208هـ).
([8]) نقله المقريزي في خططه: ح4 - 326، والسخاوي في تحفة الأحباب: 159.
شهادة الإمام الحسن العسكري (ع) (8 / ربيع الأول / السنة 260 هـ)
شهادة الإمام العسكري(ع)
إنّ المعتمد العباسي كان قلقاً من شعبية الإمام الحسن العسكري(ع) ونفوذه ومحبوبيته بين الناس، واهتمام الناس به وانجذابهم إليه، وقد عرف أن الاعتقال والاضطهاد له مردوداته عكسية، فعندئذ لجأ إلى سمّ الإمام (ع) وقتله، وكان ذلك في سنة 260 هجرية في 8 ربيع الأول([1]).
وبهذه المناسبة سنستعرض بإختصار الوضع السياسي العام في عصر الإمام (ع) وكيفية مواجهة السلطة الحاكمة آنذاك من قبل الإمام وأهم نشاطاته وقصة ولادة ولده الإمام المهدي(ع) ، ثم نختم الحديث بمقتطفات من كلامه الشريف.
الوضع السياسي العام في عصر الإمام (ع)
يطلق على فترة خلافة المتوكل العباسي وما بعده العصر العباسي الثاني، لما لهذه الفترة من خصائص امتازت بها عن خصائص العصر العباسي الأول الذي بدأ بعد سقوط الدولة الأموية سنة (132هـ).
لقد عاصر الإمام العسكري(ع) في هذا العصر أعواماً عصيبة منه مع خلفاء مستبدين علوا عرش الدولة منذ أن أقدم سامراء مع أبيه الإمام الهادي(ع) أيام المتوكل سنة (234هـ)، واستمر مقيماً فيها إقامة جبرية حتى استشهد سنة (260هـ) في خلافة المعتمد العباسي.
وأهم ظواهر هذا العصر هو النفوذ الذي تمتع به الأتراك الذين غلبوا الخلفاء، في سلب زمام إدارة الدولة، وما اتصفوا به من سلوك شائن في التعامل مع الأهالي.
ويمكن إبراز أهم مظاهر هذا العصر فيما يلي:
1- تدهور الوضع السياسي للدولة العباسية، حيث استولى الموالي الذين كانوا في الأغلب من الأتراك، وكانت سيطرتهم على مقاليد السلطة في العاصمة والأمصار، حيث ساهموا في خلع المتوكل، والمهتدي وقتلهما، ونصب غيرهما([2]).
2- ظهور اللهو والمجون وحياة الترف التي كان يحياها الخليفة وأتباعه، والتي كانت عاملاً مهماً في سيطرة الأتراك، وسقوط هيبة الخليفة عند عامة الناس.
3- حوادث الشغب والفتن التي حدثت في بغداد، وكانت نتيجتها أن بويع لخليفتين في آن واحد، حيث بويع (المستعين) في بغداد، وكان الأتراك في نفس الوقت قد بايعوا المعتز في سامراء، وقد جهز الأخير جيشاً بقيادة أخيه لقتال المستعين في بغداد([3]).
4- ظهور الحركات الإنفصالية في أطراف الدولة، ونشأت دويلات صغيرة من هنا وهناك لا تخضع لمركزية الدولة في سامراء، وكل ذلك لضعف سلطان الخليفة، كما نشأت الحروب الدامية بين الأمراء على الأمصار، فشهدت الدولة العباسية مسرحاً لحروب دامية، ولأعمال التخريب من حرق ونهب للأموال والغلات وغيرها([4]).
ولكن على الرغم من الضعف الذي أحاط بالدولة العباسية في عصر الإمام (ع) إلا أن السلطة القائمة ضاعفت إجراءاتها التعسفية في مواجهة الإمام الحسن العسكري(ع) والجماعة الصالحة المنقادة لتعاليمه وإرشاداته، فلم تضعف في مراقبته، ولم تترك الشدة في التعامل معه، بسجنه أو محاولة تسفيره إلى الكوفة خشية منه، ومن حركته الفاعلة في الأمة.
نشاطات الإمام العسكري(ع) :
قام الإمام العسكري(ع) - على الرغم من حرجية المرحلة التي عاصرها، والمراقبة الشديدة له وللشخصيات الشيعية البارزة - بخطة للقيام بمهام إمامته، ويمكن سردها في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أنه حيث اتسعت رقعة التشيع في عهده، وامتدت إلى مدن ومناطق مختلفة، وتمركز الشيعة في عدة مدن، كالكوفة وبغداد ونيشابور وقم، والمدائن واليمن والري وآذربايجان وسامراء وجرجان والبصرة، فقد أوجد الإمام (ع) شبكة اتصالات منظمة تؤمن اتصال الشيعة بالإمامة من جهة، واتصالهم ببعضهم من جهة أخرى، ويتم
من خلال ذلك توجيههم دينياً وسياسياً ومعنوياً، فنصب الإمام العسكري(ع) الوكلاء، والنواب في مختلف المناطق، وبذلك كان يراقب الأوضاع، فنصب إبراهيم بن عبده في نيشابور([5])، وأحمد بن إسحاق في قم، وإبراهيم بن مهزيار الأهوازي، وغيرهم.
وكان على رأس وكلاء الإمام (ع) محمد بن عثمان العمري الذي كان حلقة الوصل بينهم وبين الإمام (ع) ، فكانوا يأتون بالأموال والأسئلة والشبهات إليه، ويقوم هو بدوره ليدفعها إلى الإمام (ع) .
النقطة الثانية: كان يتصل بشيعته أيضاً عبر إرسال الرسل والمبعوثين، فكان يعالج مشاكلهم بهذا الطريق، وعلى سبيل المثال، كان (ع) يرسل أبا الأديان - أحد أصحابه المقربين - برسائله وخطاباته إلى شيعته، كما كان يحمل منهم أيضاً الرسائل والأسئلة والأخماس والحقوق الأخرى إلى الإمام في سامراء([6]).
النقطة الثالثة: كان (ع) يدعم ويساند الشيعة مالياً، لا سيما أصحابه المقربين، مما يمنع الكثير من أن تلجئهم الحاجة والفاقة والضغط المالي إلى الحكم العباسي الظالم، وكانت طريقة الإمام (ع) أن يدفع المبالغ الطائلة إلى أحد مقربيه لينفقها بدوره على شيعته ومواليه، كما فعل مع علي بن جعفر صاحبه وصاحب أبيه (ع) ([7]).
النقطة الرابعة: تجهيز الشيعة وإعدادهم لعصر الغيبة، فكانت الشيعة ولعدة عقود
من الزمن قد ألفت الاتصال المباشر بالإمام (ع) ، ولم تألف غيابه عنها إلا في حالات خاصة كالسجن، بل حتى في حالة سجن الإمام (ع) كان هناك من يتمكن من الاتصال به، أما بعد عصر العسكري(ع) فستدخل الشيعة مرحلة جديدة في علاقتها وارتباطها مع الإمام (ع) لم تألفها بعد، وهي غياب الإمام وعدم اتصاله بشيعته، وهي مرحلة خطيرة جداً من الصعب تحملها أو الاعتقاد بها إلاّ لمن امتحن الله قلبه للإيمان، فكان دور الإمام الحسن العسكري(ع) أن يستخدم الأساليب التي تساعد الشيعة على التعايش والتأقلم على تلك المرحلة، فقام (ع) - كما ذكرنا - بالاتصال بشيعته عبر الوكلاء والنواب لتعتاد الشيعة على هذا النمط من التعامل مع الإمامة.
كما أنه أرسل إلى الخلّص من أصحابه في الأمصار يدعوهم إلى انتظار الفرج بخروج ولده الموعود المنتظر، فقد كتب إلى علي بن الحسين بن بابويه القمي جاء فيها:
«... عليك بالصبر وانتظار الفرج، قال النبي(ص) : Sأفضل أعمال أمتي انتظار الفرجR، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشّر به النبي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي، وأمر جميع شيعتي بالصبر، فإنّ (الأرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ)، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته»([8]).
اطلاعه (ع) على ولادة ولده الموعود
بعد ولادة الإمام المهدي(ع) أرسل الإمام العسكري إلى خلّص أصحابه يعرّفهم بولادته، كما أنه اطّلع البعض منهم عليه، فقد دخل عليه أحمد بن إسحاق - وكان من أصحابه المقربين إليه - لكي يسأله عن الخلف من بعده، فقال له الإمام مبتدئاً: يا أحمد بن إسحاق إن الله لم يخل الأرض منذ خلق آدم ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث وبه تخرج بركات الأرض.
قال: فقلت: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟
فنهض (ع) مسرعاً فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر ليلة البدر، من أبناء ثلاث سنين، فقال (ع) : يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله(ص) وكنيّه، والذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، مثله في هذه الأمة مثل الخضر ومثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلاّ من ثبّته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه([9]).
مقتطفات من كلام الإمام (ع)
قال (ع) لجماعة من شيعته: «أوصيكم بتقوى الله، والورع في دينكم، وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من برٍّ أو فاجر، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد(ص) ، صلّوا في عشائركم، واشهدوا جنائزكم، وعودوا مرضاكم، وأدوا للنّاس حقوقهم، فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق في حديثه، وأدى للناس الأمانة، وحسّن خلقه معهم، وقيل هذا شيعي، يسرّني ذلك.
اتقوا الله وكونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً, جرّوا إلينا كلّ مودّةٍ، وادفعوا عنّا كل قبيحٍ، فما قيل فينا من خيرٍ فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فنحن منه بُراء، لنا حقٌّ في كتاب الله، وقرابة من رسول الله، وولادة طيّبة لا يدّعي ذلك غيرنا إلاّ كذّاب»([10]).
وقال أيضاً: «ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنّما هي كثرة التفكّر في أمر الله، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهداً ويأكله غائباً، إن أُعطي حسده، وإن ابتلي خذله»([11]).
وقال أيضاً: «من وعظ أخاه سرّاً فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه»([12]).
([1]) إعلام الورى: 367، ودلائل الإمامة: 223، والأنوار البهية: 162.
([2]) الكامل في التاريخ 4: 301.
([3]) الكامل في التاريخ 4: 390.
([5]) اختيار معرفة الرجال: 575 – 580، وبحار الأنوار 50: 321 – 323.
([6]) المناقب لابن شهر آشوب 4: 425، وريحانة الأدب 7: 570.
([8]) المناقب لابن أبي شهر آشوب 4: 425، والأنوار البهية: 161.
خروج النبي (ص) من غار ثور (4 ربيع الأول/ السنة 13 للبعثة)
قال تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)([1]).
بعد أن بقي النبي(ص) وصاحبه في غار ثور ثلاثة أيام كان يتردد خلالها أمير المؤمنين(ع) عليهما، حتى إذا كانت ليلة اليوم الرابع هيأ علي(ع) بأمر النبي(ص) ثلاث رواحل ودليلاً أميناً يدعى أريقط ليترحلوها إلى المدينة ويدلهم الدليل على طريقها([2]).
أوصى النبي(ص) علياً في تلك الليلة بأن يؤدي أمانته على أعين الناس، وذلك بأن يقيم صارخاً بالأبطح غدوة وعشياً: «ألا من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤد إليه أمانته»([3]).
ثم أوصاه (ص) بالفواطم وهنّ: فاطمة الزهراء(عليهما السلام)، وفاطمة بنت أسد أم علي(عليهما السلام)، وفاطمة بنت الزبير، وبكل من يريد الهجرة معه([4])، وقال له عبارته المشهورة: «إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي»([5]).
ثم توجه النبي(ص) هو وصاحبه إلى المدينة سالكين إلى ذلك الخط الساحلي، وقد جاء ذكر المنازل التي مُّرا بها في (السيرة النبوية) لابن هشام، فراجع([6]).
وعن أبي عبد الله الصادق(ع) : إنّ رسول الله(ص) لما خرج من الغار متوجهاً إلى المدينة، وقد كانت قريش جعلت لمن أخذه مئة من الإبل، خرج سراقة بن جشعم فيمن يطلب، فلحق رسول الله(ص) ، فقال (ص) : اللهم اكفني سراقة بما شئت، فساخت قوائم فرسه، فثنى رجله ثم اشتد، فقال: يا محمد إني علمت أن الذي أصاب قوائم فرسي إنما هو من قبلك، فادع الله أن يطلق لي فرسي، فلعمري إن لم يصبكم خير مني لم يصبكم مني شر، فدعا رسول الله(ص) فأطلق الله عز وجل فرسه، فعاد في طلب رسول الله(ص) حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما أطلقت قوائم فرسه في الثالثة، قال: يا محمد، هذه إبلي بين يديك فيها غلامي، فإن احتجت إلى ظهر أو لبن فخذ منه، وهذا سهم من كنانتي علامة، وأنا أرجع فأرد عنك الطلب، فقال (ص) : لا حاجة لي فيما عندك([7]).
ولعل رفضه (ص) ما عرضه عليه سراقة قد كان من منطلق أنه لا يريد أن يكون لمشرك عليه يد، ثم سار رسول الله(ص) حتى بلغ خيمة أم معبد، فنزل بها، وطلبوا عندها قِرى، فقالت ما يحضرني شيء، فنظر رسول الله(ص) إلى شاة في ناحية قد تخلفت من الغنم لضرها، فقال (ص) : أتأذنين في حلبها؟ قالت: نعم، ولا خير فيها، فمسح يده على ظهرها، فصارت أسمن ما يكون من الغنم، ثم مسح يده على ضرعها، فأرخت ضرعاً عجيباً، ودرّت لبناً كثيراً، فطلب (ص) العس، وحلب لهم فشربوا جميعاً حتى رووا.
ثم عرضت عليه أم معبد ولدها الذي كان كقطعة لحم، لا يتكلم ولا يقوم فأخذ تمرة فمضغها وجعلها في فيه، فنهض في الحال ومشى وتكلم، وجعل نواها في الأرض فصارت نخلة في الحال، وقد تهدّل الرطب منها، وأشار إلى جوانبها فصار مراعي([8]).
ويروى أنه لما توفي (ص) لم ترطّب، ولما قتل علي(ع) لم تخضر، ولما قتل الحسين(ع) سال منها الدم([9]).
فلما عاد أبو معبد، ورأى كل ذلك فسأل زوجته عن سببه قالت: مرّ بي رجل من قريش ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة (خلة)، ولم تزر به صحلة (صقلة)، وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره عطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج، أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً... محفود محشود لا عابس ولا مفند.. ([10])، وهذا الوصف مشهور ومعروف لأم معبد([11]).
وليس هذا بالشيء العجيب أو الكثير على رسول الله(ص) فمريم العذراء أنبت الله لها من جذع النخلة رطباً جنياً يتساقط عليها، وأخرج لها الماء من تحت قدميها، فكيف به (ص) وهو سيد الكائنات، وأشرف الخلق وأكرمهم على الله من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وقد ظهرت على يديه الكثير من المعجزات والكرامات مما ينوء عن حمل ما سجل منه العصبة أولوا القوة.
كما أن حصول هذه الكرامات بعد مصاعب الهجرة مباشرة إنما يؤكد أنه قد كان من الممكن أن تتم الهجرة بتدخل من العناية الإلهية، ولكن الله تعالى أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها، وليكون هذا الرسول هو الأسوة الحسنة، والقدوة لكل أحد في مواجهة مشاكل الحياة، وتحمل أعباء الدعوة إلى الله بكل ما فيها من متاعب، ومصاعب وأزمات، فإن للأزمات التي يمرّ بها الإنسان دور رئيس في صنع خصائصه وبلورتها، وتجعله جدياً في موقفه، فإنه إذا كان هدف الله سبحانه، وهو إعمار هذا الكون بالإنسان، فإن الإنسان الخامل الذي يعتمد على الخوارق والمعجزات لا يمكنه أن يقوم بمهمة الإعمار هذه، فهذا إذاً مما يساعد على تربية الإنسان وتكامله في عملية إعداده ليكون عنصراً فاعلاً وبانياً ومؤثّراً، لا منفعلاً ومتأثّراً فحسب([12]).
([2]) السيرة النبوية لابن هشام 1: 488.
([3]) الكامل في التاريخ 2: 73.
([4]) سيد المرسلين 1: 602– 603.
([6]) السيرة النبوية لابن هشام 1: 491.
([7]) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) 4: 85.
([8]) ما يأتي في مصادر الحاشية رقم (4).
([10]) تاريخ الخميس 1: 334، ودلائل النبوة للبيهقي 1: 279، والسيرة الحلبية 2: 49 – 50، وبحار الأنوار 19: 75 – 76.
مبيت الإمام علي (ع) في فراش النبي (ص)(1 ربيع الأول/ السنة 13 للبعثة)
قال تعالى في كتابه العزيز:(وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ)([1])، في الليلة التي عزم فيها النبي(ص) على الهجرة إلى المدينة، حيث أخبره ربه بمكيدة قريش لقتله، وأمره أن يأمر علياً(ع) بالمبيت في فراشه، فما كان من علي(ع) غير أن سأله: أو تسلم بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال (ص): نعم، فأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً لله، فنام على فراش النبي(ص) واشتمل ببرده الحضرمي، فخرج (ص)([2]).وجعل المشركون يرمون علياً بالحجارة، وهم يحسبونه رسول الله، وعلي(ع) يتضور - أي يتلوى ويتقلب - وقد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، فهجموا عليه، فلما بصر بهم علي(ع) قد انتضوا السيوف، وأقبلوا عليه، وثب في وجوههم فأجفلوا أمامه، وتبصروه فإذا علي، فقالوا: وإنك لعلي؟ قال: أنا علي، قالوا: فما فعل صاحبك، فقال: وهل جعلتموني عليه حارساً([3]).
وقد ورد: أن الله تعالى أوحى إلى جبرائيل وميكائيل: إني آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة. فأوحى الله إليهما ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب، آخيت بينه وبين محمد(ص)، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؟ إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزلا جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبرئيل ينادي: بخٍ بخٍ، من مثلك يا ابن أبي طالب، يباهي الله به الملائكة، فأنزل الله تعالى الآية([4]) التي ابتدأنا بها؛ (وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي...).
قال الإسكافي: «وقد روى المفسرون كلهم. أن قوله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ)، نزلت في علي(ع) ليلة المبيت على الفراش»([5]).
وقد أنكر ابن تيمية نزول هذه الآية في مبيت علي(ع) في فراش النبي(ص)، فقال على ما نقله عنه الحلبي في سيرته: كذب بإتفاق أهل العلم بالحديث والسير.
وأيضاً قد حصلت له الطمأنينة بقول الصادق له: Sلن يخلص إليك شيء تكرهه منهمR، فلم يكن فيه فداء النفس، ولا إيثار بالحياة، والآية المذكورة في سورة البقرة، وهي مدنية بالاتفاق، وقد قيل: إنها نزلت في صهيب لما هاجر([6]).
وقد رد على قوله الكثير من الأعلام وخلاصته:
أولاً: إن اتفاق أهل العلم بالحديث والسير على كذب نزول هذه الآية في علي، لا عين له ولا أثر، بل على العكس تماماً حيث تلقاه العلماء والحفاظ والمحدثون من دون غمز فيه أو لمز([7])، بل إن الحاكم النيسابوري، والذهبي صححاه([8]).
ثانياً: إن ما ذكره من قول النبي(ص) لعلي(ع) حين مبيته: Sلن يخلص إليك شيء تكرهه منهمR، غير موجود في الرواية، فقد علّق على ذلك الحلبي بقوله: Sلكنه في الإمتاع لم يذكر أنه (ص) قال لعلي ما ذكر، أي لن يصل..، وعليه فيكون فداؤه للنبي بنفسه واضحاً، نعم ذكر النبي(ص) ذلك له بعد ما خرج وصاحبه من غار ثور باتجاه المدينة وأمر علياً أن يعود إلى مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها ويأتيه بالفواطمR([9]).
ثالثاً: إن سورة البقرة وإن كانت مدنية، ولكن هذه الآية باعتراف الجميع مكية، ومجرد كون هذه الآية مكية لا يخرج سورة البقرة عن كونها مدنية، لأن الحكم يكون للغالب([10]).
رابعاً: أما نزولها في صهيب فخطأ كبير، لأنّ الحادثة التي يروونها فيه، وفي نزول الآية فيه عارية عن الصحة، للاختلاف الكبير في نقلها ومضمونها، ومن أراد الوقوف على المزيد من تفاصيلها فليراجع (الإصابة) في ترجمة صهيب، و(السيرة الحلبية: 2/23 - 24).
معطيات الفداء:
ولفداء علي(ع) بنفسه معطيات كثيرة ينبغي الالتفات إليها:
أولاً: إن الدين والإسلام يستحق أبلغ التضحيات، وأعظم وأثمن ما عند الإنسان وهي حياته، وأولاده وكل غال ونفيس، ولذا ورد قوله تعالى: (إِنّ اللهَ اشْتَرَىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنّ لَهُمُ الّجَنّةَ)([11]).
ثانياً: أن موقف الأمير(ع) في فدائه النبي(ص) بحياته ووجوده يعطي تحرره من قيود الدنيا وعبوديتها، فإن المانع الذي يحول دون التضحية بالنفس حب الدنيا والتعلق بها، وقد أعطى (ع) بمبادرته للمبيت في فراشه أنه متحرر من كباح الدنيا ومفاتنها.
ثالثاً: أن على المؤمن أن يكون على استعداد دائم للقاء الله تعالى، إذ لعله في أي لحظة يدعى للقائه، فلا بد وأن يكون مستعداً للوفادة عليه.
([3]) السيرة الحلبية 2: 35، ومجمع الفوائد 9: 120.
([4]) أسد الغابة 4: 25، وتاريخ اليعقوبي 2: 39، وكفاية الطالب: 239، وشواهد التنزيل 1: 97، وتذكرة الخواص: 35، وتاريخ الخميس 1: 325، والمناقب للخوارزمي: 74، وينابيع المودة: 92، والتفسير الكبير 5: 204، والجامع لأحكام القرآن 3: 31، والسيرة الحلبية 3: 168، وتفسير البرهان 1: 207.
([5]) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 13: 262.
([7]) راجع للوقوف على من رواه كتاب إحقاق الحق.
([8]) المستدرك في الصحيحين، وبذيله التلخيص 3: 4.


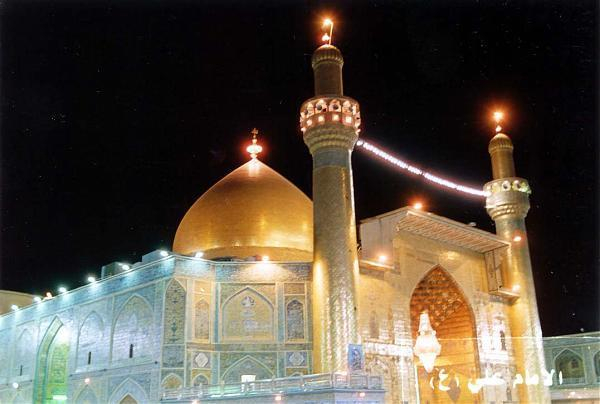


![وفاة عبد المطلب جد النبي (ص) (12/ ربيع الأول/ السنة 8 من ولادته)([1])](/ar/media/k2/items/cache/6bc5154bd73bab84ef67892390066075_Generic.jpg)