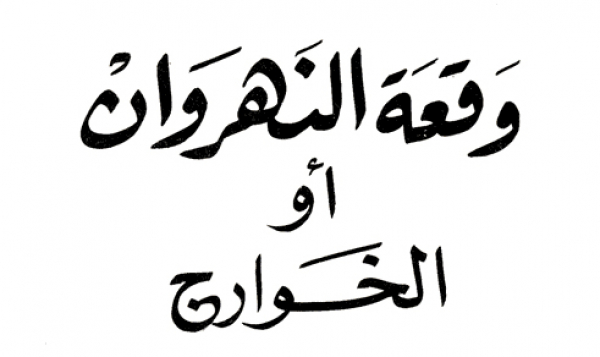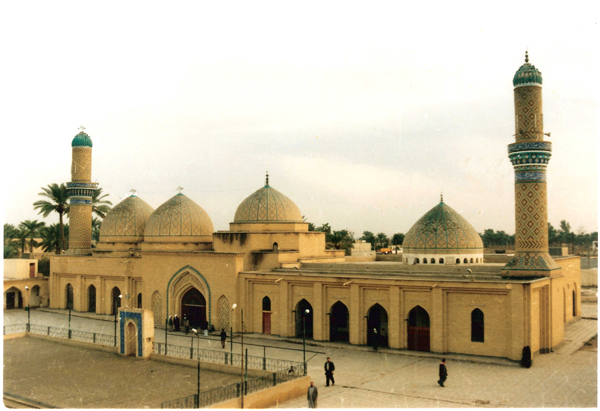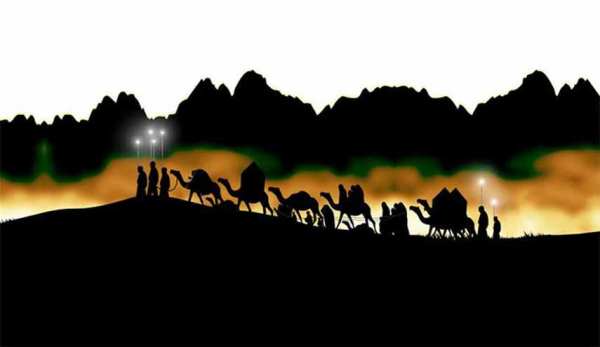Super User
وقعة النهروان بين الخوارج والإمام علي بن أبي طالب (ع)(9/ صفر / السنة 38 هـ)
النهروان موقع بين بغداد وحلوان من محافظة في العراق بعد بعقوبة إلى خانقين، وفيها جرت الوقعة المعروفة بين الإمام علي أمير المؤمنين(ع) والخوارج.
والخوارج، هم الذين أنكروا التحكيم الذي وقع بعد معركة صفين، واتخذت حركتهم بعد أن تحرك موكب الإمام من صفين شكلاً جديداً، فاعترفوا بخطئهم في قبول التحكيم وأعلنوا توبتهم وجاءوا إلى أمير المؤمنين(ع) يطلبون منه أن يتراجع ويتوب كما تابوا. فلم يستجب لطلبهم لأنه لم يخطئ إنما خالفوا أمره الذي تابوا إليه الآن، فانفصلوا عنه قبل أن يدخل الكوفة في مكان يدعى حروراء، ومن أجل ذلك سمّاهم المؤرخون بالحرورية([1])، وسُمّوا بالخوارج لأنهم خرجوا على إمامهم أمير المؤمنين(ع) ، وقد رفعوا شعاراً: «لا حكم إلا لله».
بعد أن رفع الخوارج شعارهم ذلك، حاورهم أمير المؤمنين(ع) بالتي هي أحسن وفنّد معتقداتهم وآراءهم، إلاّ أنهم لم يصغوا إلى توجيهات أمير المؤمنين(ع) واستمرّوا في غيّهم، وتعاظم خطرهم بعد انضمام أعداد جديدة لمعسكرهم، وراحوا يعلنون القول بشرك المنتمين إلى معسكر الإمام علي(ع) ، بالإضافة إلى الإمام (ع) ورأوا استباحة دمائهم!
وقد كان أمير المؤمنين(ع) عازماً على عدم التعرّض لهم ابتداءً، ليمنحهم فرصة التفكير جدياً بما أقدموا عليه عسى أن يعودوا إلى الرأي السديد.
ولكن هذه الفئة الخارجة عن الطاعة المارقة عن الدين تمادت في غيّها فقامت بقتل الأبرياء وتهديد أمن البلاد، وقد قتلوا الصحابي عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجه الحامل، كما قتلوا نسوة من طي.
وعندما أرسل إليهم الإمام (ع) الحارث بن مرّة العبدي ليتعرّف على حقيقة موقفهم، قتلوا رسول أمير المؤمنين(ع) .
وعندها كرّ (ع) راجعاً من الأنبار (حيث كان اتخذها مركزاً لتجميع قواته المتجهة نحو الشام) وتوجه إلى قتالهم، والتقى الجيشان فأمر الإمام (ع) أصحابه بالكفّ عنهم حتى يبدؤوا القتال.
فتنادى الخوارج من كلّ جانب: «الرواح إلى الجنة»، وشهروا السلاح على أصحابه وأثخنوهم بالجراح، فاستقبلهم الرماة بالنبال والسهام، وشدّ عليهم أمير المؤمنين(ع) وأصحابه فما هي إلا سويعات حتى صرعهم الله كأنما قيل لهم: موتوا فماتوا..
ومن كرامات أمير المؤمنين(ع) في هذه الوقعة أنه كان قد أخبر أصحابه قبل المعركة بأنه لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة، وكان الأمر كما أخبرهم، فلم ينج منهم إلا تسعة أو ثمانية، ولم يقتل من أصحابه إلا تسعة كما روى ذلك أكثر المؤرخين.
وهنا يروي المؤرخون حديث المُخْدَج المعروف بـ(ذي الثديَّة)، أحد القتلى في هذه المعركة، حيث كان النبي(ص) قد أخبر أمير المؤمنين(ع) بقتل الخوارج وقتل المُخْدَج
معهم، لذلك فإنه بعد انتهاء المعركة فتش عنه وألحّ في طلبه حتى وجدوه بين القتلى، وهو يقول (ع) : «والله ما كَذبت ولا كُذبت»([2]).
فكانت من كرامات أمير المؤمنين(ع) الباهرة التي أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون.
([1]) سيرة الأئمة الاثني عشر 1: 441.
([2]) أشار إلى نحوه أبو يعلى في (مسنده) 1: 371- 374، وابن أبي الحديد في (شرح النهج) 2: 276، ونقله المجلسي في (البحار) 41: 283، ورواه المفيد في (الإرشاد) 1: 371.
شهادة الصحابي عمار بن ياسر في معركة صفين(9/ صفر / السنة 37 هـ)
كان عمار بن ياسر من السابقين الأولين هاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة وصلى إلى القبلتين وشهد بدراً واليمامة وأبلى فيهما بلاءاً حسناً وكان هو وأمه ممن عذّبوا في الله فأعطاهم ما أرادوا بلسانه، فنزل فيه: (إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِالإِيمَانِ)([1]).
وقال رسول الله(ص) كما رواه ابن حجر في الإصابة: «من عادى عماراً عاداه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله»([2]).
قال: وتواترت الأحاديث عن النبي(ص) «إنّ عماراً تقتله الفئة الباغية» وأجمعوا على أنه قتل مع علي(ع) بصفين.
وفي (الاستيعاب): هذا من إخباره (ص) بالغيب وإعلام نبوته وهو من أصحّ الأحاديث.
وقال رسول الله(ص) : «إن عماراً ملىء إيماناً إلى مشاشه»([3]).
ويروى: «إلى أخمص قدميه».
وقال (ص) : «عمار جلدة ما بين عيني»([4]).
ورآه النبي(ص) يوم بناء المسجد يحمل لبنتين لبنتين وغيره لبنة لبنة، فجعل ينفضّ التراب عنه ويقول (ص): «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار».
وقيل لحذيفة حين احتضر وقد ذكر الفتنة إذا اختلف الناس بمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابن سمية (يعني عماراً) فإنه لن يفارق الحق حتى يموت.
وروى نصر بن مزاحم أنه لما كانت وقعة صفين، ونظر عمار إلى راية عمرو بن العاص قال: «والله هذه الراية قد قاتلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهنّ».
ولما كان يوم صفين خرج عمار إلى أمير المؤمنين(ع) فقال: يا أخا رسول الله أتأذن لي في القتال. فقال (ع) : «مهلاً رحمك الله». فلما كان بعد ساعة أعاد عليه الكلام فأجابه بمثله فأعاده ثالثاً فبكى أمير المؤمنين(ع) فنظر إليه عمار فقال: يا أمير المؤمنين إنه اليوم الذي وصفه لي رسول الله(ص) ، فنزل أمير المؤمنين(ع) عن بغلته وعانق عماراً وودعه، ثم قال: «يا أبا اليقظان جزاك الله عنا وعن نبيك خيراً فنعم الأخ كنت ونعم الصاحب كنت» ثم بكى أمير المؤمنين(ع) وبكى عمار.
ثم ركب أمير المؤمنين(ع) وركب عمار.
وبرز عمار إلى القتال وكان قد جاوز التسعين، وأنشأ يقول:
|
نحن ضربناكم على تنزيله |
|
فاليوم نضربكم على تأويله |
|
أو يرجع الحق إلى سبيله([5]) |
ثم قال: والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنّا على الحق وإنهم على الباطل. ثم قال:
|
الجنة تحت ظلال الأسنة |
|
اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه |
واشتدّ به العطش فاستقى فأتي إليه بلبن فشربه، ثم قال: «هكذا عهد إليّ رسول الله(ص) أن يكون آخر زادي من الدنيا شربة من لبن».
وحمل عليه ابن جون السكسكي، وأبو العادية الفزاري، فأما أبو العادية فطعنه وأما ابن جون فاحتزّ رأسه.
وروى ابن سعد بسنده قال: لما بلغ علياً(ع) نعي عمار قال: «إن امرءاً من المسلمين لم يعظم عليه قتل عمار، ولم يدخل عليه بقتله مصيبة موجعة لغير رشيد! رحم الله عماراً يوم أسلم، ورحم الله عماراً يوم قتل، ورحم الله عماراً يوم يبعث حياً، فوالله لقد رأيت عماراً وما يُذكر من أصحاب النبيّ ثلاثة إلا كان رابعاً، ولا أربعة إلا كان خامساً!»([6]).
إنّ عمّاراً قد وجبت له الجنة في غير موطن ولا موطنين ولا ثلاث! فهنيئاً له الجنّة، فقد قُتل مع الحقّ والحقّ معه، يدور الحقَّ معه حيثما دار، فقاتل عمّار وسالبه في النار([7]).
ثم تقدم علي(ع) فجمع عمّار بن ياسر إلى هاشم المرقال أمامه ثم صلى عليه فكبّر خمساً أو ستاً أو سبعاً([8])، ورثاه الحجّاج بن عمرو الأنصاري بأبيات مشجية.
وقال المسعودي في (مروج الذّهب): وكان قَتْلهُ عند المساء، ولم يغسله علي(ع) وصلى عليه ودفنه في صفّين([9]).ويُنسب إلى عمّار من الشعر قوله:
|
تَوَقَّ من الطُّرْق أوساطها |
|
وعُدَّ من الجانب المشتَبِه |
فسلام الله على عمّار وأبويه الشهيدين ياسر وسُميّة، يوم ولدوا، ويوم استشهدوا، ويوم يبعثون أحياء، بل هم اليوم أحياء عند ربّهم يرزقون (وَلَكِن لاّ تَشْعُرُونَ).
مقام عمار بن ياسر في الرقة
أما اليوم فقد تحوّل مكان استشهاد عمار إلى مزار يؤمّه المحبّون والموالون، وذلك في مدينة الرقة السورية في منطقة صفين التي شهدت أحداث تلك الوقعة الشهيرة، وقد حاز هذا المقام اهتماماً بالغاً من قبل الجمهورية الإسلامية حيث تمّ بناؤه وتشييده على أحسن ما يكون.
([2]) بحار الأنوار 31: 196، وقعة صفين: 341.
([7]) عن الفتوح لابن الأعثم الكوفي 3: 368.
([8]) الطبقات الكبرى 3: 363 عن الأشعث بن قيس، والشك في التكبيرات منه، وأنظر أنساب الأشراف 3: 318.
([9]) مروج الذهب 2: 381 ط بيروت، بتحقيق أسعد داغر.
([10]) الدرجات الرفيعة في طبقات أعلام الشيعة، للسيد المدني الشيرازي: 283، ط بغداد.
وفاة الصحابي سلمان الفارسي (المحمدي) (8/ صفر / السنة 34 هـ)
إنّ دراسة حياة الأفذاذ من الرجال، إنّما تصبح ضرورة ملحّة، حينما تكون فرصة لاستيعاب كثير من المعاني البناءة، وللتعرف على حقائق الحياة، والوقوف على عميق أسرارها، من خلال دراسة فكر ورؤية، ثم حركة وموقف هؤلاء القمم؛ ليكون ذلك رافداً ثرّاً للجانب العاطفي، ومسهماً في تعميق الوعي العقيدي، المهيمن على هذا الإنسان في كل شؤونه، ومختلف أحواله وأطواره..
دراستنا لسلمان المحمّدي
ومن هنا.. فاننا لن نسمح لدراستنا لحياة سلمان المحمّدي، أن تتخذ إلا طابع الاستفادة من التجربة الفاضلة، لتسمو بنا، ونسمو نحن بها، لتكون ربيعاً لنا نتخير من أزهاره، ونجني من أثماره، ونلتذ بأفانين تغريد أطياره.
ونكون نحن لها التجسيد الحي، والنموذج الفذ، والمثل الأعلى..
ولكننا.. إذ نؤمن بأن قضايا التاريخ، مما لا يمكن حسم الأمر فيها، بسهولة، الأمر الذي يتخذ صفة الضرورة، قبل أن يمكن استيحاء العبرة والفكرة من أية قضية..
معلومات أولية:
اسمه: سلمان([1]).
كنيته: أبو عبد الله، أو أبو الحسن، أو أبو إسحاق.
ولادته: لا مجال لتحديدها.
وفاته: في الثامن من شهر صفر سنة أربع وثلاثين للهجرة.
بلده: جي (قرية في أصفهان). وقيل: إنه من رامهرمز، من فارس.
محل دفنه: المدائن.. بلد قرب بغداد، فيه قبره رحمه الله، وقبر حذيفة بن اليمان..
أبوه: كان أبوه دهقان أرضه. وهو يعدّ من موالي رسول الله(ص) .
وكان قد تداوله بضعة عشر مالكاً، حتى أفضى إلى رسول الله(ص) وعتقائه وأصحابه بل من خواص أصحابه.
وكان قد قرأ الكتب في طلب الدين.
حرفته: كان يسفّ الخوص، ويبيعه ويأكل منه، وهو أمير على المدائن.
إسلامه: عدّ في بعض الروايات من السابقين الأولين. كما قال ابن مردويه ويقال: بل أسلم أوائل الهجرة.
مشاهده: روي: أنه شهد بدراً وأحداً، ولم يفته بعد ذلك مشهد.
عطاؤه: في عصر الخلافة: خمسة آلاف، وكان يتصدق بها، ويأكل من عمل يده.
بيت سكناه: لم يكن له بيت يسكن فيه، إنما كان يستظل بالجدر والشجر، حتى أقنعه البعض بأن يبني له بيتاً، إن قام أصاب رأسه سقفه، وإن مدّ رجليه أصابهما الجدار.
من خصائص سلمان:
قد عرفنا من بيت سكناه ومن حرفته، ومما يصنعه بعطائه زهد سلمان، وعزوفه عن الدنيا، ولا نريد استقصاء ذلك هنا أكثر من ذلك..
وقد وصفه البعض بأنه: كان خيراً فاضلاً، حبراً عالماً، زاهداً، متقشّفاً([2]). وكانت له عباءة يفرش بعضها، ويلبس بعضها...
كان يحب الفقراء ويؤثرهم على أهل الثروة والعدد. وكان، كما يقال، يعرف الاسم الأعظم. وكان من المتوسّمين، وقد قيل: الإيمان عشر درجات، وكان سلمان في الدرجة العاشرة([3])، وكان يحب العلم والعلماء.
إنّ سلمان - كما روي عن الإمام الصادق(ع) - كان عبداً صالحاً، حنيفاً، مسلماً، وما كان من المشركين. وفي حديث رسول الله(ص) : «لا تغلطنّ في سلمان، فإنّ الله تبارك وتعالى أمرني أن أطلعه على علم البلايا والمنايا والأنساب، وفصل الخطاب..»([4]).
منزلته ومقامه:
بعض ما سبق يشير إلى علو مقامه، وسامق منزلته، ولا نرى أننا بحاجة إلى المزيد، ولكننا ننقل هذا الخبر عن عائشة:
عن عائشة، قالت: «كان لسلمان مجلس من رسول الله(ص) ينفرد به بالليل، حتى يكاد يغلبنا على رسول الله(ص) »([5]).
وقد قال رسول الله(ص) - كما سيأتي: «سلمان منّا أهل البيت»([6]).
وعن الصادق(ع) : «كان رسول الله(ص) ، وأمير المؤمنين(ع) يحدثان سلمان بما لا يحتمله غيره، من مخزون علم الله، ومكنونه»([7]).
ويأتيه الأمر: «يا سلمان، ائت منزل فاطمة بنت رسول الله(ص) ، فإنها إليك مشتاقة، تريد أن تتحفك بتحفة قد اُتحفت بها من الجنة..»([8]).
وعلَّمته صلوات الله وسلامه عليها أحد الأدعية المهمة أيضاً..
وعن النبيّ(ص): «سلمان منّي، ومن جفاه فقد جفاني، ومن آذاه فقد آذاني»([9]) الخ..
وقال الإمام الصادق(ع) لمنصور بن بُزُرْج - كما روي - : «لا تقل: سلمان الفارسي، ولكن قل: سلمان المحمّدي»([10]).
من لطائف الإشارات:
ونذكر من لطائف الإشارات، وطرائف الأحداث:
إن رسول الله(ص) قد آخى بين سلمان، وأبي ذر، وشرط على أبي ذر: أن لا يعصي سلمان.
ويقال: إن تاج كسرى وضع على رأس سلمان، عند فتح فارس، كما قال له رسول الله(ص) . وكان سلمان أحد الذين استقاموا على أمر رسول الله(ص) بعد وفاته..
وكان من المعترضين على صرف الأمر عن علي أمير المؤمنين إلى غيره، وله احتجاجات على القوم في هذا المجال.
وفاة سلمان
وحين توفي سلمان تولى غسله وتجهيزه، والصلاة عليه ودفنه، علي أمير المؤمنين(ع) ، وقد جاء من المدينة إلى المدائن من أجل ذلك. وهذه القضية من الكرامات المشهورة لأمير المؤمنين(ع) ([11])، بل من الكرامات المؤكدة لسلمان.
([1]) ويكفي للاطلاع على جانب من حياته رحمه الله مراجعة كتاب (بحار الأنوار)، وكتاب سفينة البحار1: 647، وكتاب نفس الرحمان في فضائل سلمان.
([2]) الاستيعاب بهامش الإصابة 2: 58، وسفينة البحار 1: 647.
([3]) كما في باب الخصال العشرة من كتاب الخصال للشيخ الصدوق عن الصادق.
([5]) الاستيعاب بهامش الإصابة 2: 59، وسفينة البحار 1: 648.
([6]) بحار الأنوار 17: 169 ب1. والمناقب 1: 85.
ولادة الإمام موسى الكاظم (ع) (7/ صفر / السنة 128 هـ)
هو الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب(عليهم السلام) . السابع من أئمة أهل البيت المعصومين المطهرين.
ولد في الأبواء([1]) سنة ثمانٍ وعشرين ومئة للهجرة، وقبض(ع) ببغداد في حبس السندي بن شاهك، لستٍ بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومئة للهجرة. وله من العمر يومئذٍ خمس وخمسون سنة، وأمه أم ولد يقال لها: حميدة البربرية، ويقال لها حميدة المصفاة وكانت من خيار النساء، وقد مدحها الإمام الصادق(ع) فقال فيها:
«حميدة المصفاة من الأدناس كسبيكة الذهب. ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إليّ، كرامة من الله لي والحجة من بعدي»([2]).
وكانت مدة إمامته (ع) خمساً وثلاثين سنة، وكان يكنى أبا إبراهيم وأبا الحسن وأبا علي، وكان يعرف بالعبد الصالح، ويلقّب بالكاظم(ع) .
صفت نفسه الطاهرة، وخلصت سريرته، فكان أحد كواكب البيت النبوي، يضيء طريق الأجيال، وينوّر ظلمات الدنيا بعطائه السيّال، تألّق نجمه في عنان السماء، وارتقى إلى مشارف العلى، علماً وحلماً، شجاعة وسماحة، فضلاً وكرماً، مضافاً إلى انقطاعه التام إلى الله سبحانه وتعالى، فصار مهوى للقلوب والأفئدة، ولذلك تسابقت الأقلام على مختلف انتماءاتها تشيد بفضله وتذكر مناقبه وعلوّ شأنه.
عاش الإمام الكاظم(ع) مدة مديدة من حياته في ظلمات السجون، فقد سجنه المهدي العباسي ثم أطلقه، ولما آلت الأمور إلى هارون الرشيد أعاد اعتقال الإمام (ع) ، وظلّ ينقله من سجن إلى آخر حتى استشهد في سجن السندي بن شاهك في بغداد بسم دسّه له الرشيد.
وكانت شهادته (ع) في الخامس والعشرين من شهر رجب لسنة مئة وثلاث وثمانين للهجرة (183هـ)([3]).
ودفن في مقبرة قريش في بغداد، في جانب الكرخ، والتي تعرف اليوم بالكاظمية ومرقده معروف يؤمّه الزوار من كل حدبٍ وصوب ومن مختلف المذاهب الإسلاميّة، وله كرامات مشهودة.
قال الإمام الشافعي (المتوفى: 204هـ) كما في (تحفة العالم): «قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب»([4])، يقصد به استجابة الدعاء عنده.
وقال الحسن بن إبراهيم، أبو علي الخلال، شيخ الحنابلة (من علماء القرن الثالث الهجري): «ما همّني أمر، فقصدت قبر موسى بن جعفر، فتوسّلت به، إلاّ سهّل الله تعالى لي ما أحب»([5]).
وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (المتوفى: 597هـ) في كتابه (صفة الصفوة) عن الكاظم(ع): «كان يدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل وكان كريماً حليماً، إذا بلغه عن رجل ما يؤذيه بعث إليه بمال»([6]).
وجاء عن ابن الأثير الجزري في كتابه (الكامل في التاريخ): «وكان يلقّب بالكاظم لأنه يحسن إلى من يسيء إليه، كان هذا عادته أبداً»([7]).
وهناك ما لا يحصى من نصوص علماء أهل السنة في الثناء على الإمام الكاظم(ع).
واللافت في حياة هذا الإمام العظيم الذي قضى معظم حياته في السجون حتى قضى فيها، أنه أكثر الأئمة ذرية، وما ذلك إلا ليظهر الله أمره ولو كره الكارهون.
فقد جاء في كتاب (الإرشاد) للمفيد: وكان لأبي الحسن موسى(ع) سبعة وثلاثون ذكراً وأنثى منهم: علي بن موسى الرضا(ع) ، وإبراهيم، والعباس، والقاسم لأمهات أولاد، وإسماعيل وجعفر وهارون والحسين لأم ولد. وأحمد ومحمد وحمزة لأم ولد. وعبد الله وإسحاق، وعبيد الله، وزيد، والحسن، والفضل، وسليمان لأمهات أولاد. وفاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى، ورقية، وحكيمة، وأم أبيها، ورقية الصغرى، وكلثوم، وأم جعفر، ولبابة، وزينب، وخديجة، وعُليّة، وآمنة، وحسنة، وبُريهة، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأم كلثوم، لأمهات أولاد.
وكان أفضل ولد أبي الحسن موسى(ع) ، وأنبههم وأعظمهم قدراً، وأعلمهم وأجمعهم فضلاً أبو الحسن علي بن موسى الرضا(عليهم السلام) ([8]).
فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حياً.
([1]) الأبواء: قرية من أعمال الفُرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً (معجم البلدان 1/79)، وفي الأبواء مدفن آمنة بنت وهب أم الرسول الأعظم (ص).
([2]) أصول الكافي للكليني 1: 550.
([3]) إعلام الورى للطبرسي 2: 6.
([4]) أئمتنا لمحمد دخيل: 65 نقلاً عن تحفة العالم: 22، ونقله أيضاً أحمد زيني دحلان في الدرر السنية في الرد على الوهابية 4: 6.
([5]) نقل قوله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1: 120، وابن الجوزي في المنتظم 9: 89.
([6]) صفوة الصفوة 2: 184 ترجمة رقم 191 راجع فهناك المزيد من كرامات الإمام يذكرها الشيخ. كما أن ابن الجوزي ترجم للإمام الكاظم(ع) في كتابه (المنتظم) ومدحه بكلمات تقرب مما نقلناه من النص.
وفاة السيدة رقية بنت الإمام الحسين (ع)(5/ صفر / السنة 61 هـ)
من هي السيدة رقية؟
السيدة رقية طفلة لأبي عبد الله الحسين(ع) ، من زوجته أم إسحاق وذكروا ارباب المقاتل أنّ عمرها خلال السبي وبعد حادثة الطف كان يبلغ ثلاث سنين.
وكانت هذه الطفلة مثالاً للمظلومية، فقد رافقت ركب السبايا إلى الشام في رحلة مريرة شاقة، حتى إنها فارقت الحياة في خربة الشام، في موقف مؤثّر لم يشهد التاريخ مثيلاً له.
ففي الخربة، حيث مستقر السبايا استفاقت رقية (عليهاالسلام) ليلاً من منامها، وهي مضطربة اضطراباً شديداً، وهي تقول: أين أبي الحسين؟ فإني رأيته الساعة في المنام.
فلما سمعت النسوة ذلك صرخن وأعولن وارتفعت أصواتهن بالبكاء، فانتبه يزيد من نومه، وقال: ما الخبر؟ فأعلموه بما جرى، فأمر أن يذهبوا برأس أبيها إليها، فجاءوا بالرأس ووضعوه في حجرها، فرفضته وكانت تظن أنه طعام لأنه كان مغطى بمنديل، ولما رفعوا المنديل عنه، احتضنته ووضعت فمها على فمه وهي تبكي بحرقة وتخاطب الرأس بكلمات ملؤها الأسى والحسرة، وما هي إلا لحظات حتى فارقت روحها جسدها رحمة الله عليها..
وكان مشهداً فيه من القسوة والظلم ما لا يطيقه بشر. ودفنت في المكان الذي قضت فيه([1])، ودارت الأيام والسنون وأبى الله إلا أن تكون كلمته هي العليا، فارتفع فوق ذلك المكان الذي يحتضن الجسد الصغير مقام يناطح السماء في عليائه ويرتّل على مدى الدهور معاني انتصار الحق على الباطل, وما أجمل قول الشاعر([2]) معبّراً عن ذلك بهذه الأبيات:
|
ويظلّ مجدك يا رقية عبرة |
|
للظالمين على الزمان يجـدّد |
|
يزكو به عطر الأذان ويزدهي |
|
بجـلال مفرقـه النبي محمد |
|
ويكاد من وهج التلاوة صخره |
|
يندى ومن وضح الهدى يتورّد |
|
وعليه أسراب الملائك حوّم |
|
وهموم أفئدة الموالي حشّد |
|
و به يطوف فم الخلود مؤرّخاً |
|
بالشام قبر رقية يتجدّد |
مقام السيدة رقية بنت الإمام الحسين (عليهماالسلام)
يقع مقام السيدة رقية(عليهاالسلام) على بعد (100م) أو أكثر قليلاً من الجامع الأموي بدمشق في سوق مشهور بدمشق يسمى سوق العمارة، وعندما تريد الدخول إلى صحنها المطهر فإنّ أول ما يلفت نظرك، اللوحة التي على باب مقامها الشريف، مكتوب فيها: «هذا مقام السيدة رقية بنت الحسين(ع) الشهيد بكربلاء»، وهناك لوحة أخرى بالبرونز على باب الفناء الداخلي للقبة الشريفة فيها شجرة نسبها الطاهر التي تربطها بجدتها الزهراء(عليهاالسلام) وجدها الأكبر النبي(ص) وجدها أمير المؤمنين.
وقد ذكرت السيدة رقية(عليهاالسلام) في كتب أهل السنة، حيث ذكرها الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشافعي المصري المتوفى (973هـ)، في كتابه (المنن)، الباب العاشر، وتحدّث عن مقامها الشريف، فقال: Sهذا البيت بقعة شرفت بآل النبي(ص) في دمشق، وبنت الحسين الشهيد رقية(عليهاالسلام) ».
وذكرها أيضاً الشيخ القندوزي الحنفي (المتوفى عام 1294هـ)، في (ينابيع المودة: ص416).
([1]) لمزيد من الإطلاع راجع كتاب منتهى الآمال للشيخ عباس القمي 1: 327.
([2]) القصيدة للشاعر الدكتور مصطفى جمال الدين رحمه الله وهي مخطوطة تطوق ضريح السيدة رقيهB.
شهادة زيد بن الإمام علي بن الحسين (ع) (على رواية المفيد) (3/ صفر / السنة 121 هـ)
في هذا اليوم من شهر صفر استشهد زيد بن علي(ع) ، وقبل ذكر خبر استشهاده نورد بعض الأخبار الدالة على فضله وكرامته، فقد روى علي بن العباس (بسنده) عن أبي جعفر قال: قال رسول الله(ص) للحسين: «يخرج رجل من صلبك يقال له زيد يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غراً محجّلين يدخلون الجنة بغير حساب»([1]).
وعن الحسن بن الحسين عن يحيى بن مساور عن أبي الجارود قال: «قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل لي: ذاك حليف القرآن»([2]).
قصة الاستشهاد
ولإلقاء الضوء على قصة استشهاده نقتبس ما أورده المرحوم السيد محسن الأمين فيه من كتابه (المجالس السنية):
كان زيد بن علي بن الحسين(ع) عين إخوته بعد أخيه أبي جعفر الباقر(ع) وأفضلهم، وكان عابداً ورعاً فقيهاً سخياً شجاعاً وظهر بالسيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويطلب بثارات الحسين(ع) وكان سبب خروجه مضافاً إلى طلبه بدم الحسين(ع) ، أنه دخل على هشام بن عبد الملك وقد جمع هشام أهل الشام وأمر أن يتضايقوا في المجلس حتى لا يتمكن من الوصول إلى قربه. فقال له زيد: إنه ليس من عباد الله أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ولا من عباده أحد دون أن يوصي بتقوى الله وأنا أوصيك بتقوى الله فاتقه.
فقال له هشام: ما فعل أخوك البقرة؟
فقال: سماه رسول الله(ص) باقر العلم وأنت تسميه بقرة لشد ما اختلفتما في الدنيا ولتختلفان في الآخرة!
فقال له هشام: أنت المؤهل نفسك للخلافة الراجي لها؟ وما أنت وذاك لا أم لك وإنما أنت ابن أمة!
فقال له زيد: إني لا أعلم أحداً أعظم منزلة عند الله من نبي بعثه وهو
ابن أمة فلو كان ذلك يقصر عن منتهى غاية لم يبعث وهو إسماعيل بن إبراهيم(ع) فالنبوة أعظم منزلة عند الله أم الخلافة يا هشام؟ وبعد فما يقصر برجل أبوه رسول الله(ص) وهو ابن علي بن أبي طالب(ع).
فوثب هشام من مجلسه ودعا قهرمانه وقال: لا يبيتنّ هذا في عسكري.
فخرج زيد وهو يقول: إنه لم يكره قوم قط حد السيوف إلا ذلّوا. فحملت كلمته إلى هشام. فعرف أنه يخرج عليه فأرسل معه من يخرجه على طريق الحجاز ولا يدعه يخرج على طريق العراق. فلما رجع عنه الموكلون به بعد أن أوصلوه إلى طريق الحجاز. رجع إلى العراق حتى أتى الكوفة، وأقبلت الشيعة تختلف إليه وهم يبايعونه، حتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان والجزيرة. فحاربه يوسف بن عمرو الثقفي، فلما قامت الحرب انهزم أصحاب زيد وبقي في جماعة يسيرة فقاتلهم أشد القتال وهو يقول متمثلاً:
|
فذل الحياة وعزّ الممات |
|
وكلاً أراه طعامـاً وبيلا |
وحال المساء بين الصفين، وانصرف زيد وهو مثخن بالجراح وقد أصابه سهم في جبهته، وطلبوا من ينزع السهم فأتي بحجام، فاستكتموه أمره، فأخرج النصل فمات من ساعته، فدفنوه في ساقية ماء وجعلوا على قبره التراب والحشيش وأجري الماء على ذلك، وحضر الحجام وقيل عبد سندي مواراته فعرف الموضع، فلما أصبح مضى إلى يوسف فدلّه على موضع قبره فاستخرجه يوسف بن عمرو وبعث برأسه إلى هشام وبعثه هشام إلى المدينة فنصب عند قبر النبي(ص) يوماً وليلة. (ولمّا) قتل بلغ ذلك من الصادق(ع) كل مبلغ وحزن عليه حزناً عظيماً وفرق من ماله في عيال من أصيب معه من أصحابه ألف دينار وكتب هشام إلى يوسف بن عمرو أن اصلبه عرياناً فصلبه في الكناسة فنسجت العنكبوت على عورته من يومه ومكث أربع سنين مصلوباً، حتى مضى هشام وبويع الوليد بن يزيد، فكتب الوليد إلى يوسف بن عمرو: أما بعد فإذا أتاك كتابي فاعمد إلى عجل أهل العراق فاحرقه ثم انسفه في اليم نسفاً. فأنزله وحرقه ثم ذراه في الهواء.
وبالفعل كانت طريقة قتل زيد فظيعة من الفظائع التي يندى لها جبين الإنسانية خجلاً، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
دخول السبايا إلى الشام (1/ صفر / السنة 61 هـ)
بعث ابن زياد رسولاً إلى يزيد يخبره بقتل الإمام الحسين(ع) ومن معه، وأن عياله في الكوفة، وينتظر أمره فيهم، فأتاه الجواب بحملهم والرؤوس معهم([1]).
فأمر ابن زياد زجر بن قيس، وأبا بردة بن عوف الأزدي، وطارق بن ضبيان في جماعة من أهل الكوفة؛ أن يحملوا رأس الإمام الحسين(ع) ورؤوس من قتل معه إلى يزيد([2]).
وسرح في أثرهم الإمام علي بن الحسين(ع) مغلولة يداه إلى عنقه وعياله معه([3]).
وكان معهم شمر بن ذي الجوشن، وشبث بن ربعي، وعمرو بن الحجاج، وجماعة، وأمرهم أن يلحقوا الرؤوس ويشهروهم في كل بلد يأتونه([4]).
وفي الأول من شهر صفر سنة 61هـ أدخل رأس الإمام الحسين(ع) وموكب السبايا إلى الشام، ولما وضعت الرؤوس بين يدي يزيد تمثّل قائلاً:
|
يفلّقن هاماً من رجال أعزّة |
|
علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما([5]) |
ثم أذن للناس، فدخلوا والرأس بين يديه وهو ينكت ثغر الإمام بقضيب، فقال له أبو برزة الأسلمي من أصحاب رسول الله(ص) :
«أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟! أما، لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً، لربما رأيت رسول الله(ص) يرشفه! أما، إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وشفيعك ابن زياد! ويجيء هذا يوم القيامة وشفيعه محمد(ص) »([6])، ثم قام فولّى.
وسمعت هند([7]) بما دار من هذا الحديث، فخرجت مذهولة ودخلت على يزيد وهي تصيح: يزيد، رأس من هذا؟
فأراد يزيد التملّص من مسؤوليته في ارتكاب الجريمة فقال: أعولي عليه يا هند، وحدّي عليه، فإنه ابن بنت رسول الله(ص) ، وصريخة بني هاشم، عجل عليه ابن زياد فقتله([8]).
وقد يكون من المفيد أن نذكر ما ذكره ابن نما وابن طاووس: لما سمعت زينب بنت علي(س) يزيداً، يتمثل بأبيات ابن الزبعرى([9])، حتى قال:
|
لعبت هاشم بالملك فـلا |
|
خبـر جـاء ولا وحي نـزل |
فوقفت خطيبة فقالت بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه وآله:
(ثُمّ كَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاءُواْ السّوَءَىَ أَن كَذّبُواْ بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ) ([10])، أظننت يا يزيد، حيث أخذت علينا أقطار الأرض، وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا، وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك، جذلان مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة، والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلاً مهلاً، أنسيت قول الله تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنّ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوَاْ إِثْمَاً وَلَهْمُ عَذَابٌ مّهِينٌ)([11]).
أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهنّ، وأبديت وجوههنّ، تحدو بهنّ الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمعاقل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والدنيّ والشريف، ليس معهنّ من حماتهنّ حمي ولا من رجالهنّ ولي؟ وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطئ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشّنف والشّنآن، والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم:
|
لأهلّوا واستهلّوا فرحاً |
|
ثم قالوا يا يزيد لا تشل |
منحنياً على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك! وكيف لا تقول ذلك، وقد نكأت القرحة، واستأصلت الشأفة، بإراقتك دماء ذرية محمد(ص) ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردنّ وشيكاً موردهم، ولتودنّ أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممّن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا، وقتل حماتنا.
فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردنّ على رسول الله(ص) بما تحمّلت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم، ويلمّ شعثهم، ويأخذ بحقهم: (وَلاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ)([12]).
وحسبك بالله حاكماً، وبمحمد(ص) خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً، وسيعلم من سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلاً وأيّكم شرّ مكاناً، وأضعف جنداً.
ولئن جرت عليّ الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى، والصدور حرّى، ألا فالعجب كلّ العجب، لقتل حزب الله النجباء، بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلّب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل، وتعفّرها أمهات الفراعل ولئن اتخذتنا مغنماً، لتجدنا وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد، وإلى الله المشتكى وعليه المعول.
فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين.
والحمد لله رب العالمين، الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل ([13]).
ثم أمر يزيد الخطيب أن يصعد المنبر ويثني على معاوية وينال من الحسين وآله. ففعل الخطيب وأكثر من الوقيعة في علي(ع) والحسين(ع) ، فصاح به السجاد(ع) : «أيها الخاطب لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار»([14]).
ثم التفت (ع) إلى يزيد وقال له: «أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه لله رضى ولهؤلاء أجر وثواب».
فأبى يزيد، وألحّ الناس عليه، فلم يقبل، فقال ابنه معاوية الثاني: ائذن له، ما قدر أن يأتي به؟ فقال يزيد: إن هؤلاء ورثوا العلم والفصاحة وزقوا العلم زقاً. وما زالوا به حتى أذن له.
فقال (ع) : «الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاد له، والأول الذي لا أولية له، والآخر الذي لا آخرية له، والباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام، وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام..».
إلى أن قال (ع): «أيها الناس، أُعطينا ستاً وفضلنا بسبع؛ أُعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضّلنا بأن منا النبي والصديق والطيار وأسد الله وأسد رسوله وسبطا هذه الأمة (ومنا مهديها).
أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي.
أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى وخير من طاف وسعى، وحج ولبّى، أنا ابن من حُمل على البـراق وبلغ به جبـرائيل سدرة المنتهى، فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وقاتل الناكثين، والقاسطين، والمارقين، ومفرق الأحزاب، أربطهم جأشاً، وأمضاهم عزيمة ذاك أبو السبطين الحسن والحسين، علي بن أبي طالب.
أنا ابن فاطمة الزهراء، وسيدة النساء، وابن خديجة الكبـرى.
أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلماء، وناحت الطير في الهواء».
فلما بلغ إلى هذا الموضع ضجّ الناس بالبكاء وخشي يزيد الفتنة فأمر المؤذن أن يؤذن للصلاة فقال المؤذن: الله أكبر.
فقال الإمام (ع) : «الله أكبـر وأجلّ وأعلى وأكرم مما أخاف وأحذر».
ولما قال المؤذن: أشهد أن لا اله إلا الله.
قال (ع) : «نعم أشهد مع كل شاهد أن لا إله غيره ولا ربّ سواه».
فلما قال المؤذن: أشهد أنّ محمداً رسول الله.
قال الإمام للمؤذن: «أسألك بحق محمد أن تسكت حتى أكلم هذا».
والتفت إلى يزيد وقال: «هذا الرسول العزيز الكريم جدّك أم جدّي؟ فإن قلت أنه جدك علم الحاضرون والناس كلهم أنك كاذب، وإن قلت جدي فلم قتلت أبي ظلماً وعدواناً، وانتهبت ماله وسبيت نساءه، فويل لك يوم القيامة إذا كان جدّي خصمك»([15]).
فصاح يزيد بالمؤذن: أقم الصلاة، فوقع بين الناس همهمة وصلى بعضهم وتفرق الآخر، وخشي يزيد الفتنة، فأمر بنقل السبايا إلى الخربة.
([4]) المنتخب للطريحي: 339 (ط2).
([6]) الطبري 5: 390، والمسعودي 3: 71.
([7]) هي هند بنت عبد الله بن عامر بن حريز من المدينة، وهي زوج يزيد آنذاك.
([11]) سورة آل عمران: الآية 178.
([12]) سورة آل عمران: الآية 169.
وقعة صفين (1/ صفر / السنة 37 هـ)
لكل شهر من الشهور القمرية ميزة خاصة تطغى عليها فتطبعها بطابعها المميز، فشهر محرم الحرام يتميز بغلبة مناسبة عاشوراء على سائر المناسبات الأخرى التي حدثت فيها، وكذلك شهر ذي الحجة فيتميز بغلبة مناسبة الحج وما يتعلق بها من أحداث مهمة مثل عيد الغدير.
أما شهر صفر فيتميز بغلبة الحزن والمناسبات والأحداث التي وقعت فيها، ولذلك يقول الشيخ عباس القمي في كتابه (وقائع الأيام) عند ذكر وقائع وأعمال شهر صفر: Sاعلم أن هذا الشهر عُرف بالشؤم، وربما كان السبب وقوع وفاة رسول الله(ص) في هذا الشهر، يوم الاثنين، وربما كان الشؤم بسبب وقوع شهر صفر بعد ثلاثة من أشهر الحرم حيث حرّم الله فيها القتال، وقد سمح لهم بالقتال في هذا الشهر، فكان الناس يتركون بيوتهم، ويتأهبون للحرب وهذا مدعاة للشؤم..R.
الإسلام دين الفكر والحياة:
لقد أصبحت تعاليم الإسلام ثورة شاملة على كل ما يعيق تقدم الإنسان باتجاه الكمال، فكانت رسالة الرسول(ص) العمل على كسر كل القيود الفكرية والاجتماعية.. التي كبّلت الإنسان، ومنعته من التطور في جميع المجالات، يقول تعالى، في وصف نبيه(ص) : (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ الّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)([1]).
فلذلك حدث تحول كبير في تاريخ الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام إذ حوّل العرب الحفاة العراة، إلى قادة وسادة يحكمون أعظم امبراطورية في التاريخ.
ومن الدروس التي تعلمناها من الرسول(ص) لمواجهة تحديات الحياة، هو الحث على التفاؤل ونبذ التشاؤم، فقد عرف عن النبي(ص) أنه كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة كما ورد في الحديث عن رسول الله(ص) : «إن الله يحب الفأل الحسن»([2]).
ولذلك كان (ص) يأمر من رأى شيئاً يكرهه ويتطير منه أن يقول: «اللهم لا يؤتي الخير إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك»([3]).
ومن هذا المنطلق، جعل الشارع المقدس وسائل فعّالة لرفع الشؤم الذي عرف عنه شهر صفر، وذلك بالصدقة والدعاء والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وقد ورد في الحديث أنه إذا أراد امرؤ أن يصبح في مأمن من الأضرار في هذا الشهر فليقرأ هذا الدعاء عشر مرات: «يا شديد القوى، يا شديد المحال، يا عزيز، يا عزيز، يا عزيز، ذلّت لعظمتك جميع خلقك، فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل، يا منعم، يا مفضل، يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين»([4]).
ويُستحسن عند ذكر شهر صفر وصفه بالخير والبركة، فيقال: (شهر صفر المظفّر)، أو (شهر صفر الخير)، من باب التفاؤل واقتداءً برسول الله(ص) الذي كان يغير الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان وغيرها.. فقد غيّر (ص) اسم غاوي بن ظالم إلى راشد بن عبد ربه،
وغيّر (ص) اسم أرض من بئسان إلى نعمان، وغيّر (ص) اسم عاصية إلى جميلة([5]).
أحداث شهر صفر
إن من يطالع الكتب التاريخية يلاحظ وقوع أحداث مهمة في هذا الشهر أثرت كثيراً على التاريخ الإسلامي، من قبيل: وقعة صفين في الأول منه، وأربعينية الإمام الحسين(ع) في أواسطه، ووفاة الرسول(ص) وسبطه الحسن(ع) وحفيده الإمام الرضا(ع) في أواخره.وغيرها من الأحداث والتي سنستعرضها فيما سيأتي، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون، والله ولي التوفيق.
وقعة صفين (1/ صفر / السنة 37 هـ)
كان ابتداء القتال بصفّين في أول يوم من صفر سنة (37 للهجرة)، وذلك عند نهر الفرات في وادي صفين قرب الرّقة.
ويذكر المؤرخون أنه لما عزم أمير المؤمنين(ع) على المسير لقتال معاوية ومن معه من أهل الشام، خطب في أصحابه، ومما جاء في كلامه بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله(ص):
«اتقوا الله - عباد الله - وأطيعوه وأطيعوا إمامكم، فإن الرعية الصالحة تنجو بالإمام العادل. ألا وإن الرعية الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر، وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حقي، ناكثاً لبيعتي، طاعناً في دين الله عز وجل...
فالعجب من معاوية بن أبي سفيان، ينازعني الخلافة، ويجحدني الإمامة ويزعم أنه أحقّ بها مني، جرأة منه على الله وعلى رسوله، بغير حق له فيها ولا حجة، لم يبايعه عليها المهاجرون، ولا سلّم له الأنصار والمسلمون..R.إلى أن قال (ع):Sاتقوا الله - عباد الله - وتحاثّوا على الجهاد مع إمامكم، فلو كان لي منكم عصابة بعدد أهل بدر؛ إذا أمرتهم أطاعوني، وإذا استنهضتهم نهضوا معي، لاستغنيت بهم عن كثير منكم، وأسرعت النهوض إلى حرب معاوية وأصحابه فإنه الجهاد المفروض»([6]).
منع الماء:
وقد كشف معاوية عن نواياه العدائية، عندما بادر إلى الاستيلاء على الماء، وحال بينه وبين أهل العراق، فأضرّ بهم وبدوابّهم العطش، فأرسل إليهم أمير المؤمنين(ع) : «إنا لم نأت هذه الأرض لنسيطر على الماء والكلأ، ولو سبقناكم إليه، لا نمنعكم منه».
ولكن لم تجد هذه الكلمات آذاناً صاغية من الطرف المقابل، ما اضطرّ علياً(ع) إلى استعمال القوة لإنقاذ عشرات الألوف ممن كان معه من الموت عطشاً، فأرسل الأشتر في كتيبة من عسكره فأظهروا من البسالة ما أبهر جيش معاوية وأجبرهم على الانسحاب، فاستعاد أصحاب أمير المؤمنين(ع) الماء من أهل الشام.
وهنا ظهرت سماحة الإمام (ع) حيث حاول بعض أصحابه إقناعه أن يقابل أهل الشام بالمثل ويمنع عنهم الماء، فأبى(ع) عليهم أشدّ الإباء.
فبقي الجيشان ينهلان من الماء على قدم المساواة، واستمرت جهود الإمام (ع) في حلّ النزاع سلمياً كما يظهر ذلك من أكثر المرويات في هذا المجال، ولكن جهود الإمام (ع) ذهبت سدىً، بعد أن واصل أصحاب معاوية استفزازاتهم، وغاراتهم حتى أوقعوا في أصحاب الإمام عدداً من القتلى، عندها أذن الإمام بالقتال، وبدأت حرب بين الطرفين استمرت شهوراً وراح ضحيتها أكثر من مئة ألف من المسلمين، في فتنة أشعل نارها ابن هند لمآربه الخاصة.
فتنة رفع المصاحف
تفاجأ معاوية ومن معه من بسالة أصحاب الإمام في الذود عن الحق الذي يمثله
الإمام (ع) ، وفيهم أكابر صحابة رسول الله(ص) حتى إن عمار بن ياسر كان ينادي: «والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل».
ونتيجة لذلك انهار عسكر معاوية، وأوشك جيش العراق أن يحتل مضارب معاوية ويقبض عليه حياً حتى إنه دعا بفرسه لينجو، فتذكر مستشاره عمرو ابن العاص، فلجأ إليه لينقذه من هذه الورطة فأشار عليه برفع المصاحف على أسنة الرماح فكان ما أراد وارتفعت الأصوات من ناحية عسكر معاوية:
«يا أهل العراق، هذا كتاب الله بيننا وبينكم فهلموا إلى العمل به».
فانطلت الحيلة على ضعاف النفوس والخونة المنبثين في جيش علي(ع) ، وضموا أصواتهم إلى أصوات أصحاب معاوية لمنع علي(ع) وأصحابه المخلصين من الاستمرار في القتال والقضاء على رأس الفتنة.
حتى إنه جاء الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين(ع) قائلاً له: «إن لم تحكم، قتلناك بهذه السيوف التي قتلنا بها عثمان».
فقال(ع) حينئذ: «لا رأي لمن لا يطاع»، وقال لأصحابه: «هذه كلمة حق يراد بها باطل، وهذا كتاب الله الصامت وأنا المعبِّر عنه، فخذوا بكتاب الله الناطق وذروا الحكم بكتاب الله الصامت إذ لا معبّر عنه غيري»([7]).
ولما لم يرجع أصحابه إلى رأيه الذي تقدم ذكره، حتى إن نحواً من عشرين ألف مقاتل أحاطوا به مقنعين بالحديد وهم يقولون مهدّدين: «أجب القوم وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان».
وإزاء هذا الوضع الخطير، لم يجد أمير المؤمنين(ع) أمامه إلا خيارين أحلاهما مر:
إما المضي بالقتال، وهذا يعني أنه سيقاتل ثلاثة أرباع جيشه وأهل الشام بأجمعهم.
وإما القبول بالتحكيم وهو أهون الشرين، فاختاره على مضض.
التحكيم
ولم تكن مرحلة التحكيم بأيسر من مرحلة القتال على أمير المؤمنين(ع). فبعد أن اجتمعت كلمة أهل الشام على اختيار عمرو بن العاص كمندوب لهم للتفاوض، اختلف أهل العراق مع علي(ع) على اختيار مندوب لهم.
فقد كان رأيه (ع) وعدة من أصحابه اختيار أحد الثلاثة عبد الله بن عباس، أو مالك الأشتر، أو الأحنف بن قيس، وكانوا من أفضل المرشحين.
ولكن الكثرة الغالبة من ضعاف النفوس التي انطلت عليهم خديعة رفع المصاحف، رفضوا هؤلاء الثلاثة ورشحوا أبا موسى الأشعري، الذي رفض الإمام (ع) ترشيحه لانحرافه عنه.
ولكنهم ضغطوا على الإمام (ع) فخشي الإمام أن تدبّ الفتنة مرة أخرى في صفوف جيشه فاضطرّ لقبول مرشحهم، فكانت النتيجة بلا ريب لغير صالحه.
وعند اجتماع الطرفين للاتفاق على بنود التحكيم ظهرت نوايا معاوية المبيتة، عندما رفض إدراج صفة أمير المؤمنين خلف اسم الإمام (ع) حيث جاء في الكتب المعتبرة أنهم حينما شرعوا في كتابة بنود الاتفاق كتب الكاتب: هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان.
فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه، ولا تسمّه بإمرة المؤمنين، فإنما هذا أمير هؤلاء وليس بأميرنا، فقال له الأحنف بن قيس: لا تمح هذا الاسم، فإني أتخوّف إن محوته لا يرجع إليك أبداً.
فامتنع أمير المؤمنين(ع) من محوه فتراجع الخطاب فيه ملياً من النهار، فقال الأشعث بن قيس: امح هذا الاسم...
فقال أمير المؤمنين(ع):
«الله أكبـر سنة بسنة ومثل بمثل والله إني لكاتب رسول الله(ص) يوم الحديبية وقد أملى علي: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فقال له سهيل: امحُ رسول الله، فإنا لا نقر لك بذلك، ولا نشهد لك بذلك، اكتب اسمك واسم أبيك، فامتنعت من محوه»، فقال النبي(ص) : «امحه يا علي، وستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض..».
وتمّ الكتاب بين الطرفين ووقّعه من كل منهما عشرة من قادتهم ووجهائهم، ويتلخص مضمونه بأن يقفوا عند أحكام الله ويرجعوا إلى حكم الكتاب فيما يختلفون فيه، وإلى سنّة رسول الله(ص) فيما لم يجدوا حكمه في الكتاب، والتزم علي ومعاوية ومن يتبعهما من المؤمنين والمسلمين بما يحكم به الحكمان، وأن يجتمع الحكمان في مكان بين الشام والحجاز يدعى (دومة الجندل)، وأن لا يحضر معهما إلاّ من أرادوه، وأن يعمل الطرفان على توفير الجو المناسب لهما خلال اجتماعهما وفيما بعده.
ومن الغريب أنه لم يرد في نص الوثيقة أي ذكر لأسباب الصراع وموضوعه الحقيقي من قريب أو بعيد، في حين أن أسباب الصراع واضحة لأن معاوية كان قبل معركة الجمل يطالب بمحاكمة أولئك الذين قتلوا عثمان أو تسليمهم إليه ليتولّى القصاص منهم، وبعد تمرّد السيدة عائشة وطلحة والزبير تعزّز موقفه وأصبح يطالب بإعادة الخلافة شورى بين المسلمين على أن يكون له رأي في ذلك.
وقد ردّ علي(ع) على طلبه الأول بأن يدخل فيما دخل فيه المسلمون ثم يحاكم القوم إليه ليقتصَّ لعثمان من قاتليه إذا أدينوا بجريمة توجب القصاص، وردّ (ع) على طلبه الثاني، بأنّ خلافته قد تمّت بإجماع أهل الحرمين الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة من قبله، بل بايعه جميع الأمصار ما عدا الشام.
وتشير بعض الروايات إلى أن إقصاء أمير المؤمنين عن الخلافة كان أمراً مفروغاً منه لدى الطرفين، ولكن الخلاف كان على البديل، فقد اقترح أبو موسى الأشعري عبد الله بن عمر بن الخطاب، فردّ عليه ابن العاص بأن عثمان بن عفان قتل مظلوماً ومعاوية وليه.
ولم يُبدِ أبو موسى أية ملاحظة حول هذه الناحية، ومضى ابن العاص يغريه بالسلطة إن هو وافق معه على أن تكون الخلافة لمعاوية.
وبعد حوار طويل بين الطرفين استطاع ابن العاص أن يخدعه فأظهر له موافقته على إقصائهما معاً وترك الأمر للمسلمين يختارون لأنفسهم من يريدون، وكان ما أراده ابن العاص فخلع أبو موسى علياً وأثبت ابن العاص معاوية.
وانتهت مهزلة التحكيم على هذا النحو كما يرويها المؤرخون. وهي نتيجة مفروغ منها بعد أن رفض كل اقتراحات الإمام (ع) ومناشداته، من قبل الكثرة التي غلب عليها الشيطان فأضل أعمالهم.
وقد نصَّت المرويات على أنه أقام في صفين بعد إعلان الهدنة وكتابة بنود الاتفاق يومين أو ثلاثة مشغولاً بتهدئة الخواطر والنفوس، ودفن القتلى من أصحابه، ثم خرج بعدها متوجهاً إلى الكوفة ليواجه مشاكل جديدة.
([1]) سورة الأعراف: الآية 157.
([2]) مكارم الأخلاق: 250 الطبرسي.
شهادة الإمام علي بن الحسين (ع) (25/ محرم / السنة 95 هـ)
الإمام علي بن الحسين(ع) ، الملقّب بزين العابدين والسجاد، هو الإمام الرابع من الأئمة الاثني عشر المعصومين من عترة النبي محمد(ص).
هو الإمام الزاهد العابد زين العابدين وسيد الساجدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه شاه زنان بنت يزدجرد، وقيل شهربانو، وقيل شهربانويه بنت كسرى، وقيل: اسمها غزالة… إلى غير ذلك مما ورد في أسمائها.
وروي عنه أنه كان يقول: أنا ابن الخيرتين([1]).
وقال الشاعر في مدحه (ع):
|
وإنّ وليداً بين كسرى وهاشم |
|
لأكرم من نيطت عليه التمائم |
كان مولده (ع) بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة، فقضى مع جده أمير المؤمنين سنتين، ومع عمه الحسن اثني عشرة سنة، ومع أبيه ثلاثاً وعشرين سنة، وبعد أبيه أربعاً وثلاثين سنة، وقيل أربعين سنة([2]).
لقد كانت فاجعة مقتل أبيه واخوته وبني عمومته التي شاهدها أمام عينيه في واقعة الطف وتجرّع مرارتها، وهو مريض يعاني من وطأة المرض خلال أحداث الطف الفظيعة، تنغّص عليه حياته كلها فتلك الصور لم تفارق مخيلته، ومع هذا نهض بمهام الإمامة ونشر الأحكام والأخلاق وتفقد الفقراء والمساكين، وكان (ع) رأس مدرسة الفقه والحديث التي كانت تضم الموالي والتابعين.
وقد أحصى الطوسي في (رجاله)، أكثر من مائة وستين من التابعين والموالي ممن كان ينهل منه، ويروون عنه في مختلف المواضيع، وعدَّ منهم سعيد بن المسيب وابن جبير، وجبير بن مطعم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وجابر بن عبد الله الأنصاري، ويحيى بن أم الطويل، وأمثال هذه الطبقة من أعلام التابعين.
وجاء في (طبقات ابن سعد): أن علي بن الحسين(ع) كان ثقة مؤموناً كثير الحديث عالياً رفيعاً ورعاً.
وقال المبرِّد في (الكامل): أن سعيد بن المسيب سئل عن السجاد، فقال: هذا الذي لا يسع مسلماً أن يجهله..
وقال الراغب الأصفهاني في (محاضراته)، وابن الجوزي في (مناقبه): أن عمر بن عبد العزيز قال وقد قام علي بن الحسين(ع) من مجلسه: من أشرف الناس؟
قال المتزلفون ممن حضر عنده: أنت يا أمير المؤمنين.
فقال عمر بن عبد العزيز: كلا، أشرف الناس هو علي بن الحسين(ع) ، ذلك الذي من أحب الناس أن يكونوا منه، ولم يحب أن يكون من أحد.
وروى الشيخ الصدوق في كتابه (العلل) بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه قال: قلت لمحمد بن شهاب الزهري: لقيتَ علي بن الحسين؟
قال: نعم لقيته وما لقيت أحداً أفضل منه، والله وما علمت له صديقاً في السر ولا عدواً في العلانية، فقيل له: وكيف ذلك؟
فقال: لأني لم أر أحداً وإن كان يحبه إلا وهو لشدة معرفته بفضله يحسده، ولا رأيت أحداً، وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراته له يداريه.
وقال المفيد في (ارشاده): ثبتت الإمامة للسجاد من وجوه:
«أحدهما أنه كان أفضل خلق الله بعد أبيه علماً وعملاً، والإمامة للأفضل دون المفضول بدلائل العقول.
ومنها: أنه كان أولى بأبيه الحسين(ع) .
ومنها: وجوب الإمامة عقلاً في كل زمان.
ومنها: ثبوت الإمامة في العترة خاصة.
ومنها: نص رسول الله(ص) بالإمامة عليه، فيما روى من حديث اللوح([3])، الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي(ص)، ورواه محمد بن علي الباقر(ع) ، ونص جده أمير المؤمنين عليه، ووصية أبيه الحسين(ع) إليه، وإيداعه أم سلمةما قبضه عليّ من بعده»([4]).
وذكر المفيد في (إرشاده) القصيدة المشهورة التي مدح فيها السجاد من قبل الشاعر المعروف الفرزدق، بعد أن رأى أن هشام بن عبد الملك يظهر له تجاهلاً([5]) وهو يرى تداعي الناس سماطين لهيبة الإمام وهو يسعى لاستلام الحجر الأسود في ركن الكعبة:
|
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته |
|
والبيت يعرفه والحلُّ والحرمُ |
«وكانت وفاته (ع) في يوم السبت الخامس والعشرين من محرم كما هو المشهور وقيل الثامن عشر من شهر محرم الحرام، وقيل في الثاني والعشرين منه، وأما السنة، فقيل: سنة اثنتين وتسعين، وقيل: أربع وتسعين، وقيل: خمس وتسعين.
وعمره الشريف سبع وخمسون سنة كأبيه (ع) ، وقيل تسع وخمسون وأربعة أشهر وأيام، وقيل: أربع وخمسون، وقيل: ثمان وخمسون، وقيل إنه مات في ملك هشام بن عبد الملك وأنه هو الذي سمّه، ودفن مع عمه الحسن في مقبرة البقيع»([6]).
الإمام السجاد(ع) والدعاء:
تمتد الأدعية بأنواعها وأساليبها المختلفة للتناسب مع جميع شؤون الإنسان وأبعاده، فهي تستنزل دموع حيائنا في لحظات الإنابة إلى الله الغفور الرحيم، وتجسّد تضرعنا إليه، وترفع أيدينا الملتمسة إلى مالك الوجود، ونعفّر جباهنا بالتراب استكانة له، وتبصرنا عجزنا وضعفنا وفقرنا وذلتنا تجاهه جلت عظمته، وتكشف لنا قدرته المطلقة، وحكمته البالغة ورحمته الواسعة.
فالصحيفة السجادية، ودعاء كميل، ودعاء عرفة، ودعاء أبي حمزة الثمالي، ودعاء مكارم الأخلاق، ورسالة الحقوق، هي تجليات من بحار هذه الأنوار.
فهذا الإمام السجاد(ع) في دروسه الرائعة التي بثّها في الدعاء التي تتضمنه صحيفته، أنها مناهج قويمة تصلح البشر في سرّهم وعلانيتهم، وفي سكونهم وحركاتهم، في أبطى البواطن من ميولهم وعواطفهم وخلجاتهم وانفعالاتهم، وفي أظهر الظواهر من أخلاقهم ومظاهرهم وأعمالهم وأقوالهم.
ففي الصحيفة ورسالة الحقوق ركائز تربوية ومناهج تثقيفية وطرق تعليمية.
إنّ أدعية الإمام السجاد(ع) ورسالة الحقوق، تحمل رسالة جليلة قويمة تجري مع الفطرة في بساطتها ومع البرهان في قوته ومع حقائق الكون في ثباتها واضطرادها.
أجل.. ماذا تمثل هذه الصحيفة الشريفة بالنسبة للمسلمين؟ وماذا تقدم لهم من إضاءات في طريق الهداية والرشاد؟
إنّ هذه الصحيفة هي من إنشاء وإملاء إمام العارفين وسيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين(ع) ، وتعد هذه الشخصية الإسلامية الكبرى واحدة من بين أشهر وأهمّ شخصيات الإسلام الذين حملوا لواء الدعوة والتبليغ وعانوا آلام الطريق الصعب وعاشوا هموم الرسالة، فكانت أيامهم كلها لله، وحياتهم في خدمة الدين المبارك، ووظفوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم وما يملكون من مواهب واستعدادات، لغرض هداية الناس ودعوتهم إلى الالتزام بمبادئ الرسالة الحقة من أجل إسعادهم في ظل ما ينتجه الالتزام والاهتداء بذلك من عدل وإنصاف وأمان وسعادة.
عرض موجز لرسالة الحقوق:
ترجع أهم حقوق الإنسان العامة إلى حقين هما: المساواة والحرية، وقد ادعت الأمم الغربية، أنّ العالم الإنساني مدين لها بتقرير هذين الحقين.
والحق أن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صوره وأوسع نطاق. وأن الأمم الإسلامية في عهد الرسول(ص) والخلفاء من بعده كانت أسبق الأمم في السير عليها.
فهذه رسالة الحقوق، القانون الخالد، الذي أوصى به الإمام زين العابدين(ع) تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة ومن حقائق الوجود والإنسانية.
فلنمرّ مروراً سريعاً، على رسالة الحقوق للإمام زين العابدين(ع) بديباجتها النظرية البليغة التي لم تفصل بين السماء والأرض كما تفعل إعلانات حقوق الإنسان العالمية اليوم، بل راحت تؤكّد على تغيير المحتوى الداخلي للإنسان الذي به ومنه تنطلق إرادات التغيير نحو عالم أفضل وأكمل.
يقول الإمام زين العابدين(ع) في ديباجته لرسالة الحقوق هذه:
«اعلم رحمك الله، إن لله عليك حقوقاً محيطة بك، في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، وآلة تصرفت بها، بعضها أكبـر من بعض. وأكبـر حقوق الله عليك، ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق، ومنه تفرع، ثم أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك، على اختلاف جوارحك، فجعل لبصرك عليك حقاً، ولسمعك عليك حقاً، وللسانك عليك حقاً، وليدك عليك حقاً، ولرجلك عليك حقاً، ولبطنك عليك حقاً، ولفرجك عليك حقاً، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال.
ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقاً، فجعل لصلاتك عليك حقاً، ولصومك عليك حقاً، ولصدقتك عليك حقاً، ولهديك عليك حقاً، ولأفعالك عليك حقاً، ثم تخرج الحقوق منك، إلى غير ذلك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، وأوجبها عليك حقاً أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك، فهذه حقوق يتشعب منها حقوق، فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك: حق سائسك بالسلطان ثم سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بالملك، وكل سائس أمام، وحقوق رعيتك ثلاثة: أوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان، ثم حق رعيتك بالعلم، فإن الجاهل رعية العالم، وحق رعيتك بالملك من الأزواج، وما ملكت من الإيمان، وحقوق رحمك متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة، فأوجبها عليك حق أمك، ثم حق أبيك، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك ثم الأقرب فالأقرب، والأول فالأول.
ثم حق مولاك، المنعم عليك، ثم حق مولاك الجاري نعمته عليك، ثم حق ذوي المعروف لديك، ثم حق مؤذنك بالصلاة، ثم حق إمامك في صلاتك، ثم حق جليسك ثم حق جارك، ثم حق صاحبك، ثم حق شريكك، ثم حق مالك، ثم حق غريمك الذي تطالبه، ثم حق غريمك الذي يطالبك، ثم حق خليطك، ثم حق خصمك المدعي عليك، ثم حق خصمك الذي تدعي عليه، ثم حق مستشيرك، ثم حق المشير عليك، ثم حق مستنصحك ثم حق الناصح لك، ثم حق من هو أكبـر منك، ثم حق من هو أصغر منك، ثم حق سائلك، ثم حق من سألته، ثم حق من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل أو مسرة بذلك بقول أو فعل، عن تعمد منه أو غير تعمد منه، ثم حق أهل ملتك عامة، ثم حق أهل الذمة، ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال، وتصرف الأسباب.
فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه، ووفقه وسدده...»([7]).
لقد احتوت هذه الفقرات المشرقة من كلام الإمام (ع) على عرض موجز للحقوق الأصيلة التي قنّنها (ع) للإنسان المسلم.
شهادته:
لقد كان وجود الإمام مقلقاً لحكومة الوليد بن عبد الملك، خصوصاً ما يراه من إقبال الناس، بل اندفاعهم إليه، مما أدى إلى أن يوسوس له شيطانه فدسّ إليه السم فقضى شهيداً محتسباً صابراً في 25 محرم سنة 95 للهجرة.
فسلام على الإمام زين العابدين يوم ولد، سلام عليه يوم أدى رسالته، وسلام عليه يوم استشهد، وسلام عليه يوم يبعث حياً.
([3]) الإرشاد للمفيد 2: 138- 139.
([4]) المصدر السابق، وكذلك إكمال الدين: 311، وعيون أخبار الرضا(ع) 1: 40، وغيبة النعماني: 62، وأمالي الطوسي 1: 297، وغيبة الطوسي: 143، والكافي 1: 242.
([7]) نقلاً من كتاب (الصحيفة السجادية الكاملة)، تقديم الأستاذ علي أنصاريان، ط المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية بدمشق، سورية، 1419هـ.
خروج السبايا من الكوفة إلى الشام (19/ محرم / السنة 61 هـ)
بعث ابن زياد رسولاً إلى يزيد يخبره بقتل الحسين ومن معه، وأن عياله في الكوفة، وهو ينتظر أمره فيه. فعاد الجواب بحملهم والرؤوس معهم([1]).
وكتب رقعة ربط فيها حجراً ورماه في السجن المحبوس فيه آل محمد(ص) وفيها: «خرج البريد إلى يزيد يأمركم في يوم كذا ويعود في يوم كذا، فإذا سمعتم التكبير فأوصوا، وإلا فهو الأمان».
ورجع البريد من الشام يخبر بأن يسرّح آل الحسين إلى الشام([2]). فأمر ابن زياد زجر بن قيس، وأبا بردة بن عوف الأزدي، وطارق بن ضبيان، في جماعة من الكوفة أن يحملوا رأس الحسين ورؤوس من قتل معه إلى يزيد([3]). وهناك قول بأنّ الذي ذهب برأس الحسين(ع) هو يجبرة بن مرة بن خالد بن قتاب بن عمر بن قيس بن الحرث بن مالك بن عبيد الله بن خزيمة بن لؤي([4]).
ثم سرح ابن زياد الإمام السجاد(ع) مغلولة يديه إلى عنقه وعياله معه على حال تقشعرّ منها الأبدان([5])، وقال اليافعي: «سيقت بنات الحسين بن علي ومعهم زين العابدين وهو مريض كما تساق الأسرى، قاتل الله فاعل ذلكR، وخالف ابن تيمية ضرورة التاريخ فقال (كما في المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي 288): Sسير ابن زياد حرم الحسين بعد قتله إلى المدينة»([6]).
وكان مع السبايا شمر بن ذي الجوشن، ومجفر بن ثعلبة العائدي، وشبث بن ربعي، وعمر بن الحجاج، وجماعة وأمرهم أن يلحقوا بركب الرؤوس، وليشهروها في كل بلد يأتونها([7])، فجدّوا السير حتى لحقوا بهم في بعض المنازل.
وحدث ابن ميعة أنه رأى رجلاً متعلّقاً بأستار الكعبة يستغيث بربه، ثم يقول: ولا أراك فاعلاً!
فأخذته ناحية وقلت: إنك لمجنون، فإنّ الله غفور رحيم، ولو كانت ذنوبك عدد القطر لغفرها لك، قال لي: اعلم كنت ممن سار برأس الحسين(ع) إلى الشام، فإذا أمسينا وضعنا الرأس وشربنا حوله.
وفي ليلة كنت أحرسه وأصحابي رقود، فرأيت برقاً وخلقاً أطافوا بالرأس، ففزعت وأدهشت ولزمت السكوت، فسمعت بكاءاً وعويلاً وقائلاً يقول: يا محمد إن الله أمرني أن أطيعك، فلو أمرتني أن أزلزل بهؤلاء الأرض كما فعلت بقوم لوط، فقال له: يا جبرائيل إن لي موقفاً معهم يوم القيامة بين يدي ربي سبحانه، فصحت يا رسول الله الأمان.. فقال لي: «اذهب فلا غفر الله لك، فهل ترى الله يغفر لي؟»([8]).