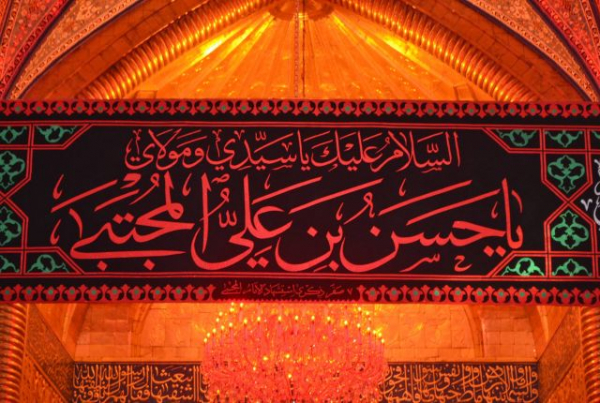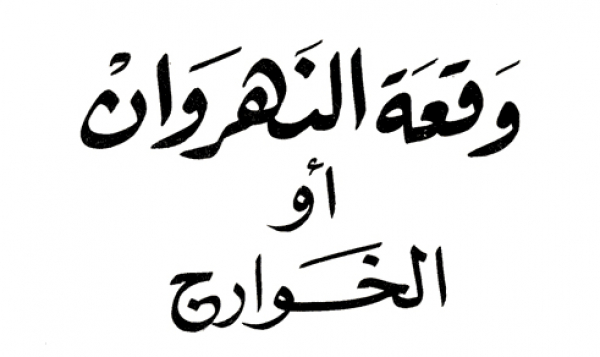Super User
هجرة النبي (ص) إلى المدينة المنورة(1 ربيع الأول/ السنة 13 للبعثة)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية نبينا محمد(ص)، وعلى الأقمار المضيئة الأئمة الطاهرين(عليهم السلام).
مع إطلالة شهر ربيع الأول ربيع الشهور، لما ظهر فيه من آثار الرحمة الإلهية حيث نزل فيه من ذخائر بركاته وأنوار جماله على الأرض، حيث اتفق فيه ميلاد الرسول الأعظم (ص) على المشهور بين الإمامية وذلك في اليوم السابع عشر منه، وهجرته (ص) المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في اليوم الثاني عشر منه والتي أصبحت مبدءاً للتاريخ الإسلامي.
وفي التاريخ المذكور على رواية بعض علمائنا ورواية إخواننا علماء أهل السنة كانت ولادة الرسول الأعظم (ص) في الثاني عشر من سنة عام الفيل، ولذا فقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما بين التاريخين المذكورين أعلاه أسبوعاً للوحدة بين المسلمين، وفيه يحتفل جميع المسلمين بهذه المناسبة الميمونة، ومضت إيران على نهج إمامها الراحل واستمرت بقيادة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي تسعى إلى إيجاد روابط التوحيد بين المسلمين والوقوف في وجه عدوهم المشترك الاستكبار العالمي المتمثّل اليوم بأمريكا والكيان الغاصب لفلسطين، وورد البحث عن هذا الموضوع مفصلاً في بحث المناسبات، ونكتفي هنا بالإشارة عنه فقط، فراجع هناك.
وليس بالأمر الغريب أن يلتقي ميلاد رسول الإسلام الجدّ محمد(ص) بميلاد مجدّد الإسلام الحفيد الصادق(ع) ، فمن مدرسة الصادق(ع) الكبرى وتلاميذه كانت رحلة الحق والعلم والفضيلة.
ونحن نقدم بين يديك أيها القارئ الكريم هذه السلسلة من المناسبات التي تبحث في أهم الأحداث والوقائع التي جرت في هذا الشهر بدءاً من خروج النبي(ص) إلى المدينة، ومروراً بشهادة الإمام العسكري(ع) ، وزواج السيدة خديجة الكبرى، وبناء أول مسجد في الإسلام، وانتهاءاً بمعاهدة الصلح المشهور بين الإمام الحسن(ع) ومعاوية، وإلى غيرها من المناسبات.
ومع هذه الوقائع المهمّة نقف خاشعين نحني الرؤوس أمام تلك الرحمة المحمدية والسواعد الجعفرية لنبي الإسلام ومجدّده، ولنوجّه التهنئة بميلاده الميمون لجميع المسلمين، ولنلقي إليهم تحايا القلب والروح.
وتأكيداً للأهمية التي نوليها للأحداث والوقائع الإسلامية التي جرت في هذا الشهر ومساهمة منا في الدعوة إلى القراء الكرام للاستفادة أكثر وأكثر من هذه البحوث من سلسلة المناسبات الإسلامية، ندعو الجميع أن يتخذوا من شهر ربيع الأول شهراً للوحدة والتآخي والمحبّة.
وفّق الله الجميع لإحياء هذه المناسبات لما فيه الخير والصلاح للأمة الإسلامية جمعاء، والقيام بإحياء هذا الشهر العظيم من الأعمال العبادية وفهم معانيها والعمل بمقتضاها.
والله من وراء القصد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هجرة النبي (ص) إلى المدينة المنورة(1 ربيع الأول/ السنة 13 للبعثة)
قال الله تعالى: (إِلاّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنّ اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ بِجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُواْ السّفْلَىَ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)([1]).
كان النبي(ص) يعيش في مكة بمنعة عمه أبي طالب، وكانت لا تجترئ عليه قريش، ولا يمكنهم النيل منه ما دام أبو طالب إلى جانبه، وخوفاً من سيوف بني هاشم، غير أنه بعد رحيل أبي طالب فقد النبي(ص) ناصره ومعينه، وانكشف أمام قريش، فبدأت بحياكة المؤامرات لاغتياله، وبدأ بذلك النبي(ص) مرحلة جديدة في مواجهة قريش، وهي الخروج من مكة ليدعو إلى دينه بمعزل عن أولئك الذين كابدوه وعاندوه وأحاطوا به الدوائر، فاختار الرحيل إلى الطائف علّه يجد مناصراً لدينه في بني ثقيف، غير أنهم قابلوه بأن سلطوا عليه صبيانهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة والأشواك وغيرها، فأيس(ص) منهم وأقفل عائداً إلى مكة يترقّب مواسم الحج والعمرة ليلتقي بالقوافل فيعرض دينه عليها، لعلّه يجد من يدعو لنشره في بلادهم بعيداً عن مكة حيث لا أبو جهل ولا أبو سفيان ولا غيرهما من صناديد الشرك وفراعنته.
وبينما كان النبي(ص) ذات يوم جالساً في حِجر إسماعيل يذكر ربه ويناجيه؛ إذ مرّ به أسعد بن زرارة، وكان قد قدم من يثرب يطلب من قريش مؤازرته وقومه على الأوس، فتقدم من النبي(ص) فقال له: إلى ما تدعو يا محمد؟!! فقال (ص) : إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأني رسول الله، وأدعوكم إلى Sألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ([2])...
فلما سمع أسعد ذلك أسلم، وقال: بأبي أنت وأمي أنا من أهل يثرب من الخزرج، وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة، فإن وصلها الله بك فلا أحد أعزّ منك، والله يا رسول الله لقد كنّا نسمع من اليهود، خبرك، وكانوا يبشّروننا بخروجك، ويخبروننا بصفتك، وأرجو أن نكون دار هجرتك وعندنا مقامك، فقد أعلمنا اليهود ذلك، فالحمد لله الذي ساقنا إليك، والله ما جئت إلاّ لأطلب الحلف على قومنا، وقد أتانا الله بأفضل مما أتيتُ له، ثم رجع إلى المدينة وأخبر بأمر النبي(ص) ، وشاع خبره فيها، ودخل في الإسلام عدد كبير([3])، حتى إذا كان في العام المقبل وافى الموسم من أهل يثرب اثنا عشر رجلاً، فلقوه بالعقبة وبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف، وإنهم إن وفوا بذلك كان لهم الجنة، وإن غشوا في ذلك شيئاً، فأمرهم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر.
وقد طلبوا من رسول الله(ص) أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن وأحكام الإسلام، ويفقههم في الدين، فأرسل معهم مصعب بن عمير([4]).
وكان مصعب حريصاً جداً على الدعوة إلى الإسلام، وعلى انتشاره في المدينة، فكان يدعو إلى الإسلام، ويعلّم من أسلم القرآن وأحكام الإسلام، حتى دخل في الإسلام خلق كثير، وفي العام المقبل أقبل مصعب في موسم الحج مع وفود المدينة تدعو رسول الله(ص) ليهاجر إليهم، وبايعوه على النصرة، وعلى أن يمنعوه ما يمنعوا منه أولادهم وأهليهم، فقبل النبي(ص) الهجرة إليهم([5]).
وبعد ذلك أخذ النبي(ص) يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فأخذ الرجل والرجلان والثلاثة، يركبون سواد الليل مهاجرين إلى المدينة، وكان ينتظر رسول الله(ص) الأمر الإلهي في هجرته.
قريش تتآمر لقتل النبي (ص):
لما علمت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى يثرب، وقد دخل أهلها الإسلام، قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق. فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله(ص) في ليلة معينة، وكانوا قد انتخبوا من كل قبيلة فارساً حتى بلغ عددهم خمسة عشر رجلاً ينتظرون خروج النبي(ص) لصلاة الصبح فيغيرون عليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين العرب، ولا تطلب بنو هاشم بثأره فيقبلون بالدية، ويروى أن من دبر لهم هذه الحيلة إبليس الذي اجتمع معهم في دار الندوة بصفة رجل نجدي([6]).
وأمره الله أن يأمر علياً(ع) بالمبيت في فراشه، فخرج النبي(ص) في فحمة العشاء والرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون، وقد قرأ عليهم قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ)([7])، وأخذ بيده قبضة من تراب فرمى بها على رؤوسهم، ومرّ من بينهم، فما شعروا به، وأخذ طريقه إلى غار ثور([8]).
أدركت قريش الأمر، فركبوا في طلب النبي(ص) ، واقتفوا أثره، حتى وصل القافي إلى نقطة لحوق أبي بكر به، فأخبرهم أن من يطلبونه صار معه رجل آخر، فاستمروا يقتفون الأثر حتى وصلوا إلى باب الغار، فصرفهم الله عنه، حيث كانت العنكبوت قد نسجت على باب الغار وباضت في مدخله حمامة وحشية، فاستدلوا من ذلك على أن الغار مهجور ولم يدخله أحد، وإلا لتخرق النسج، وتكسّر البيض، ولم تستقر الحمامة الوحشية على بابه([9]).
ولما أمن النبي(ص) الطلب خرج من غار ثور متوجهاً وصاحبه إلى يثرب.
فوائد وغايات:
ولهذه الحادثة العظيمة الأثر البليغ في حياتنا، وينبغي أن نقتبس منها الدروس والعبر، ويمكن تلخيصها بما يلي:
الفائدة الأولى: أن العلاقة مع الدين والمبادئ الإلهية ليست علاقة مرهونة بمعايير الظروف والحالات، فإذا كان الإنسان يعيش في رخاء وطد علاقته مع دينه ومبادئه، فإذا ضُيّق عليه، وحورب كان هذا عذراً له في التنازل عما يؤمن به ويعتقد بمبدئيته، بل يجب أن يكون الارتباط مع الدين ارتباطاً أصيلاً يذلل من أجله كل الصعوبات، ويتحمل في سبيله كل الأخطار إلى أن يفتح الله عليه، ويعلي كلمته التي وعد الله تعالى بإعلائها، ولو استلزم الفرار بدينه من بلده، والخروج من ماله، والهجرة إلى بلد آخر، ولذا فلا يعذر يوم القيامة من يتخلى عن دينه نتيجة ما يجده من صعوبة وعناء في ممارسته في وطنه، قال تعالى: (إِنّ الّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِيَ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً)([10]).
وقال تعالى: (مَا لَكُمْ مّن وَلاَيَتِهِم مّن شَيْءٍ حَتّىَ يُهَاجِرُواْ)([11]).
الفائدة الثانية: أن على المبلغ لرسالات الله الثقة الكبيرة بالله تعالى في أن ينصره ويوفقه، ويحرسه بعينه رغم كل الصعاب، وعليه دائماً أن يتأمل في شدة ارتباط النبي(ص) بربه، وفي قوله لصاحبه في الغار: «لا تحزن إن الله معنا»، فعليه دائماً أن يستشعر معية الله تعالى وهدايته وتسديده، وأن الله وعد الصادقين والصابرين والمجاهدين في سبيله بالكفاية والنصر والهداية، قال تعالى: (أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ)([12])، وقال: (وَالّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنَا)([13]).
وقد نهج المسلمون - كسائر الأمم - أن يؤرخوا الحوادث والأيام وما في ذلك من مناسبات مهمة تشكّل الجزء الأكبر من حضارة المسلمين، فعمدوا إلى الهجرة المباركة للرسول الأعظم(ص) من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، في السنة الثالثة عشر من البعثة فجعلوها مبدءاً للتاريخ.
فإذا بنى هذا التاريخ وحسب على دوران القمر على الأرض يسمى التاريخ الهجري القمري وإذا بنى وحسب على دوران الأرض على الشمس يسمى التاريخ الهجري الشمسي.
([2]) السيرة النبوية لابن هشام 2: 235.
([3]) البداية والنهاية 3: 158.
([4]) البداية والنهاية 3: 158، وتاريخ اليعقوبي 2: 37- 38، وتاريخ الخميس 1: 321.
([5]) البداية والنهاية 3: 158، وتاريخ اليعقوبي 2: 37- 38، وتاريخ الخميس 1: 321.
([9]) تاريخ الخميس 1: 328، والبداية والنهاية 3: 181– 182.
واقعة الحرة([1]) (28/صفر/السنة 63 هـ)
وهي حادثة مشهورة وقعت في عام 63 هجرية، استباح فيها يزيد بن معاوية مدينة الرسول (ص) ، والواقعة حدثت في حرّة واقم، وهي الحرّة الشرقية من المدينة وهي: «أطم من آطام المدينة تنسب إليه الحرّة»([2])، وكانت أول واقعة يتمرّد فيها أهل المدينة على حكومة يزيد بن معاوية بعد واقعة الطف، استنكاراً لمقتل الحسين بن علي(ع) ورفضاً للسيادة الأموية على مقدّرات المسلمين، وانتهت الواقعة بسيطرة جيش الشام واستباحته المدينة ثلاثة أيام فكثر القتل والنهب والسلب والاعتداء على الأعراض، خلافاً لتحذيرات رسول الله(ص) المتكررة من الاعتداء على أهل المدينة.
قال (ص) : «من أخاف أهل المدينة أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»([3])، ولما مرّ رسول الله(ص) بالحرّة وقف فاسترجع وقال: «يُقتل في هذه الحرة خيار أمتي»([4]).
العوامل والأسباب القريبة للواقعة:
كان لمعاوية سياسة خاصة تختلف عن سياسة ابنه يزيد، فكان يستخدم الشدّة مع اللين في سياسته مع أهل المدينة، كما وكان مدارياً للأنصار بأساليب عديدة من إغراء وخداع وترغيب وإذا لم تنفع هذه فيأتي دور الترهيب، فأبقى أحقادهم وكراهيتهم لحكمه في نطاق المعارضة السلمية، ولم تظهر منه موبقات كالتي ظهرت في عهد يزيد، فتحولت المعارضة السلمية الى معارضة مسلحة أفرزتها الممارسات السلبية التي ارتكبها يزيد في سنوات حكمه القليلة منها:
أولاً: نشر الفسق والفجور والفساد.
اشتهر يزيد بولعه بالمعازف وشرب الخمر والغناء واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب، والنطاح بين الكباش والدباب والقرود، وما من يوم إلاّ ويصبح فيه مخموراً، وكان يشدّ القرد على مسرجة ويسوق به ويلبسه قلانس الذهب([5]).
«كما كان فاسقاً قليل الدين مدمن الخمر.. وله أشياء كثيرة غير ذلك غير أنني أضربت عنها لشهرة فسقه ومعرفة الناس بأحواله»([6])، وانتقل الفسق والانحراف من يزيد الى كثير من ولاته، ولم ينحصر ذلك بين الحاكم وولاته بل عملوا على: «تشجيع حياة المجون في المدينة من جانب الأمويين الى حد الإباحية.. لأجل أن يمسحوا عاصمتي الدين (مكة والمدينة) بمسحة لا تليق بهما ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينية»([7]).
فوجد أهل المدينة أن الإسلام بدأ ينحسر عن التأثير وتنطمس معامله وأسسه التي شيدها رسول الله(ص) والتي شيدوها بمؤازرته ومناصرته، وإن الجاهلية عادت من جديد ودبّ الانحراف واستشرى في عاصمة الإسلام مصحوباً بإلغاء دور المدينة في سير الأحداث وإصلاح الأوضاع الطارئة، فلم يبق لهم إزاء هذه التطورات الخطيرة إلا التخطيط لإعادة الأمور الى مجاريها التي أرادها رسول الله(ص) فأعدّوا العدّة لاسترجاع مكانة المدينة، واسترجاع المفاهيم والقيم الإسلامية الى ما كانت عليه قبل حكم الأمويين بتحكيم الإسلام وتقرير مبادئه في العقول والقلوب والمواقف، وتأجّل الموقف الثوري الى وقته وظرفه المناسب.
ثانياً: مقتل الإمام الحسين(ع) وأهل بيته.
كان مقتل الإمام الحسين(ع) وأهل بيته وخيرة الصحابة والتابعين معه ذا أثر كبير على نفوس أهل المدينة؛ لأن الإمام الحسين(ع) يمثل القيادة الحقيقية للمسلمين، والأمل المنشود في إعادة الإسلام الى ما كان عليه في عهد رسول الله(ص) مضافاً الى الحب والتكريم الذي يكنّه أهل المدينة له باعتباره ابن بنت رسول الله(ص) وابن أمير المؤمنين علي(ع) الذي وقف أهل المدينة معه في جميع أدوار مسيرته التاريخية، فازدادت كراهية أهل المدينة خصوصاً والمسلمين عموماً للحكم الأموي بمقتل الحسين(ع) تلك القتلة المأساوية، من قتل الكبار والصغار وقتل بعض النساء، وما رافقها من تمثيل بجثث القتلى واقتياد بنات رسول الله(ص) سبايا الى الكوفة ثم الى الشام، وحمل رؤوس الشهداء على الرماح، وضرب عبيد الله بن زياد لوجه الحسين بالقضيب([8]).
فوجدوا أن هتك حرمة الإسلام بمقتل سبط رسول الله(ص) لم يبق لأحد حرمة بعده، ومما زاد في كراهيتهم ليزيد وتحريك ضمائرهم باتجاه التمرد على حكم يزيد قيام الإمام علي بن الحسين(ع) وعمته زينب (س) وزوجة أبيه الرباب بإثارة المظلومية وإبراز تفاصيل الظلم الذي تعرض له الإمام الحسين(ع) وأهل بيته، فحرّكت تلك المظلومية كوامن الغضب والكراهية وتحولت من طور القوة الى طور الفعل والتحدي العسكري، فتظافرت جميع الوقائع في إنضاج الموقف الثوري، كما قال المسعودي: «ولما شمل الناس جور يزيد وعمّاله وعمهم ظلمه، وما ظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسول الله(ص) وأنصاره ما أظهر من شرب الخمور وسيره سيرة فرعون، بل كان فرعون أعدل منه في رعيته، وأنصف منه لخاصته وعامته.. أخرج أهل المدينة عامل يزيد..»([9]).
وقال الدياربكري: «إن أكابر أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد لسوء سيرته، وأبغضوه لما جرى من قتل الحسين»([10]).
ثالثاً: الاستهانة بالمفاهيم والقيم الإسلامية.
لم يكتف يزيد بقتل الحسين(ع) وأهل بيته، بل تسافل في موبقاته ليعلن بصراحة ما يختلج في خاطره من مفاهيم واعتقادات ومن أهداف أراد تحقيقها فتحققت أولى خطواتها بمقتل الحسين(ع) ، فحينما شاهد يزيد رؤوس الشهداء على المحامل لم يتمالك خواطره وأفصح عن سريرته في شعره الذي يقول فيه:
|
لما بدت تلك الحمول وأشرفت |
|
تلك الرؤوس على شفا جيرون |
فأثبت يزيد أن دوافع قتل الحسين دوافع جاهلية تعود إلى طلب ثأر المشركين الذين قتلهم رسول الله(ص) وأمير المؤمنين علي(ع) ، وتأسف يزيد على قتلى المشركين في معركة بدر وتمنّى حضورهم لمشاهدة أخذ الثأر فأنشد شعراً له أو لغيره متمثلاً به:
|
ليت أشياخي ببدر شهدوا |
|
جزع الخزرج من وقع الأسل |
وقد أضاف ابن العماد الحنبلي بيتاً آخر ليزيد:
|
لعبت هاشم بالملك فلا |
|
ملك جاء ولا وحي نزل([13]) |
ومن خلال هذه الأشعار أفصح يزيد عن متبنياته الفكرية والعاطفية والسلوكية، وأعلن تحديه الواضح لأفكار المسلمين وعواطفهم، فأيقن أهل المدينة انحراف الحكم الأموي عن الإسلام وتخطيطه لعودة الجاهلية الى مسرح الأحداث من جديد، فوجد أهل المدينة أن إصلاح الأوضاع القائمة لا يتحقق من خلال المعارضة السلمية الهادئة، فلا جدوى للقول ولا معوّل على الكلام، ما لم يُتخذ موقف يتناسب وحجم التحدي، حجم المخاطر المحيطة بالإسلام وبالكيان الإسلامي، فكان الموقف هو الثورة المسلحة في أوانها.
رابعاً: السخط العام على الحكم الأموي.
واجه الحكم الأموي سخط عام من قبل المسلمين جميعاً وفي جميع الأمصار، واستشرى السخط العام ليمتد إلى الأسرة الحاكمة نفسها والموالين لها، فتبرأت أم عبيد الله بن زياد من ابنها لإصدار أوامره بقتل الإمام الحسين(ع) وساندها في البراءة أحد أبنائها، ولاقى يزيد استنكاراً شديداً من قبل نسائه ومن قبل أخواته، واستنكر يحيى بن الحكم أخو مروان مقتل الإمام الحسين(ع) وأصاب الندم الغالبية العظمى من قادة الجيش وجنوده الذين شاركوا في مقتل الحسين كعمر بن سعد وشبث بن ربعي([14]).
كما استنكر البقية من صحابة رسول الله(ص) مقتل الحسين(ع) ومنهم زيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع، وندم الكثير من المسلمين لعدم اشتراكهم في المعركة إلى جنب الحسين(ع) ، خصوصاً أهل الكوفة والبصرة والمدائن، وأخذوا يعدّون العدّة للوثوب على الحكم الأموي في ثورة مسلحة، وقد اعترف يزيد بالسخط العام على حكومته، وحاول التنصّل عن جريمة قتل الحسين وإلقاء اللوم على عبيد الله بن زياد فقال: «بغّضني بقتله إلى المسلمين، وزرع في قلوبهم العداوة، فأبغضني البر والفاجر»([15]).
وقد اضطرّ يزيد الى إكرام الإمام زين العابدين، وإرساله مع نساء الحسين الى المدينة بتبجيل واحترام ملقياً باللوم على ابن زياد، وهذه الأحداث جعلت أهل المدينة يشعرون بضعف الحكم الأموي وانحسار شعبيته في داخل الشام وحدها، خصوصاً أنه لم يتخذ موقفاً حازماً من تمرّد عبد الله بن الزبير في مكة وجمعه للأتباع والأنصار، فازداد شعور أهل المدينة بضعف الحكم الأموي، مما دفعهم للتخطيط الى القيام بثورة مسلحة.
العوامل والأسباب الفعلية للواقعة
أولاً: الاعتداء على بعض أهل المدينة.
جعل والي المدينة عمرو بن سعيد الأشدق على شرطته عمرو بن الزبير، فأرسل بدوره الى نفر من أهل المدينة فضربهم ضرباً شديداً منهم المنذر بن الزبير وابنه محمد، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وعثمان بن عبد الله بن حكيم، ومحمد بن عمار بن ياسر وغيرهم، مما أثر هذا الموقف في نفوس أهل المدينة من بقية المهاجرين وأبنائهم والأنصار وأبنائهم، واعتبروا ذلك بداية للاستهانة بهم والاعتداء على كرامتهم وأرواحهم، وأيقنوا أن الحكم الأموي الذي تجرأ على قتل ابن بنت رسول الله(ص) ، سيكون أكثر جرأة وإقداماً على قتلهم وهو يعلم بكراهيتهم لحكمه، فأيقنوا أن الهجوم على المدينة بات وشيكاً فتهيأوا للمواجهة المسلحة.
ثانياً: التحولات الإدارية.
عزل يزيد عمرو بن سعيد الأشدق عن ولاية المدينة، وأعاد الوليد بن عتبة إليها، ثم عزله فولّى مكانه عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وهو فتى حدث صغير السن قليل التجربة في الإدارة وفي التعامل مع أهل المدينة، وفيهم بقايا المهاجرين والأنصار، ورافق كل التحولات تغيير في الأجهزة الحكومية العاملة في المدينة مما أضعف السيطرة عليها وأصبحت الفرصة مناسبة للخروج من قبضة الحكومة الحالية.
ثالثاً: الإطلاع المباشر على ممارسات يزيد.
أرسل عثمان بن محمد وفداً من أهل المدينة الى يزيد ومنهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي وبعض الأشراف فأكرمهم يزيد بالأموال والعطايا لشراء ذممهم، ولكن ذلك لم يثنهم عن عزمهم بعد أن اطلعوا اطلاعاً مباشراً على ممارسات يزيد المخالفة للمنهج الإسلامي، فلما رجعوا أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: «..قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر ويضرب بالطنابير ويعزف عنده القيان ويلعب بالكلاب».
وقال ابن حنظلة موضحاً دوافع الثورة: «.. فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات، ويشرب الخمر ويدع الصلاة»([16])، وقد أخذوا العطايا من يزيد لتعينهم على التمرّد المسلّح في وقته المناسب.
رابعاً: مصادرة الأموال وردود الأفعال الحكومية.
منع أهل المدينة من وصول الحنطة والتمر إلى الشام، واعتبروا ذلك حقاً لهم في ظرف الفقر الذي خيّم عليهم والذي فرضه الحكم الأموي عليهم، فأخبر المسؤول عن إيصالها الوالي عثمان بن محمد فأرسل الى رؤوس أهل المدينة وكلمهم بكلام غليظ وتأزم الموقف فأعلنوا الخروج عليه، وحينما سمع يزيد بالحدث كتب إليهم كتاباً شديد اللهجة جاء فيه: «... وأيم الله لئن آثرت أن أضعكم تحت قدمي لأطأنكم وطأة أقلّ منها عددكم، وأترككم أحاديث تتناسخ كأحاديث عادٍ وثمود، وأيم الله لا يأتينكم مني أولى من عقوبتي فلا أفلح من ندم».
ولما قُرئ الكتاب وأيقن عبد الله بن مطيع ورجاله معه أن يزيد باعث الجيوش إليهم أجمعوا على الخلاف والخروج عن طاعته([17]).
وهكذا «كان تحرك المدينة استنكاراً مباشراً لمقتل الحسين ورفضاً للسيادة الأموية التي حادت برأيهم عن الشرعية وانحرفت عن روح الإسلام»([18]).
واستثمر يزيد موقفهم لإبراز موقفه الانتقامي منهم بدافع الثأر لما حدث في بدر، لأن غزوة بدر (التي كانت غالبيتها من الأنصار.. قد أثار حقد قريش على هؤلاء مُلقية عليهم مسؤولية الهزيمة التاريخية التي ظلّت تتفاعل أجيالاً في نفوس بني أمية ([19]).
سير الأحداث
ولّى يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان المدينة وهو فتى حدث، لم يمر بتجربة في التعامل مع الأفراد أو التعامل مع الأحداث، فأرسل وفداً من أهل المدينة إلى يزيد ومنهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي فأكرمهم يزيد بالعطايا، ولكن ذلك لم يمنعهم من إظهار مساوئه التي اطلعوا عليها، فلما وصلوا إلى المدينة اتفقوا على خلع يزيد، ومنعوا من وصول الحنطة والتمر إلى الشام، فلما سمع يزيد بالخبر بعث الجيوش إليهم، فأعلنوا العصيان المسلح وتهيأوا للمقاومة وحصروا بني أمية ومواليهم وكانوا ألفاً ثم أخرجوهم بعدما أخذوا منهم المواثيق أن لا يظاهروا عدوّهم عليهم.
أوصى يزيد قائد الجيش مسلم بن عقبة: «أدع القوم ثلاثاً فإن أجابوك وإلا فقاتلهم فإذا ظهرت عليهم فانهبها ثلاثاً».
وقام أهل المدينة بحفر خندقٍ حولها، وحين وصول جيش الشام؛ خان مروان وأبناؤه الميثاق، وظاهروا الجيش على قتال أهل المدينة، وأقنعوا بني حارثة بإدخال جيش الشام من جهتهم، فدخل الى جوف المدينة، فكان الهجوم على أهلها من الأمام ومن الخلف ثم من الجهات الأربع، فحوصرت المدينة، لكن أهلها استبسلوا بالقتال واستطاع عبد الله بن حنظلة أن يهزم كل من توجه إلى قتاله إلى أن قُتل أخوه وأبناؤه العشرة، وبعد مقتلهم انهزم أهل المدينة، واستطاع الجيش الأموي إخماد حركتهم وأباح قائدهم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال، ودعى ابن عقبة أهل المدينة إلى البيعة على أنهم عبيد ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم فمن أبى البيعة بهذه الصورة قُتل، واستثنى من ذلك الإمام علي بن الحسين(ع) واستطاع(ع) أن يشفع لبقية أهل المدينة، وأنقذهم من القتل([20]).
نتائج الحقد الأموي على المدينة وأهلها:
أولاً: عدد القتلى.
استمرّ الجيش الشامي بإبادة أهل المدينة وإكثار القتل فيهم ثلاثة أيام، حتى بلغ العدد الذي أحصي يومئذٍ «من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس ألفاً وسبعمائة، ومن سائر الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان».
«وقتل من أصحاب النبي(ص) ثمانون رجلاً، ولم يبق بدريّ بعد ذلك»([21]).
وفي رواية الزهري: «سبعمائة من وجوه الناس، ومن لا يعرف من عبد وحر وامرأة عشرة آلاف»([22]).
وفي رواية ابن أعثم (6500) ورواية المسعودي (4200)([23]).
والظاهرة البارزة في هوية القتلى تُظهر التركيز على أبناء الصحابة وبقية الصحابة من حملة القرآن ومن المشاركين في بدر، حتى كانت الحرّة نهاية للبدريين جميعاً وقتل فيها (سبعمائة من حملة القرآن)([24]).
ومن الوجوه البارزة التي قتلت في الواقعة: عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة وأبناؤه العشرة وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس وزيد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن زيد بن عاصم، ومحمد بن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب، ومعقل بن سنان الأشجعي، وإبراهيم بن نعيم النحّام، ومحمد بن أبي كعب، وسعد وسليمان وإسماعيل وسليط وعبد الرحمن وعبد الله أبناء زيد بن ثابت، وعون وأبو بكر ابنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن محمد بن الحنفية والفضل بن العباس بن ربيعة، وحمزة بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، والعباس بن عتبة بن أبي لهب، ومحمد بن أبي الجهم.
ثانياً: الاعتداء على النساء والأطفال.
لم يرع الجيش الشامي أية حرمة للنساء والأطفال، فاستقبلوا أوامر الإباحة باندفاع منقطع النظير، وحولوها إلى واقع ملموس، فبعد هزيمة أهالي المدينة (افتض فيها ألف عذراء) وأنه «حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج»([25]).
فقد خالف الجيش المسلّمات الأساسية في الشريعة الإسلامية وفي الأعراف القائمة، فمهما كان ذنب الرجال فلا ذنب للنساء وهنّ مؤمنات مسلمات لا يجوز سبيهنّ أو الاعتداء عليهنّ، ودخلت الجيوش الشامية أحد البيوت فلم يجدوا فيها إلا امرأة وطفلاً ليس لديها مال أخذوا طفلها وضربوا رأسه بالحائط فقتلوه([26]). وقام أحد جنود الشام بتكرار العملية حينما ضرب ابناً لابن أبي كبشة الأنصاري بالحائط فانتشر دماغه في الأرض([27]).
ثالثاً: النهب والسلب.
أول دور انتهبت والحرب قائمة دور بني عبد الأشهل، فما تركوا في المنازل التي دخلوها شيئاً إلا نهبوه من أثار وحلي وفرش حتى الحمام والدجاج كانوا يذبحونها، ودخلوا على أبي سعيد الخدري. فقال لهم: أنا صاحب رسول الله(ص). فقال له جنود الشام: ما زلنا نسمع عنك، ولكن أخرج إلينا ما عندك، فلما لم يجدوا عنده شيئاً نتفوا لحيته وضربوه، ثم أخذوا ما وجدوه من مواد عينية لا قيمة لها، وأرسلت سعدى بنت عوف المري الى مسلم بن عقبة المري تطلب منه عدم التعرض لإبلها باعتبارها ابنة عمٍّ له، فقال: «لا تبدأوا إلا بها»، واستمر جيش الشام بالنهب والسلب ثلاثة أيام فما تركوا مالاً او ممتلكات عينية إلا أخذوها([28]).
رابعاً: انتهاك المقدسات.
لم يرع جيش الشام أي حرمة للمقدسات الإسلامية فكان همّه إرضاء يزيد بن معاوية بأي أسلوب كان، وكانت طاعته مقدمة على كل شيء، فكان الجيش يخاطب بقايا المهاجرين والأنصار (يا يهود)([29]).
وسمّى ابن عقبة المدينة Sنتنة وقد سماها رسول الله(ص) طيبة ([30]).
وعطلت الشعائر الإسلامية ثلاثة أيام، قال أبو سعيد الخدري: «فوالله ما سمعنا الأذان بالمدينة.. ثلاثة أيام إلا من قبر النبي(ص) »([31]).
وحينما وصلت الأخبار الى يزيد وفي رواية حينما ألقيت الرؤوس بين يديه جعل يتمثل بقول ابن الزبعري:
|
ليت أشياخي ببدر شهدوا |
|
جزع الخزرج من وقع الأسل |
وسبق ليزيد أن تمثل بهذه الأبيات حينما وصل إليه رأس الإمام الحسين(ع) .
وهكذا كانت الواقعة تعبيراً عن الحقد الذي يكنّه الأمويون للأنصار منذ واقعة بدر، والذي ظهر في توجيهات يزيد لابن عقبة قبل الواقعة: «فإذا قدمت المدينة فمن عاقك على دخولها أو نصب لك الحرب، فالسيف السيف، أجهز على جريحهم وأقبل على مدبرهم وإياك أن تبقي عليهم»([33]).
وقد نفّذ ابن عقبة تلك التوجيهات وشجّع على الإبادة الجماعية فكان مناديه ينادي: «من جاء برأس فله كذا وكذا ومن جاء بأسير فله كذا وكذا»، فلم يبق بدري إلا قتل([34]).
فأخذ يزيد ثأر المشركين الذين قتلوا ببدر يوم الحرّة فانتقم من بقايا المهاجرين والأنصار وأبنائهم انتقاماً متناسباً مع درجة الحقد التي يكنّها لهم.
([1]) راجع الكامل في التاريخ ج3 وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 209.
([2]) معجم ما استعجم: عبد الله الأندلسي 1: 438، عالم الكتب 1403هـ الطبعة الثالثة.
([3]) تاريخ الإسلام، الذهبي: 26، دار الكتاب العربي ط1. 1412هـ.
([4]) الإمامة والسياسة، الدينوري 1: 219، القاهرة 1388هـ.
([5]) البداية والنهاية، ابن كثير 8: 235.
([7]) الإمام الحسن، لعبد الله العلايلي: 26، منشورات الشريف الرضي ط1. 1415هـ.
([8]) الكامل في التاريخ 4: 79-80، تاريخ الطبري 5: 456.
([9]) مروج الذهب: للمسعودي 3: 69، دار الهجرة، ط 2. 1397هـ.
([10]) تاريخ الخميس، لحسين الدياربكري 2: 300، مؤسسة شعبان.
([11]) روح المعاني، للآلوسي 26: 73، دار إحياء التراث العربي.
([12]) البداية والنهاية 8: 192، المنتظم 5: 343.
([13]) شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي 1: 69، دار الآفاق - بيروت.
([14]) الكامل في التاريخ 4: 86-90.
([15]) البداية والنهاية 8: 232.
([16]) تاريخ الإسلام، للذهبي: 27، تاريخ الخلفاء، للسيوطي: 167.
([17]) الإمامة والسياسة 1: 207.
([18]) التوابون، للدكتور إبراهيم بيضون: 82.
([19]) الأنصار والرسول، د. إبراهيم بيضون: 29.
([20]) الكامل في التاريخ، تاريخ الطبري، الإمامة والسياسة، مروج الذهب.
([21]) الإمامة والسياسة 1: 215- 216.
([23]) الفتوح 5: 181. مرج الذهب 3: 70.
([24]) تاريخ الإسلام، للذهبي: 30.
([25]) تاريخ الخلفاء: 167، البداية والنهاية 8: 221، تاريخ الإسلام: 26.
([26]) المحاسن والمساوئ، للبيهقي 1 :104.
([27]) الإمامة والسياسة 1: 215.
([28]) م. ن: 1- 213، المنتظم 6: 15.
([29]) أنساب الأشراف: قسم 4، 1، 327.
([31]) الفتوح، ابن أعثم 5: 182. دار الكتب العلمية ط1. 1406هـ.
([32]) أنساب الأشراف: 4-1-333، الأخبار الطوال: 267، العقد الفريد 5: 139.
شهادة الإمام علي الرضا (ع)([1]) (على رواية الطبـرسي وابن الأثير)(29/ صفر /السنة 203هـ)
شهادة الإمام علي الرضا (ع)([1]) (على رواية الطبـرسي وابن الأثير)(29/ صفر /السنة 203هـ)
إنّ من يقرأ سيرة الإمام الرضا(ع) يلفت نظره قصة ولاية العهد التي أسندت إليه من قبل المأمون، وقد ابتلي الإمام ابتلاءاً شديداً في فرض ولاية العهد عليه من قبله، فقد ضيّق عليه المأمون غاية التضييق، بحيث سئم الإمام الحياة، وراح يدعو اللّه تعالى أن ينقله إلى دار الخلود قائلاً: «اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعجّل لي الساعة...»([2])،
وما اكتفى المأمون بالتضييق على الإمام (ع) ، بل كان يترصّد الفرصة المناسبة ليقضي عليه كما قضى من قبل على وزيره فضل بن سهل لمّا أحسّ بالخطر منه على خلافته، ولذا لم يتمكن من إضمار ما في نفسه من حقد على الإمام (ع) وأخذ يغتنم الفرص ليتخلص من
الإمام (ع) ، ولو اقتضى ذلك أن يقتله بيده الغادرة، وقد فعل ذلك حيث ذكر معظم المؤرخون والرواة أن المأمون هو الذي دسّ السّم في العنب أو الرّمان إلى الإمام في قرية يقال لها: سناباد من قرى طوس، في آخر صفر سنة (203هـ)([3])، وأخفى المأمون موت
الإمام (ع) يوماً وليلة، وبعد ذلك شُيّع جثمان الإمام تشييعاً حافلاً لم تشهد مثله خراسان في جميع أدوار تاريخها، وجيء بالجثمان الطاهر فحفر له قبر بالقرب من قبر هارون الرشيد([4])، وواراه المأمون فيه، ويقال إنّه أقام عند قبره الشريف ثلاثة أيام، في محاولة منه لرفع التهم عنه في قضية قتل الإمام وإظهار إخلاصه وحبه له.
سبب دفن الإمام إلى جانب قبـر هارون العباسي:
قد يسأل سائل عن السبب في دفن الإمام بقرب هارون مع ما هو معروف عن هارون من حقده على العلويين من أهل البيت، وقد سئل المأمون عن ذلك فأجاب: ليغفر الله لهارون بجواره للإمام الرضا(ع) ، وقد فنّد ذلك شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي بقوله:
|
أربع بطوس على قبر الزّكيّ بها |
|
إن كنت تربع من دين على وطر |
قيل: فضرب المأمون بعمامته الأرض وقال: «صدقت واللّه يا دعبل».
وحيث وصل الحديث بنا إلى دعبل الخزاعي، فالجدير بنا أن نذكر علاقته مع
الإمام (ع) ، ثم نذكر مقتطفات من قصيدته التائية المعروفة التي نظمها في مدح ورثاء
أهل البيت(ع)، والإمام الرضا(ع) .
الإمام الرضا(ع) والشاعر دعبل الخزاعي:
كان الإمام الرضا(ع) يشجّع الشعراء الرساليين المحبين لأهل البيت عليهم السلام على نظم الشعر من أجل نشر فضائل أهل البيت عليهم السلام ودورهم العلمي والقيادي في الأمة، وتبيان مظلوميتهم على مرّ التاريخ، لأنَّ الشعر كان خير وسيلة إعلامية في ذلك العصر، لسرعة انتشاره وسهولة حفظه وإنشائه.
ومن أولئك الشعراء الرساليين الذين نذروا حياتهم وشعرهم لخدمة أهل البيت عليهم السلام ، دعبل الخزاعي الذي كان لأشعاره أكبر الأثر في نشر فضائل أهل البيت عليهم السلام ، ولا سيما قصيدته التائية التي صارت لقوة سبكها وسلاسة أسلوبها تتلى على كل لسان عبر التاريخ ولهذه القضية قصة نوردها بالتفصيل
دخل دعبل على الإمام الرضا(ع) بمرو - بعد البيعة بولاية الإمام - فقال له: يا ابن رسول اللّه إني أنشدتُ فيكم قصيدة وآليت على نفسي ألا أنشدها أحداً قبلك، فقال له الإمام (ع) : هاتها يا دعبل.
فأنشده إياها وفيها استعراض للوقائع التي مرت على أهل البيت من حين وفاة النبي(ص) مروراً بأحداث السقيفه، وموقف المسلمين من الخلافة، وما جرى على أهل البيت خلال العهدين الأموي والعباسي، والخصائص التي حباهم اللّه بها، ثم ختم القصيدة بخروج الإمام العادل الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وقد تأثّر الإمام بهذه القصيدة وأخذ يبكي ويقول: صدقت يا دعبل.
ولما فرغ دعبل من إنشاد القصيدة التائية المعروفة، قام الإمام الرضا(ع) وأنفذ إليه صرّة فيها مئة دينار([5])، وقيل عشرة آلاف درهم من الدّراهم التي ضربت بإسمه، فردّها دعبل وقال: واللّه ما لهذا جئت، وإنما جئت للسلام عليك والتبرك بالنظر إلى وجهك الميمون وإني لفي غنى، فإن رأى أن يعطينى شيئاً من ثيابه للتبرك فهو أحب إليّ، فأعطاه الإمام (ع) جبة خزّ وردّ عليه الصرة([6])، وانصرف دعبل.
وينبغي هنا أن نذكر على سبيل الاختصار مقتطفات من تلك القصيدة التائية الرائعة تبركاً وتوسلاً بأهل البيت، وبالإمام الرضا(ع) :
|
ذكرتُ محلّ الرَّبع([7]) من عرفات |
|
فأجريتُ دمع العين بالعبرات |
|
مدارس آيات خلت من تلاوة |
|
ومنزل وحي مقفر العرصات([8]) |
|
ديار علي والحسين وجعفر |
|
وحمزة والسجّاد ذي الثّفنات([9]) |
|
منازل كانت للصّلاة وللتقى |
|
وللصوم والتطهير والحسنات |
|
أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً |
|
وقد مات عطشاناً بشطّ فرات |
|
إذاً للطمت الخدّ فاطم عنده |
|
وأجريت دمع العين في الوجنات |
|
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي |
|
نجوم سماوات بأرض فلاة |
|
قبور بكوفان وأخرى بطيبة |
|
وأخرى بفخ([10]) نالها صلواتِ |
|
وقبر بأرض الجوزجان محلّه |
|
و قبر بباخمرى([11]) لدى الغربات |
|
قبور بجنب النهر من أرض كربلاء |
|
معرّسهم فيها بشط فرات |
|
توفوا عطاشى بالعراء فليتني |
|
توفيت فيهم قبل حين وفاتي |
|
وقبر ببغداد لنفس زكية |
|
تضمّنها الرحمن في الغرفات([12]) |
ولما وصل دعبل إلى هذا البيت من القصيدة، قال له الإمام الرضا(ع) : أفلا أُلحق لك بيتين بهذا الموضع، بهما تمام قصيدتك؟ فقال: بلى يا ابن رسول اللّه.
فقال الرضا(ع) :
|
وقبـر بطوس([13]) يا لها من مصيبة |
|
ألحّت على الأحشاء بالزّفرات([14]) |
فقال دعبل: هذا القبر الذي بطوس قبر من؟
قال الرضا(ع) : «هو قبـري، ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزوّاري، ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له»([15]).
([1]) نقلاً عن كتاب (لمحات من حياة الإمام الرضا(ع) وأخته السيدة فاطمة المعصومة) أيوب الحائري.
([2]) عيون أخبار الرضا(ع) 2: 241.
([3]) اختلفت الأخبار في تعيين يوم شهادة الإمام الرضا(ع) ولكن المشهور والمعمول هو التاسع والعشرون من شهر صفر وهو المعمول به في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول العربية.
([4]) خرج هارون الرشيد العباسي من بغداد متجهاً إلى خراسان لمقاتلة العلويين وفي طوس مرض ثم توفي ودفن في قرية سناباد في دار حميد بن قحطبة الطائي..
([7]) الربع: المكان الذي يتوقف به ويطمأن.
([9]) الثفنات: ما تقرن من الجلد، علامات في الجبهة من كثرة السجود.
([10]) فخ: موقع بمكة وقعت فيه حادثة فخ.
([11]) باخمرى: مكان بين الكوفة وواسط في العراق فيه قبر القاسم أخو الإمام الرضاA.
([13]) قد جاء في الحديث الشريف أن بين جبلي طوس لقبضة من تراب الجنة، وفيها قبر الإمام الرضاA.
([14]) الزّفرات: تتابع الأنفاس من شدة الغم والحزن.
([15]) عيون أخبار الرضاA 2: 295، ط ايران، منشورات الشريف الرضي.
شهادة الإمام علي الرضا (ع)([1]) (على رواية الطبـرسي وابن الأثير)(29/ صفر /السنة 203هـ)
شهادة الإمام علي الرضا (ع)([1]) (على رواية الطبـرسي وابن الأثير)(29/ صفر /السنة 203هـ)
إنّ من يقرأ سيرة الإمام الرضا(ع) يلفت نظره قصة ولاية العهد التي أسندت إليه من قبل المأمون، وقد ابتلي الإمام ابتلاءاً شديداً في فرض ولاية العهد عليه من قبله، فقد ضيّق عليه المأمون غاية التضييق، بحيث سئم الإمام الحياة، وراح يدعو اللّه تعالى أن ينقله إلى دار الخلود قائلاً: «اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعجّل لي الساعة...»([2])،
وما اكتفى المأمون بالتضييق على الإمام (ع) ، بل كان يترصّد الفرصة المناسبة ليقضي عليه كما قضى من قبل على وزيره فضل بن سهل لمّا أحسّ بالخطر منه على خلافته، ولذا لم يتمكن من إضمار ما في نفسه من حقد على الإمام (ع) وأخذ يغتنم الفرص ليتخلص من
الإمام (ع) ، ولو اقتضى ذلك أن يقتله بيده الغادرة، وقد فعل ذلك حيث ذكر معظم المؤرخون والرواة أن المأمون هو الذي دسّ السّم في العنب أو الرّمان إلى الإمام في قرية يقال لها: سناباد من قرى طوس، في آخر صفر سنة (203هـ)([3])، وأخفى المأمون موت
الإمام (ع) يوماً وليلة، وبعد ذلك شُيّع جثمان الإمام تشييعاً حافلاً لم تشهد مثله خراسان في جميع أدوار تاريخها، وجيء بالجثمان الطاهر فحفر له قبر بالقرب من قبر هارون الرشيد([4])، وواراه المأمون فيه، ويقال إنّه أقام عند قبره الشريف ثلاثة أيام، في محاولة منه لرفع التهم عنه في قضية قتل الإمام وإظهار إخلاصه وحبه له.
سبب دفن الإمام إلى جانب قبـر هارون العباسي:
قد يسأل سائل عن السبب في دفن الإمام بقرب هارون مع ما هو معروف عن هارون من حقده على العلويين من أهل البيت، وقد سئل المأمون عن ذلك فأجاب: ليغفر الله لهارون بجواره للإمام الرضا(ع) ، وقد فنّد ذلك شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي بقوله:
|
أربع بطوس على قبر الزّكيّ بها |
|
إن كنت تربع من دين على وطر |
قيل: فضرب المأمون بعمامته الأرض وقال: «صدقت واللّه يا دعبل».
وحيث وصل الحديث بنا إلى دعبل الخزاعي، فالجدير بنا أن نذكر علاقته مع
الإمام (ع) ، ثم نذكر مقتطفات من قصيدته التائية المعروفة التي نظمها في مدح ورثاء
أهل البيت(ع)، والإمام الرضا(ع) .
الإمام الرضا(ع) والشاعر دعبل الخزاعي:
كان الإمام الرضا(ع) يشجّع الشعراء الرساليين المحبين لأهل البيت عليهم السلام على نظم الشعر من أجل نشر فضائل أهل البيت عليهم السلام ودورهم العلمي والقيادي في الأمة، وتبيان مظلوميتهم على مرّ التاريخ، لأنَّ الشعر كان خير وسيلة إعلامية في ذلك العصر، لسرعة انتشاره وسهولة حفظه وإنشائه.
ومن أولئك الشعراء الرساليين الذين نذروا حياتهم وشعرهم لخدمة أهل البيت عليهم السلام ، دعبل الخزاعي الذي كان لأشعاره أكبر الأثر في نشر فضائل أهل البيت عليهم السلام ، ولا سيما قصيدته التائية التي صارت لقوة سبكها وسلاسة أسلوبها تتلى على كل لسان عبر التاريخ ولهذه القضية قصة نوردها بالتفصيل
دخل دعبل على الإمام الرضا(ع) بمرو - بعد البيعة بولاية الإمام - فقال له: يا ابن رسول اللّه إني أنشدتُ فيكم قصيدة وآليت على نفسي ألا أنشدها أحداً قبلك، فقال له الإمام (ع) : هاتها يا دعبل.
فأنشده إياها وفيها استعراض للوقائع التي مرت على أهل البيت من حين وفاة النبي(ص) مروراً بأحداث السقيفه، وموقف المسلمين من الخلافة، وما جرى على أهل البيت خلال العهدين الأموي والعباسي، والخصائص التي حباهم اللّه بها، ثم ختم القصيدة بخروج الإمام العادل الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وقد تأثّر الإمام بهذه القصيدة وأخذ يبكي ويقول: صدقت يا دعبل.
ولما فرغ دعبل من إنشاد القصيدة التائية المعروفة، قام الإمام الرضا(ع) وأنفذ إليه صرّة فيها مئة دينار([5])، وقيل عشرة آلاف درهم من الدّراهم التي ضربت بإسمه، فردّها دعبل وقال: واللّه ما لهذا جئت، وإنما جئت للسلام عليك والتبرك بالنظر إلى وجهك الميمون وإني لفي غنى، فإن رأى أن يعطينى شيئاً من ثيابه للتبرك فهو أحب إليّ، فأعطاه الإمام (ع) جبة خزّ وردّ عليه الصرة([6])، وانصرف دعبل.
وينبغي هنا أن نذكر على سبيل الاختصار مقتطفات من تلك القصيدة التائية الرائعة تبركاً وتوسلاً بأهل البيت، وبالإمام الرضا(ع) :
|
ذكرتُ محلّ الرَّبع([7]) من عرفات |
|
فأجريتُ دمع العين بالعبرات |
|
مدارس آيات خلت من تلاوة |
|
ومنزل وحي مقفر العرصات([8]) |
|
ديار علي والحسين وجعفر |
|
وحمزة والسجّاد ذي الثّفنات([9]) |
|
منازل كانت للصّلاة وللتقى |
|
وللصوم والتطهير والحسنات |
|
أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً |
|
وقد مات عطشاناً بشطّ فرات |
|
إذاً للطمت الخدّ فاطم عنده |
|
وأجريت دمع العين في الوجنات |
|
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي |
|
نجوم سماوات بأرض فلاة |
|
قبور بكوفان وأخرى بطيبة |
|
وأخرى بفخ([10]) نالها صلواتِ |
|
وقبر بأرض الجوزجان محلّه |
|
و قبر بباخمرى([11]) لدى الغربات |
|
قبور بجنب النهر من أرض كربلاء |
|
معرّسهم فيها بشط فرات |
|
توفوا عطاشى بالعراء فليتني |
|
توفيت فيهم قبل حين وفاتي |
|
وقبر ببغداد لنفس زكية |
|
تضمّنها الرحمن في الغرفات([12]) |
ولما وصل دعبل إلى هذا البيت من القصيدة، قال له الإمام الرضا(ع) : أفلا أُلحق لك بيتين بهذا الموضع، بهما تمام قصيدتك؟ فقال: بلى يا ابن رسول اللّه.
فقال الرضا(ع) :
|
وقبـر بطوس([13]) يا لها من مصيبة |
|
ألحّت على الأحشاء بالزّفرات([14]) |
فقال دعبل: هذا القبر الذي بطوس قبر من؟
قال الرضا(ع) : «هو قبـري، ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزوّاري، ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له»([15]).
([1]) نقلاً عن كتاب (لمحات من حياة الإمام الرضا(ع) وأخته السيدة فاطمة المعصومة) أيوب الحائري.
([2]) عيون أخبار الرضا(ع) 2: 241.
([3]) اختلفت الأخبار في تعيين يوم شهادة الإمام الرضا(ع) ولكن المشهور والمعمول هو التاسع والعشرون من شهر صفر وهو المعمول به في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول العربية.
([4]) خرج هارون الرشيد العباسي من بغداد متجهاً إلى خراسان لمقاتلة العلويين وفي طوس مرض ثم توفي ودفن في قرية سناباد في دار حميد بن قحطبة الطائي..
([7]) الربع: المكان الذي يتوقف به ويطمأن.
([9]) الثفنات: ما تقرن من الجلد، علامات في الجبهة من كثرة السجود.
([10]) فخ: موقع بمكة وقعت فيه حادثة فخ.
([11]) باخمرى: مكان بين الكوفة وواسط في العراق فيه قبر القاسم أخو الإمام الرضاA.
([13]) قد جاء في الحديث الشريف أن بين جبلي طوس لقبضة من تراب الجنة، وفيها قبر الإمام الرضاA.
([14]) الزّفرات: تتابع الأنفاس من شدة الغم والحزن.
([15]) عيون أخبار الرضاA 2: 295، ط ايران، منشورات الشريف الرضي.
شهادة الإمام الحسن المجتبى (ع) (على رواية الطبـرسي)(28/ صفر / السنة 50 هـ)
لمحات من سيرته
عدّدت الروايات حول تاريخ شهادة الإمام الحسن(ع) كن المشهور هو الثامن والعشرون من شهر صفر على رواية الشيخين المفيد والطوسي، وهو المعمول به في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول العربية.
كان عمره الشريف عند شهادته سبعاً وأربعين سنة وأشهراً، أقام منها مع جده رسول الله(ص) سبعاً، أو ثماني سنين، وقام بالأمر بعد أبيه علي بن أبي طالب(ع) وله سبع وثلاثون سنة.
وأقام في خلافته ستة أشهر وثلاثة أيام، وصالح معاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وأربعين، وإنما صالحه وهادنه خيفة على نفسه وأهل بيته وشيعته، لأن جماعة من رؤساء صحابته كاتبوا معاوية وضمنوا له تسليم الحسن(ع) ، ولم يكن فيهم من يأمن غائلته، إلا فرقة قليلة من أهل بيته وشيعته لا تقوم بقتال أهل الشام([1]) فاضطرّ(ع) للمصالحة.
وبعث إليه معاوية في الصلح، وشرط عليه الإمام (ع) شروطاً كثيرة منها: أن يرفع السبّ عن علي(ع) ، وأن يؤمن شيعته ولا يتعرض لأحد منهم، فأجابه معاوية إلى ذلك، وكتب كتاب الصلح بناءً عليه، ولم يلتزم الفاسق بأي شروط.
ثم خرج الحسن إلى المدينة، وأقام بها عشر سنين، حتى دسّ إليه معاوية السم على يد زوجه جعدة بنت الأشعث، فانتقل إلى رضوان الله تعالى.
قصة استشهاد الإمام الحسن(ع)
لما تم الأمر لمعاوية عشر سنين، عزم أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده، فنظر في نفسه فرأى أثقل الناس عليه مؤونة هو الحسن بن علي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص الزهري، أما الحسن(ع) فلن تعدل الناس عنه إلى يزيد، لأنه ابن بنت رسول الله(ص) ، وأما سعد فإنه من الصحابة الستة أصحاب الشورى، فسعى إلى التخلّص منهما بكل شكل ووسيلة حتى يخلو له الأمر عن منازع ينازعه في ذلك. فأرسل إلى سعد رجلاً فدسّ إليه سماً فمات، ثم عزم على التخلص من الحسن(ع) ، فأرسل إلى الأشعث بن قيس، وهو قبل ذلك من حزب علي(ع) ، وكان علي ولاّه على أذربيجان فاقتطع من فيء مال المسلمين مالاً وهرب إلى معاوية وبقي عنده، فاستشاره معاوية في قتل الحسن، فقال: الرأي عندي؛ أن ترسل إلى ابنتي جعدة، فإنها تحت الحسن وتعطيها مالاً جزيلاً، وتعدها أن تزوجها من ابنك يزيد وتأمرها أن تسم الحسن، فقال معاوية: نعم الرأي، ولتكن أنت الرسول إليها، فقال: لا بل يكون الرسول غيري، لأني إذا سرت إليها يستوحش الحسن من ذلك.
وهكذا كان، ووعدها بالمال الجزيل وأن يزوجها يزيد إذا قتلت الحسن(ع) ، فرضيت بالمهمة وسُرّت بها، وبقيت تتحيّن الفرص حتى كان ذلك اليوم الذي قدم فيه الإمام (ع) إلى منزله وكان صائماً في يوم صائف شديد الحر، فقدَّمت إليه طعاماً فيه لبن ممزوج بعسل قد ألقت فيه سُمّاً، فلما شربه الحسن أحسّ بالسم، فالتفت إلى جعدة وقال لها: «قتلتيني يا عدوّة الله، قتلك الله، وأيم الله لا تصيبين مني خلفاً، ولقد غرك وسخر بك فالله مخزيه ومخزيك»([2]).
ودخل عليه أخوه الحسين(ع) ، فرأى وجهه قد تغيّر وقد مال بدنه إلى الخضرة من أثر السمّ، فقال له الحسين(ع): بأبي أنت وأمي ما بك؟
فقال (ع): «صحّ يا أخي حديث جدي رسول الله فيّ وفيك!» فقال له الحسين(ع): ما حدثك به جدك؟ وماذا سمعته منه؟
فبكى الحسن ومدّ يده إلى أخيه الحسين واعتنقا طويلاً وبكيا بكاءً شديداً، ثم قال: أخبـرني رسول الله(ص): «مررت ليلة المعراج على منازل أهل الإيمان وبروضات الجنان، فرأيت قصرين عاليين متجاورين على صفة واحدة، لكن أحدهما من الزبرجد الأخضر، والثاني من الياقوت الأحمر..» إلى آخر الحديث الذي فيه إشارة إلى كيفية شهادة كل منهما أحدهما بالسم والآخر بالسيف.
ثم إن الحسن قام في مرضه أربعين يوماً، فلما تحقق من دنوّ أجله، دعا بالحسين ونصبه علماً للناس، ودفع إليه كتب رسول الله(ص) وسلاحه، وكتب أمير المؤمنين(ع) وسلاحه، وأوصاه بوصاياه. ولما حضره الموت وكان الحسين(ع) عنده جعل يجود بنفسه، حتى قال الحسن(ع) : «أستودعكم الله، والله خليفتي عليكم»، ثم غمض عينيه ومد يديه ورجليه، ثم قضى نحبه وهو يحمد الله ويقول: «لا إله إلا الله..»([3]).
ودفن في البقيع عند جدته فاطمة بنت أسد، كما أوصى، لأنه علم أنه لن يسمح له أن يدفن في جوار جده رسول الله(ص). وخاف أن تراق الدماء عند دفنه.
ذكر شيء من مناقبه (ع)
وللحسن(ع) من الفضائل والمناقب ما لا يخفى على أحد من العامة أو الخاصة وبما لا يدع لذي لب ريباً في أن الذي ناصب الحسن العداء ودسّ له السم، إنما خرج من ربقة الإسلام وحارب الله ورسوله، وإليك بعض فضائله مع أخيه الحسين(ع) من الكتاب والسنّة. فأما من الكتاب: فيكفي أن نذكر الآيات التالية والسور التالية:
1- آية التطهير، 2- آية المباهلة، 3- آية المودة، 4- سورة الدهر. والتي اتفق المسلمون على أنها نزلت في الخمسة أهل الكساء.
وأما فضائلهما من السنة فقد اتفق عليها الفريقان:
1- حديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، إنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض»([4]).
2- حديث السفينة: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق»([5]).
3- قول النبي(ص): «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض».. أو أمان لأمتي([6]).
4- قول النبي لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم»([7]).
5- قول النبي(ص): «والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار». قال الحاكم في (المستدرك) عن هذا الحديث: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»([8]). وهناك أحاديث غيرها كثيرة، وفي ذلك كفاية لمن له عقل أو قلب.
فسلام عليك يا سيدي يا أبا محمد الحسن(ع) يوم ولدت، ويوم استشهدت مسموماً مظلوماً، ويوم تبعث حياً.
([4]) صحيح مسلم4: 1873 (باب فضائل علي بن أبي طالب)، وسنن الترمذي 5: 329، وصحيح شرح العقيدة الطحاوية للنووي: 654، صحيح الجامع الصغير 1: 482.
([5]) انظر الحديث في (فضائل الصحابة) لأحمد بن حنبل 2: 785، والمعجم الكبير للطبراني 3: 44. والمستدرك للحاكم 2: 343 و3: 151.
([6]) المستدرك على الصحيحين 2: 448، و3: 149، و3: 457، والصواعق المحرقة: 351.
وفاة النبي الأكرم (ص) (28/ صفر / السنة 11 هـ)
المشهور بين العلماء أن رسول الله(ص) قبض يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة، وهو (ص) ابن ثلاث وستين سنة.
مواقف مهمة قبل وفاته(ص)
لما أحسّ رسول الله(ص) بدنوّ أجله، اتخذ (ص) مواقف وخطوات مهمة تجاه الأمة ومستقبلها فجعل يقوم في مقام بعد مقام في المسلمين يحذّرهم من الفتنة بعده والخلاف عليه. ويؤكد عليهم بالتمسك بسنّته والاجتماع عليها والوفاق، ويحثّهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين، ويزجرهم عن الخلاف والارتداد.. وكان أوصى (ص) :
«أيها الناس، إني فرطكم، وأنتم واردون عليّ الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين، فانظروني كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني، سألت ربي ذلك فأعطانيه، ألا وإني قد تركتهما فيكم، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهما فتفرقوا ولا تقصِّروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم..
أيها الناس، لا ألفيكم بعدي ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.. ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»([1]).
جيش أسامة:
ثم إنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة، وندبه أن يخرج بجمهور الأمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم، واجتمع رأيه (ع) على إخراج جماعة
من متقدّمي المهاجرين والأنصار في معسكره، حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته (ص) من يختلف في الرئاسة ويطمع في التقدم على الناس بالإمارة، ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده، ولا ينازعه في حقه منازع، تعقد له الإمرة على من ذكرناه.
فأمر أسامة بالخروج عن المدينة ليعسكر بالجرف، وحثّ الناس على الخروج إليه والمسير معه، وحذَّرهم من الإبطاء عنه([2]).
وحين بدأ به (ص) المرض خرج للبقيع واستغفر لمن دفن فيها طويلاً.. ثم قال للإمام علي(ع): «... فإذا أنا مت فاغسلني واستر عورتي، فإنه لا يراها أحد إلا كمه»([3]).
ثم عاد إلى منزله عليه وآله السلام فمكث ثلاثة أيام موعوكاً، ثم خرج إلى المسجد معصوب الرأس معتمداً على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيده اليمنى وعلى الفضل بن العباس باليد الأخرى، حتى صعد المنبر فجلس عليه، ثم قال:
«معاشر الناس قد حان مني خفوق من بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياها، ومن كان له عليّ دين فليخبـرني به.
معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء نعطيه به خيراً أو يصرف به شراً إلا العمل.
أيها الناس، لا يدّع مدّع، ولا يتمنّ متمنٍّ، والذي بعثني بالحق، لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت، اللهم هل بلّغت؟».
ومكث في بيت أم سلمة يوماً أو يومين، ثم انتقل إلى بيت عائشة، واستمرّ به المرض أياماً وثقل عليه (ص). وعلم أن بعضاً من أكابر الصحابة قد تأخر عن جيش أسامة، فاستدعاهم وجمعهم في المسجد، ثم قال (ص) : «ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة؟!» قالوا: بلى يا رسول الله.
قال (ص) : «فلمَ تأخرتم عن أمري؟».
فقال أحدهم: إنني كنت خرجت ثم عدت لأُجدّد([4]) بك عهداً، وقال الآخر: يا رسول الله، لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب.
فقال النبي(ص) : «فأنفذوا جيش أسامة فأنفذوا جيش أسامة» يكررها ثلاثاً، ثم أغمي عليه (ص). ولما أفاق (ص) قال:
«إيتوني بدواة وكتف، أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي أبداً»، فقام بعض من حضر يلتمس دواةً وكتفاً، فقال له أحد الصحابة: ارجع، فإنه يهجر([5])!!
إلى الرفيق الأعلى:
ثم ثقل (ص) وحضره الموت وأمير المؤمنين(ع) حاضر عنده، فلما قرب خروج نفسه قال له (ص): «ضع رأسي يا علي في حجرك، فقد جاء أمر الله عز وجل فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجّهني إلى القبلة وتولّ أمري وصلّ عليّ أول الناس، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي، واستعن بالله تعالى»([6]).
وهكذا فعل أمير المؤمنين(ع) ، فأكبت فاطمة عليهاالسلام تنظر في وجهه وتندبه وتبكي، وهي تقول:
|
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه |
|
ثمال اليتامى عصمة للأرامل |
ففتح رسول الله(ص) عينيه، وقال: Sيا بنية، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقوليه، ولكن قولي: (وَمَا مُحَمّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفإِنْ مّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىَ أَعْقَابِكُمْ)([7]) فبكت طويلاً، فأومأ إليها بالدنوّ منه، فدنت فأسرّ إليها شيئاً، تهلل له وجهها.
ثم قضى (ص) ، ثم وجهه أمير المؤمنين(ع) وغمض عينيه ومدّ عليه إزاره، واشتغل بالنظر في أمره. وغسله (ع) والفضل بن العباس يناوله الماء، وتولّى تحنيطه وتكفينه ولما فرغ من غسله وتجهيزه تقدم فصلى عليه وحده لم يشركه معه أحد في الصلاة عليه.
وكان المسلمون في المسجد يخوضون فيمن يؤمّهم في الصلاة عليه، وأين يدفن؟! فخرج إليهم أمير المؤمنين(ع) فقال لهم:
«إن رسول الله(ص) إمامنا حياً أو ميتاً»، فيدخل إليه فوج إثر فوج فيصلون عليه بغير إمام فينصرفون، ثم أردف (ع) قائلاً: «وإن الله تعالى لم يقبض نبياً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه، وإني دافنه في حجرته التي قبض فيها»، فسلم القوم لذلك ورضوا به.
ونزل علي (ع) القبر، فكشف عن وجه رسول الله(ص) ووضع خده على الأرض موجهاً إلى القبلة على يمينه، ثم وضع عليه اللبن وهال عليه التراب.
فسلام عليك يا رسول الله يوم ولدت، ويوم مت، ويوم تبعث حياً، اللهم ارزقنا شفاعته، وارفع درجته، وقرّب وسيلته، واحشرنا معه وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
([2]) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة باتجاه الشام. (معجم البلدان: 128).
([4]) صحيح البخاري 1: 172 ب46، وصحيح مسلم 1: 313 ح94 و95، وروى هذا الحديث أيضاً البيهقي في دلائل النبوة 7: 186.
([5]) الإرشاد 1: 184، والهلال العاري: في كتابه 2: 794، والنيشابوري في الإيضاح: 259، والطبري 3: 192-193 وبثلاثة طرق، وروي الحديث في البحار: 30/70/73 بخمس طرق عن البخاري وطريقين عن الجمع بين الصحيحين، وبثلاثة طرق عن صحيح مسلم، منها مسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسائرها عن ابن عباس.
أربعينية الإمام الحسين (ع)(20/ صفر / السنة 61 هـ)
لقد سرّ يزيد قتل الحسين(ع) ومن معه وسبي حرم رسول الله(ص) ([1])، وظهر عليه السرور في مجلسه، فلم يبال بإلحاده وكفره، حين تمثل بشعر ابن الزبعرى:
|
ليت أشياخي ببدر شهدوا |
|
جزع الخزرج من وقع الأسل |
حتى قال:
|
لعبت هاشم بالملك فلا |
|
خبر جاء ولا وحي نزل |
ولم يدم سرور يزيد طويلاً ولا سيما بعدما أحدثته خطبة السيدة العظيمة زينب وخطبة الإمام السجاد(ع) ، من أثر عظيم بين الناس بما وضحته من الحقائق التي سعى يزيد إلى إخفائها فعاب عليه خاصته وأهل بيته ونساؤه ذلك. واستنكر الناس بأجمعهم ما ارتكبه يزيد من جرائم فظيعة في قسوتها وانقلابها على كل مفاهيم الدين العظيم ولا سيما أنها تمت بمرأى من الصحابة، فأقرفتهم الجريمة وضاقوا بيزيد ذرعاً مع ما عليه من فسق وفجور وتحدٍّ لحدود الله.
عندها خشي يزيد الفتنة، وانقلاب الأمر عليه؛ عجل بإخراج السجاد(ع) والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم المدينة، وهيأ لهم ما يريدون، وأمر النعمان ابن بشير وجماعة معه أن يسيروا معهم إلى مدينة جدهم مع الرفق([2]).
فلما وصلوا إلى العراق قالوا للدليل: مُرَّ بنا على كربلاء. فوصلوا إلى مصرع الحسين(ع) فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالاً من آل الرسول (ص) وردوا لزيارة قبر الحسين(ع) ، فتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا في كربلاء ينوحون على الحسين(ع) ثلاثة أيام([3]).
ووقف جابر الأنصاري على القبر فأجهش بالبكاء وقال: «يا حسين..» ثلاثاً.
ثم قال: «حبيب لا يجيب حبيبه! وأنّى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك، وفُرِّق بين رأسك وبدنك، فأشهد أنك ابن خاتم النبيين، وابن سيد المؤمنين، وابن حليف التقوى، وسليل الهدى، وخامس أصحاب الكساء، وابن سيد النقباء، وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء..
وما لك لا تكون كذلك وقد غذّتك كف سيد المرسلين، ورُبِّيت في حجر المتقين، ورُضعت من ثدي الإيمان، وفُطمت بالإسلام، فطبت حياً وطبت ميتاً، غير أنّ قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاكة في الخيرة لك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا».
ثم جال ببصره حول القبر، وقال: «السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلّت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، وجاهدتم الملحدين، وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين».
ثم قال: والذي بعث محمداً (ص) بالحق نبياً، لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه.
فقال له عطية العوفي: كيف! ولم نهبط وادياً ولم نعلُ جبلاً ولم نضرب بسيف، والقوم فُرِّق بين رؤوسهم وأبدانهم وأُوتمت أولادهم وأُرملت الأزواج؟!
فقال له: «إني سمعت حبيبي رسول الله(ص) يقول: من أحب قوماً كان معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمداً بالحق نبياً إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه»([4]).
رأس الحسين(ع) مع رؤوس أهل بيته وأصحابه تعاد للأجساد
لما عرف زين العابدين(ع) الموافقة من يزيد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها، فلم يرفض يزيد رغبة الإمام (ع) ، فدفع إليه رأس الحسين مع رؤوس أهل بيته وصحبه فألحقها بالأبدان.
وقد نصّ على مجيء علي بن الحسين السجاد(ع) بالرؤوس إلى كربلاء، المصادر التالية من علماء العامة:
1- قال ابن شهر آشوب في (المناقب: 2/200): «ذكر المرتضى في بعض رسائله أن رأس الحسين أعيد إلى بدنه في كربلاء».
2- والقزويني في (عجائب المخلوقات: 67)، قال: «في العشرين من صفر ردّ رأس الحسين(ع) إلى جثته».
3- وفي (تذكرة الخواص) لسبط ابن الجوزي: 150، قال: «الأشهر أنه رُدَّ إلى كربلاء فدفن مع الحسين».
وبناء على ذلك فإنه لا يعبأ بما يقال خلافه من أن الرأس قد دفن في مكان آخر بعيداً عن الجسد. ولعلّ من الجميل إيراد ما تمثله أبو بكر الآلوسي عندما طُرحت عليه هذه المسألة، فعبّر عن شدّة ولائه وحبه للحسين بغض النظر عن محلّ دفن الرأس، قائلاً هذين البيتين:
|
لا تطلبوا رأس الحسين |
|
بشرق أرض أو بغرب |
أما من علماء الإمامية فنذكر منهم: الفتال في (روضة الواعظين: 165)، وابن نما الحلي في (مثير الأحزان)، وابن طاووس في (اللهوف: 112) حيث قال: «عليه عمل الإمامية». والطبرسي في (إعلام الورى: 151)، و(مقتل العوالم: 154)، حيث قال: «إنه المشهور بين العلماء».
وأخيراً، يستحب في هذا اليوم زيارة الحسين(ع) والمعروف بزيارة الأربعين. وقد حثّ عليها الأئمة(ع)، فقد روي عن الإمام العسكري(ع) قوله:
«علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»([5]).
سقوط الأندلس ( 17/ صفر / السنة 636 هـ )
سقطت الأندلس في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر عام 636هـ، وفي هذا اليوم، حيث وقع الاتفاق بين زيان وملك الروم خايمي، إلا أن خايمي دخل دخول الفاتحين هو وجنده إلى بلنسة في يوم الجمعة (27 صفر سنة 636هـ)، الموافق لليوم التاسع من أكتوبر سنة (1238م).
فكانت بلنسية، بعد قرطبة ثانية القواعد الأندلسية العظيمة التي سقطت في تلك الفترة في أيدي الأسبان، وقد كان انهيارها في القواعد الأولى من الصرح الأندلسي الشامخ مقدمة لانهيار معظم القواعد الباقية تباعاً في فترة قصيرة، لا تتجاوز العشرة أعوام.
وجدير بالذكر أن المسلمين في كل الأمصار التي احتلوها لم يذكر عنهم أنهم تنبأوا بمصيرها سوى الأندلس.
فقد شعر المسلمون بأنّ نجمهم بدأ يأفل في الأندلس منذ بدأت الطوائف في أواخر القرن الخامس الهجري في دويلات، فقد أخذ المسلمون يترقّبون ذلك اليوم الذي سيغادرون فيه إسبانيا (الأندلس)، مما ألجأ الكثير منهم إلى التحالف مع العرب في المغرب العربي وعبر البحر.
فعقب سقوط طليطلة (478هـ /1085م) واشتداد الوطأة النصرانية على ملوك الطوائف، صارت الكارثة قاب قوسين أو أدنى، استنجد المسلمون بإخوانهم المغاربة عبر البحر (المرابطين)، واستجاب المرابطون إلى غوث إخوانهم في الأندلس وعبروا البحر إلى إسبانيا، والتقوا بالجيوش النصرانية إلى جانب الطوائف الضئيلة في موقعة الزلاقة الكبرى، وأحرزوا فيها نصرهم الباهر بسحق جيوش النصرانية (479هـ/1086م)، وأنقذت الأندلس بذلك من الفناء المحقق، ثم استولى المرابطون على الأندلس، وحكموها زهاء نصف قرن آخر، وخلفهم الموحدون وحكموا زهاء قرن آخر، ثم جاشت الأندلس بالثورة ضد حكامها المغاربة، واجتمعت فلول الثورة آخر الأمر في الجنوب، حيث قامت مملكة غرناطة آخر الممالك الأندلسية، وقدر لها أن تعيش مائتين وخمسين عاماً أخرى.
وقد ورد الإنذار بالخطر على الأندلس، قبل سقوط طليطلة، في أقوال ابن حيان المؤرخ الأندلسي الكبير في تعليقه على موقعة (بريشتر) من أعمال الثغر الأعلى (أراغون) وسقوطها في يد النصارى سنة (456هـ/1063م) في وابل من القتل والسبي وشنيع الاعتداء.
ولما سقطت طليطلة وارتجت الأندلس فرقاً ورعباً، قال شاعرهم:
|
يا أهل الأندلس شدّوا رحالكم |
|
فما المقام بها إلا من الغلط |
وكان آخر ملوك غرناطة لا يجازفون بالذهاب إلى الحج خوفاً من وقوع المكروه والهجوم عليها من قبل النصارى، وكانوا يكتفون بكتابة الرسائل إلى التربة النبوية، ويرسلون المصاحف المذهبة كهدايا.
وعندما نرجع إلى التاريخ نجد أن سبب النكبة في الأندلس، هو انفصال الأندلس عن الدولة الإسلامية وقيامها ككيان مستقل لا تربطه بالقاعدة أية رابطة.
فالإسلام الذي حرّر أوروبا ابتداءً من الأندلس إلى جنوب فرنسا والذي كان يتوقع له أن يجتاز كل أوروبا توقف أولاً ثم عاد إلى الانحسار في الوقت الذي وصل فيه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إلى الأندلس، فقامت الفتن بين المسلمين داخل إسبانيا وانشغلوا في تعزيز الانفصام عن جسد الدولة الإسلامية، ومنذ ذلك اليوم وقفت الأندلس لوحدها في مواجهة أوروبا الغربية كلها، ولم تعد الدولة الأم مسؤولة عنها، وصار عليها أن تواجه مصيرها بنفسها.
آن لنا أن نعيد النظر في دراسة التاريخ ونواجه الحقائق كما هي فلا نتغاضى عنها، وأن نأخذ من كل ذلك العبرة، وما أكثر ما يمكن أن نأخذ منه العبر([1]).
شهادة محمد بن أبي بكر (والي علي بن أبي طالب (ع) على مصر)(14/ صفر / السنة 37 هـ)
ولادته ونشأته
نشأ محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، في بيت النبوة والخلافة، في بيت تربّى فيه الحسن والحسين(ع) . وترعرع عندهم وهو يرتشف من منهل أخلاقهم ويسمو بعزّ فضائلهم، وشرف مكانتهم.
ربّاه أمير المؤمنين(ع) كأحد أبنائه ينفق عليه كما ينفق عليهم ويعلمه كما يعلمهم، وقد قال (ع) : «محمد ابني من ظهر أبي بكر»([1]).
فشبّ وهو عارف بحقيقة أهل البيت(عليهم اسلام)، ومكانتهم من الله ورسوله، وفضلهم على بقية الناس، وخصائصهم التي خصّهم الله تعالى بها.
روى ابن سعد في (طبقاته): إنّ أبا بكر تزوّج أسماء بنت عميس فولدت له محمداً، ثم توفي عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب فأنجبت له يحيى.
وقد رضع محمد بن أبي بكر الولاء والحب لأهل بيت النبوة(عليهم اسلام) من ثدي أمه، وتعلم الإسلام والإيمان من مربيه علي(ع).
وقعة الجمل:
شهد محمد بن أبي بكر وقعة الجمل، وقاتل بكل بسالة وشجاعة إلى جانب مولاه أمير المؤمنين(ع) . ولما استعر القتال واشتبكت الصفوف، نادى أمير المؤمنين(ع) بعقر الناقة.
فكان محمد بن أبي بكر من بين المتقدمين في الصفوف لعقر الناقة، وبعد أن عقرت، وفرّ أصحاب الجمل، قطع محمد بن أبي بكر البطان وأخرج الهودج، فقالت عائشة: من أنت؟
فقال محمد: أبغض أهلك إليك.
فقالت عائشة: ابن الخثعمية.
فقال محمد: نعم، ولم تكن دون أمهاتك.
فقالت عائشة: لعمري، بل هي شريفة، دع عنك هذا، الحمد لله الذي سلمك.
فقال محمد: قد كان ذلك ما تكرهين.
فقالت عائشة: يا أخي لو كرهته ما قلته.
فقال محمد: كنت تحبين الظّفر، وأني قتلت؟
فقالت عائشة: قد كنت أحب ذلك، ولكنه لما صرنا إلى ما صرنا إليه، أحببت سلامتك لقرابتي منك، فاكفف ولا تعقب الأمور، وخذ الظاهر ولا تكن لومة ولا عذلة، فإنّ أباك لم يكن لومة ولا عذلة([2]).
ولايته على مصر:
ولّى أمير المؤمنين محمد بن أبي بكر على مصر، بعد أن عزل عنها واليها قيس بن سعد([3]).
ولما وصل محمد بن أبي بكر إلى مصر قرأ على أهلها كتاب أمير المؤمنين(ع):
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولاّه مصر وأمره بتقوى الله في السر والعلانية وخوف الله عز وجل في الغيب والمشهد وباللين على المسلمين، وبالغلظة على الفجار، وبالعدل على أهل الذمّة، وبإنصاف المظلوم، وبالشدة على الظالم، وبالعفو عن الناس، وبالإحسان ما استطاع، والله يجزي المحسنين..» إلى آخر الكتاب.
ثم إن محمد بن أبي بكر قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
«الحمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختلف فيه من الحق، وبصرنا وإياكم كثيراً مما عمي عنه الجاهلون.
ألا إن أمير المؤمنين ولاّني أمركم وعهد إليّ ما قد سمعتم، وأوصاني بكثير منه مشافهة، ولن آلوكم خيراً ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، فإن يكن ما ترون من إمارتي وأعمالي طاعة لله وتقوى فاحمدوا الله عز وجل ما كان من ذلك فإنه هو الهادي، وإن رأيتم عاملاً لي عمل غير الحق زائغاً فارفعوا إليّ وعاتبوني فيه، فإني بذلك أسعد وأنتم بذلك جديرون»([4]).
ولم يتخذ محمد بن أبي بكر مواقف حازمة تجاه الأوضاع في مصر، لا سيما تجاه الذين اعتزلوا عن قبول ولايته وخلافة أمير المؤمنين(ع) ، وعملوا على بث الدعايات المغرضة المطالبة بدم عثمان مما أضعف مركز محمد بن أبي بكر ووصلت أخبار ذلك وانفضاض أهل مصر من حول محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين(ع) فبعث مالك الأشتر والياً عليها، فعظم ذلك الخبر على معاوية لمعرفته بمقام مالك وسعى لقتله بكل وسيلة لئلا يصل إلى مصر.
فبعث معاوية إلى الجايستار رجلاً من أهل الخراج، فقال له: إنّ الأشتر قد ولي مصر فإن أنت كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت. فخرج الجايستار حتى أتى القلزم، وكان الأشتر قد خرج من العراق إلى مصر، فلما انتهى إلى القلزم استقبله الجايستار فقال له: هذا منزل وهذا طعام وعلف. فنزل به الأشتر، وأتاه الرجل بعسل جعل فيه سم، فسقاه إياه فلما شربها مات. ولما سمع معاوية بن أبي سفيان ذلك قال: إن لله جنوداً من عسل. ثم أقبل على أهل الشام، وقال: كان لعلي بن أبي طالب يمينان أحدهما قطعت في صفين وهو عمار بن ياسر، والآن قطعت الثانية وهو مالك الأشتر([5]).
خبر شهادة محمد بن أبي بكر
وأما مسلمة بن مخلد ومن شايعه من العثمانية في مصر فقد كتبوا كتاباً إلى معاوية بن أبي سفيان: عجّل علينا خيلك ورجلك.
فقال معاوية لعمرو بن العاص: تجهز يا أبا عبد الله.
فبعثه إلى مصر في ستة آلاف رجل، فلما وصل عمرو بن العاص إلى مصر، اجتمعت إليه العثمانية، وكتب إلى محمد بن أبي بكر كتاباً:
«أما بعد؛ فتنحّ عني بدمك يا ابن أبي بكر فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر، إنّ الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك...».
فلما قرأ محمد بن أبي بكر الكتاب، كتب كتاباً إلى أمير المؤمنين(ع) يطلب فيه العون والمدد، ويخبره بالموقف عنده.
وبعد أن وصله كتاب أمير المؤمنين(ع) كتب إلى معاوية يردّ فيه بما قاله، وينتدب لقتاله، ثم قام خطيباً في الناس، يحضّهم فيه على جهاد أعداء الله.
فانتدب معه نحو ألفي رجل، وخرج محمد بن أبي بكر لمقاتلة الخارجين عليه. وكان على رأس جيش الشام عمرو بن العاص الذي خرج لقتال محمد ابن أبي بكر.
والتقى الجيشان ودارت بينهما معركة عظيمة، فكانت الغلبة في البداية لجيش محمد، إلا أن عمرو بن العاص استنجد بجيش الشام، فجاءه المدد وكان يفوق جيش محمد أضعافاً، فاحتوشوا جيش محمد من كل مكان وقتلوا معظم رجاله وفرّ الباقون، وانسحب محمد بن أبي بكر.
فخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بن أبي بكر، فمرّ في قوم في قارعة الطريق فسألهم: هل لمح أحدكم غريباً؟ فقال أحدهم: إني دخلت الخربة فوجدت فيها رجلاً جالساً. فقال ابن حديج: هو وربّ الكعبة. فانطلقوا يركضون حتى دخلوا عليه فاستخرجوه وقد أهلكه العطش، فطلب محمد أن يشرب، فقال له ابن حديج بوجود عمرو بن العاص: لا سقاه الله من سقاك قطرة، منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائماً، ثم قتله وألقاه في جيفة حمار وألقاه في النار وهو حي.
وقيل إن معاوية بن حديج قطع رأس محمد بن أبي بكر وأرسله إلى معاوية ابن أبي سفيان بدمشق، وطيف برأسه وهو أول رأس طيف به في الإسلام([6]).
([2]) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 2: 404.
([3]) أعيان الشيعة السيد محسن الأمين 1: 137.
([4]) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد 6: 66.
وقعة النهروان بين الخوارج والإمام علي بن أبي طالب (ع)(9/ صفر / السنة 38 هـ)
النهروان موقع بين بغداد وحلوان من محافظة في العراق بعد بعقوبة إلى خانقين، وفيها جرت الوقعة المعروفة بين الإمام علي أمير المؤمنين(ع) والخوارج.
والخوارج، هم الذين أنكروا التحكيم الذي وقع بعد معركة صفين، واتخذت حركتهم بعد أن تحرك موكب الإمام من صفين شكلاً جديداً، فاعترفوا بخطئهم في قبول التحكيم وأعلنوا توبتهم وجاءوا إلى أمير المؤمنين(ع) يطلبون منه أن يتراجع ويتوب كما تابوا. فلم يستجب لطلبهم لأنه لم يخطئ إنما خالفوا أمره الذي تابوا إليه الآن، فانفصلوا عنه قبل أن يدخل الكوفة في مكان يدعى حروراء، ومن أجل ذلك سمّاهم المؤرخون بالحرورية([1])، وسُمّوا بالخوارج لأنهم خرجوا على إمامهم أمير المؤمنين(ع) ، وقد رفعوا شعاراً: «لا حكم إلا لله».
بعد أن رفع الخوارج شعارهم ذلك، حاورهم أمير المؤمنين(ع) بالتي هي أحسن وفنّد معتقداتهم وآراءهم، إلاّ أنهم لم يصغوا إلى توجيهات أمير المؤمنين(ع) واستمرّوا في غيّهم، وتعاظم خطرهم بعد انضمام أعداد جديدة لمعسكرهم، وراحوا يعلنون القول بشرك المنتمين إلى معسكر الإمام علي(ع) ، بالإضافة إلى الإمام (ع) ورأوا استباحة دمائهم!
وقد كان أمير المؤمنين(ع) عازماً على عدم التعرّض لهم ابتداءً، ليمنحهم فرصة التفكير جدياً بما أقدموا عليه عسى أن يعودوا إلى الرأي السديد.
ولكن هذه الفئة الخارجة عن الطاعة المارقة عن الدين تمادت في غيّها فقامت بقتل الأبرياء وتهديد أمن البلاد، وقد قتلوا الصحابي عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجه الحامل، كما قتلوا نسوة من طي.
وعندما أرسل إليهم الإمام (ع) الحارث بن مرّة العبدي ليتعرّف على حقيقة موقفهم، قتلوا رسول أمير المؤمنين(ع) .
وعندها كرّ (ع) راجعاً من الأنبار (حيث كان اتخذها مركزاً لتجميع قواته المتجهة نحو الشام) وتوجه إلى قتالهم، والتقى الجيشان فأمر الإمام (ع) أصحابه بالكفّ عنهم حتى يبدؤوا القتال.
فتنادى الخوارج من كلّ جانب: «الرواح إلى الجنة»، وشهروا السلاح على أصحابه وأثخنوهم بالجراح، فاستقبلهم الرماة بالنبال والسهام، وشدّ عليهم أمير المؤمنين(ع) وأصحابه فما هي إلا سويعات حتى صرعهم الله كأنما قيل لهم: موتوا فماتوا..
ومن كرامات أمير المؤمنين(ع) في هذه الوقعة أنه كان قد أخبر أصحابه قبل المعركة بأنه لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة، وكان الأمر كما أخبرهم، فلم ينج منهم إلا تسعة أو ثمانية، ولم يقتل من أصحابه إلا تسعة كما روى ذلك أكثر المؤرخين.
وهنا يروي المؤرخون حديث المُخْدَج المعروف بـ(ذي الثديَّة)، أحد القتلى في هذه المعركة، حيث كان النبي(ص) قد أخبر أمير المؤمنين(ع) بقتل الخوارج وقتل المُخْدَج
معهم، لذلك فإنه بعد انتهاء المعركة فتش عنه وألحّ في طلبه حتى وجدوه بين القتلى، وهو يقول (ع) : «والله ما كَذبت ولا كُذبت»([2]).
فكانت من كرامات أمير المؤمنين(ع) الباهرة التي أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون.
([1]) سيرة الأئمة الاثني عشر 1: 441.
([2]) أشار إلى نحوه أبو يعلى في (مسنده) 1: 371- 374، وابن أبي الحديد في (شرح النهج) 2: 276، ونقله المجلسي في (البحار) 41: 283، ورواه المفيد في (الإرشاد) 1: 371.
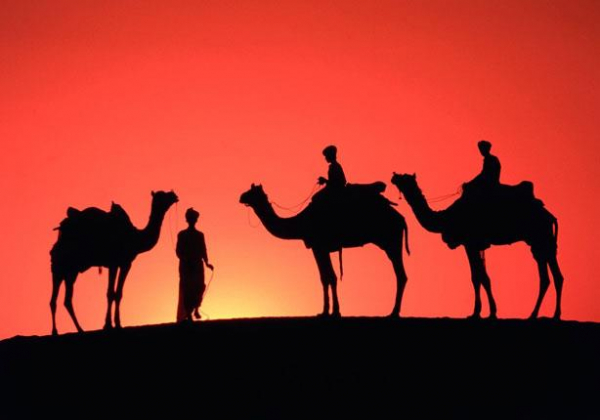
![واقعة الحرة([1]) (28/صفر/السنة 63 هـ)](/ar/media/k2/items/cache/461510d20e2dc56b9cb56e9d1e4b11ea_Generic.jpg)
![شهادة الإمام علي الرضا (ع)([1]) (على رواية الطبـرسي وابن الأثير)(29/ صفر /السنة 203هـ)](/ar/media/k2/items/cache/709c2188730d4b5dd12f70667014177e_Generic.jpg)
![شهادة الإمام علي الرضا (ع)([1]) (على رواية الطبـرسي وابن الأثير)(29/ صفر /السنة 203هـ)](/ar/media/k2/items/cache/db9007420d2f9e87779d774487d3111b_Generic.jpg)